يعرض الكتاب موضوعًا من أشد الموضوعات التي تحتاجها الأمة اليوم، ألا وهو “فقه النصر والتمكين”، وما يميز هذا الكتاب المنهج الذي اتبعه الكاتب في العرض، من خلال التأصيل والتفصيل، والجمع بين الماضي والحاضر، ثم الربط بين الأسباب المادية والأسباب المعنوية، والمزاوجة بين المفاهيم النظرية والخطوات والنماذج التطبيقية على أرض الواقع، لذلك جاء الطرح متوازنًا؛ بعيدًا عن التنظير المثالي، أو الإغراق في التفاؤل.
تعريف بالكتاب:
يتناول الكتاب موضوع فقه النصر والتمكين، وأهميته ودوره الجوهري في حياة الأمة الإسلامية، حيث يناقش بالتفصيل هذا المفهوم من منظور إسلامي، ويعرض أنواعه، ويشرح أسبابه وشروطه، ثم يستعرض مراحل النصر والتمكين، وأهداف كل مرحلة.
يقع الكتاب في 534 صفحة، وقد صدر عن دار المعرفة في بيروت لبنان عام 2014م.
تعريف بالمؤلف:
علي محمد الصلَّابي، ولد في مدينة بنغازي في ليبيا عام (1383هـ/ 1963م).
حصل على الإجازة الجامعية من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة المدينة المنورة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة أم درمان بالسودان، قسم التفسير وعلوم القرآن.
صدرت له مؤلفات كثيرة؛ منها: (السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا، الوسطية في القرآن الكريم).
عرض الكتاب:
يبدأ المؤلف كتابه بتمهيد يوضح فيه معنى الكلمات الثلاث المُشَكِّلة لعنوان الكتاب (الفقه – التمكين – القرآن)، حيث يتناول معاني هذه الكلمات في اللغة والاصطلاح، وتطور معانيها عبر التاريخ، ثم ينتقل إلى عرض الكتاب الذي يتكون من ثلاثة أبواب:
» الباب الأول: أنواع التمكين في القرآن الكريم.
» الباب الثاني: شروط التمكين وأسبابه.
» الباب الثالث: مراحل التمكين وأهدافه.
ويتوزع كل باب من الأبواب الثلاثة على عدة فصول، تندرج تحتها أفكار الباب، وتنسجم فيما بينها لتوضح المعنى المراد.
الباب الأول- أنواع التمكين في القرآن الكريم:
يبدأ الكاتب بالتأكيد على نقطة جوهرية يغفُل عنها الكثير من الناس، حيث يقصرون معنى النصر على صورة معيَّنة معهودة لديهم، قريبة الرؤية لأعينهم، ولكنَّ صور النصر في الحقيقة شتّى، وقد يلتبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة، فإبراهيم عليه السلام وهو يُلقى في النار، ويحيى عليه السلام وهو يُنشر بالمنشار، وأصحاب الأخدود، هل كانوا في موقف نصر أم هزيمة؟ ما من شك -في منطق العقيدة- أنهم كانوا في قمة النصر.
إن النصر والتمكين للمؤمنين له صور متنوعة؛ من أهمها: تبليغ الرسالة، وهزيمة الأعداء، وإقامة الدولة.
الفصل الأول- تبليغ الرسالة وأداء الأمانة:
إن من أنواع التمكين التي ذكرت في القرآن الكريم: تمكين الله تعالى للدعاة بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، واستجابة الخلق لهم، وقد أشار القرآن الكريم إلى ثلاثة نماذج منها:
1. أصحاب القرية: تعرض القصة نموذجًا لقرية لم يستجب أهلها لدعوة المرسلين، ومضوا في كفرهم وعنادهم، بل هددوا المرسلين بالرجم والعذاب الأليم. ولكن رغم ذلك فإن المرسلين نُصِروا نصرًا مؤزرًا، والمتأمل للآيات يتضح له ذلك بشكل جليّ.
2. أصحاب الأخدود: إن قصة الغلام مع الملك الكافر من أوضح القصص في تمكين الله تعالى للدعاة في تبليغ رسالتهم وأداء أمانتهم. في حساب الأرض تبدو خاتمة القصة أليمة أسيفة، ولكنّ القرآن يُعَلِّم المؤمنين شيئًا آخر؛ وهو أن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ومتاع ليست هي القيمة الكبرى في الميزان التي تقرر حساب الربح والخسارة، إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة، والمتأمل في قصة الغلام يجد أنه انتصر بعقيدته ومنهجه، وكذلك الراهب ثبت وزهقت روحه من أجل أن تبقى عقيدته، أما جليس الملك (الأعمى) فقد انتصر مرتين: الأولى عندما تخلى عن مكانته عند الملك مع ما فيها من عزّ وجاه، والثانية عندما تخلى عن حياته مقابل العقيدة.
3. تمكين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة في مكة: تعرض قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصيحة الأولى في مكة إلى أن رجع إليها فاتحًا، صورة من أوضح الصور في تمكين الله لعباده، رغم الصد والإيذاء الذي تعرض له وأصحابه من قبل المشركين، وهذا ديدن المكذبين في كل زمان ومكان.
إن النبي صلى الله عليه وسلم في طور المرحلة المكية قام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة خير قيام، اهتم فيها ببناء الفرد المسلم الذي يحمل تكاليف الدعوة ويضحي من أجلها، وعلى هذا النهج سار الكثير من الدعاة من أمته على مر العصور، كالإمام أحمد بن حنبل، وابن تيمية، والعزّ بن عبد السلام، وغيرهم.
تعرض قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصيحة الأولى في مكة إلى أن رجع إليها فاتحًا، صورة من أوضح الصور في تمكين الله لعباده، رغم الصد والإيذاء الذي تعرض له وأصحابه من قبل المشركين، وهذا ديدن المكذبين في كل زمان ومكان.
الفصل الثاني- هلاك الكفار ونجاة المؤمنين أو نصرهم في المعارك:
يعرض لنا القرآن الكريم أربعة نماذج: نوح وموسى وطالوت والنبي صلى الله عليه وسلم.
إن قصة نوح عليه السلام ملأى بالدروس، وهي نموذج رفيع للتدليل على أن من أنواع التمكين هلاك الكفار ونجاة المؤمنين، ومما يكسبها أهمية خاصة ما تميزت به؛ من أن نوحًا أول الرسل إلى البشر، وهو من أولي العزم، وقضى في دعوة قومه مدة طويلة (950 سنة)، كما ورد اسمه كثيرًا في القرآن (43 مرة في 29 سورة).
وأما قصة موسى مع فرعون فتبين ضراوة الصراع بين الحق والباطل، وتسلط الضوء على استكبار فرعون وتجبره، واستعباده عباد الله واستضعافهم، وكيف أراد الله لبني إسرائيل أن يرد إليهم حريتهم المسلوبة وكرامتهم المغصوبة.
وكانت قصة طالوت مع بني إسرائيل من أروع القصص القرآني في بيان سنن الله في النهوض بالأمم المستضعفة، وما هي السمات المطلوبة للقيادة التي تتصدى لمثل هذه الأعمال العظيمة، لتقوية الشعوب والنهوض بها نحو المعالي، وفق منهج رباني، ووسائل عملية وتربوية عميقة على معاني الطاعة والثبات والتضحية من أجل العقيدة الصحيحة.
وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أيضًا هذا النوع من التمكين ألا وهو النصر على الأعداء، فبعد أن هاجر إلى المدينة قدّر ظرفه وزمانه ومكانه، وجهز قوات جهادية حققت أهدافها القريبة والبعيدة، معتمدًا على الله في ذلك، آخذًا بالأسباب التي أمره الله بها، فترك لنا معالم نيّرة في مغازيه الميمونة، ودروسًا عظيمة في كيفية تحقيق النصر على الأعداء، والتمكين لدين الله.
كانت قصة طالوت مع بني إسرائيل من أروع القصص القرآني في بيان سنن الله في النهوض بالأمم المستضعفة، والسمات المطلوبة للقيادة التي تتصدى لمثل هذه الأعمال العظيمة؛ لتقوية الشعوب والنهوض بها نحو المعالي، وفق منهج رباني، ووسائل عملية وتربوية عميقة على معاني الطاعة والثبات والتضحية من أجل العقيدة الصحيحة.
الفصل الثالث- مشاركة الكفار أو الظلمة في الحكم:
» المبحث الأول- أدلة المانعين والقائلين بالجواز بالمشاركة في الحكم:
أولاً- أدلة المانعين المشاركة في الحكم، من أهمها:
1. النصوص الحاكمة على مَن لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق. كقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]. وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]. وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47].
2. أن الحاكمية يجب أن تكون لله وحده. قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف: 40].
3. نهي المؤمنين أن يحتكموا إلى شريعة غير شريعة الله، وجعل ذلك منافيًا للإيمان.
4. في المشاركة في الحكم غير الإسلامي مفاسد عظيمة، فالذين لا يُحَكِّمون شرع الله يحادّون الله في أمره، وينازعونه في حكمه.
5. طاعة الحكام فيما يشرعونه مخالفين أمر الله تعني اتخاذهم أربابًا من دون الله.
6. المشاركة في هذا الحكم فيها ركون إلى الظلمة، وإطالة في عمرهم.
ثانيًا- أدلة القائلين بالجواز:
قالوا إن الأصل عدم المشاركة، ولكن هناك حالات استثنائية أباحت الشريعة فيها المشاركة، واستدلوا بأدلة من أهمها: دخول يوسف عليه السلام في الوزارة، يقول ابن تيمية: “ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكنه فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يمكن أن يناله بدون ذلك”.
» المبحث الثاني- شواهد من التاريخ الحديث في المشاركة:
استطاع الإسلاميون في بعض بلدان العالم الإسلامي أن يدخلوا بعض الوزارات عن طريق الانتخابات والأحلاف، ورغم الجدل الذي دار حولها، إلا أنها راعت القواعد الشرعية في مبادئ المصالح والمفاسد، وحاولت جاهدة أن تلتزم بقواعد الضرورة، ومصلحة العمل الإسلامي، ومصالح المسلمين في هذه الأقطار. ومن أهم هذه التجارب: الحركة الإسلامية في الأردن، والحركة الإسلامية في اليمن، والحركة الإسلامية في تركيا.
الفصل الرابع- إقامة الدولة:
» المبحث الأول- تمكين الله تعالى لداوود وسليمان عليهما السلام:
تعرض قصة داوود صفات الحاكم المؤمن الذي مكّن الله له، ومن أهمها: الصبر، والعبودية، والقوة على أداء الطاعة، والرجّاع إلى الله بالطاعة في أموره كلها، وقوة الملك، والحكمة، وحسن الفصل في الخصومات.
بهذه الصفات أعاد داوود لبني إسرائيل دولتهم وعزهم، وعلى ذلك سار ابنه من بعده سليمان عليه السلام، الذي وصفه القرآن بكونه أوابًا إلى الله، وقد أكرمه الله بالملك والنبوة، وأعطاه الفهم الثاقب وسداد الرأي ورجاحة العقل.
لقد تسلم سليمان قيادة دولة قوية أسست على الإيمان والتوحيد، وأوتي الملك الواسع والسلطان العظيم بحيث لم يُؤتَ أحدٌ مثلما أوتي، ولكنه أعطي قبل ذلك عطاء أعظم وأكرم، هيأه لأن يكون شخصية فريدة متميزة في التاريخ؛ لقد أعطي النبوة، ومُنح العلم، وأوتي الحكمة. إنه يمثل صفحة من أنصع الصفحات المشرقة في عصور بني إسرائيل الذهبية أيام كانوا على الدين الصحيح.
تعرض قصة داوود صفات الحاكم المؤمن الذي مكّن الله له، ومن أهمها: الصبر، والعبودية، والقوة على أداء الطاعة، والرجّاع إلى الله بالطاعة في أموره كلها، وقوة الملك، والحكمة، وحسن الفصل في الخصومات. بهذه الصفات أعاد داوود لبني إسرائيل دولتهم وعزهم
» المبحث الثاني- فقه التمكين عند ذي القرنين:
المتأمل في قصة تمكين ذي القرنين يتضح له مجموعة من المعالم؛ منها:
أ. دستوره العادل: فقد التزم العدل المطلق في كل أحواله وسكناته، ولم يعامل الأمم التي تغلب عليها بالظلم والجور، بل عاملهم بمنهج العدل الرباني. لقد كان ميزان العدالة في حكمه هو التقوى والإيمان والعمل الصالح، ودائمًا ما كان يتطلع إلى مقامات الإحسان.
ب. منهجه التربوي في الشعوب: قدم ذو القرنين لكل حاكم منهجًا أساسيًا وطريقة عملية لتربية الشعوب على الاستقامة والسعي بها نحو العمل لتحقيق العبودية الكاملة لله تعالى.
ج. اهتمامه بالعلوم المادية وتوظيفها للخير: حيث وظف ذو القرنين العديد من العلوم في دولته القوية، مثل علم الجغرافيا؛ الذي وظفه في حركته مع جيوشه شرقًا وغربًا، وشمالاً وجنوبًا، كما كان صاحب خبرة ودراية بمختلف العلوم المتاحة في عصره، يدل على ذلك حسن اختياره للخامات، ومعرفته بخواصها، وإجادة استعمالها والاستفادة منها، كاستعماله للحديد والنحاس في بناء سد يأجوج ومأجوج، كما كان واقعيًا في قياسه للأمور وتدبيره لها، فلم يجعل السد من الحجارة؛ لأنه قدّر حجم الخطر، وقدّر ما يحتاج إليه من علاج، ورغم علمه بأخبار الغيب التي جاءت بها الشرائع، إلا أنه لم يتخذ منها تكئة لتبرير القعود والهوان.
الباب الثاني- شروط التمكين وأسبابه:
الفصل الأول- شروط التمكين:
إن الاستخلاف في الأرض للمؤمنين وعدٌ من الله لهم، متى ما حققوا شروطه، وهذه الشروط هي:
» أولاً: الإيمان بالله والعمل الصالح:
بيّن علماء أهل السنة أن الإيمان: هو التصديق بالقلب، والنطق بالشهادتين، والعمل بالجوارح والأركان. أي: هو اعتقاد وقول وعمل. ومعرفة المعنى الحقيقي للإيمان وشروطه تستلزم على المؤمن عدة أمور، من أهمها: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة ما جاء به من عند الله، ومحبة المؤمنين، وإيثارهم على النفس بالمال والنصرة والتأييد.
» ثانيًا: تحقيق العبادة:
العبادة في اللغة: الطاعة، وفي الشرع: خضوع وحب. وإن من شروط التمكين للأمة المسلمة أن تفهم حقيقة العبادة، وتعمل على نشر مفهومها الصحيح حتى تخرج الأمة من الأوهام والمغالطات.
ودائرة العبادات رحبة واسعة تشمل شؤون الإنسان كلها، وتستغرق كافة مناشطه وأعماله. وإن من أخطر الانحرافات التي وقعت فيها الأجيال المتأخرة من المسلمين: انحرافهم في تصور مفهوم معنى العبادة. وإذا تأملنا في مهمة العبادة يمكننا أن نستخلص منها العديد من الفوائد؛ من أهمها:
أ. تثبيت الاعتقاد: إن روح العبادة هو إشراب القلب حب الله تعالى، وهيبته، وخشيته، والشعور الغامر بأنه رب الكون ومليكه، والتوجه دائمًا بما شرع من شعائر ونسك، باعتبارها مظهرًا عمليًا دائبًا لصدق الإنسان في دعوى الإيمان، وتذكيرًا مستمرًا بسلطان الإله الأعلى، وإلهابًا متجددًا لجذوة اليقين في الله.
ب. تثبيت القيم الأخلاقية: فقد جاء المنهاج الرباني في العبادة ليتمم مكارم الأخلاق، ويدعو الناس إلى المثل العليا، والفضائل الكريمة، التي تحقق للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة.
ج. إصلاح الجانب الاجتماعي: ويظهر ذلك في الأثر العميق للعبادات في إيجاد العلاقات الاجتماعية، كالصلاة، والزكاة والحج.
» ثالثًا: محاربة الشرك:
من شروط التمكين محاربة الشرك بجميع أشكاله، لذلك يجب على الأمة أن تعرف حقيقة الشرك وخطره وأسبابه وأدلة بطلانه وأنواعه. وفي معرفة ذلك فوائد عديدة؛ منها: أن الإنسان بمعرفته للشرك يحذر من الوقوع فيه، ويحذّر غيره أيضًا، كما يظهر له بذلك حسن الإسلام والتوحيد.
وللشرك آثار وبيلة على الإنسان في الدنيا والآخرة، سواء كان فردًا أم جماعة، من أخطرها: إطفاء نور الفطرة، والقضاء على عزة النفس ومنازع النفس الرفيعة، بالإضافة إلى تمزيق وحدة النفس البشرية، وإحباط العمل.
» رابعًا: تقوى الله عز وجل:
تقوى الله لها ثمرات على الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة، من أهمها:
• السهولة واليسر في كل أمر.
• تيسير العلم النافع.
• محبة الله ومحبة ملائكته والقبول في الأرض.
• نصرة الله وتأييده وتسديده.
• البركات من السماء والأرض.
• الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم.
• حفظ الذرية بعناية الله تعالى.
• سبب للنجاة من عذاب الدنيا والآخرة.
الفصل الثاني- أسباب التمكين:
» أولاً- سنة الأخذ بالأسباب وإرشاد القرآن للإعداد:
إن العمل بسنة الأخذ بالأسباب من صميم تحقيق العبودية لله تعالى، وهو الأمر الذي خلق له العبيد، وأرسلت له الرسل، وأنزلت لأجله الكتب، وبه قامت السماوات والأرض، وله وجدت الجنة والنار. وقد اهتم القرآن الكريم اهتمامًا كبيرًا بإرشاد الأمة للأخذ بأسباب القوة، وأوجب عليهم ذلك بصورة واضحة في قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [الأنفال: 60]. يقول سيد قطب: “الإسلام يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها… فلا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الإنسان”.
» ثانيًا- الأسباب المعنوية، من أهمها:
أ. إعداد الأفراد الربانيين: رسم النبي صلى الله عليه وسلم منهجًا مميزًا في تربية الأفراد على معاني الربانية، وتحمل أداء رسالة ربِّ البرية، فكان مهتمًا ببناء القاعدة الصلبة، وتربية أتباعه على معاني العقيدة الصحيحة منذ اليوم الأول لبعثته، وزرع فيهم العديد من الصفات؛ من أهمها: الصبر، والإلحاح في الدعاء، والإخلاص، والثبات، والإيمان بالقضاء والقدر.
من أهم صفات القائد الرباني: سلامة المعتقد، والثقة بالله، والقدوة، والصدق، والكفاءة، والشجاعة، والمروءة، والحزم والإرادة القوية، والحلم، والقدرة على حل المشكلات.
ب. القيادة الربانية: من أخطر عوائق التمكين غياب القيادة الربانية، وذلك أن قادة الأمة هم عصب حياتها، وبمنزلة الرأس من جسدها، فإذا صلح القادة صلحت الأمة، وإذا فسدوا فسدت. ولقد فطن أعداء الأمة لذلك، فحرصوا على ألا يمكنوا القادة الربانيين، كتب المستشرق البريطاني “مونتجمري وات” في جريدة التايمز اللندنية قائلاً: “إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرى”.
ومن أهم صفات القائد الرباني: سلامة المعتقد، والثقة بالله، والقدوة، والصدق، والكفاءة، والشجاعة، والمروءة، والحزم والإرادة القوية، والحلم، والقدرة على حل المشكلات.
ج. محاربة أسباب الفرقة: بنوعيها؛ الداخلية والخارجية.
أما الخارجية؛ فمن أهمها: اتساع الفتوحات الإسلامية، ودخول الكثير من أبناء الشعوب الأخرى في الإسلام ولم ينصهروا في عقيدته، بالإضافة إلى اندساس أصحاب العقائد المنحرفة في الإسلام بقصد الكيد له والنيل منه.
وأما الأسباب الداخلية؛ فمن أهمها: الابتداع، والجهل، واتباع الهوى، وتحكيم العقل وتقديمه على النصوص، والهجوم القبيح على أهل السنة، ومخالفة منهجهم في النظر والاستدلال.
د. الأخذ بأصول الوحدة والاتحاد والاجتماع: فالوحدة سبيل الارتقاء وتبوء المكانة الرفيعة، ومن أهم أسباب وحدة المسلمين: وحدة العقيدة، وتحكيم الكتاب والسنة، وصدق الانتماء إلى الإسلام، وطلب الحق والتحري في طلبه، وتحقيق الأخوة بين أفراد المسلمين.
» ثالثًا- الأسباب المادية:
إذا أرادت الأمة أن تحقق النصر لا بد لها أن تهتم بالأسباب المادية، لأنها لا تقل أهمية عن الأسباب المعنوية؛ ومن أهم الأسباب المادية:
أ. التفرغ والتخصص ومراكز البحوث: لأن الأعمال العظيمة تحتاج إلى أوقات كبيرة وجهود ضخمة، وهذا يستدعي تفريغ أصحاب الكفاءات، مع التنوع والتكامل، لسد كل الثغرات، مع توفير كل ما يحتاجونه لإنجاز مهامهم. ومن الضرورة بمكان التوجه لإعداد متخصصين في جوانب الحياة كافة، والعمل على إنشاء مراكز بحوث ومعلومات متخصصة، لأن عصرنا اليوم يحتاج إلى التخصص الدقيق، فالذكاء والموهبة وحدها لا تكفي، بل الذي يفيد هو الدراسة العملية التخصصية.
ب. التخطيط والإدارة: فالتخطيط السليم والإدارة الناجحة من الأسباب الأكيدة في التمكين لدين الله. والتخطيط في المفهوم القرآني هو الاستعداد في الحاضر لما يواجه الإنسان في حياته في المستقبل. ويتجلى ذلك بشكل واضح في القرآن الكريم من خلال قصة يوسف عليه السلام، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ج. الإعداد الاقتصادي والإعلامي والأمني: فالقوة الاقتصادية عصب الحياة الدنيا، والضعيف فيها يُقهر ولا يُحسب له حساب. كما لا يخفى دور الإعلام الخطير، حيث امتد أثره إلى الفرد والأسرة والمجتمع، وأصبح الإعلام يؤثر في الشعوب ويحرك الجيوش. أما الجانب الأمني فقد تواتر التأكيد عليه في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120]. وهذا يشمل كل ما يثخن في العدو؛ من استطلاع أخباره، ومعرفة مواطن الضعف فيه، ومواقع آلياته ومنشآته، لأنه يوصل للتخطيط السليم المؤدي إلى الظفر به.
الباب الثالث- مراحل التمكين وأهدافه:
الفصل الأول- مراحل التمكين:
1. مرحلة الدعوة والتعريف بالإسلام: تتمثل أهم وظائف هذه المرحلة في تبليغ وحي الله إلى الناس، وتزكية نفوسهم، وتعليمهم العلم النافع. فإذا تحقق ذلك تحقق التعريف بالإسلام بالشكل الصحيح، وتكوين قاعدة عريضة من المدعوين.
2. مرحلة اختيار العناصر التي تحمل الدعوة: وأهم أهداف هذه المرحلة:
• الاصطفاء: وله معايير؛ من أهمها القدرة الروحية والعقلية والبدنية والحركية والإنتاجية.
• التوظيف: أي حدود العمل للفرد، وتقديره في حدود إمكانات الفرد وطاقته.
• الإعداد والتربية: ويعني إعداد الأفراد وتجهيزهم ليكونوا قادرين على حمل أعباء الجهاد في سبيل الله.
• الانضباط: وذلك بالوصول بالأفراد إلى الانضباط وحفظهم بالحزم، وإحكام إعدادهم وتكوينهم.
وحتى يكون الجيل مؤهلاً للنصر والنهوض بالأمة لا بد أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات الإيمانية والسلوكية والأخلاقية؛ كالإخلاص، والصدق، والصبر، والعطاء، والعفة، والإيمان بالواقعية والعمل الجماعي، والانضباط، وقوة الإرادة، وعزة النفس، والثبات على الحق.
من الصفات الإيمانية والسلوكية والأخلاقية لجيل التمكين: الإخلاص، والصدق، والصبر، والعطاء، والعفة، والإيمان بالواقعية والعمل الجماعي، والانضباط، وقوة الإرادة، وعزة النفس، والثبات على الحق
3. مرحلة المغالبة:
أجمع تعريف لهذه المرحلة هي مرحلة المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن أهم أولويات هذه المرحلة: الاهتمام بالأفراد المتخصصين القادرين على سد ثغرات العمل الإسلامي، وتعميق الانتماء للدين الإسلامي وللدعوة إلى الله، ويجب أن يكون على رأس هذه المرحلة فقهاء وعلماء قد بلغوا درجة النظر في معرفة الدين وفي معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أيضًا من إعطاء دور للعلماء وأن يكونوا في طلائع الطائفة المنصورة التي تسعى لتحكيم شرع الله.
4. مرحلة التمكين:
هي ذروة العمل الإسلامي، وتمثل الثمرة الناضجة، وهذه المرحلة تعني أن الله تعالى يمكِّن لدينه في الأرض عن طريق المؤمنين، وأن هذا التمكين يسبقه الاستخلاف والملك والسلطان، ويعقبه أمن بعد خوف، كما أن الوصول إليه لا يكون إلا بعد تحقيق شروطه من إيمان وعمل صالح، وتحقيق العبودية، ومحاربة الشرك، وتقوى الله. كما أن لاستمراره شروطًا أيضًا؛ منها إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاثة هي إجمال للإسلام كله.
5. الحركات الإسلامية ودورها في العودة إلى التمكين:
شهد العصر الحديث عدة تجارب لحركات إسلامية كان لها دور في عودة التمكين لدين الله، وقد توارثت الأجيال من بعدها تلك التجارب التي تعد معالم راسخة في فقه التمكين، ومن أبرز تلك الحركات خلال القرنين الماضيين: حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، وحركة الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي في الهند، والحركة الإسلامية في السودان.
الفصل الثاني- أهداف التمكين:
إذا رجعنا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أن من أهداف التمكين:
1. إقامة المجتمع المسلم: الذي تتحقق فيه العبودية لله تعالى، وهذا يستدعي إقامة دولة الإسلام بدعائمها ودستورها وقواعدها ومبادئها. أما تلك الدعائم فتتمثل في:
أ. الحاكمية: حيث إن نظام الحكم في الإسلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدين والأخلاق والعقيدة، وقد اقترنت السياسة بالدين في الإسلام، وارتبطت بالعقيدة الصحيحة، ولم يبقَ في الأرض عقيدة سليمة غيرها.
ب. الحاكم الصالح: إن وجود الحاكم الصالح ضرورة إسلامية لتدعيم الدولة الحاكمة بما أنزل الله، ولذلك نجد الشريعة قد أوجبت تنصيبه، وتوافَر الإجماع على ذلك منذ عهد الصحابة.
والأصل في الإمام أن يكون صالحًا في نفسه، قدوة لغيره. كما أن دستور الدولة الإسلامية نص على شروط الإمامة العظمى، المتمثلة في: الإسلام، والعدالة، والذكورة، والقدرة وسلامة الحواس، والقرشية، والحرية، والبلوغ، والعقل، والعلم، والحنكة في أمور السلم والحرب.
ج. الرعية الصالحة: فهي قيّمة على مسلك الولاة، بحيث إذا زاغوا عن السبيل ردتهم، وإذا اعوجّوا قومتهم، فإن أبوا إلا الانحراف خلعتهم. وقد أناطت الشريعة بالرعية مجموعة من الواجبات تجاه الولاة؛ هي: الطاعة، والنصرة، والنصح، والتقويم. وبالمقابل، بيّنت لها حقوقها، وحثت الحاكم على تنفيذها، ومن أهم هذه الحقوق:
1. الإبقاء على عقيدة الأمة صافية.
2. حماية الأمة من المفسدين والمحاربين وأعداء الخارج.
3. تحري الأمانة في اختيار المناصب.
4. إعطاء حقوق الرعية وما يستحقونه من غير إسراف ولا تقتير.
4. تحصيل أموال الزكاة والخراج والفيء… إلخ، وصرفها في مصارفها الشرعية.
2. إقامة قواعد النظام الإسلامي: ومن أهم هذه القواعد:
أ. الشورى: هي واجبة على الحاكم في الشريعة الإسلامية؛ فلا يحل للحاكم أن يتركها، وأن ينفرد برأيه دون مشورة المسلمين من أهل الشورى، كما لا يحل للأمة أن تسكت على ذلك، وأن تتركه ينفرد بالرأي دونها. قال ابن عطية: “والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب”. وقال الإمام المودودي: “والأمير حتم عليه أن يسوس البلاد بمشاورة أهل الحل والعقد أعضاء مجلس الشورى، وهو أمير ما دام مزودًا بثقة الأمة”.
وقد شرع الله نظام الشورى لحكم بالغة ومقاصد عظيمة، من أهمها: أن الشورى من أنجح الضوابط لكبح جماح العواطف لدى الحكام، وهي نوع من الحوار المفتوح، ومن أحسن الأساليب لتوعية الرأي العام وتنويره، كما أنها تشعر كل فرد في المجتمع بدوره، وتمنحهم الدفء العاطفي والترابط الفكري، ثم إنها امتثال لأمر الله بها، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ب. العدالة: إن إقامة العدل بين الناس أفرادًا وجماعات ودولاً ليست من الأمور التطوعية التي تُترك لمزاج الحاكم وهواه، بل هي من أقدس الواجبات وأهمها. وإن من أهداف التمكين إقامة المجتمع الإسلامي الذي تسود فيه قيم العدل والمساواة، ورفع الظلم ومحاربته بكل أشكاله، فلا وجود لإسلام في مجتمع يسوده الظلم.
ج. المساواة: يعد مبدأ المساواة أحد المبادئ العامة التي أقرها الإسلام، وهي تساهم في بناء المجتمع المسلم، كما أنها من أهم المبادئ التي جذبت الكثير من الشعوب قديمًا نحو الإسلام. وليس المقصود بالمساواة هنا “المساواة العامة” بين الناس جميعًا في كافة أمور الحياة، ولكن المقصود المساواة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية، المساواة المقيدة بأحوال فيها التساوي، وليست مطلقة في جميع الأحوال، أي معاملة الناس أمام الشرع والقضاء والحقوق العامة دون تفريق بسبب اللون أو الجنس أو الأصل أو الثروة…..الخ.
د. الحريات: نعني بالحرية في نظر الإسلام: ممارسة الأفراد لكل حق من الحقوق الشخصية والفكرية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة وتعاليمها، ولا تصطدم مع المصالح الجماعية، ولا تتنافى مع الآداب الاجتماعية.
وقد كفل الإسلام لكل فرد من أفراد المجتمع مجموعة من الحقوق؛ من أهمها: حق الحياة، وحق الأمن، وحرية العمل، وحرية النقد والتعبير.
الشورى من أنجح الضوابط لكبح جماح العواطف لدى الحكام، وهي نوع من الحوار المفتوح، ومن أحسن الأساليب لتوعية الرأي العام وتنويره، كما أنها تشعر كل فرد في المجتمع بدوره، وتمنحهم الدفء العاطفي والترابط الفكري، ثم إنها امتثال لأمر الله بها، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
3. نشر الدعوة إلى الله:
إن من أهداف الدولة المسلمة دعوة الناس إلى دين الله، سواء داخل الأمة أو خارجها، للمسلمين وغير المسلمين، أما داخل الأمة فيكون من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والدعوة إلى الأخلاق الكريمة، بكافة الوسائل الشرعية، وأما خارج الأمة فمن أعظم الوسائل الجهاد في سبيل الله. وتحقيق هذه الأمور له ثمرات كثيرة؛ من أهمها إعزاز المسلمين، وإذلال الكافرين، ودخول الناس في دين الله أفواجًا.
الخاتمة:
ينهي المؤلف كتابه بخاتمة يلخص فيها أبرز النقاط التي وردت في أبواب وفصول الكتاب، فيعيد التأكيد على أهمية العلم بفقه التمكين ودراسته دراسة واقعية، ويعرض أهم صور النصر وأنواعه الواردة في القرآن والسنة، وشروط التمكين وأسبابه، ثم يسرد مراحل التمكين وأهدافه. ويختم بتوصيات ونصائح إلى زعماء الأمة، والقائمين على الجامعات الإسلامية، وإلى أبناء الأمة الإسلامية كافة.
محمود كريم
باحث متخصِّص في اللغة والنقد



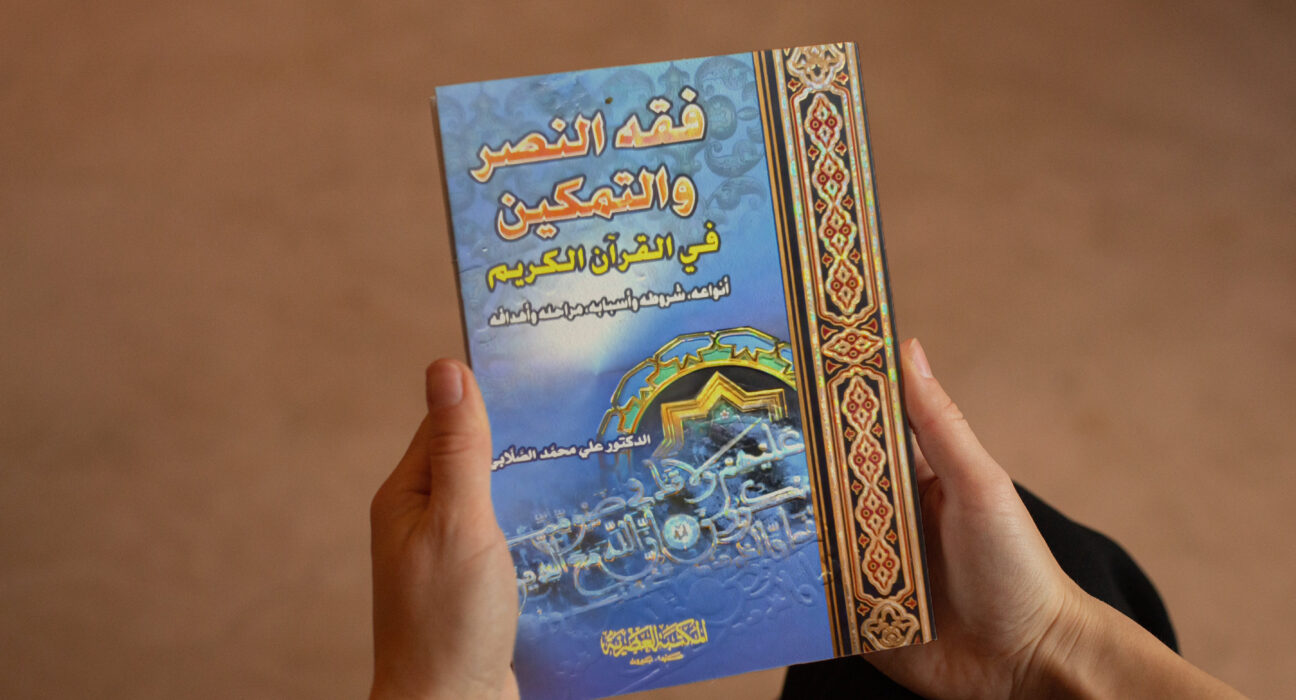



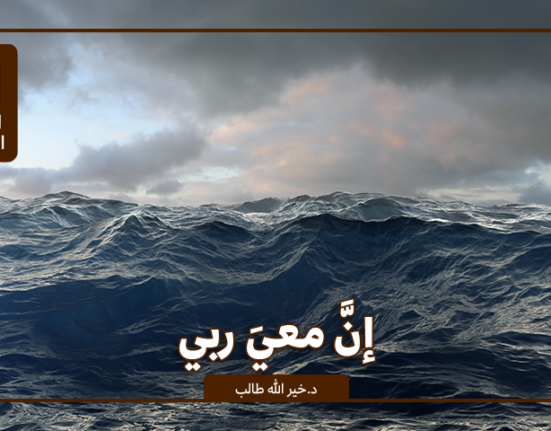

1 تعليق
التعليقات مغلقة