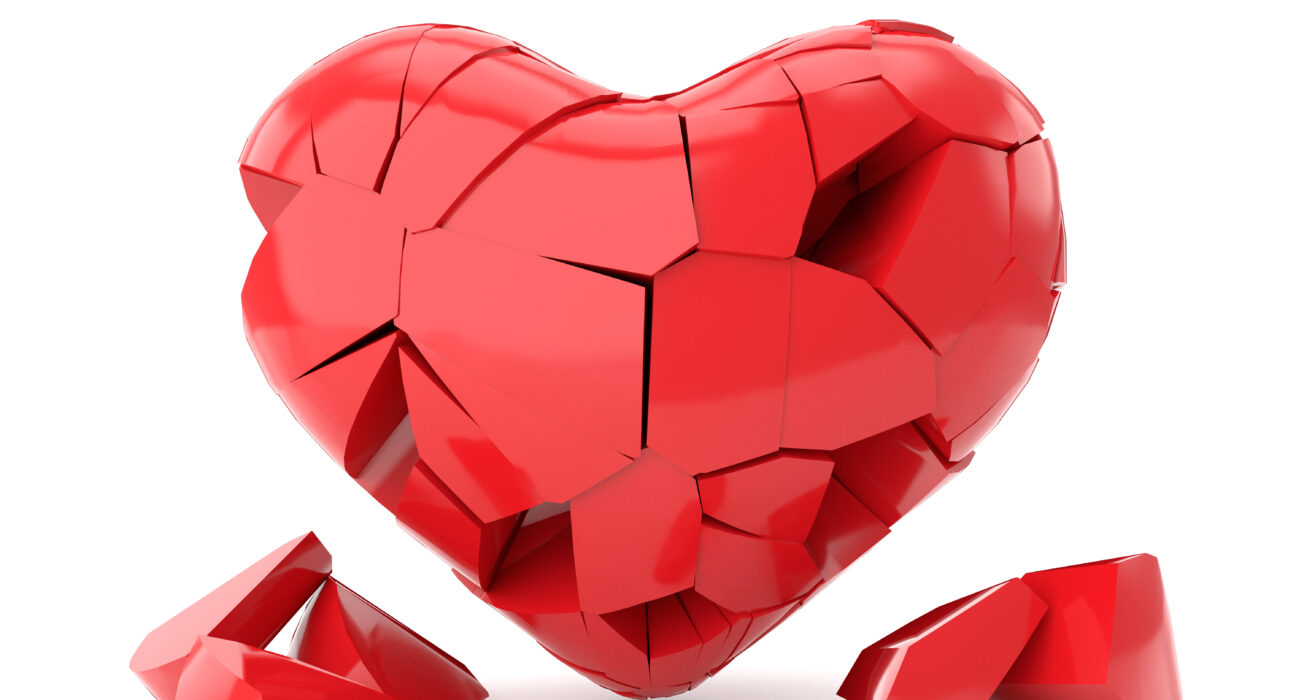محاسن الدين الإسلامي كثيرة، ومن أهمها اكتمال بنيانه، ووضوح غاياته، وتحقيقه للحاجات النفسية والاجتماعية، لكنَّ استغراق المسلمين في تفاصيل حياتهم اليومية قد يحجب عنهم حقيقة تميز الإسلام عن الأديان والثقافات الأخرى، وشيئًا من المقارنة مع ما وصل إليه البشر من الأفكار والنظريات المعاصرة يوضح حجم التيه الذي يعيشه من يبتعد عن معين النور الصافي.
مدخل:
من ينظر في تاريخ الفكر الغربي يجده متضاربًا في نظره لمعيارية الأخلاق، ومدى أصالة الحس الأخلاقي في التاريخ الإنساني وفطريته في النفس البشرية، وقد زادت أزمة الرؤية الغربية لفلسفة الأخلاق بعد طغيان العلم التجريبي وإحلال النظرة المادية الطبيعانية مكان الرؤية الدينية، فصار الحديث عن “أخلاق مطلقة ثابتة” محل نقاش وجدال واسع، ليطال هذا الخلاف صلة الأخلاق بالدين بين من يرى في الأخلاق منظومة قائمة بذاتها، وبين من يرى تبعيتها للدين، ولعل هذا التصور المتأزم لعلاقة الأخلاق بالدين كان له أسبابه العقدية والتاريخية، ليكون الإشكال المطروح: هل يمكن أن تسري مقولة الفصل الغربية على سائر المنظومات الدينية والعقدية؟ أم أن مقولة الفصل هذه موصولة بما عاشه الفكر الغربي من صراعات مع الدين المسيحي.
هذه الورقة ستحاول عرض الآراء القائلة بالفصل مع بيان أصل الصلة بين الأخلاق والدين.
الأخلاق التي كان الغربي يستقيها من الكتاب المقدَّس، أضحت موضع محاكمةٍ ونقدٍ في عصر النهضة، فنظرة القرون الوسطى للإنسان مخلوقًا ضعيفًا مليئًا بالخطايا، سينبذها فلاسفة التنوير لتكون مهمتهم الكبرى في تخليص الإنسان من هذا التصور بمحاولة الفصل بين الدين والأخلاق
الهيومانية الغربية ومقولة الفصل:
لعل إحدى الصدمات الكبرى بين العقل في العصر الوسيط والعقل في العصر الحديث، هو إيمان الأول بأن العالم يمثل نظامًا أخلاقيًا، في حين آمن الثاني بأنه يخلو من مثل هذا النظام[1]، وهي سمة بدأت معالمها تتحدد بدخول الفكر الغربي مرحلة النهضة، ولعل بلوغ الفكر الغربي هذا المبلغ من القطيعة مع الديني في تصوره للأخلاق هو نتاج تقديس العقل.
فالناظر في الفترة التاريخية التي يطلق عليها “الفترة الحديثة” يلمس فيها ذلك النظر العقلي المختلف في جوانب عديدة عن نظرة الفترة الوسيطة، ومن هذه الجوانب جانبان لهما الأهمية القصوى: تضاؤل السلطة الكنسية، وتزايد سلطة العلم التجريبي. فثقافة الأزمنة الحديثة أقرب إلى الثقافة العلمانية منها إلى الثقافة الدينية[2]، إنها ثقافة تغييب الإلهي مقابل إعلاء الروح المادية، وإحلالها مكانة المرجعية في بناء التصور الحديث للعالم عمومًا. فالحداثة جاءت لتجاوز ما كان سائدًا في الموروث، وذلك بتحكيم سلطة العقل والعلم مقابل فكرة الله[3]، فأيُّ شيءٍ يُشمُّ منه رائحةُ الدين يصبح موضعَ شكٍّ ولا يُمكن أن يكون علميًا[4].
فالأخلاق التي كان الغربي يستقيها من الكتاب المقدَّس، أضحت موضع محاكمةٍ ونقدٍ في عصر النهضة، فنظرة القرون الوسطى للإنسان مخلوقًا ضعيفًا مليئًا بالخطايا، سينبذها فلاسفة التنوير لتكون مهمتهم الكبرى في تخليص الإنسان من هذا التصور بمحاولة الفصل بين الدين والأخلاق.
ذهب علماء التنوير في القرن 18م إلى القول بضرورة فصل الأخلاق عن الدين، وقد كان لنظرتهم هذه أسبابها التاريخية والموضوعية المتمثلة في تخويل السلطة المطلقة للكنيسة ورجالاتها التي لم تقف عند الوساطة الروحية وبيع صكوك الغفران، بل توسَّع طغيانها ليشمل الفكر والعلم، فكانت الكنيسة هي التي تحدِّد أغراض العلم وتسن نظم البحث[5]، وكل رؤيةٍ جديدةٍ للكون تُعتبر مخالفة لما سطر في الكتاب المقدس تُرفض ويُتهم أصحابها بالهرطقة[6]، بل إن الشواهد التاريخية تحيلنا إلى ما مارسته محاكم التفتيش من حرق وتعذيب لجملة من العلماء الذين لم يرضخوا لخرافات الكنيسة، ولم ترضهم تفسيرات الكهنة.
فهذه الأحداث المتشابكة، والصراعات المتأجِّجة بين الكنيسة والعلم، أدَّت إلى ميلادٍ جديدٍ لنهضةٍ فكرية، وزيادةٍ في “سخط الناس على ما لديهم من عقائد عتيقة، فأعلنت الحرب على كل نوع من أنواع السلطات، وطولب بحرية الفكر وأصبح الحق في نظر الناس ليس ما اعتبر حقًا منذ قرون، ولا ما قال عليه فلان، وإنما الحق ما بُرهن عليه واقتنعت بكونه حقًا”[7]، ورويدًا رويدًا بدأ انسلاخ الفكر الغربي من النظرة الدينية السائدة عن الكون والإنسان، حتى أعلن مارسليو فاسيو Marsilio Piofici عميد فلاسفة المذهب الإنساني في القرن 13م، أن الإنسان لم يعد خليفة الله في الأرض فحسب، وإنما شريكه في العلم والإبداع[8]، تعالى الله عن ذلك.
ذهب علماء التنوير في القرن 18م إلى القول بضرورة فصل الأخلاق عن الدين، وذلك بسبب السلطة المطلقة للكنيسة ورجالاتها التي توسَّع طغيانها ليشمل الفكر والعلم، وكانت كلُّ رؤيةٍ جديدةٍ للكون تعتبر مخالَفةً تُرفض ويُتهم أصحابها بالهرطقة وتنالهم عقوبات الإعدام والتصفية الجسدية
فكان من مؤاخذات التنويريين على المسيحية تعرُّضُها لآفتين اثنتين أدت إلى تأسيسٍ أخلاقيٍّ مستقل عن الدين”[9] وتتمثل هاتان الآفتان في:
-
الخرافة واللاعقلانية:
حيث “طغت بحسبهم الصفة الخرافية على المعتقدات المسيحية، فكادت أن تعيد الوثنية إلى الكنيسة، بل عدها أحدهم وهو “ديدرو” أكثر إهانة للألوهية من الإلحاد نفسه وأحصوا من هذه المعتقدات: “الخطيئة الأصلية”[10] و”التثليث” و”التجسيد” و”ألوهية المسيح” و”خلاص البشر” و”التوجه إلى الأيقونات” و”المعجزات والأسرار”[11].
بالإضافة إلى الخرافة التي حظي بها جزء كبير من العقائد المسيحية حسب التنويرين كان لِآفة أخرى التأثير البالغ على نظريتهم في العلاقة بين الدين والأخلاق وهي:
-
الصراعات الدينية:
كان لاختلاف المسيحيين حول جملة من المعتقدات الأثر الواضح في نشوب الحرب بين الفرق المختلفة حيث “استولت على النفوس ألوان من التعصب لهذه المعتقدات، توهمًا لأفضليتها على غيرها، وأذكت بين الطوائف المسيحية فتنة عقدية كبرى أدخلتها في حروب طاحنة دامت سنين طويلة على فترات مختلفة وقد دعا هذا التعصب “التنويريين” إلى ممارسة شديد نقدهم لهذه المعتقدات التاريخية، بل صريح قدحهم في معتنقيها حتى اشتهر عن فولتير، قوله “اسحقوا الخسيس” قاصدًا بذلك التشنيع بالمسيحية التاريخية أو بالأخص الكاثوليكية، وقد ضمنوا هذا النقد والقدح مصنفات مستقلة نشر بعضها بأسماء مستعارة أو مجهولة، وأثار بعضها سخط الكنيسة وإدانتها”[12].
فهذه المعتقدات الخرافية حسب التنويريين والتي أدخلت أوروبا في سنوات مديدة من الحروب والاقتتال جعلت من فصل الأخلاق عن الدين ضرورة ملحة، وفي هذا الصدد يقول فرنسوا جوليان: “فلم تبق للأخلاق حاجة لسند الميتافيزيقا وهو سند مشبوه طالما أن نتائج الميتافيزيقا لم تعد مقنعة”[13].
وبناء على هاتين الآفتين اندفع إنسانيو عصر النهضة إلى وضع صيغ متعدِّدةٍ للفصل بين الدين والأخلاق[14]، حيث كان انتقادهم “لتأسيس الأخلاق دينيًا مستمدة من فكرة الثواب والعقاب في الآخرة، وتحديدًا من التفسيرات الأخلاقية للدين”[15]، ومن الأمثلة على ذلك أن الدين في نظر الناقد يعزز الأخلاق لدى ضعاف النفوس الذين لا يرون العمل الأخلاقي أمرًا يستحق أن يقوم به الإنسان بحد ذاته، وهذا يعني من زاوية نظرهم أن الدين بتلويحه بالثواب والعقاب يحجب إمكانية التطور الكامل لقوى الإنسان الأخلاقية الحرة[16].
لكن هذا النقد عند التنويريين لا يُلامس حقيقة الصلة بين الله والإنسان، القائمة على التخيير ثم الحساب، فالأصل في صلة الله بالإنسان أنه خيّره، إن شاء ائتمر بأمره، وانتهى بنهيه، وإن شاء لم يأتمر بأمره ولم ينته بنهيه، ولم يقف تخييره له عند هذا الحد، بل إن شاء أقر بوجوده وعمل بحسب إقراره، وإن شاء أنكره، وله أن يأتي تصرفاته على وفق إنكاره”[17].
ومن هنا كانت حجَّة التنويريين بأنَّ تأسيسَ الأخلاق على الدين قد يُعزِّز الأخلاق عند ضعاف النفوس أمرًا واهيًا؛ لأن الله جعل للإنسان حرية الاختيار والتصرف طبقًا لقرارة نفسه، وما استقر عليه فكره وضميره الإنساني.
وما يمكن استنتاجه من هذا العرض السريع لنظرية فصل الدين عن الأخلاق أن قاعدتها الأساسية هي المرحلة المظلمة التي عرفتها أوروبا في ظل تغطرس الكنيسة وما نتج عن ذلك من إراقة الدماء خلال سنوات متطاولة في الزمن، فأسست هذه الفترة لقطيعة الغربيين مع الدين الذي لم يفصل عن الأخلاق فقط، وإنما فصل عن الحياة بوجه عام ليبقى حبيس الكنائس ودور العبادة.
كان من تبعات فصل الأخلاق عن الدين التمهيد لتأسيس أخلاق نسبية، فما كان خطأ عندك أو في ثقافتك قد يكون صوابًا عند الآخر أو ثقافة أخرى
الفكر الغربي ومقولة تبعية الأخلاق للدين:
كان من تبعات فصل الأخلاق عن الدين التمهيد لتأسيس أخلاق نسبية، فما كان خطأ عندك أو في ثقافتك قد يكون صوابًا عند الآخر أو ثقافة أخرى.
يقول ولتر ستيس: “الميزة الكبرى للنظرة الدينية هي تقديم أساس متين للأخلاق وسط الطبيعة المتغيرة للعالم، وليس أساسًا مهتزًا وسط رمال الطبيعة البشرية المتحركة، فالقيم والقوانين الأخلاقية هي بالضرورة موضوعية، وتكون القيمة موضوعية إذا كانت مستقلة عن أية أفكار إنسانية أو مشاعر أو آراء للبشر”[18].
لكن إذا كان هذا الاتجاه يرى أن فصل الدين عن الأخلاق ضرورة “فهناك اتجاه آخر من الأخلاقيين يرى تبعية الأخلاق للدين[19] وقد بنوا ذلك على أصلين اثنين وهما (الإيمان بالإله) و(إرادة الإله)”[20].
وقد ظهر هذا الاتجاه عندما ازدوجت الفلسفة الأخلاقية الموروثة عن اليونان في الغرب “بتعاليم الدين المسيحي، حيث اندرج فيها مبدأ الإيمان بالإله وتقرر التسليم بأنه لا أخلاق بغير إيمان، علمًا بأن الإيمان هو عبارة عن التصديق اليقيني بالوجود الغيبي للإله عن طريق القلب، فمادام الغرض من الأخلاق هو رسم طريق الحياة الطيبة للإنسان، فلا شيء يبلغ مبلغ الدين في الحرص على تحقيق هذا الغرض في عاجل الإنسان وآجله معًا، وما ذلك إلا لكون الدين ينبني على الإيمان بإله قادر على كل شيء يعين المؤمن على الوصول إلى هذه الحياة الطيبة، متفضلة عليه بوجوده وشفقته”[21].
حسب هذا التصور فإن ما يجعل الأخلاق تابعة للدين هو شمولية هذا الأخير لكل المعاني الأخلاقية وحرصه على تحقيق سعادة الإنسانية في الحال والمآل، فإذا كان علم الأخلاق تنظيرًا لما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني، فإن الدين يعزز في نفس معتنقيه كل القيم التي من شأنها أن تصلح الناس ليس ظاهرًا فقط بالتزام بعض القيم الأخلاقية وإنما من الباطن تبعًا لمبدأ “الإيمان بالإله” الذي يقر القلب الموقن به فتنطلق جوارح الإنسان معلنة الانقياد للإله الذي يعينه على سلوك طريق الخير والحياة الطيبة.
وبما أن الإيمان بالإله هو في نفس الوقت إيمان بصفاته كانت إرادته وهي الصفة الباعثة على الأفعال الأخلاقية أولى هذه الصفات الإلهية التي تجعل الإله مريدًا بإرادة كاملة، فتكون إرادته في أفعال مخلوقاته من البشر إنما هي الأمر بخيرها، فيلزمه اتباعه وكذا النهي عن شرها، فيلزمه اجتنابه[22].
بناء على هذين الأصلين المتلازمين وهما “الإيمان بالإله” و”إرادة الإله”[23]، كانت الأخلاق تابعة للدين، فمن آمن بالإله يجب أن يمتثل لإرادته ومشيئته التي تحقق الخير للبشرية، فلا سبيل لفصل الأخلاق عن الدين، فحسب هذا الاتجاه الأخلاق لا يمكن أن تثمر في نفس الفرد بدون إيمان.

حقيقة الصلة بين الأخلاق والدين:
لكننا في علاقة الأخلاق بالدين سنسير سيرًا آخر يوضح الرؤى ويزيل الضبابية التي ارتبطت بطبيعة تلك الصلة، حيث سنعالج الموضوع من زاويتين اثنتين:
زاوية نظرية تجريدية: ترى إمكان استقلال الدين عن الأخلاق من جهة وترى إمكان تداخلهما وتكاملهما من ناحية أخرى.
زاوية تاريخية: تكشف لنا عن حقيقة الصلة بينهما في الواقع.
الدين والأخلاق في أصلهما حقيقتان منفصلتا النزعة والموضوع، لكنهما يلتقيان في نهايتهما فينظر كل منهما إلى موضوع الآخر من وجهة نظره الخاصة، كمثل شجرتين متجاورتين تمتد فروعهما، وتتعانق أغصانهما، حتى تظلل إحداهما الأخرى
د. محمد عبد الله دراز
-
الزاوية التجريدية:
فمن الناحية التجريدية: “إذا نظرنا إلى (الدين) من حيث هو معرفة (الحق) الأعلى وتوقيره، وإلى (الخُلق) من حيث هو قوة النزوع إلى فعل (الخير) وضبط النفس عن الهوى، كان أمامنا حقيقتان مستقلتان، يمكن تصور إحداهما دون الأخرى، فتخص أولاهما بالفضيلة النظرية، والأخرى بالفضيلة العملية”[24].
لكن وبالرغم من ذلك تتكامل الأخلاق مع الدين، “فلما كانت الفضيلة العملية يمكن أن تتناول حياة الإنسان في نفسه ومختلف علائقه مع الخلق ومع الرب كان القانون الأخلاقي الكامل هو الذي يرسم طريق المعاملة الإلهية، كما يرسم المعاملة الإنسانية”[25].
فالأخلاق إذن بإمكانها أن تقف بجانب الفضيلة النظرية في رسم طريق المعاملة الإلهية، إذ القانون الأخلاقي الكامل هو الذي يتناول حياة الإنسان في نفسه، وفي مختلف علائقه مع الخلق، ومع الربِّ فيكون موضوعها قريبًا من موضوع الدين في تنظيم هذه العلاقة وتعزيزها في نفس الفرد والجماعة.
وكذلك الأمر بالنسبة للفضيلة النظرية، “لما كانت الفكرة الدينية هي التي لا تجعل من الألوهية مبدأ تدبير الأفعال فحسب، بل مصدر حكم وتشريع في الوقت نفسه، كان القانون الديني الكامل هو الذي لا يقف عند وصف الحقائق العليا النظرية، وإغراء النفس بحبها وتقديسها بل يمتد إلى وجوه النشاط المختلفة في الحياة العملية، فيضع لها المنهاج السوي الذي يجب أن يسير عليه الفرد والمجتمع”[26].
ومن هنا يكون الدين هو المنظم لعلاقة الفرد بربه من ناحية والناموس الذي نستقي منه التشريعات المنظمة لعلاقة الفرد بالجماعة من ناحية أخرى، فهو يجمع بين الفضيلة النظرية من حيث معرفة الحق وتوقيره والفضيلة العملية من حيث وضع التشريعات المنظمة للسلوك الإنساني، لتكون الأخلاق جزءًا من هذه المنظومة الدينية الشاملة.
وخلاصة القول في هذا الجانب النظري التجريدي أن “الدين والأخلاق في أصلهما حقيقتان منفصلتا النزعة والموضوع، لكنهما يلتقيان في نهايتهما فينظر كل منهما إلى موضوع الآخر من وجهة نظره الخاصة، كمثل شجرتين متجاورتين تمتد فروعهما، وتتعانق أغصانهما، حتى تظلل إحداهما الأخرى”[27].
-
الزاوية التاريخية:
أما من الناحية التاريخية: “فإننا لا نرى الصلة بين الدين والأخلاق تبلغ دائمًا هذا الحد من التساند والتعانق، لا في مبدأ نشأتهما في نفس الفرد ولا في دور تكونهما وتركزهما في قوانين وقواعد مقررة في المجتمع”[28].
فالشعور الأخلاقي في عهد الطفولة يكون أقدم وأرسخ في نفس الطفل من الشعور الديني، لذلك نراه يبدأ في سن مبكرة جدًا استحسان بعض الأفعال، واستنكار بعضها، والاستحياء من بعض آخر[29].
أما في المجتمع فإن امتزاج القوانين الدينية والقوانين الأخلاقية نراه لا يجري على سنن واحد في العصور والبيئات المختلفة، فكثيرًا ما ظهرت في التاريخ نظم أخلاقية لا تعرض لواجب الآلهة قط، ولا تستقي تشريعاتها للفضائل الأخلاقية من وحي الدين، بل من وحي الضمير أو سلطان المجتمع، أو غير ذلك، كما ظهرت في التاريخ مذاهب دينية لا تعتني هذه العناية بالناحية العملية الاجتماعية، بل كثيرًا ما تجعل المتدين ينطوي على نفسه، متخذًا مثله الأعلى في العُزلة والصمت والتأمل.
لكن رغم هذا التباين الذي قد يظهر في البداية “يبقى الفكر الأخلاقي من أقدم الأفكار الإنسانية، ولا يسبقه سوى الفكر الديني الذي هو قديم قدم الإنسان نفسه، وقد التحم الفكران معًا خلال التاريخ، ففي تاريخ علم الأخلاق، لم يوجد عمليًا مفكر جاد لم يكن له موقف من الدين، إما عن طريق استعارة الضرورة الدينية كمبادئ للأخلاق، أو عن طريق محاولة إثبات العكس، ولذلك يمكن القول بأن تاريخ علم الأخلاق بأكمله قصة متصلة لتشابك الفكر الديني والأخلاقي”[30].
الأخلاق والدين يجب أن يمضيا جنبًا إلى جنب في النفس البشرية لتحقيق السعادة في الدارين معًا، والفصل بين الدين والأخلاق عند بعض المفكرين الغربيين جاء نتيجة الخرافة المرتبطة بالعقائد المسيحية، بالإضافة إلى الصراعات الدينية التي أسالت الدماء الأوروبية سنوات مديدة
ومن هنا فالدين والأخلاق فكران عريقان في القدم، يتداخلان من حيث الموضوع فيكمل بعضهما البعض، فالدين في جانبه العملي لا يخلو من مبادئ وتشريعات ترسم طريق الصلاح للبشرية، والأخلاق كذلك لا غنى عنها في بناء العلاقة بين الإله والفرد وتعزيز الصلة بينهما.

ولعل عزت علي بيجوفيتش قد أكَّد على ضرورة الجمع بين العنصرين اللذين ظلا في اعتقاد كثير من الناس منفصلين، وبين ذلك بمثال يجلى تصوره في مفهوم العلاقة بين الدين والأخلاق استنادًا لما ورد في القرآن الكريم من آيات تدل على هذه اللحمة بين الدين والأخلاق حيث قال: “اقرأ هذه الآية: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ إنها تتكرر بصيغتها أو معناها في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة، كأنما تؤكد لنا ضرورة توحيد أمرين اعتاد الناس على الفصل بينهما. إن هذه الآية تعبر عن الفرق بين الدين (الإيمان) وبين الأخلاق (العمل بالصالحات) كما تأمر في الوقت نفسه بضرورة أن يسير الاثنان معًا”[31].
فالأخلاق والدين يجب أن يمضيا جنبًا إلى جنب في النفس البشرية لتحقيق السعادة في الدارين معًا، فالقول بضرورة الفصل بين الدين والأخلاق عند ثلة من المفكرين الغربيين جاء كما رأينا نتيجة الخرافة المرتبطة بالعقائد المسيحية التي تضاربت مع العقل والفكر الغربي، بالإضافة إلى الصراعات الدينية التي أسالت الدماء الأوروبية سنوات مديدة.
وعليه يكون الفصل بين الدين والأخلاق ليس حتمية تاريخية تجري على كل الأمم والشعوب وإنما هو ضرورة ارتبطت بالتجربة الأوروبية مع الكنيسة، التي أدخلت الغربيين في قطيعة مع الدين.
فقد تكون بعض المجتمعات البشرية مؤسسة على نظم أخلاقية، لكن يبقى الدين في جزئه العملي مرتبطًا بالأخلاق وتبقى الأخلاق في رسمها لطريقة المعاملة الإلهية كما رأينا مرتبطة بالدين، ولذلك فالإنسان حسب تعبير باسكال[32] يبقى عاجزًا عن معرفة الخير الحقيقي والعدل بمعزل عن الإيمان.
فالدين والأخلاق إذن متداخلان في الموضوع، متكاملان في الغاية، فكل منهما يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان سواء في علاقاته الإنسانية أو في علاقته مع الله.
د. كريمة دوز
دكتوراه في العقيدة والفكر ومقارنة الأديان من جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس- المغرب
[1] ينظر: الدين والعقل الحديث، ولتر ستيس، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ص (141).
[2] تاريخ الفلسفة الغربية، برتراند راسل (3/7)، بتصرف.
[3] الحداثة وما بعد الحداثة، مجموعة من الباحثين، ص (35).
[4] الدين والعقل الحديث، ولتر ستيس، ص (103).
[5] ينظر: قصة الفلسفة الحديثة، أحمد أمينوزكي نجيب محمود، ص (48).
[6] شنت الكنيسة حملة شعواء همجية ضد كل من قال بكروية الأرض، أحرقت من أحرقت وعذبت من عذبت، وهددت بتعذيب كل من لم يكف عن هذه الهرطقة التي تقول بكروية الأرض وأنها ليست مركز الكون بحجة أن التوراة قالت إن الأرض مستوية وإنها هي مركز الكون، والإنسان مركز الوجود، فأحرقت العالم الإيطالي جردانو برنو حيًا، وسجنت العالم الإيطالي غاليليو. (مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، ص (50)، بتصرف).
[7] قصة الفلسفة الحديثة، أحمد أمين وزكي نجيب محمود، ص (48).
[8] ثلاث رسائل في الإلحاد والعقل والإيمان، عبد الله الشهري، ص (44).
[9] بؤس الدهرانية (النقد الانتمائي لفصل الدين عن الأخلاق)، طه عبد الرحمان، ص (33).
[10] تعلن المسيحية أنه بسبب معصية آدم بعدم طاعته لوصية الله بأن لا يأكل من شجرة المعرفة، قد أخطأ، وتوارث خطيئته جميع ذريته، فجيمع الجنس البشري مولودون خطاة. ينظر: الغفران بين الإسلام والمسيحية، إبراهيم خليل أحمد، ص (93-94).
[11] بؤس الدهرانية (النقد الانتمائي لفصل الدين عن الأخلاق)، طه عبد الرحمان، ص (34).
[12] المرجع السابق نفسه.
[13] جدل في الأخلاق، فرانسوا جوليان. ترجمة: خديجة الكسوري بن حسين وآخران، ص (21).
[14] ينظر: بؤس الدهرانية (النقد الانتمائي لفصل الدين عن الأخلاق)، طه عبد الرحمان، ص (12).
[15] الدين والعلمانية في سياقهما التاريخي، عزمي بشارة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص (120).
[16] المرجع السابق، ص (120-121).
[17] بؤس الدهرانية (النقد الانتمائي لفصل الدين عن الأخلاق)، طه عبد الرحمان، ص (76).
[18] الدين والعقل الحديث، ولتر ستيس، ص (342).
[19] يعتبر أغسطينوس (354-430م) من الفلاسفة المسيحيين الذين قالوا بتبعية الأخلاق للدين، حيث ربط الفلسفة الأخلاقية بالله، فكما أن الله مصدر الحقيقة، كذلك هو مصدر الأخلاق، وعلى هذا يقول: “إن الحياة السعيدة في نعيم الله، ومن أجل الله، ولا شيء غير هذه الحياة يمكن أن يسمى سعيدًا، فالسعادة والحقيقة شيئان مترادفان”، وهكذا كانت معظم آرائه وأفكاره في السلوك الإنساني تستند على النصوص اللاهوتية، فتعتمد على الأوامر والنواهي والتقارير الدينية، مثل افعل ولا تفعل. ينظر: فلسفة العصور الوسطى، عبد الرحمان بدوي، ص (33).
[20] سؤال الأخلاق (مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية)، طه عبد الرحمان، ص (31).
[21] المرجع السابق نفسه.
[22] المرجع السابق، ص (33).
[23] معلوم أن الفلسفة الأخلاقية المبنية على الإيمان بالإله وتعتبر هذا الإيمان أصلاً من أصولها، وتبني عليه جملة من الفضائل الإنسانية، لابد أن تعتبر كذلك صفات هذا الإله الواجبة في حقه، ولا سيما تلك التي تكون باعثة على الأفعال الخُلقية، وأولى هذه الصفات الإلهية هي كونه مريدًا بإرادة كاملة، وإرادته في أفعال مخلوقاته من البشر إنما هي الأمر بخيرها، فيلزم إتيانه وكذا النهي عن شرها، فيلزم اجتنابه. ينظر: سؤال الأخلاق، طه عبد الرحمان، ص (33).
[24] الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، محمد عبد الله دراز، ص (93).
[25] المرجع السابق نفسه.
[26] المرجع السابق نفسه.
[27] المرجع السابق، ص (94).
[28] المرجع السابق نفسه.
[29] الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، محمد عبد الله دراز، ص (64)، بتصرف.
[30] الإسلام بين الشرق والغرب، علي عزت بيجوفيتش، ترجمة: محمد يوسف عدس، ص (197).
[31] المرجع السابق، ص (198).
[32] ينظر: خواطر، بليز باسكال، ترجمة: إدوار البستاني، ص (135).