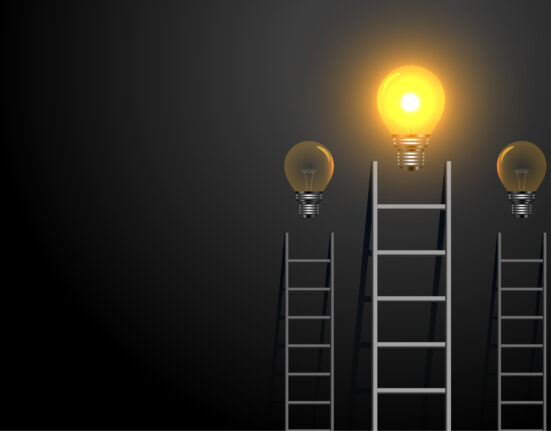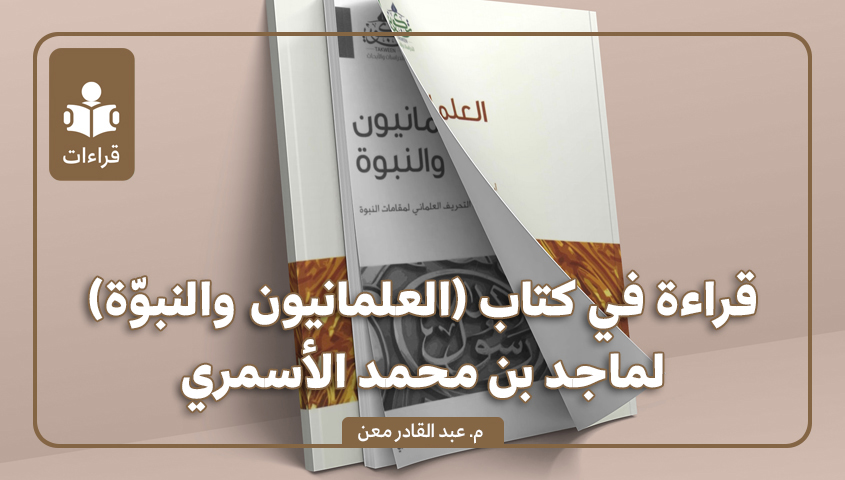للدولة ركائز أساسية لا تقوم بدونها، وهي: الشعب، والسلطة الحاكمة، بالإضافة إلى الإقليم الجغرافي، والسيادة من ناحية الاستقلال التام في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية[1]؛ حتى تكون دولة قوية قادرة على القيام بأعمالها، وتقود النهوض والازدهار، ومواجهة المخاطر المحدقة بها.
وتتفاوت القراءات في اعتبار مقياس قوة الدولة وصلابتها، فيذهب البعض إلى أنها القوة الاقتصادية، أو العسكرية، أو مدى التقدم العلمي والتقني الذي تشهده، أو تماسك مؤسساتها ودوائرها المختلفة وجودة أنظمتها، أو قوة دعمها الخارجي والاعتراف بها من دول العالم، أو مجموعة مركبة من هذه العناصر.
لكن الوحي والآثار والتاريخ ودراسة عوامل ازدهار الدول والحضارات تخبرنا أن العديد من الدول قد انهارت وهي في أوج قوتها العسكرية، أو الاقتصادية، أو تقدمها المادي.. كالحضارة اليونانية، والرومانية، وفي العصر الحديث الاتحاد السوفييتي، وأن العديد من أنظمة الحكم قد فشل وسقط مع توفر الدعم الخارجي والاعتراف الدولي.
فما هو الركن الأشد خطورة والأكثر أهمية وحضورًا في قوة الدول والحضارات وبقائها؟
إنه قوة مجتمعها، وصلابته وتماسكه الداخلي، وفاعليته.
اهتمام الأنبياء بالمجتمعات وتربيتها كان استراتيجية فعالة لبناء المجتمع السليم الذي يسبق النهوض ويقوده، فكانوا يبدؤون بتصحيح الأفكار التي تشكل تصورات الناس، مع بذل الجهد في إصلاح المجتمعات وتربيتها، وغرس بذور التماسك بين أفرادها، ومحاربة مظاهر فسادها وأسباب التنافر بين أفرادها
الأنبياء عليهم السلام والمجتمعات:
لم يكن اهتمام الأنبياء ببناء المجتمعات وتربيتها من قبيل المصادفة، أو من قبيل فعل الممكن والمتاح، بل كانت استراتيجية فعالة لبناء المجتمع السليم الذي يسبق النهوض ويقوده، فكانوا يبدؤون بتصحيح الأفكار التي تشكل تصورات الناس وأسس التفكير لديهم، مع الجهد في إصلاح المجتمعات وتربيتها، وغرس بذور التماسك فيها، ومحاربة مظاهر فسادها وأسباب التنافر بين أفرادها.
فكانت رسالة نبي الله لوط في إصلاح الأخلاق واستعادة الفطرة بالنهي عن الفاحشة وقطع الطريق وفعل المنكرات، ورسالة نبي الله شعيب في إصلاح الاقتصاد والنهي عن تطفيف الكيل والإفساد في الأرض، ثم كانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم جامعة لكل خير جاء به الأنبياء؛ يدعو إلى مكارم الأخلاق وإصلاح النفوس، إلى جانب عبادة الله تعالى وحده ونبذ الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)[2]، وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في حواره مع النجاشي: (أمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام)[3].
وقد دأب النبي صلى الله عليه وسلم في كل من مكة والمدينة على تأسيس نواة قيادة مجتمعية واعية من عرفاء الناس ومقدميهم ومطاعيهم؛ ففي مكة أنشأ مجتمع دار الأرقم الذي كان مركز إعداد وتدريب الكوادر وبناء الركيزة الأولى للمجتمع المسلم، وقبل هجرته إلى المدينة حرص على أن يؤسس نواة مجتمعية تكون هي أساس بناء الدولة المسلمة في بيعتي العقبة[4]، ثم عقد وثيقة المدينة بين سكانها المسلمين وغير المسلمين لتقوية وتماسك المجتمع فتستقيم أمور الدولة لاحقًا.
وبناء على النظر في سيرة الأنبياء، واستقراء سنن قيام الأمم وصعودها نستطيع القول: إن الأساس الذي تقوم عليه الدول والحضارات هو المجتمع؛ فالمجتمع سابق لوجود الدولة تاريخيًا، وهو أساس بناء السلطة ووجودها وهي منبثقة عنه وتعمل لمصلحته؛ والمجتمع يستطيع أن يبني دولة ويحافظ عليها، وإذا سقطت أو ضعفت فإنه يقيم غيرها. لكن الدولة لا تستطيع إيجاد مجتمع، بل إن حاولت تهميشه أو العبث به فإنه سرعان ما يثور عليها وينفضُّ عنها، كما حصل في الثورة الأوروبية، والبلدان الشيوعية، وفي الثورات العربية، ويحصل بشكل أو آخر في الدول الغربية.
الأساس الذي تقوم عليه الدول والحضارات هو المجتمع؛ فالمجتمع سابق لوجود الدولة تاريخيًا، وهو أساس بناء السلطة ووجودها وهي منبثقة عنه وتعمل لمصلحته؛ والمجتمع يستطيع أن يبني دولة ويحافظ عليها، وإذا سقطت أو ضعفت فإنه يقيم غيرها
كيف عمل الإسلام على بناء مجتمع قوي فاعل؟
يقوم تعامل الإسلام مع المجتمع على منظومة من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية والتشريعية، ويمكن تحديد ثلاث اتجاهات لها:
1. تكافل المجتمع وتضامنه:
من خلال الأعمال التي تقوي الضعفاء وترفع من سوية المنكسرين، مثل سنن عيادة المريض، وتعزية أهل الميت، وكفالة اليتيم، والقيام على حاجات الأرامل، والصدقة على الفقراء والمساكين، وتزويج الأيامى، وعتق الرقاب، والوضع عن المعسرين، ومواساة الحزانى، فكلها ترفع من سوية الفئات المنكسرة بسبب معنوي أو مادي، فيعودون إلى توازنهم وإنتاجيتهم، ولا يبقون أسرى لأوجاعهم وآلامهم، غير منتجين ولا مشاركين.
2. نشر الأفعال الإيجابية والنافعة:
في جملة من الأفعال والأقوال التي تعزز الإيجابية المغذية للثقة بين أفراد المجتمع حتى وإن كانوا لا يعرفون بعضهم، وهي تزداد فضلاً وأهمية كلما كانوا أقرب لبعضهم كالجيران والأقارب والأرحام وأفراد العائلة الواحدة؛ فصلاة الجماعة، وإلقاء السلام وإطعام الطعام وإغاثة الملهوف وإماطة الأذى وبذل النصح والكلمة الطيبة وصلة الرحم، والتزاور والتهادي، والوفاء بالعهد والصدق في الحديث وفي الوعد،… كلها تعزز من تماسك المجتمع وتواصله، وانتشار الثقة والتواصل بين أفراده.
3. بناء المجتمع القوي الفعال:
ويكون هذا الاتجاه ببناء روح الإيجابية والمبادرة، لينتقل المجتمع لدور الشراكة مع السلطة والعمل وعدم انتظار الأوامر، من مطالبة الجميع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب استطاعته، مرورًا بنصرة المسلم لأخيه: إن كان مظلومًا وقف معه حتى يأخذ حقه، وإن كان ظالمًا منعه من الظلم، مرورًا بجعل اختيار الحاكم والمشاركة الحقيقية في صياغة مؤسسات الحكم حقًا له؛ فسلطان الأمة صنو سيادة الشريعة في نظام الحكم الإسلامي، والحث على الرقابة على تصرفات الحاكم، وانتهاء بالإنكار على السلطان الجائر فإن قُتل في هذا المقام كان في منزلة سيد الشهداء!
تعامل الإسلام مع المجتمع وفق اتجاهات ثلاثة، ترفع من فاعليته وتزيد من الثقة بين أبنائه، وهي: تكافل المجتمع وتضامنه، ونشر الأفعال الإيجابية والنافعة، وبناء المجتمع القوي الفعال
قوة المجتمع قوة للدولة:

إن المجتمع القوي ينتج عنه دولة قوية متماسكة، فيرعاها ويحافظ عليها، ويقوم مقامها إن سقطت، ويُعيد بناءها من جديد.. ولهذا أمثلة كثيرة في تاريخنا الإسلامي، أشهرها التصدي للغزو المغولي للعالم الإسلامي حينما عجزت السلطة عن التصدِّي له، فقام المجتمع بجميع فئاته بمدافعته حتى كسر شوكته واستوعبه وأدخله في الإسلام.
أما السلطة التي تحرص على إضعاف المجتمع وتحييده وتستقوي عليه، فهي عبء على المجتمع وعلى نفسها، وسرعان ما تكون مكشوفة أمام الأعداء ومحلاً لطمعهم؛ لأنها فاقدة للأساس الذي تعتمد عليه وتستند إليه.
إن من أكبر أخطاء السلطات التي تنزع إلى الاستبداد: اعتبار نفسها في صراع أو تحدٍ مع المجتمع، أو اعتباره خصمها الذي تحاول تقييده وتحييده وترويضه، فالمجتمع شريك للسلطة في إقامة الدولة؛ فإن كانت السلطة الحاكمة تمثل القوة الخشنة بما تملكه من أدوات السلطة، فإنَّ المجتمع يمثل القوة الناعمة للدولة.
إن الحكومات المستبدة تخشى من شراكة المجتمعات ورقابتها ومساءلتها، لذلك تنزع إلى إضعافها وتفتيتها ونزع مكامن قوتها، ومنع قيام مؤسسات قوية في المجتمع حتى لا تنازعها السلطة والقيادة بزعمها، أو تلجأ إلى إيجاد مؤسسات شكلية أو تحت سلطتها ورقابتها، فتفرغ الدولة من أقوى سلطاتها، وتتخلى هي عن أقوى أسلحتها، فتدمر معالم المجتمع وشخصيته، فيصبح عبئًا على نفسه وعلى السلطة، وهذا ما يفسر انهيار الدول ذات السلطات المستبدة وبطء أو تعثر عافيتها بعد انهيار هذه السلطات.
أما السلطات التي تعرف للمجتمعات مكانتها وقوتها، وفائدتها في قوة الدول وتقدمها فإنها تدعم المجتمعات ومؤسساتها، وتؤسس معها شراكة حقيقية، بل تجعل من مقاييس التقدم كثرة وقوة واستقلال مؤسسات المجتمع؛ كالدول الغربية التي تسمى بالديمقراطية، والتي وصلت إلى هذه النتائج بعد حروب طويلة أكلت الأخضر واليابس، فاقتربوا بذلك من روح التشريعات الإسلامية في أمور الحكم والسلطة، ولعل في هذا مصداقًا لمقولة عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الروم، فقد قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تقوم الساعة والروم أكثر الناس) فقال له عمرو: أبصر ما تقول، قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمرو: “لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربعًا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرةً بعد فرةً، وخيرُهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك”[5].
المجتمع القوي ينتج عنه دولة قوية متماسكة، فيرعاها ويحافظ عليها، ويقوم مقامها إن سقطت، ويُعيد بناءها من جديد.. أما السلطة التي تحرص على إضعاف المجتمع وتحييده وتستقوي عليه، فهي عبء على المجتمع وعلى نفسها، وسرعان ما تكون مكشوفة أمام الأعداء ومحلاً لطمعهم؛ لأنها فاقدة للأساس الذي تعتمد عليه
المجتمع شريك السلطة وداعم لها:
من هنا ينبغي على السلطات الحاكمة أن تدرك أن المجتمع بشخصياته ومؤسساته هو أفضل داعم لها، وأنها بإفساح المجال له لأخذ دوره ومكانته يعود عليها بالقوة والنفع.. فالمجتمع هو المؤثر في سلوك الأفراد وأخلاقهم، ومن يحدد القيم والمعايير الصالحة.
والمجتمع بسلطته هو القيم والرقيب على الأفراد وتقويمهم، وتستطيع مؤسساته المختلفة (الشرعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية،… وغيرها) أن تقوم بحاجات المجتمع ومتطلباته وتلبيها، وتكون عونًا للحكومة في قضائها، وبذلك توفر عليها أوقاتًا وجهودًا كثيفة.
بل إن مؤسسات المجتمع كثيرًا ما تقوم بأعمال لا تستطيع الحكومة القيام بها، أو لا يناسب القيام بها ليس في الداخل فحسب، بل حتى في العالم الخارجي مع بقية الدول والأنظمة، وبهذا ترفع الحرج عن السلطة، وتوصل ما ينبغي قوله أو فعله في مجالات أو أوقات حساسة.
كما أن المجتمع هو الضامن لإرادته ومكتسباته في حال تغول السلطة أو انحرافها عن جادة الحق، فتكون مؤسسات المجتمع هي الملاذ الآمن للفكر والهوية.
وقد تكرر ذلك مرارًا عبر التاريخ؛ كمحنة خلق القرآن في عهد الدولة العباسية، ومواجهة الدولة العبيدية وانحرافاتها في الشمال الأفريقي، والتصدي للغزو الفكري المعاصر بشتى فروعه وانحرافاته: الشيوعية، والإلحادية، والليبرالية، والتكفيرية، وغيرها.. بما حفظ الدين وعقائد الناس.
بل كان المجتمع بقادته ووجهائه وعلمائه أهم مَن وقف أمام الغزو الصليبي والاستعمار المعاصر حينما عجزت الدول عن القيام بهذه المهمة وانهارت، كما أنه حافظ على دين وهوية الشعوب تحت ظل الأنظمة القمعية من شيوعية وإلحادية وعلمانية وغيرها، فـ “الحراك المجتمعي” أو “المجتمع الحي” هو خير ضمانة للحفاظ على المجتمع ودينه وهويته.
المجتمع شريك في تحمل المسؤولية في القرارات المهمة:
إن مشاركة المجتمع ومؤسساته في قرارات السلطة تتضمن جانبًا مهمًا وهو تحمل المسؤولية التاريخية والشرعية في القرارات المهمة التي تؤثر في مصير الدولة، السياسية منها، والعسكرية، والاقتصادية، وغيرها، وعدم انفراد بضعة أشخاص في السلطة بها، وهذا مما يرشِّد هذه القرارات ويقويها، ويجعلها منبثقةً من واقع المجتمع وحاجاته الحقيقية.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والمؤيّد بالوحي، لم ينفرد في نوازل المدينة ولم يقض أمرًا إلا بعد استشارة الصحابة رضي الله عنهم، وكان يقول: (ليرفع لنا عرفاؤكم أمركم)[6]، ثم تحمّل معهم نتيجة هذه الاستشارة، كما في أسارى غزوة بدر، والخروج لغزوة أحد، وغيرها.
وكثيرًا ما كان ينزل على رأي أصحابه ولو خالف رأيهم رأيه واجتهاده -ما لم يكن وحيًا-، ومن ذلك اختيار موقع معسكر المسلمين في بدر، ومسألة بذل ثلث ثمار المدينة لغطفان من عدمه في الأحزاب، وغيرها من المواقف، فكان صلى الله عليه وسلم بهذه الشورى وهذا النزول على رأيهم يرفع من شأنهم ومن ثقتهم بأنفسهم ومن قوتهم المجتمعية.
وعلى سنته سار الخلفاء الراشدون، والعديد من الخلفاء في الدول الإسلامية المتعاقبة.
إضعاف المجتمع وتفكيك مؤسساته، وتنحية نخبه عن صناعة القرار، سيؤدي إلى إجفال العلماء والنشطاء والصلحاء، وكل من يحاول تقديم النصح أو النقد، وإلى تقريب الموافقين والمادحين، مما ينبت طبقة جديدة من المنافقين والمتسلقين الذين يقولون ما يرضي السلطة، ويوافق هواها، وهذا بداية انحراف وفساد عظيم
مجتمع ضعيف.. مجتمع منافق:

إن إضعاف المجتمع وتفكيك مؤسساته، وتنحية نخبه عن صناعة القرار، سيؤدي إلى إجفال العلماء والنشطاء والصلحاء، وكل من يحاول تقديم النصح أو النقد، أو حتى المشاركة في صناعة القرارات أو تسديدها، وعدم اعتبار كلامهم ومواقفهم، وإلى تقريب الموافقين والمادحين، مما ينبت طبقة جديدة من المنافقين المتسلقين الذين يقولون ما يرضي السلطة، ويوافق هواها، وهذا بداية انحراف وفساد عظيم.
وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قوة المجتمع، وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته لما تولى: “فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني”، وقال فيها: “أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم”[7]، وهو بهذه الكلمات يضع قواعد العلاقة بين السلطة والمجتمع، ويبين حقوق المجتمع ووجباته تجاه السلطة الحاكمة.
ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه مواقف مشهودة مشهورة، منها أنه قال يومًا في مجلس، وحوله المهاجرون والأنصار: “أرأيتم لو ترخّصت في بعض الأمر، ما كنتم فاعلين؟ فسكتوا، فعاد مرتين، أو ثلاثًا، قال بشير بن سعد: لو فعلت قومناك تقويم القدح، قال عمر: أنتم إذن أنتم”[8].
ومنها أنه وَجد يومًا محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فقال عمر: كيف تراني يا محمد؟ فقال: أراك والله كما أحب، وكما يُحب من يحب لك الخير، أراك قويًا على جمع المال، عفيفًا عنه، عادلاً في قسمه، ولو ملت عدلناك كما يُعدل السهم في الثقاف، فقال عمر: هاه، فقال: ولو ملت عدلناك كما يُعدل السهم في الثقاف، فقال: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني[9].
وخطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في يوم جمعة فقال: إنما المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطينا، ومن شئنا منعنا، فلم يردّ عليه أحد، فلما كانت الجمعة الثانية قال مثل مقالته، فلم يردّ عليه أحد، فلما كانت الجمعة الثالثة قال مثل مقالته، فقام إليه رجلٌ ممن شهد المسجد فقال: كلا، بل المال مالنا والفيء فيئنا، من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا، فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه، فأجلسه معه على السرير، ثم أذن للناس فدخلوا عليه، ثم قال: أيها الناس، إني تكلمت في أول جمعة فلم يرّد علي أحد، وفي الثانية فلم يردّ علي أحد، فلما كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سيأتي قوم يتكلمون، فلا يُرد عليهم، يتقاحمون في النار تقاحم القردة)، فخشيت أن يجعلني الله منهم، فلما ردّ هذا عليّ أحياني، أحياه الله، ورجوت أن لا يجعلني الله منهم[10].
وهذه المواقف من عمر ومعاوية رضي الله عنهما تصبُّ في تقوية المجتمع وتشجيعه على قول الحق ولو في وجه الحاكم العام.
حفظ لنا التاريخ كلمات مضيئة للخلفاء الراشدين وغيرهم من بعدهم تضع قواعد العلاقة بين السلطة والمجتمع، وتبين حقوق المجتمع ووجباته تجاه السلطة الحاكمة، وتصبُّ في تقوية المجتمع وتشجيعه على قول الحق ولو في وجه الحاكم العام
السلطة السورية الجديدة والفرصة التاريخية:
إن المرحلة التاريخية الهامة والحرجة التي تمر بها سوريا اليوم، وما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية توجب على السلطة أن تولي وجهها نحو المجتمع الداخلي؛ اعترافًا به، ودعمًا وتقويةً له، وتلاحمًا معه، وإتاحةً للمجال لتكوين المؤسسات المجتمعية بأنواعها، وحرصًا على أخذ المشروعية الداخلية، واستشارةً حقيقيةً في القرارات والخطوات المصيرية سياسية كانت أو اقتصادية، أو غيرها، لتقوية الدولة أمام التحديات الداخلية والخارجية، وتفويت الفرصة على المتربصين بها، ومنع خطر انفضاض الناس عنها، أو شعورهم أنها لا تمثلهم.
إن نموذج الدولة الذي اعتادت عليه الدول العظمى في المنطقة هو نموذج مفرَّغ من حيوية المؤسسات المجتمعية؛ لذا فإنهم سيميلون إلى استمراره والضغط والابتزاز بناءً عليه، وبالتالي فلن يتحقّق للسوريين ما يصبون إليه، وما بذلوا من أجله الغالي والنفيس. كما أن تناقض مصالح الدول فيما بينها سيستنزف من يلتفت إلى جعلها أولوية متفردًا بمواجهتها بالأجهزة الرسمية وهي محدودة، وبالتالي نبقى في حلقة مفرغة تغري القوى الخارجية بالمزيد من الابتزاز مما يؤدي إلى إبقاء سوريا كما عهدوها.
إن العمل على هذا الأمر شاقٌّ وطويل، ويحتاج للتنازل عن العديد من أوجه “السلطة”، وقد لا يتوقع أن يكون انتقالاً جذريًا في مرحلة التأسيس، لكن البدايات الصحيحة ضرورية ولو كانت صغيرة، ونتائجها ستوفر أساسًا صلبًا لدولة قوية، ممثلة للشعب، مستقلة القرار، لا تخضع للابتزاز ولا الضغوط.
وإن الجميع مخاطب بهذا، السلطة الحاكمة، وسائر قادة المجتمع السوري من العلماء والسياسيين والمفكرين والأكاديميين، ورجال المال والأعمال، وعموم الناس.
أما إذا قصّرت الدولة في هذا الجانب أو آثرت الاعتماد على الخارج، وأهملت المجتمع ومؤسساته، فالمسؤولية تنتقل إلى العلماء {بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ} [المائدة: 44] فتبدأ مسؤوليتهم في النصح والبيان والتوجيه.
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذا وأدوه كما فهموه، قال أبو الدرداء رضي الله عنه لوالي الشام: “إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا تغيرتم نتغير عليكم”[11]! قالها له وهو صحابي مثله رضي الله عنهما، لكنه واجب بيان الحق وأداء الأمانة.
وللعلماء بعدهم مواقف صلبة تتعاظم فيها نفوسهم أمام لعاعة الدنيا، وتتحاقر فيها الدنيا ومتعها ولذاتها من الجاه والمال والدعة في عيونهم، حتى صاروا كالجبال شموخًا وعزة، والتاريخ زاخر بمواقف سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل، حتى شكل سفيان الثوري وعبدالله بن المبارك ما يشبه الرابطة العلمائية التي تقوم بواجب النصح والاحتساب، وتنكر على من يقف على أبواب الولاة من العلماء، ويتواصون على هذا العهد فيما بينهم[12]، كل ذلك حفاظًا على استقلال كلمة العلماء، وقوة المجتمع، ومنعًا للحاكم من التفرد بالسلطة والاستبداد.
فَهِم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دور المجتمع في تقوية الدولة، فعملوا به وأدوه إلى من بعدهم، وللعلماء بعدهم مواقف صلبة تتعاظم فيها نفوسهم أمام لعاعة الدنيا، وتتحاقر فيها الدنيا ومتعها ولذاتها من الجاه والمال والدعة في عيونهم، حتى صاروا كالجبال شموخًا وعزة، والتاريخ زاخر بمواقفهم وأفعالهم
أسرة التحرير
[1] حيث تعرف الدولة في الاصطلاح السياسي بأنها: كيان سياسي ذو سيادة يُمارس السلطة على إقليم محدد (أرض) ويضم سكانًا دائمين، وله نظام حكم يُدير شؤونه، ويتمتع بالاعتراف القانوني والسياسي داخليًا وخارجيًا.
[2] أخرجه أحمد (8952)، والأخلاق متعددة، ومنها أخلاق الحاكم والمحكوم وما يُعرف اليوم بـ (الأخلاق السياسية).
[3] أخرجه أحمد (1740).
[4] بيعتا العقبة: الأولى في العام الثاني عشر للبعثة، والثانية في العام الثالث عشر للبعثة، وكانتا في مكة، بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من أهل المدينة، وكانت بيعة العقبة الثانية تتضمن في بنودها السمع والطاعة ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام.
[5] أخرجه مسلم (2898).
[6] ينظر: صحيح البخاري (2307).
[7] سيرة ابن هشام (2/661).
[8] تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر (10/292).
[9] سير أعلام النبلاء (2/372).
[10] أخرجه أبو يعلى (7382).
[11] أخبار الشيوخ وأخلاقهم، للمروذي، ص (57).
[12] للتوسع ينظر كتاب: أخبار الشيوخ وأخلاقهم.