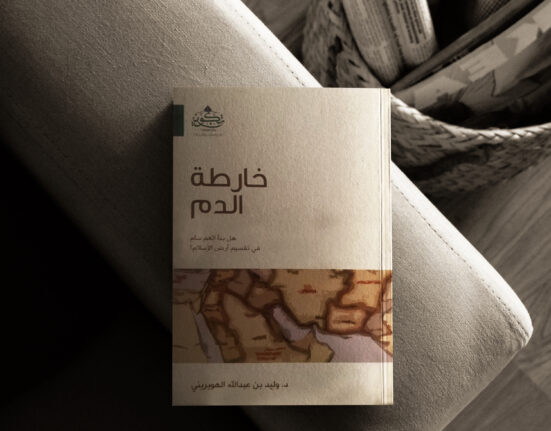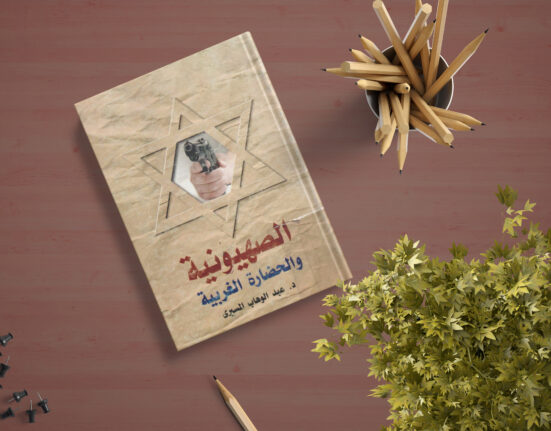يتناول المقال مسألتين؛ الأولى تبحث في التغريب وأثر المركزية الغربية في التعامل مع الآخر غير الغربي، ونتائج الاستشراق ودوافعه. وتتناول الثانية معنى التشريع وبعض الأمثلة المميزة التي نتجت عن تطبيقه في حضارتنا وتراثنا، ومنها الحسبة والأوقاف وطبيعة النظام القضائي، ويبيّن -ضمنًا- تلك المعركة الحاصلة والموجّهة ضدّ تشريعات الإسلام، وأنها نتاج رؤية ضيقةٍ ذات جذور عميقة.
مركزية الغرب وعقدة الهيمنة:
بعد فشل الاستعمار العسكري الذي فرضته الحضارة الغربية أخذَ الغربيون يعتمدون على صورٍ جديدة من الهيمنة على الشعوب ومقدراتها وعقائدها، وذلك من خلال الغزو الفكري الذي يعدّ جزءًا من سياستهم التي تنبع من تصور “مركزية الغرب”، هذا التصوّر الذي كان مرتبطًا مباشرة وبالضرورة بالاعتقاد بالبنية المنحرفة لـلآخر[1].
وقد جذّرت فلسفة التفكيك هذا التصوّر؛ إذ رفضت المرجعيةَ الفكرية والأخلاقية، هادفةً من وراء ذلك إلى نسف أي أساس للحقيقة، فليس في ظاهرة التفكيك حقيقة واحدة، بـل مجموعـة مـن الحقـائق المتنـاثرة النسـبية[2]، وقد ترتب على هذا جملة من الفلسفات والرؤى المنطلقة من التحرر المطلق من القيمِ والمبادئ التي اعتبرت مجرّد تصوراتٍ عقلية.
هذه المركزية هي التي شكّلت وتشكّل الوعي الغربي بنفسه أولاً، وبالآخر الذي لا يريد أن يرى في موضوعه إلا ما يتقصد أن يراه هو فعلاً ويرغب فيه[3]، فأصبح مضمون الخطاب الغربي ضيّقًا غير قادر على استيعاب مَن يختلف معه، بل العكس؛ فعنده أنّ كل من ابتعد عن المدار المتصل بذلك المركز هوى إلى الحضيض؛ لأنه فقد اتصاله بالمركز المانح للأشياء أهميتها[4].
وقد أكد الفيلسوف “ماكس فيبر” على كل هذا، بل وأعلن عن وجهة نظر فلسفية ذات طابع اجتماعي مغزاها أن هناك عقلانية خاصة في الحضارة الغربية تميزها عن غيرها؛ ففي الاقتصاد يميّز “فيبر” الغرب بالتنظيم العقلاني الرأسمالي للعمل الحر[5]، وفي العلم يصرّح أن بحثًا علميًا عقلانيًا منهجيًا متخصصًا وهيئة من المتخصصين المجربين لا وجود لهم في مكان غير أوروبا[6]، وفي السياسة يختزل وجود البرلمانات ورؤساء الوزراء والديموقراطية بالعالم الغربي وحده، وبالمجمل فهو يوضح أنْ ليس إلا الغرب مكانًا لوجود علم نعترف اليوم بقيمة تطوره[7].
وتوصل في دراسة مستفيضة عن الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية إلى أن الرأسمالية هي من نتاج الروح الدينية البروتستانتية بأخلاقها وقيمها ومعتقداتها، وخصوصًا لدى أتباع الكالفينية؛ إذ إن هذه الطائفة البروتستانتية تعمل على تشجيع الادخار والاستثمار[8]، وأنّ الأخلاق الدينية -البروتستانتية الكالفينية خصوصًا- هي التي أثّرت أيّما تأثير في الاقتصاد، بل في ظاهرةٍ اقتصادية هي قمّةُ ما بلغه التفكير العقلاني الاقتصادي: الرأسمالية الغربية الحديثة[9].
بعد فشل الاستعمار العسكري الذي فرضته الحضارة الغربية، أخذَ الغربيون يعتمدون على صورٍ جديدة من الهيمنة على الشعوب ومقدراتها وعقائدها؛ وذلك من خلال الغزو الفكري الذي يعدّ جزءًا من سياستهم التي تنبع من تصور “مركزية الغرب”، هذا التصوّر الذي كان مرتبطًا مباشرة وبالضرورة بالاعتقاد بالبنية المنحرفة لـلآخر
الاستشراق وأزمة الانحياز:
لم تكن هذه الرؤية وحدها هي الأداة للهيمنة على الأرض الإسلامية، بل إنّ التحامل الفكري في كثير من الدراسات الاستشراقية أسهم في صنع انطباع معقد وسلبي لدى الساسة والمفكرين، وهذا الانطباع لم يستطيعوا الانفكاك منه حتى يومنا هذا، ووصلت حدة الانطباع هذه إلى مجتمعنا؛ فنجد فيه مَن ينقم على تاريخنا وتراثنا ويصفه بالوحشي والرجعي والبائد بلا تدقيق ولا رويّة ولا منهج.
ولعلّ ما انتقده “إدوارد سعيد” على المستشرقين يلخّص تلك الرؤية التي تأصّلت شيئًا فشيئًا في كتابات الكثير من رواد الاستشراق، فهم يرون أنّ كل ذرة من ذرات الشرق تُفصح عن طابعها الشرقي وبالتالي أصبح الإنسان الشرقي شرقيًّا في المقام الأول وإنسانًا في المقام الثاني[10]. ويرون أن لغة العرب لا تملك الجماليَّة بينما كان العرب متخلِّفين عن الرَّكب، حسب تعبير المستشرق فريدريك شليجل. وأما دينهم فهو مزيجٌ مشوه مستقى من الأصول المسيحية واليهودية!
يعزو “سعيد” سبب هذا الخطاب الشمولي/ المتطرف لأسباب سياسية مرتبطة بقضايا الاستعمار تارة وتارة لأسباب ثقافية دينية؛ فهو يقول: “إن الاستشراق في جوهره مذهب سياسي فُرض فرضًا على الشرق لأن الشرق كان أضعف من الغرب”[11]، وبسبب أثر البيئة الثقافية الغربية التي كان ينظر من خلالها المستشرق للشرق فقد دخلت أطروحات متأثرة بالأساس البيولوجي والتفاوت العنصري[12] في تفسير القضايا الشرقية، وأصبح الانطباع عن الشرق يُقدّم في إطار يجمع بين الحتمية البيولوجية والتوبيخ السياسي والأخلاقي معًا[13].
وإننا لو راجعنا مسألة أصل الاهتمام بدراسة الشرق الأوسط ولغات شعوبه والإسلام بشكل خاص لوجدنا أن دافعه في بداية الأمر هو: انخراط الغرب في شؤون الشرق خصوصًا بعد الغزو الفرنسي لمصر، إضافة لذلك فإن هناك باعثًا عمليًا كبيرًا يقف خلف هذه الدراسات، وهو ناتج عن انطلاقة القوة العثمانية ونهضتها[14]، كما أن الحاجة للاستخبارات السياسية والعسكرية من جهة ومناسبات التجارة من جهة أخرى كانت تستدعي دراسة جديدة وأكثر عملية للمنطقة[15].
ولو انتقلنا من البحث في أسباب الاستشراق وأهدافه إلى مضمون ما كتبه الكثير من المستشرقين لوجدنا أنّ هناك حملات كبيرة -عند بعضهم- على منهج الإسلام، فنجد في كتبهم مشاريع كثيرة منها التشكيك بآثار الإسلام ونبوّة نبيّه وصحابته، وعند آخرين منهم منهج في التقليل من أهمية السنة النبوية وأنسنة الإسلام ونسبته للمذاهب المسيحية اليهودية، وقد اتبعوا في ذلك مناهج استقرائية مادية متحيّزة، وقد ساعد الإعلام الغربي والعربي مؤخرًا على نشر مثل هذه الشبهات، والقصد من وراء ذلك هو الهجوم على الإسلام، وبتعبير “سفر الحوالي”: أن هذه الحملات لا تخص تنظيمًا معينًا ولا تتمحور حول ما يسمى الإرهاب وإنما تهاجم الإسلام في ذاته[16].
لكن هذه الحملات فشلت فشلاً ذريعًا؛ وذلك لأن الإسلام ينتقل من إنسان إلى إنسان ومن أمة إلى أمة بسهولة ويُسر، وكأن له أجنحة قدسية تحمله وتجري به مجرى الريح[17]، ولأن الإسلام لا يولد طفلاً صغيرًا وإنما يولد عملاقًا هائلاً[18]؛ فقد وقف أمام كل شبهة وفنّدها أوضح تفنيد وفق منهج ربّاني منطقي عقلاني، وهذا هو المنهج ذاته الذي واجَهَ كل شبهة طوال هذه القرون، فلم يقف تساؤل أو شك أمامه إلا وحلّه وفكّ معضلته حتى وصل بالإنسان إلى تكوين حضارة كبرى وعظمى ذات طابع أخلاقي راشد، هذه الحضارة التي أثرت في العالم أجمع؛ فما من ناحية من نواحي تقدم أوربا إلا وللحضارة الإسلامية فيها فضل كبير وآثار حاسمة لها، ونرى تأثير العقلانية الإسلامية والشريعة الإسلامية في أخلاق الأمم اجتماعها وتشريعها في أوروبا النصرانية وفي الهند الوثنية بعد الفتح الإسلامي[19].
في كتابات المستشرقين حملات كبيرة على الإسلام، بدءًا من التشكيك بصحّته ومحاولة أنسنته ونسبته للمذاهب المسيحية اليهودية، إلى التشكيك بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلّم والطعن في صحابته، إلى التقليل من أهمية السنة النبوية، إلى غير ذلك من الطعون التي فشلت فشلاً ذريعًا؛ رغم ضخامة الجهد المبذول ودعم الدُوَل وترويج الإعلام.
التشريع الإسلامي؛ تعريفه وآثاره:
يمكن تعريف التشريع الإسلامي بأنه: “سن القوانين التي تُعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث”[20]، وقال الدكتور محمد الزحيلي: “إنّ التشريع اصطلاحًا لم يعرّفه الفقهاء، وإنما عرفوا مضمونه ومحتواه، وهو: الحكم الشرعي”[21].
ويتناول الشرع في موضوعاته جوانب الحياة كلها، لا بل يتناول مشاكل الإنسان المعاصرة ويُخرج لها الحلول، فهو لا يقف عند الظواهر فقط، بل يغوص إلى أعماق المشكلة[22]، وهو بذلك يتحدّى كُل ما أنتجه وينتجه الفكر الإنساني من قوانين وأحكام، لتظل حائرة مصدومة من تلك القدرة الإعجازية في خلود التشريع وإلهيته المطلقة.
هذا التشريع الإسلامي هو عين منظومة القيمِ الربانية التي أرساها الإسلام، وهو يتضمن ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والعقائد والأخلاق، وتتداخل أهدافه ومآلاته في الميدان الاجتماعي والإداري بما فيه إدارة الشؤون المالية، ومكافحة الجريمة والرشوة وتقسيم الأموال بالعدل بين الناس وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وقد بيّن الدكتور “عبد الفتاح تقية” وسائل تحقيق هذا التكافل الاجتماعي الذي نادى به التشريع، ومنها:
1. تحريم العلاقات التي تولد الحقد والضغينة وتثير المنازعات، كتحريم الخمر والميسر والزنا وعقود الغرر، كما حرم كل ما من شأنه أن يكون سببًا لاستغلال الإنسان مثل تحريم الربا والاحتكار والغش.
2. تحديد وظيفة اجتماعية لكل حق، بحيث إذا خرج صاحبه عن هذه الحدود تجرّدَ من الحماية المقررة، فالعمل حق يمارسه صاحبه بما لا يضر الجماعة فإن فعل أُجبر على منع وقوع الضرر، كما لو امتنع أرباب السلع الضرورية عن بيعها للناس إلا بزيادة عن قيمتها أجبرهم ولي الأمر على بيعها بسعر المثل.
3. التزام الدولة بتوفير الحاجات الأساسية للمجتمع، وهو نظام أشبه بنظام التأمينات الاجتماعية… وقد اعتبر الفقهاء هذا الالتزام من فروض الكفاية[23]، ويقع هذا الفرض تحت مضمون القاعدة الفقهية: “دفع الضرر قدر الإمكان”.

بين التشريع الإسلامي والروماني:
لمّا كان مصدر التشريع الإسلامي هو الوحي الإلهي، فإنّه لابد أن يكون شاملاً جامعًا بين الجزاء في الدنيا وفي الآخرة على حدٍّ سواء، وهذا ما يختلف به عن غيره من القوانين الوضعية، وهو كذلك قد سبق التشريعَ الروماني في تقدير بعض المبادئ العظيمة، ومنها مبدأ انتقال الملكية بمجرّد الاتفاق (أي بلا حاجة إجراءات رسمية)[24]، ومن الاختلافات الأخرى بين التشريع الإسلامي والقوانين الرومانية: أن الشريعة الإسلامية قنّنت العلاقة بين الدائن والمدين وجعلتها على أساس الود والتعاطف، بينما جعل فقه الرومان تلك العلاقة مبنية على القوة والضعف والاسترقاق[25].
إن هذه الاختلافات الهائلة تدعو بلا ريبٍ للنظر في مصادر كلا التشريعين، والنظر أكثر في تلك الفِرية التي ادّعاها المستشرقون بتأثير الحقوق الرومانية في الفقه الإسلامي. وصاحبُ هذه الفرية وهو المستشرق الإيطالي “سانتيلانا”؛ تراجع عن قوله بهذا الأثر ولم يتردد في التصريح بأنه: “عبثًا نحاول أن نجد أصولاً تلتقي فيها الشريعتان الشرقية والغربية… إنّ الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة والمبادئ الثابتة لا يمكن إرجاعها أو نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا؛ لأنها شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلاً”[26].
لقد تراجع هذا المستشرق عن أقواله، ولكن المشكلة أن العديد من المتأثرين به لا أظنهم يتراجعون، بل هم سيصرون ويجمعون الأدلة على شبهاتهم ناسينَ أو متناسين أن الحضارة الإسلامية -سواء نظرنا إلى منتجاتها الفكرية من ناحية الكم أو نظرنا إليها من ناحية الكيف- فإننا سنجد الفقه يحتل الدرجة الأولى بدون منازع، وأن الفقه إنتاج عربي إسلامي محض، وهو العطاء الخاص بالثقافة العربية الإسلامية[27].
ولو ابتعدنا عن مكانة الفقه ومقارنته مع غيره، وتوجهنا نحو الفقهاء المسلمين لوجدنا أنهم امتازوا على فقهاء الرومان، بل امتازوا على فقهاء العالم؛ باستخلاصهم أصولاً ومبادئ عامة من نوع آخر، هي أصول الأحكام من مصادرها، وهذا ما أسموه بعلم أصول الفقه[28]، هذا العلم الذي يمثّل أول محاولة في العالم استهدفت إنشاء علم للقانون متميز عن القوانين التفصيلية[29].
مصدر التشريع الإسلامي هو الوحي الإلهي، وهذا يجعله شاملاً بحيث يتناول جوانب الحياة كلها، ويضع الحلول لمشاكل الإنسان في كل مكان وزمان، متفوّقًا على غيره من الشرائع والقوانين، جامعًا بين الجزاء في الدنيا وفي الآخرة على حدٍّ سواء
الأوقاف:
وضّحنا سالفًا أنّ التشريع الإسلامي كان يجمع بين الدنيا والآخرة، فكان هناك جزاء يترتب وثواب يتأتّى من فعل الخيرات والالتزام بالحدود، وكان من ثمرة هذا الجمع الإلهي: الأوقاف التي تمثّل الحجر الأساس الذي قامت عليه كل المؤسسات الخيرية في تاريخ حضارتنا[30]، فانتشرت هذه الأوقاف وتنوعت، فمنها المساجد والبيمارستانات والخانات والمدارس الدينية والأسبلة والرباطات والتكايا.
ولو قلّبنا في تاريخنا لوجدنا فيه من الأوقافِ ما يجعلنا في غاية العجب، ومثال ذلك أنه كان في مدينة مرّاكش بالمغرب مؤسسة وقفية تسمى دار الدُّقة؛ وهي دار تذهب إليها النساء اللاتي يقع بينهن وبين أزواجهن نفور وبغضاء، وكانت هناك أوقاف لإعارة الحلي والزينة في الأعراس والأفراح، بل وهناك وقف لختان الأولاد وإعطائهم كسوة ودراهم[31].
الحسبة:
وهي واحدة من مميزات وثمرات التشريع الإسلامي، والحسبة شرعًا هي: الأمر المعروف إذا ظَهَرَ تركُه والنهي عن المنكر إذا ظَهَرَ فعله[32]، ولكنها أخذت تتطور مع تطوّر الفكر والمجتمع الإسلامي، وصارت الحسبة تعني: مُشارفة السوق والنظر في المكاييل والموازين ومنع الغش والتدليس فيما يباع من مأكول ومصنوع[33].
وقد أخذت وظيفة المحتسب تتطور أكثر في ظلّ الخلافة العباسية؛ فأُنيطت بالمحتسب وظائف أخرى تتعلق بالإشراف على نظافة الأسواق والمساجد ومراقبة الموظفين للتقيد بالأعمال، حتى مراقبة المؤذن والقضاة، بل وامتحان واختيار ذوي المهن والحرف[34]، كما جاء ذلك في أمثلة عديدة في تاريخنا.
يجدر بنا أن نشير إلى أنّ هذه الوظائف المبتكرة إنما أُسست على منهج النبوة والوحي وتعتمد على أصول من القرآن والسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أول محتسب عرفناه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني)[35].
من ثمرات التشريع الإسلامي: الأوقاف التي تمثّل الحجر الأساس الذي قامت عليه كل المؤسسات الخيرية في تاريخ حضارتنا، والحسبة التي تعبّر عن الفاعلية الفردية والمجتمعية للإبقاء على المعروف والانتهاء عن المنكر، والقضاء الذي يهدف لتحقيق العدل ومنع الظلم بأسس راسخة ووسائل ميسّرة.
النظام القضائي:
الإسلام بمبادئه كافة يهدف للقيم السامية، ويعلي شأن العدلِ في الحكم القضائي؛ وجاءت الآيات المباركة في الحث على العدلِ: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]، {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا)[36]، وعنه صلى الله عليه وسلم: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل -وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)[37].
إنّ هذا التأكيد المستمر في الآي الكريم والحديث الشريف على العدل يؤكد لنا عظيم أهميته في حياة الناس، لذا ولكي تُؤدّى وظيفة العدل على أكمل وجه قَنّنَ فقهاؤنا قواعد وشروط صارمة لتولّي منصب القضاء، وفي الوقت ذاته كان النظام القضائي يأخذ شكلاً بسيطًا في هيكلته؛ حيث إنّه يتميز بالبساطة الحكيمة الخالية من كل التعقيدات والشكليات والبعد عن الهيمنة والاستعلاء والتأله[38]، وهذه البساطة الحكيمة لا تضيع وقت المتقاضين ولا تثقلهم بالنفقات القضائية التي تُدفع عادة في العالم المتمدن[39]، وقد وصف لوبون القضاء ونظام المرافعات بأنّه: “بسيط للغاية؛ أي إنه يقوم بالقضاء قاض منفرد معيّن من قبل ولي الأمر ولا تستأنف أحكام القاضي، ويحضر الخصوم أمام القاضي بدعوة، ويترافعون مشافهةً[40].
ومع تطوّر الحياة الاجتماعية والاقتصادية تحت ظل الشريعة الإسلامية أخذت مؤسسة القضاء بالتطور، ولكن إجراءاتها المذكورة آنفًا لم تتغير، إذ ظهرت وظائف جديدة في العصر العباسي مثل صاحب المسائل، وكانت وظيفته التحقيق في المسائل التي يعهد بها القاضي إليه، وأول من استعمله القاضي محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى صاحب أبي حنيفة[41]، كما ظهرت وظائف أخرى في النظام القضائي هي: القسّام الذي يتولى قسمة الحقوق بين أصحابها ويسمّى بالحسّاب أيضًا، وكذلك وظيفة الأمناء الذين يكلفهم القضاة ببعض الأعمال المهمة، مثل حفظ أموال اليتامى والقاصرين وحفظ التركات[42]، وغيرها من الأعمال.
من أمثلة عناية الشريعة بالتفاصيل:
عمق التشريع وتفاصيله المقننة:
اعتنت الشريعة بأدق تفاصيل الأحكام، ففيما يتعلّق بحقوق الحيوان على سبيل المثال: راعت الشريعة حقوق الحيوان وحالته النفسية وكيفية ذبحه وإطعامه، وقد صاغت مبادئ الشريعة حقوقًا للحيوان نفسه وحالته النفسية! وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه كتابا سمّاه “كتاب الذبائح والصيد”، وذكر فيه ذلك الحديث العظيم الذي يبيّن المراعاة الشاملة لآداب التعامل مع الحيوان؛ ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهم مروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن من فعل هذا)[43]، وفي روايةٍ: (لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يمثل بالحيوان)[44].
وجاء في حديث آخر عن كيفية الذبح وعدم تعذيب الحيوان حتى وصل لدرجة ألا يرى الحيوان السكين الذي سيُذبح بها! فقد روى الطبراني: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: (أفلا قَبْلَ هذا؟ أوَتريد أن تميتها موتتين)[45].
وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته)[46]، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم التلهي بصيد الحيوان، بل ونهى عن لعنه[47].
ومن تلك المواقف العظيمة التي نقف عندها ونتأمّل إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم وربانية رسالته، أنه صلى الله عليه وسلم دخل حائطًا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حَنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذِفراه فسكت، فقال: (مَن رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل؟) فجاء فتى من الأنصار، فقال: لي يا رسول الله، قال: (أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؛ فإنه شكا إلي أنك تُجيعه وتُدئبه)[48].
اعتنت الشريعة بأدق التفاصيل، حتى إنّها راعت حقوق الحيوان وحالته النفسية؛ فشرعت تشريعات تأمر بالعناية به وإطعامه، وتحرّم الإساءة إليه وإرهاقه، وتوصي بالإحسان إليه حتى عند ذبحه.
كلمة أخيرة:
ما سبق لمحة موجزة على ما أنتجته الحضارة الإسلامية من خلال الشريعة الربانية التي انتهجتها، والتي أُعجِبَ بمثاليتها وعظيم قوانينها وأثر أحكامها حتى مَن لا يؤمنون بها، وأمامَ هذا الشرع لا يمكن لأي منصف إلا أن يقول فيه ما يمليه عليه ضميره، حتى لو كان مخالفًا له وغريبًا عنه.
فها هو ذا الأديب الروسي “ليو تولستوي” يبشّر بعظمة الشريعة ويقول: إنها “ستعمُّ كل البسيطة؛ لائتلافها مع العقل وامتزاجها بالحكمة والعدل”. وأبدى المستشرق البريطاني “مونتغمري وات” رأيه في أن الشريعة “تختلف اختلافًا واضحًا عن جميع أشكال القانون؛ إنها قانون فريد في بابه، إن الشريعة الإسلامية هي جملة الأوامر الإلهية التي تنظِّم حياة كل مسلم من جميع وجوهها”[49].
ولعله من المناسب أن أختم بقول منصف نقله “غوستاف لوبون” عن العالم المتدين مسيو “لوبْلِه”: “صان المسلمون أنفسهم حتى الآن من مثل خطايا الغرب الهائلة فيما يمس رفاهية طبقة العمال، وتراهم يحافظون بإخلاص على النظم الباهرة التي يسود بها الإسلام بين الغني والفقير والسيد والأجير على العموم، وليس من المبالغة أن يقال إذن: إن الشعب الذي يزعم الأوربيون أنهم يرغبون في إصلاحه هو خير مثال في ذلك الأمر الجوهري”[50].
كمال أنمار أحمد
كاتب ومهتم بالشأن الإسلامي الحضاري والفكري – العراق
[1] الآخر في الفكر الغربي، لعادل حمدي، ص (245).
[2] مجلة الدراسات الإسلامية، العدد ١١، ص (٥١٧)، الألوهية في الفكر الغربي الديني الحديث.
[3] المصدر السابق، ص (٢٤٨).
[4] المصدر السابق، ص (٢٤٧).
[5] الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، لماكس فيبر، ص (٩).
[6] المصدر السابق، ص (٦).
[7] المصدر السابق، ص (٥).
[8] مقال: “قراءة في الرؤية الغربية وريادة الحضارة الإسلامية”، موقع الجزيرة، كمال أنمار.
[9] مقال ماكس فيبر: “الدين وأخلاق العمل والرأسمالية”، موقع الحكمة، برّاق زكريا.
[10] الاستشراق، إدوارد سعيد، ص (٣٥٩).
[11] المصدر السابق، ص (٣٢١).
[12] المصدر السابق، ص (٣٢٤).
[13] المصدر السابق، ص (٣٢٥).
[14] الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، مجموعة مؤلفين، ص (134-١٣٥).
[15] المصدر السابق، ص (١٣٦).
[16] المسلمون والحضارة الغربية، للدكتور سفر الحوالي، ص (١٠٣).
[17] في أروقة التاريخ، لمحمد إلهامي، ص (٤٤).
[18] المصدر السابق، ص (٢١٠٤).
[19] ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، لأبي الحسين الندوي، ص (116).
[20] التشريع الإسلامي خصائصه ومقاصده، لعبد الفتاح تقية، ص (٨).
[21] مصطلح التشريع ومشتقاته في الاستعمال الحقوقي، للدكتور سعد مطر المرشدي، ص (١٩).
[22] السبق العلمي في تشريعات القرآن الكريم، للدكتور زكي البشايرة، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة، العدد (33)، ص (١١٤٣).
[23] التشريع الإسلامي خصائصه ومقاصده، ص (١٧-18).
[24] مقال: “التشريع الإسلامي بين التشريعات الحديثة”، إيلاف فاضل التميمي، مجلة دعوة الحق، العدد (26).
[25] السبق العلمي في تشريعات القرآن، ص (١١٥٠).
[26] تكوين العقل العربي، لمحمد عابد الجابري، ص (٩٧).
[27] المصدر السابق، ص (٩٦).
[28] مقال: “التشريع الإسلامي بين التشريعات الحديثة”.
[29] تكوين العقل العربي، ص (٩٩).
[30] ماذا قدّم المسلمون للعالم، لراغب السرجاني، ص (٤٧٧).
[31] المصدر السابق، ص (٤٨١).
[32] الأحكام السلطانية، للماوردي، ص (349).
[33] الحسبة في الإسلام، لأحمد المراغي، ص (5).
[34] ينظر: ماذا قدم المسلمون للعالم، ص (٥١١).
[35] أخرجه مسلم (١٠٢).
[36] أخرجه مسلم (٢٥٧٧)
[37] أخرجه مسلم (1827).
[38] مقال: القضاء في الإسلام، للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق، على موقع الألوكة.
[39] حضارة العرب، لغوستاڤ لوبون، ص (٤٠٤).
[40] المرجع السابق، ص (403).
[41] ماذا قدم المسلمون للعالم، ص (٥٤٦).
[42] المصدر السابق، ص (٥٤٧).
[43] أخرجه البخاري (5515).
[44] أخرجه أحمد (3133).
[45] أخرجه الطبراني (11916)، والحاكم (7563).
[46] أخرجه مسلم (١٩٥٥).
[47] أخرج مسلم (2595) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة).
[48] أخرجه أبو داود (2549)، ذِفراه: أصل أذنيه، تُدئبه: أي تتعبه.
[49] مقال: قالوا عن الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد يسري إبراهيم، على موقع الألوكة.
[50] حضارة العرب، ص (٤٠٤).