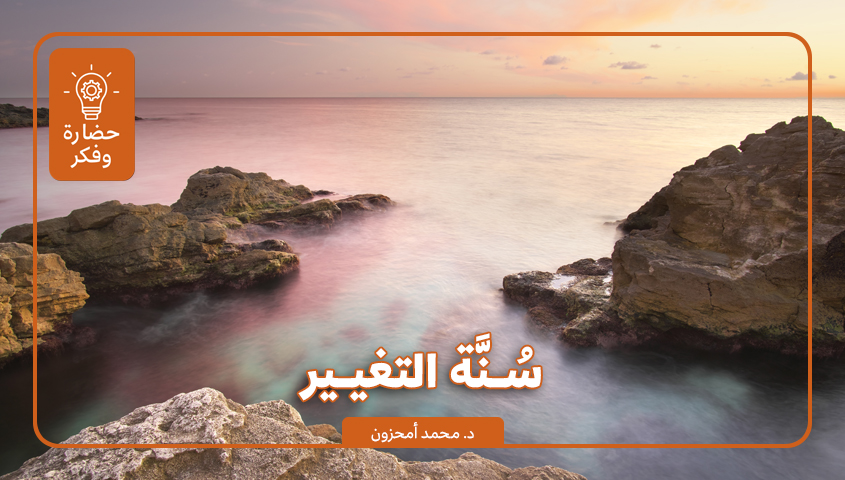علامات الساعة جزء من العقيدة، ولا يثبت منها إلا ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، وقد يقع الانحراف حين يُربط الواقع بها بلا ضوابط، انطلاقًا من الوهم والعاطفة؛ فينتج تأويل فاسد أو استغلال سياسي، والضوابط الشرعية تقوم على: التحقق من صحة النصوص، وفهمها بميزان الشرع، والرجوع لأهل العلم، والمطلوب هو الاستعداد لها بالعمل الصالح وتثبيت الإيمان، لا التواكل أو انتظار الأحداث بغير وعي.
مدخل:
كلما وقع حدث عالمي ذو أهمية تداعى عدد من الناس لربط هذا الحدث بوقوع أحد أشراط الساعة، وربما اعتمد هؤلاء على روايات ضعيفة أو موضوعة في أشراط الساعة، وإذا صحت الرواية لَوَوْا عنق النص وتأولوه بما لا يحتمل التأويل ليوافق الحدث الواقع.
وينتشر هذا التأويل بين الناس مما ينتج عنه مواقف خاطئة واعتقادات فاسدة تؤثر على المجتمع وعلاقات الناس، وقد تحمل على انحرافات في المنهج والفكر.
لذلك لا بد من بيان ضوابط التعامل مع أشراط الساعة وتنزيلها على الوقائع درءًا للوقوع في الآثار السيئة لهذا التأويل.
وليس المقصود من مقالنا هذا سرد ما ورد من الأشراط، ولا تحقيق ما ورد منها، ولا الرد على من أنكرها؛ فقد كتب في هذا من العلماء الكثير، وإنما المقصود الإشارة إلى نقاط يمكن أن تحدد التعامل معها نصوصًا ووقوعًا، ولذلك لن نخوض في شرح وتفصيل كل ما يرد من الأمثلة عن أشراط الساعة، وإنما نشير إليها إشارة ونقف عند موضع الشاهد منها.
أشراط الساعة:
يطلق عليها عدة أسماء منها: أشراط – علامات – أمارات – أحداث – آيات.
وأشراط الساعة: العلامات الدالة على قرب الساعة.
أو هي أحداث وأمور تجري مرتبطة بقرب اليوم الآخر.
ومن أدلة ثبوت علامات الساعة:
– من القرآن الكريم قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ} [الأنعام: 158]. وقد ورد في تفسير هذه الآية ما رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: (ثلاثٌ إذا خَرجْنَ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربها، والدَّجال، ودابة الأرض)[1].
– من السنة النبوية: عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: “أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أَدم، فقال: (اعدُد ستًا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم مُوْتانٌ يأخذ فيكم كقُعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا)[2].
وموضع الإيمان بأشراط الساعة هو من علم العقيدة، ومن الإيمان بيوم القيامة، قال تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ} [محمد: 18]، وفي حديث جبريل عليه السلام: قال: فأخبرني عن الساعة، قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)، قال: فأخبرني عن أمارتها[3]، وقوله: (اعدُدْ ستًّا بين يدي الساعة…).
آثار الإيمان بأشراط الساعة:
للإيمان بأشراط الساعة آثار عديدة على المسلم، لعل من أهمها:
1. تحقيق الإيمان بركن من أركان الإيمان الستة كما سبق بيانه.
2. تثبيت الإيمان وتقويته إذا رأى المسلم تحقق ما أخبر به الشرع من أشراط وأخبار.
3. تعليم المسلم الأحكامَ الشرعية في قادم الحوادث، وبيان كيفية التعامل معها، فمن ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يومًا، يوم من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا، وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام الطويلة: أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (لا، اقدُرُوا له قَدْره)[4].
4. تحذير للمسلم من الوقوع في المحرمات مثل الألفاظ التي وردت في الأحاديث: (أحذركم الدجال، بادروا بالأعمال فتنًا …).
أشراط الساعة من علم الغيب:
أشراط الساعة من قضايا العقيدة، وتندرج تحت باب علم الغيب المتعلق بالمستقبل والذي ذكر القرآن بعضه وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض خبره.
والغيب في أشراط الساعة يكون في: العلم بأنها من علامات الساعة، ووقت وقوعها، وتنزيل الواقعة على الحدث؛ لذا لابد من الدقة في تنزيلها والتعامل معها.
وطرق إثبات نصوصها: هي طرق إثبات الغيبيات؛ فهي محصورة بطريق الوحي الصحيح من نصوص الكتاب والسنة.
توقع وقوع أشراط الساعة والسؤال عنها:
يصح توقع حدوث بعض أشراط الساعة، بل إن الغاية من ورود أشراط الساعة في النصوص لنتوقع حدوثها فنتذكر ونتعظ ونستعد، فعن النواس بن سمعان الكلابي قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الغداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فلما رُحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرتَ الدجال غداةً فخفَّضتَ فيه ورفّعتَ حتى ظننا أنه في طائفة النخل، قال: غيرُ الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجُه دونَكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيجُ نفسِه، والله خليفتي على كل مسلم)[5].
وكذلك حين ظن عمر رضي الله عنه أن ابن صياد هو الدجال، ففي الحديث عن محمد بن المنكدر قال: “رأيت جابرَ بنَ عبد الله يحلف بالله: أن ابن الصائد الدجالُ، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم”[6].
والدليل على أن السؤال عنها وتحقيق مسائلها مطلوب: حديث جبريل حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
لذلك يجب أن نفرق بين توقع حدوثها وبين الجزم بوقوعها في زمن ما قبل الوقوع.
يصح توقع حدوث بعض أشراط الساعة، بل إن الغاية من ورود أشراط الساعة في النصوص لنتوقع حدوثها فنتذكر ونتعظ ونستعد
ضوابط تنزيل الأشراط على الواقع:
1. التأكد من صحة وصراحة النص الوارد فيها:
فالنصوص أقسام:
» نصوص صحيحة صريحة، والصريح الذي له معنى واحد لا يختلف فيه، كنزول عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق.
» نصوص صحيحة غير صريحة، كحديث: (ستصالحون الروم صلحًا آمنًا تقاتلون أنتم وهم عدوًا من ورائكم)[7]، فتحديد الروم، وكيفية الصلح معهم، والعدو الذي سيقاتلونه جميعًا: غير محدد، ولا دليل على تحديده.
» نصوص ضعيفة صريحة، مثاله حديث: (تخرجُ من خراسان راياتٌ سود، لا يردّها شيء حتى تُنصب بإيلياء)[8].
»نصوص ضعيفة غير صريحة، مثاله حديث: (يخرج رجل يقال له: السفياني في عمق دمشق)[9].
» نصوص موضوعة، أو من الإسرائيليات.
والأحاديث الضعيفة والموضوعة لا يعمل بها في هذا الباب، والإسرائيليات يعمل فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم)[10].
2. عدم التكلف في البحث عنها وتنزيلها:
فهناك فرق بين توقع حدوثها وبين البحث عنها وتنزيلها على الوقائع والأعيان، فالبحث ليس تكليفًا، وهو ربط النص الوارد بحادثة ما بمجرد وقوعها دون انقضائها، أما التوقع فهو يدخل في باب المواعظ والترغيب والترهيب بذكر الأشراط، كالتحذير من الدجال.
والتكليف حكم شرعي يحتاج لدليل على ثبوته، وإن ألزمنا أنفسنا بالبحث فقد يكون سببًا في الانحراف والضلالة.
مثال ذلك: البحث عن المهدي وما يتبع ذلك من أشراط، فقد نشأ بسبب البحث عن المهدي وانتظاره انحراف عن أهل السنة والجماعة في فرق شتى تجاوزت مجرد البحث إلى اعتقادات باطلة كما هو الحال عند الرافضة والبهائية.
هناك فرق بين توقع حدوث أشراط الساعة وبين البحث عنها وتنزيلها على الوقائع والأعيان، فالبحث ليس تكليفًا، وهو ربط النص الوارد بحادثة ما بمجرد وقوعها دون انقضائها، أما التوقع فهو يدخل في باب المواعظ والترغيب والترهيب بذكر الأشراط كالتحذير من الدجال.
متى نجزم بوقوع أحد أشراط الساعة؟
نجزم بعد التحقق من الوقوع بشكل قطعي بعد التأكد من ثبوت النص الدال على العلامة، كموقف علي رضي الله عنه من ذي الثُّدَيّة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسمًا، أتاه ذو الخويصرة -وهو رجل من بني تميم- فقال: يا رسول الله اعدل، فقال: (ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟! قد خبتَ وخسرتَ إن لم أكن أعدل، فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال: دعه، فإنّ له أصحابًا … آيتهم رجل أسود إحدى عضُديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البَضعة تَدَرْدَرُ، ويخرجون على حين فرقة من الناس)، قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتُمس فأتي به حتى نظرت إليه على نَعْتِ النبي صلى الله عليه وسلم الذي نَعَتَه[11].
3. ومن الجزم بالوقوع، التأكد من انقضاء العلامة وتمامها:
فسبب الوقوع في الخطأ في أغلب الأحوال هو عدم الانتظار إلى انقضاء الحادثة. وقد تكلم العلماء كثيرًا في بيان المراد بـ”إفساد بني إسرائيل” الوارد في سورة الإسراء، وحملها بعض المعاصرين على علو الصهاينة في هذا الزمان، وما تزال الأحداث تجري ولم تنته بعد، فلا نستطيع الجزم بأنه الإفساد الثاني، والكلام في هذا الأمر طويل له موقعه.
كما لا نستطيع الجزم بنطق الحجر والشجر إلا بعد وقوعه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله)[12].
4. الاجتهاد في استنباطها ووقوعها يكون من أهل الاجتهاد والاختصاص:
الكشف عن علامة من علامات الساعة أحد أنواع العلوم الشرعية، والعلم الشرعي يرجع فيه الناس إلى أهل الاختصاص والاجتهاد، فلا يقوم بذلك العامي.
أما الاستنباط فلا بد من تحقيق النصوص ودراستها ومعرفة متعلقاتها الشرعية، وأما الوقوع فلا بد من الإحاطة بالواقع من كل جوانبه فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.
مثال ذلك: الموقف من معرفة مكان ردم يأجوج ومأجوج، هل هو سور الصين كما يروج بعض العامة، وهل قوم يأجوج ومأجوج هم شعب الخَزَر؟!
الكشف عن علامة من علامات الساعة أحد أنواع العلوم الشرعية، والعلم الشرعي يرجع فيه الناس إلى أهل الاختصاص والاجتهاد، فلا يقوم بذلك العامي.
5. التحقق من معاني النصوص وفهمها بشكل صحيح:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنَعت العراقُ درهمها وقَفيزها، ومَنَعت الشأم مُدْيَها ودينارها، ومَنَعت مصر إردَبَّها ودينارها، وعُدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم)، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه[13].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عم ذاك؟ قال: (تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم)[14].
فالنص الثاني يبين المقصود بالنص الأول من منع الدرهم والدينار، وقد تكلف بعضهم بحملها على الحصار المادي على بلاد العراق والشام.
ومن الفهم: الإحاطة بشروط ومكملات وأحوال وقوع الأشراط كما جاءت بذلك النصوص، فمثلاً: نزول سيدنا عيسى عليه السلام مرتبط بخروج الدجال، وقد وردا في حديث واحد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، أو بِدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافّوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله، لا نُخلي بينكم وبين إخواننا؛ فيقاتلونهم … فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إنَّ المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون -وذلك باطل- فإذا جاؤوا الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فأَمَّهُم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانْذابَ حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته)[15].
6. عدم التكلف في قراءة الواقع:
والتكلف في قراءة الواقع ينشأ من التخيلات والأوهام التي ترافق الأحداث العظيمة، مثال ذلك: كتاب هرمجدون الذي يحمل من العجائب الكثير، ومما قال مؤلفه مثلاً: “روى نُعيم بن حماد بسنده عن كعب قال: “علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب عليها رجل أعرج من كندة”.. ما كنت أظن أن يختار الأمريكان رجلاً أعرج فيجعلوه في منصب رئيس هيئة أركان القوات المشتركة … فلما رأيت الجنرال “ريتشارد مايرز” يقبل على عكازين ليعلن للشعب الأمريكي بدء عمليات القوات المشتركة الجوية والبرية والبحرية ضد أفغانستان، قلت: الله أكبر، صدقت يا رسول الله. إن خروج ألوية القوات المشتركة لجيش الغرب (الرايات الصليبية) تحت قيادة الأعرج الكندي لهو بدء الملاحم، وهو لعمر الله علامة خروج المهدي عليه السلام…) إلى آخر كلامه!!
7. التقريب الزماني والمكاني للواقعة:
قد يحمل بعض الناس ما أُشير إليه من أشراط الساعة المتأخرة على أحداثٍ وقعت في أزمنة لا تحتمل أن تكون زمنَ النهاية، مثال ذلك: حمل خروج يأجوج ومأجوج -وهو من آخر أشراط الساعة- على ظهور المغول والتتار، وهو تأويل بعيد من جهة الزمان والمكان.
كما قال ابن عاشور في يأجوج ومأجوج: “والذي يجب اعتماده أن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتر”، “إن موضع السدين هو الشمال الغربي لصحراء (قوبِي) الفاصلة بين الصين وبلاد المغول شمال الصين وجنوب )منغوليا)”[16].
قد يحمل بعض الناس ما أُشير إليه من أشراط الساعة المتأخرة على أحداثٍ وقعت في أزمنة لا تحتمل أن تكون زمنَ النهاية، مثال ذلك: حمل خروج يأجوج ومأجوج -وهو من آخر أشراط الساعة- على ظهور المغول والتتار، وهو تأويل بعيد من جهة الزمان والمكان.
8. مراعاة ألفاظ الشريعة والعرف في زمن النبوة:
فتحديد مكان دابق -المذكور في الحديث السابق- هل هو في الشام أم هو موضع قرب المدينة؟
والذي عليه أهل العلم أن دابق في الشام، نقل القاري قول التوربشتي -رحمه الله- في دابق: “وهو موضع معروف من عمل حلب، ومرج دابق مشهور… فيخرج إليهم جيش من المدينة… وقال في الأزهار: وأما ما قيل من أن المراد بها مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضعيف؛ لأن المراد بالجيش الخارج إلى الروم جيش المهدي بدليل آخر الحديث، ولأن المدينة المنورة تكون خرابًا في ذلك الوقت”[17].
وهل نَجْد هي العراق أم نجد في جزيرة العرب؟ يرجع ذلك إلى ألفاظ الشريعة والعرف في زمن النبوة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان)[18].
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: “وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي شرق أهل المدينة، وأصل النجْد: ما ارتفع من الأرض، وهي خلاف الغَور، فإنه ما انخفض من الأرض، وتِهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة” انتهى. وعُرف بهذا وَهاء ما قاله الداودي أن نجدًا من ناحية العراق، كأنه توهم أن نجدًا موضع مخصوص، وليس كذلك، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى نجدًا، والمنخفض غورًا”[19].
9. الأصل أن تحمل ألفاظ النصوص على حقيقتها دون تأويل:
فالأحاديث التي وردت في شرح تفاصيل بعض أشراط الساعة أشكلت على بعض الناس هل هي على حقيقتها أم أنها يمكن تأويلها؟ من ذلك: تأويل البعض نطق الحجر والشجر، وتكليم الرجل عَذَبة سوطه، والقتال بالسيف والرمح، وتجاوز البعض ذلك إلى تأويل الدجال بأمريكا والحضارة الغربية!
والأصل فيها حملها على الحقيقة؛ إذ لا داعي لتأويلها، ولا يستحيل عقلاً ولا شرعًا وقوعها كما هي.
10 معرفة الجهة التي تروج لوقوع أحد أشراط الساعة:
فقد وظف بعض أصحاب الفرق المخالفة كالرافضة والخوارج نصوص بعض أشراط الساعة لنشر فكرهم وتلبيس الحق بالباطل أمام العامة من الناس.
فاعتنوا بنشر كتاب “الجَفْر”[20] وعلامات عودة المهدي الغائب –بزعمهم– وفعلوا من القبائح نتيجة لذلك ما لم يذكر مثلها التاريخ.
وظف بعض أصحاب الفرق المخالفة كالرافضة والخوارج نصوص بعض أشراط الساعة لنشر فكرهم وتلبيس الحق بالباطل أمام العامة من الناس.
خاتمة:
ومن خلال ما سبق يتضح أن من أهم الأخطاء في التعامل مع موضوع أشراط الساعة:
تكذيب النصوص الصحيحة الصريحة، أو ردّها لأسباب متنوعة، أو الاعتماد على الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، أو تحريف معاني النصوص بتأويلات فاسدة، أو التكلف في تنزيلها على وقائع أو أحداث معينة، أو توظيفها لخدمة أغراض فكرية أو سياسية منحرفة.
أو التواكل عليها وعدم الأخذ بالأسباب للحماية من فتنها، وترك العمل وانتظارها، بل هو من جملة الأخذ بالأسباب وتحقيق التوكل على الله، جاء في الحديث: (إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة، فليغرِسها)[21].

د. جمال الفرا
خطيب وداعية
[1] أخرجه مسلم (158) والترمذي (3072).
[2] أخرجه البخاري (3176)، أَدم: الجلد المدبوغ، مُوْتانٌ: الموت الكثير، عُقاص الغنم: داء يصيب الدواب تموت منه فجأة.
[3] أخرجه مسلم (8).
[4] أخرجه مسلم (2937).
[5] أخرجه مسلم (2937).
[6] أخرجه البخاري (7355).
[7] أخرجه أبو داود (4292).
[8] أخرجه الترمذي (2269) وقال: حديث غريب.
[9] أخرجه الحاكم في المستدرك (8840).
[10] أخرجه البخاري (4485).
[11] أخرجه البخاري (3610) ومسلم (1064) واللفظ للبخاري، ومعنى تَدَرْدَرُ: أي تضطرب.
[12] أخرجه البخاري (2926) ومسلم (2922).
[13] أخرجه مسلم (2896)، والقفيز: مكيال معروف لأهل العراق، والمُدي: مكيال معروف لأهل الشام.
[14] أخرجه البخاري (3180).
[15] أخرجه مسلم (2897).
[16] التحرير والتنوير (16/31، 33).
[17] مرقاة المفاتيح (8/3412).
[18] أخرجه البخاري (1037).
[19] فتح الباري (13/47).
[20] ويقصدون بالجفر: علم يبحث في خصائص الحروف ويستخرج منها دلائل تشير إلى أحداث تقع في المستقبل.
[21] أخرجه البخاري في الأدب المفرد (749) وأحمد في المسند (12902) واللفظ لأحمد.