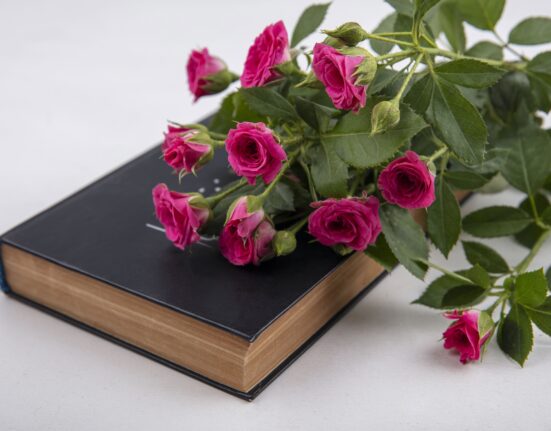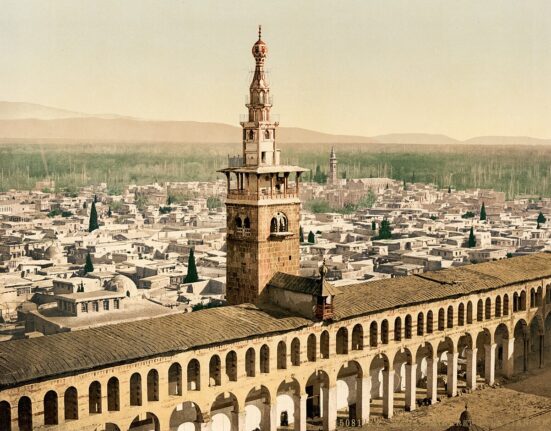للقيام بالحسبة دورٌ مهمّ في صلاح المجتمع وسلامته ونجاته، ومن ميادينها التي يغفل عنها كثير من الناس أو لا يولونها حقّها: الأسرة، فما أهمّية الحسبة في نطاق الأسرة؟ وما عواقب إهمالها؟ وما المنكرات التي تنتشر في نطاق الأسرة؟ وكيف يكون إنكارها؟ وهل هناك خصوصية لطريقة إنكار المنكر بين الأقارب؟ هذا ما سيجيب عنه هذا المقال
مدخل:
من أعظم سمات هذه الأمّة وخصائصها وأركان دينها: قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جعله الله تعالى دليلاً على خيريّتها، فقال سبحانه: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]، وقُدّم ذكره في هذا المقام على الإيمان بالله لأنّ “الموجب لهذه الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأمّا إيمانهم فذاك شرط التأثير”[1].
وقد ذمّ الله سبحانه الأمم السابقة بسبب تركهم القيام بهذا الأمر العظيم، فقال سبحانه: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 78 كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 78-79].
ولذا فإنّ من أوجب الواجبات على المسلم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويعظم الوجوب إذا رأى المنكرَ أو علم به، (مَن رأى منكم منكرًا فليغيّرهُ بيده، فإن لم يستطع فبِلسانهِ، فإن لم يستطع فبِقلبهِ، وذلك أضعفُ الإيمان)[2].
تعريف الحسبة:
الحسبة هي القيام بمهمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[3]، ومتولّيها هو المحتسب، وهو الغيور الذي يقوم بتغيير المنكر وإقامة المعروف دون تكليف من أحد، وإنّما دافعه في ذلك براءة الذمّة ورجاء المثوبة من عند الله.
لكن شاع في التاريخ الإسلامي أن يُراد بالحسبة تلك الوظيفة التي يكلّف بموجبها ولي الأمر مَن يراه مناسبًا من المسلمين للقيام بتغيير المنكر وإقامة المعروف، قال ابن خلدون في تعريفها: “أمّا الحسبة فهي وظيفة دينيّة من باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعيّن لذلك مَن يراه أهلاً له”[4].
وكلامنا في هذا المقال ينصرف بالدرجة الأولى إلى المحتسب المتطوّع الذي هو كلّ واحد من المسلمين، ولا سيما أنّنا نتحدّث عن الحسبة في دائرة خاصّة وهي الأسرة.
الحسبة هي القيام بمهمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتولّيها هو المحتسب، وهو إمّا متطوّع، أو موظّف من قبل الدولة ويسمّى المحتسب: متولّي الحسبة أو والي الحسبة
المراد بالأسرة:
المقصود بها هنا: الأسرة بالمفهوم الواسع، التي تشمل الأسرة النواة التي تنشأ برابطة زوجية بين رجل وامرأة، ثم يتفرّع عنها الأولاد، والتي تظلّ على صلة وثيقة بالأسرة الممتدّة المكوّنة من أصول الزوجين من أجداد وجدّات، والحواشي من إخوة وأخوات، والقرابة القريبة من الأحفاد والأسباط، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم[5].
أهمّية الحسبة في نطاق الأسرة:
من ميادين الحسبة: ما يكون في نطاق الأسرة، وهو على قدر كبير من الأهميّة، وإهماله فيه خطر عظيم على الأسرة أوّلاً ثمّ على المجتمع؛ وذلك لأمور:
1. أنّ الأسرة هي الحاضنة التي تتشكّل فيها هويّة أفرادها، ومعالم شخصيتهم الدينية والقِيَميّة والأخلاقية والنفسية والعاطفية، فإذا لم يكن ثمّة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فسينشأ الفرد في هذه الأسرة على حال من الجهل وتشرّب الفساد بحيث (لا يعرِفُ معروفًا، ولا يُنكِرُ منكرًا، إلا ما أُشربَ من هَواه)[6].
وإذا وُجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التربية والتعليم فسينشأ أفرادها على الخير، ويتشكّل فيهم الوعي الديني والسلوكي ومراقبة الله عزّ وجلّ، قال سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6]، قال البغوي: “مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلّموهم وأدّبُوهُم؛ تَقُوهُم بذلك نارًا”[7]، وقال السعدي: “ووقاية الأهل والأولاد: بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، فلا يَسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيمن يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرّفه”[8].
2. أنّ الأسرة هي نواة تكوين المجتمع وأساس استقراره، تؤثّر فيه وتتأثر به؛ فإن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع، كما أنّ الأسرة على اتصال بالمجتمع من خلال الأقارب من أنسباء وأصهار، ومن خلال الجيران؛ فإذا لم يُعمل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنّ ما يكون في الأسرة من تقصير في الخير وعمل بالشرّ؛ سيستمرّ، ثم إنّه لن يبقى قاصرًا عليها، بل سيتسرّب إلى محيطها ويؤثّر فيه، وبدل أن تكون الأسرة لبنة بناء للمجتمع ستكون عامل هدم فيه.
3. أنّ الحسبة في نطاق الأسرة تحفظها من الانهيار؛ فهي وسيلة للتقويم والمراقبة، ولضمان بقاء المعروف وانتفاء المنكر، وبذلك تكون الأسرةُ سفينةَ النجاة لأفرادها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ القائم على حدودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قوم استهموا على سفينةٍ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استَقَوا من الماء مرّوا على من فوقهم، فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نُؤْذِ مَن فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجَوا، ونجَوا جميعًا)[9]؛ وهذا الـمَثل ليس خاصًّا بالمجتمع، بل ينطبق على الأسرة كذلك؛ فهي مجتمع صغير متكامل، ويرتبط بغيره من المجتمعات الصغيرة (الأُسَر الأخرى)، والتي تكوّن بمجموعها المجتمع، ففي القيام بالحسبة صلاح للأسرة والمجتمع، وفي تركها هلاك لها وللمجتمع.
الحسبة في نطاق الأسرة تحفظها من الانهيار؛ فهي وسيلة للتقويم والمراقبة، ولضمان بقاء المعروف وانتفاء المنكر؛ وبذلك تكون الأسرةُ سفينةَ النجاة لأفرادها، وللمجتمع من بعدهم.
4. أنّ مَن يضيّع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دائرته القريبة فهو لما بعدها أضيع، فمسؤولية الأمر بالمعروف وتغيير المنكرات التي يقوم بها بعض أفراد الأسرة تقع بالدرجة الأولى على أقاربهم، قال الحقّ تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وقال صلى الله عليه وسلم: (كلّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيّته؛ فالإمام رَاعٍ وهو مسؤولٌ عن رعِيّته، والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيّته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولةٌ عن رعيّتها)[10].
كما أنّ ترك الإنكار على الأسرة يعتبر من الغش للرعية والمسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول سواء كان رجلاً أو امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما مِنْ عبدٍ يسترْعيه اللهُ رعيَّةً، يموتُ -يومَ يموتُ- وهوَ غاشٌّ لرعِيَّتِهِ إلَّا حرّمَ اللهُ عليْهِ الجنَّةَ)[11].
5. أنّ الحسبة في نطاق الأسرة فيها ميزتان:
الأولى: أنّ هناك جانبًا خفيًّا من المنكرات التي تحصل في الأسرة ومحيطها لا يطّلع عليها في الغالب إلا بعض أفراد الأسرة أو أقاربهم أو جيرانهم، وإهمال الحسبة في هذه المنكرات ممّن يطّلع عليها يعني بقاءها واستفحالها وتأثيرها في كافة أفراد الأسرة، وانتقالها إلى المجتمع نتيجة التعايش الطبيعي بين الأسر، وتوريثها للأجيال القادمة. وكلّما ازداد القرب ازدادت المسؤولية؛ فإنّ القريب ألصق بقريبه وأكثر اطلاعًا على ما يقع منه من منكرات، وعلى تكرار وقوعها، وهل ارتكابها ناتج عن جهل أو عمد، وغير ذلك من التفاصيل؛ ممّا يعظّم المسؤولية على مَن يطلع على هذه المنكرات.
الثانية: أنّ الناس في الغالب لا يقبلون النصيحة إلا ممّن يعرفونهم ويثقون بهم، ولهذا فالأقارب أولى الناس ببذل النصيحة، وهم أولى باليد والسلطة.
6. أنّ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأقارب والقيام به في الأباعد يعوّد على النفاق، والكيل بمكيالين، والله تعالى يقول مستنكرًا على بني إسرائيل: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [البقرة: 44]، كما أنّه يعني الرضا به بنوع من أنواع الرضا، وصاحبه يخشى عليه من الدخول في هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (يُـجَاءُ بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار، فتَنْدَلِق أقتَابُه في النار، فيدور كما يدور الحمار بِرَحَاهُ، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه)[12].
مَن يضيّع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أسرته فهو في غيرها أضيع، كما أنّ ترك الإنكار في هذا المحيط الواقع تحت مسؤوليته يعدّ من الغش للرعية.
أمثلة للمنكرات في نطاق الأسرة:
هناك عدد من المنكرات التي تنتشر في نطاق الأسرة، وقد تكون جزءًا من حياتها اليومية، والتي تستدعي التدخّل لإنكارها بالطرق المعروفة في إنكار المنكر والتي ذكرها العلماء وسآتي لذكرها لاحقًا.
والمنكرات التي تنتشر في نطاق الأسرة كثيرة، لكن يمكن إجمالها في أربعة عناوين عامّة جامعة لا يكاد يخرج عنها إلا القليل.
المنكر الأول: سوء العشرة بين الزوجين وتقصير بعضهما في حقوق بعض:
ومن صور المنكرات التي تندرج تحت هذا العنوان العريض:
1. التعدّي على الحقوق أو التقصير في أدائها، وهذا التعدّي بابُه عريض لا يتّسع المقام لذكر أمثلته كلّها، لكن من أبرزها: تقصير كلٌّ من الزوجين في مهامّه ومسؤولياته، وتقصير الزوج في النفقة وترك العدل بين زوجاته، وإسراف الزوجة في النفقة، ومحاربتها زواجه بأخرى بالتعدّي والظلم أو الضغط عليه ليطلّق أختها[13].
2. سوء الخُلُق والعِشرة: بالإهمال، أو التجاهل، أو الهجر بلا سبب، أو السبّ والإهانة.
3. الظلم البيّن كالضرب بغير وجه حقّ[14]، أو أخذ المال بغير وجه حقّ، أو استغلال الجهل ببعض الأحكام الشرعية للقيام بما يحرم القيام به!
4. طلاق الرجل زوجته أو طلبه من الزوجة بغير سبب.
هذه المنكرات وغيرها تؤدّي إلى إضفاء جوّ من عدم الاستقرار في الأسرة، وتُفقِد الزوجين أكبر نِعَم الله عليهما وهي: السكن والمودّة والرحمة؛ فتعمّ التعاسة أرجاء البيت، وينشأ الأولاد في جوّ مشحون بالتوتّر؛ ممّا يؤثر على نفسيتهم وبناء شخصيتهم. وإن لم يحصل الطلاق بين الزوجين حقيقةً فسيحصل بينهما الطلاق العاطفي أو النفسي الذي يكون غير مُعلَن؛ فيكون البيت قائمًا في الظاهر ومنهارًا في الباطن، وهذا قد يفتح الباب للخيانة وطلب التعويض العاطفي خارج الأسرة بطرق محرّمة تؤدّي إلى مزيد من الضياع والتشتت.
وإنكار هذا المنكر يأتي بالدرجة الأولى من داخل الأسرة، فيُنكِر الزوج على زوجته، أو الزوجة على زوجها، أو الولد على والديه، كلّ ذلك بالطرق الشرعية الصحيحة، فإن لم يُزل المنكر فعلى مَن يطّلع عليه أو يعلم عنه من الأقارب أو الجيران المبادرةُ بإنكاره؛ لأنّ استقرارَ البيت ومنعَ الشقاق والطلاق مطلبٌ شرعي أمر الله تعالى لأجله باتخاذ الحكمين، قال سبحانه: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35][15].
كثير مما يقع بين الزوجين من سوء العشرة أو التقصير في الحقوق لا يُنظر إليه على أنّه منكر يأثم فاعله، ويجب على من علم به إنكاره! وهذا يؤدّي إلى استمرار المنكر واستفحاله.
المنكر الثاني: التقصير في تربية الأولاد:
ومن صور المنكرات التي تندرج تحت هذا العنوان العريض:
1. التقصير في تعليم الأولاد العقيدة الصحيحة، وغرس محبّة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، وكيفية أداء العبادات والتقصير في متابعتهم في قيامهم بها وبخاصّة أداء الصلاة، والتقصير في إنكار ارتكابهم المعاصي الظاهرة وإن كانت صغيرة.
2. تركهم عرضة للمؤثرات الخارجية التي تهدم العقائد وتُفسد الأخلاق -سواء من فضاءات الإعلام أو أصدقاء السوء- دون توجيه وتعليم وحوار.
3. إهمالُ تربيتهم منذ الصغر على البرّ وإعانتهم عليه، وإهمالُ تربيتهم على محاسن الأخلاق كالعفّة والحياء، وإهمالُ تربيتهم على ما يخص البنات كالحجاب وما يخصّ الأبناء كالرجولة.
4. تركهم نهبة للألعاب والتفاهات التي تبثّ على وسائل التواصل الاجتماعي دون ترشيد أو توجيه.
5. سوء المعاملة، ومن أمثلتها: التقصير في النفقة، والإهمال والتهميش، وتمييز بعضهم على بعض، والإهانة باستخدام الضرب الـمُذلّ أو الألفاظ الجارحة.
هذه المنكرات وغيرها تؤدّي إلى نشوء جيل ضائع بلا هُوية، تزيد بين أفراده مظاهر الانحراف والإلحاد، والميوعة والضعف أو العدوانية والجرائم.
وكون هذه المنكرات صادرة عن أحد الوالدين يُوجب على الآخر الإنكار عليه، فإن اشتركا في هذا المنكر وجب على غيرهما ممن يعلم حالهما من الأقارب الإنكار عليهما، وينبغي أن ينصبّ الجهد على تنبيه الوالدين ووعظِهما وإعانتهما؛ لأنّ التدخّل في تربية الأولاد بشكل مباشر محفوف بالمخاطر -إلّا في حالات خاصّة جدًا- وله عواقب تربوية كثيرة ليس هذا مقام ذكرها.
المنكر الثالث: العقوق:
العقوق ناتج في الغالب عن سوء تربية الوالدين لأولادهما، وقد يكون ناتجًا عن عوامل خارجية كالإعلام وأصدقاء السوء، وصوره كثيرة ومتنوّعة لا تخفى، وعنوانها العريض: ارتكاب الأعمال التي تتنافى مع البرّ والإحسان والأخلاق الكريمة معهما، وسأكتفي في هذا المقام بذكر أمثلة عليها، فمن ذلك:
1. قلّةُ أو انعدامُ تقدير الوالدين وإنزالهما منزلتهما التي يستحقّانها، ولا سيما عند تقدّم الأولاد في العلم أو الوظيفة أو المكانة الاجتماعية، ومن ذلك: التعامل معهما بندّية، أو ترك الاهتمام برأيهما أو استشارتهما في المهمّ من الأمور، أو عدم إخبارهما بالمفرح منها، أو مقاطعتهما بالكلام والإكثار من مجادلتهما.
2. الإثقال عليهما بالطلبات والنفقات. ونتيجةً لسوء التربية أو التأثّر بالمجتمع تصبح هذه الطلبات والنفقات الزائدة والمبالغ فيها طبيعية وحقًّا أصيلاً في نظر الأولاد، يغضبون إذا لم يحصلوا عليه!
3. ترك الإنفاق عليهما عند كبرهما، أو المنّ عليهما بالنفقة، أو هجرهما وإيداعهما في دار العجزة.
4. التقصير في زيارتهما وتفقّد أحوالهما، والتأخّر في قضاء حوائجهما.
هذه المنكرات وغيرها تؤدّي إلى اضطراب الأسرة، وانعدام الطمأنينة والراحة فيها، وقد تؤدّي إلى انتقال العقوق من ولد لآخر من الأسرة، ومن أسرة لأخرى، فضلاً عمّا سيعانيه الولد العاقّ في عاقبة أمره من كدر في الحياة وضيق في الرزق، وربما مجازاته بعقوق أولاده له.
وكون هذه المنكرات صادرة عن الأولاد فهذا يستدعي الإنكار عليهما من والديهما، ومما يعين في ذلك تبادل الأدوار بين الأب والأمّ، فالأب ينكر على أولاده تقصيرهم في حقّ أمّهم، والأمّ تنكر على أولادها تقصيرهم في حقّ أبيهم، وينكر الأولاد على بعضهم، فإن لم يُجْدِ ذلك نفعًا فعلى مَن يعلم حالهم من الأقارب نصحهم، وتأنيبهم، وحجزهم عن إيقاع العقوق على والديهم، ولكل حالة خصوصيتها.
العقوق ناتج في الغالب عن سوء التربية من جهة الوالدين، وقد يكون ناتجًا عن عوامل من خارج الأسرة كأصدقاء السوء والإعلام، وعلاجه يكون بتتبّع أسبابه والعمل على تصحيحها.
المنكر الرابع: الظلم الواقع بين الأقارب:
ومن صور المنكرات التي تندرج تحت هذا العنوان العريض:
1. قطع الأرحام بهجرهم وترك الإحسان إليهم، أو بإيذائهم بأنواع من الأذى الذي يؤدّي إلى التهاجر والتباغض والتدابر.
2. التقصير في النفقة على الفقراء من الأقارب، ولا سيما النفقة على الأخوات الأرامل أو غير المتزوجات مع القدرة على ذلك وإلجائهنّ لعدم الاستقرار أو لكثرة التنقّل بين البيوت أو سماع ما لا يسرّ من التلميحات، أو تركهنّ للفقر والحاجة وربّما سؤال الناس.
3. إهمال رعاية الأولاد الذين غاب آباؤهم بسبب الموت أو الفقد أو السفر، وتركهم دون متابعة وتربية، ويعظم الخطب عندما يكون الإهمال بعد الاطلاع على الخلل الحاصل، أو بعد طلب الأم المساعدة في تربية أولادها وترك الاستجابة لطلبها.
4. أكل أموال الورثة -وبخاصّة النساء والأيتام- ظلمًا وعدوانًا، ففي كثير من المجتمعات لا تُعطى النساء حقّهنّ من الميراث، أو يستأثر الذكور بالعقارات وتُحرم منه الإناث.
5. بعض صور سوء العشرة بين الزوجين، وعقوق الأولاد التي يظهر فيها جانب الظلم البيّن كما تقدّم.
ومسؤولية إنكار هذه المنكرات تقع على عاتق الجميع الأقرب فالأقرب، وقد يستدعي الحال تفاعلاً واستنفارًا وربّما استعانة بمن له مكانة أو سلطة؛ لأنّ تفشي مثل هذه المنكرات يؤدّي إلى قطيعة الرحم، وفشوّ الظلم، وتولّد الأحقاد والضغائن بين المظلوم وظالمه، كما أنّ أكل المال بغير حق قد يؤدّي إلى فقر المظلوم وإذلاله بسؤال الناس، ويؤدّي إهمالُ رعاية الأقارب وأولادهم إلى نشوء جيل يعاني الضياع والتهميش والفقر، وضررُ ذلك كلّه لا يقتصر على الأسرة فحسب، بل يمتدّ إلى المجتمع، ويؤثّر فيه سلبًا.
طريقة إنكار المنكرات في نطاق الأسرة:
إنكار المنكرات في نطاق الأسرة يكون بالطرق المعروفة في إنكار المنكر والتي ذكرها العلماء، لكن مع وجود خصوصية لبعض الحالات، وأنا هنا أستعرضها بشكل سريع ومختصر وأنبّه على ما فيها من خصوصية، ثم أستعرض بعض الحالات الخاصة وأذكر بعض أقوال العلماء فيها:
» المرتبة الأولى: التعريف والتّنبيه والتّذكير، وتكون غالبًا في حقّ الجاهل.
» المرتبة الثانية: الوعظ والتّخويف من اللّه، وتكون في حقّ مَن عُرف أنّه قد اقترف المنكر وهو عالم به.
وهاتان المرتبتان في مقام التربية والتعليم، وينبغي أن تكونا {بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}، مع التحلّي بالحلم والصبر، كما كان هديه صلى الله عليه وسلم مع الناس وأهل بيته على وجه الخصوص.
وإذا كان مرتكب المنكر كبيرًا في السنّ والمنزلة فينبغي أن يكون التعليمُ بغاية اللين، والتنبيهُ على المنكر بأحسن الأساليب وألطفها؛ لأنّ النصيحة إذا أتت من الأدنى إلى الأعلى يكون تقبّلها في الغالب صعبًا، فعلى الزوجة -مثلاً- إذا أرادت نصح زوجها أن تراعي حقّه وقدره؛ فتتلطّف معه في الخطاب ولا ترفع صوتها عليه، ولا يكون وقوعه في المنكر سببًا في تقصيرها في حقوقه.
أمّا إن كان مرتكب المنكر أحد الوالدين فيجب على الولد أن يستخدم معهما أقصى ما يمكن من الحكمة واللين والتلطّف والإقناع بالتي هي أحسن، بعيدًا عن الزجر والتقريع، ولا ينبغي أبدًا أن يمنعه إصرارهما على المنكر من برّهما وتجنّب إيذائهما، فقد قال تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [لقمان: 15]، ومن أعظم أمثلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الوالد التي يُقتدى بها: مثال إبراهيم عليه السلام مع أبيه كما جاء في سورة مريم [41-48]، والمتأمّل في طريقة الخطاب يدرك جملة الأحكام والآداب المشتملة عليها.
وينبغي مع التعريف والوعظ: السترُ على فاعل المنكر وتجنّب فضحه، مع الدعاء له بالهداية؛ فهذا أدعى لاستجابته للنصح، فإن أصرَّ وأبى فينتقل معه إلى مراتب أخرى من مراتب الإنكار.
» المرتبة الثالثة: الزّجر والتّأنيب والإغلاظ بالقول والشدّة في الإنكار، وذلك فيمن لم ينفع فيه وعظ.
» المرتبة الرابعة: التهديد والتخويف بالعقوبات سواء كانت مقدّرة كالحدود أو غير مقدّرة كالتعزيرات، أو تهديده بالهجر ومقاطعته حتى يتوب. وينبغي أن يكون الهجر جميلاً، و”الهجر الجميل هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجر، وهو ترك المخالطة فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذى”[16].
وهاتان المرتبتان في آخر المحاولات لتغيير المنكر باللسان، ولا تكونان إلا ممن يصحّ صدورهما منه، فعلى سبيل المثال: لا يزجر الولد والديه، ولا تهجر الزوجة زوجها إلّا في حالات معيّنة كأن يكون مُنكره فاحشًا تخشى على نفسها وأولادها منه، أو يكون مكفّرًا فيجب عليها حينئذٍ أن تفارقه.
» المرتبة الخامسة: التّغيير باليد: بإزالة المنكر أو منع حصوله.
ولا يعني مجيء هذه المرتبة في هذا الموضع أنّه لا يصار إليها إلّا بعد المراتب الأربعة الأولى، بل قد يلجأ المحتسب إلى تغيير المنكر باليد إذا كان الموقف يستدعي ذلك كإنقاذ حياة شخص من بين يدي من سيقتله ضربًا؛ إذ لا وقت للنصح والإرشاد والزجر والتهديد في هذه الحال.
إن كان مرتكب المنكر أحد الوالدين فيجب على الولد أن يستخدم معهما أقصى ما يمكن من الحكمة واللين والتلطّف والإقناع بالتي هي أحسن، بعيدًا عن الزجر والتقريع، ولا ينبغي أبدًا أن يمنعه إصرارهما على المنكر من برّهما وتجنّب إيذائهما.
وفي المراتب الخمسة السابقة بعض التفصيلات الأخرى التي يحسن ذكرها، منها على سبيل المثال:
* أنّ للوالدين حقّ إنكار منكر أولادهما وتأديبهم ولو صاروا كبارًا؛ لعموم حديث (مَن رأى منكم منكرًا فَلْيُغيّرهُ)، ولأنّ مسؤوليتهما لا تنقطع ببلوغ الأولاد ولا باستقلالهم وتكوين أُسَرهم الخاصّة بهم.
* ميدان احتساب المرأة هو احتسابها على النساء والصبيان، والمحارم من الرجال، ولا سيما أنّها تختصّ بمعرفة منكرات لا يطلع عليها غيرها، لكن عليها ألّا يدفعها حنانها ورحمتها أن تتهاون في إنكار المنكر سواء من زوجها أو أولادها أو سائر قرابتها، أو إخفاء منكرات أولادها عن زوجها؛ إلّا في حالات ضيّقة تقتضيها المصلحة.
ولا تحتسب على الرجال الأجانب عنها ولو كانوا من أقاربها إلّا بشروط وضوابط (تزيد على الشروط العامّة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) خلاصتها فيما يلي:
• الحاجة، بأن لا تجد رجالاً ينكرون المنكر، ويكون المنكر مما لا يحتمل السكوت عليه.
• الالتزام بالحجاب، وعدم الاختلاط أو الخلوة، وعدم الخضوع بالقول.
• أمن الفتنة عليها وبها، بأن تنكر المنكر بحضرة جماعة من النساء، أو تكون كبيرة في السن.
• أمن الضرر على نفسها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغِي للمؤمنِ أن يُذلّ نفسهُ، قالوا: وكيف يُذلّ نفسهُ؟ قال: يتعرّضُ من البلاءِ لـمَا لا يطيقُ)[17].
* احتساب الرجال على النساء الأجنبيات عنه من قريباته وغيرهن أيضًا له ضوابط يمكن إجمالها فيما يلي:
• الحاجة، بألّا يجد امرأة تُنكر هذا المنكر، ويكون المنكر مما لا يحتمل السكوت عليه.
• الالتزام بضوابط الحديث بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه حتى ولو كانت من أقاربه.
• أمن الفتنة، بغضّ البصر، وعدم تجاوز قدر الحاجة، وإذا احتاج للنظر فيكون بغير شهوة.
• أمن الضرر.
• عدم تجاوز الإنكار باللسان إلى اليد إلّا عند الحاجة؛ فإن حصلت مشاجرة بين امرأتين أنكر عليهما باللسان، فإن لم يستجيبا وخشي الضرر عليهما أو على إحداهما حَجَزَ بينهما ولو اقتضى ذلك مسّهما؛ درءًا للمفسدة الأكبر.
» المرتبة السادسة: إيقاع العقوبة: وذلك فيمن جاهر بالمنكر وكابر وامتنع.
وهذه المرتبة إنّما تكون لمن له ولاية كالأب على أولاده، والزوج على زوجته، ويكون القصد منها التأديب والزجر عن معاودة المنكر، لا الانتقام والتشفّي، ولذا يجب أن تكون العقوبة في حدود المأذون به شرعًا.
» المرتبة السابعة: الاستعانة بالأعوان من الأقارب على اختلاف درجات قرابتهم: وذلك فيما لا ينفع فيه الجهد الفردي، فإنّ الكثرة قد تنفع في علاج بعض المشكلات ومنع بعض المنكرات، لا سيما إن كان للمستعَان بهم مقام ووجاهة أو سلطة.
» المرتبة الثامنة: رفع الأمر إلى الحاكم أو الجهات المختصّة كالشرطة أو القضاء، وذلك حين تفشل الجهود السابقة في منع حصول المنكر.
وهاتان المرتبتان لا بدّ منهما إذا كان المنكر عظيمًا واستفحل ولم ينفع في منعه شيء، وإهمالهما يؤدّي إلى بقاء المنكر وتفشّيه، واستمرار الظلم والرضا به بنوع من أنواع الرضا، وهو مؤشّر خطير يؤذن بالعقوبة للمجتمع كلّه (إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشَكَ أن يعُمّهُم اللَّه بعقاب منه)[18].
إنكار المنكر في إطار الأسرة وبين الأقارب يمنع كثيرًا من المظالم التي إذا تُركت فإنّها ستستشري، وقد تنتشر في المجتمع، وبالتأكيد ستكون عاقبتها وخيمة على الجميع.
وختامًا:
فإنّ إنكار المنكر في إطار الأسرة وبين الأقارب ينبغي أن يكون فيه قدر زائد من: العناية بالأسلوب، وحُسن المعاملة والخُلُق الرفيع، وإظهار المحبّة والشفقة والرحمة، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والحرص على عدم الإكثار من الموعظة لدرجة الملل وحصول القطيعة، بل يكون التخوّل بها عند رجاء قبولها {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} [الأعلى: 9]، مع التأكيد على ألّا يكون إنكار المنكر وسيلة للتدخّل في خصوصيات الأقارب وانتهاك حرمات بيوتهم. وإنّ ذلك ليسير على من يسّره الله عليه، وأخلص النيّة لله، والتزم في خاصّة نفسه بما يأمر به وانتهى عمّا ينهى عنه، واستعان على ذلك بعد الله تعالى باستشارة ذوي العقل والحكمة.
جهاد بن عبد الوهاب خيتي
المشرف العام على موقع (على بصيرة)، ماجستير في السنة وعلوم الحديث
[1] التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي (8/158).
[2] أخرجه مسلم (49).
[3] قال الماوردي في (الأحكام السلطانية، ص: 349): “الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله”.
[4] المقدّمة (1/280-281).
[5] يُنظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، أ.د. وهبة الزحيلي، ص (20).
[6] أخرجه مسلم (231).
[7] معالم التنزيل في تفسير القرآن (5/122).
[8] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص (874).
[9] أخرجه البخاري (2493).
[10] متفق عليه: البخاري (2409) ومسلم (1829)
[11] متفق عليه: البخاري (7150)، ومسلم (142) واللفظ له.
[12] متفق عليه: البخاري (3267)، ومسلم (2989).
[13] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختها لِتَكفأَ ما في إنائِها) متفق عليه: البخاري (2140)، ومسلم (1413). والمعنى: لا تطلب المرأة من زوجها أن يُطلّق ضرّتَها؛ لتَستأثِرَ بخيرِ زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه.
[14] ذكر الله في كتابه طرق علاج نشوز الزوجة، [والنشوز هو: معصيةُ المرأةِ زوجها فيما فرض الله عليها مِن طاعته]، فقال سبحانه: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34]، وقد بيّن العلماء شروط هذا الضرب، وأكملُ هذه الشروط ما ذكره الحنابلة، حيث ذكروا: ألّا يكون نشوزها بسبب منعها من حقوقها، وألّا يضربها إلّا بعد وعظها وهجرها في المضجع، وأن يغلبَ على ظنّه أنّ ضربه يفيدُ في رجوعها، وأن يكون قصده إرادةَ تأديبها لا تعنيفها، وألّا يكون الضرب مُبرّحًا، وأن يجتنب الوجه أو ما يُخافُ منه هَلَكة أو تلف.
[15] قال السعدي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كلّ منهما في شقّ؛ فابعثوا رجلين مكلّفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق؛ فينظران ما ينقم كلّ منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلّاً منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك، قنَّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسّر من الرزق والخُلُق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه… وإن رَأيَا أنّ التفريق بينهما أصلح، فرّقا بينهما. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص (177) بتصرّف يسير.
[16] التحرير والتنوير (29/268).
[17] أخرجه الترمذي (2254) وقال: حسن غريب.
[18] أخرجه أبو داوود (4338)، والترمذي (2168)، وابن ماجه (4005).