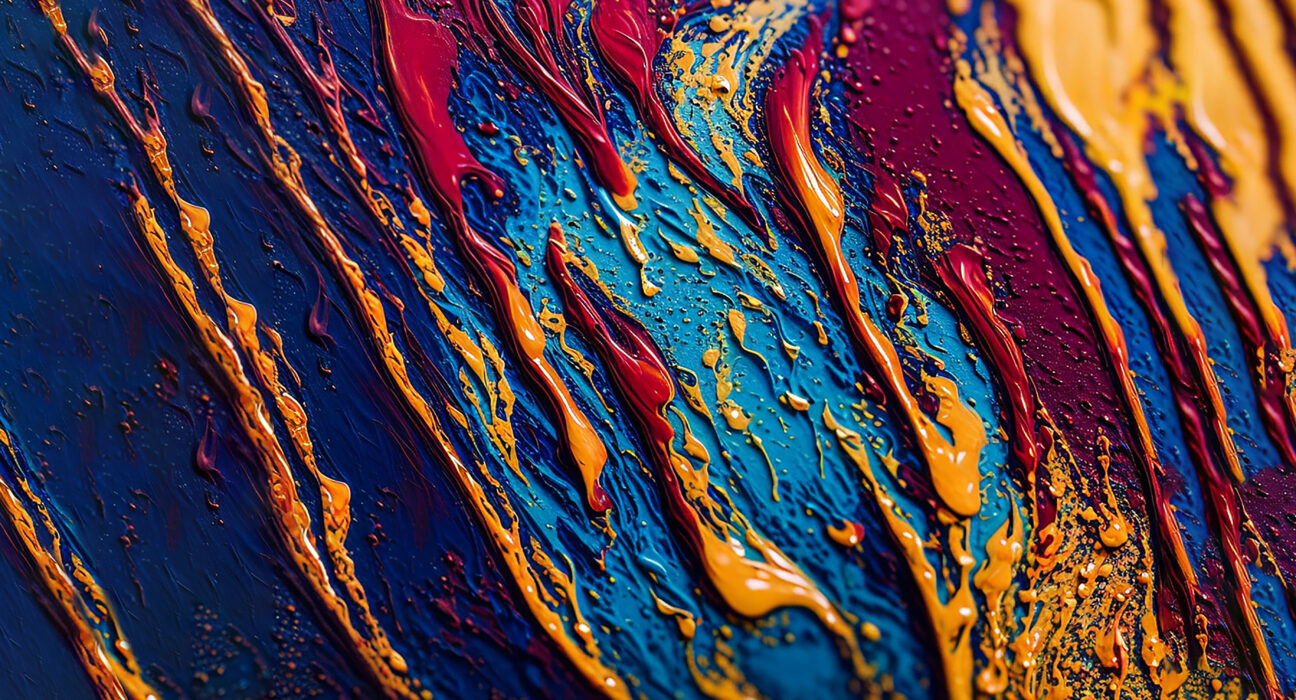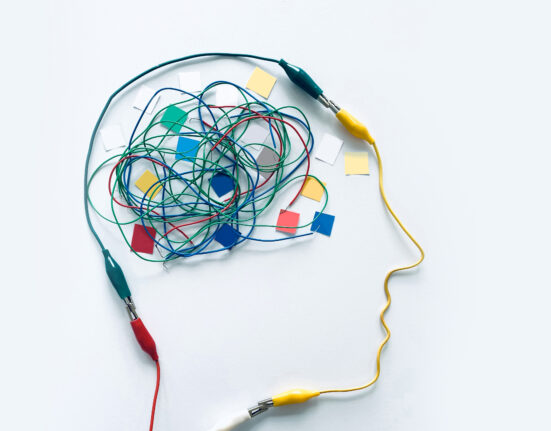ما من باحث سلك مغامرة البحث في الإنسان وأولى العناية بدراسته ومحاولة سبر أغواره، إلا وزاد حيرة فيه، ويقينًا بأنه أمام سر مجهول وكائن فريد، لا تحده حدود العالم المادي ولا تقيده قيوده، وعندما نحى الفكر الغربي الحديث في البحث تجاه الإنسان وقضاياه الوجودية الكبرى منحًى ماديًا خاليًا من روح الدِّين؛ وقف أمام سؤال المعنى دون جواب، وتأزم في فهمه للإنسان وموقعه الوجودي، فاكتسب صفة الإنكار لكل غيبي، بل تخلى تدريجيًا عن هويته الإنسانية وما يميزه عن باقي الكائنات
مقدمة:
كان الإنسان وسيبقى موضع استفهام الإنسان باختلاف نحلته وحضارته، والناظر في المسيرة المفهومية لفلسفة الإنسان وقضاياه الوجودية الكبرى (الأنطولوجية)، سيقف أمام تصورات متباينة في فهمه والإجابة على تساؤلاته، وتضارب هذه التصورات يظهر بجلاء في الساحة المعرفية الغربية، التي انتقل فيها الإنسان من حال إلى حال، ومن مقال إلى مقال، يتقلب بتقلب الفلسفات والمذاهب، وأكثر ما يمكن أن يوصف به في التصور الغربي أنه زئبقي الكينونة، غير ثابت القيمة، ولا يمكن أن نلمس له روحًا أو جسمًا يرتقي به عن خسة الدنيا.
وكلما تقدم الفكر الغربي في ماديته تراجع في فهمه للإنسان وقيمته الوجودية في الكون، فالرجل الغربي وإن تدرج في تحقيق كمالات الدنيا وعَيْش حياة فِرْدَوْسِيَّة في واقعه، إلا أن هذه الإنجازات ظلت محدودة بسقف المادة وعالم الشهادة، غافلة عن حاجة الروح للقوت كما البدن.
فالإنسان لا يكون إنسانًا إلا بوصل الروح بالجسد، وربط عالم الغيب بالشهادة، وكلما حاول الفصل بين هذه العناصر شَوَّه فطرته وأتى على إنسانيته، فهو دون وصلهما أقرب للبهيمية منه للإنسانية، ويسري عليه قول الله جل وعلا: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: 44]، والحضارة الغربية ضلت طريقها في محاولة الإجابة على سؤال: ما الإنسان؟ وعلائقه الكبرى: كسؤال المعنى والغاية والهدف.
ولما كانت روح العصر روحًا غربية، كان البحث في قيمة الإنسان في التصور الغربي أمرًا ملحًا، وذلك للوقوف على الخلل الذي اعترى النظرة الغربية الحديثة للإنسان عمومًا ولمنزلته خصوصًا.
فتلك الأشواق التي كان يحملها الإنسان الغربي والحماسة التي قادته إلى رفع شعار “الولاء للإنسان” في بدايات النهضة ثم جعل المبدأ السفسطائي “الإنسان معيار الأشياء كلها” قاعدة للمعرفة، ستنمحي تدريجيًا لتغيب عن المشهد الغربي ويحل محلها شعار “تغييب الإنسان”.
ولعل في هذا العرض من الخلاصة والبيان ما يظهر حال الإنسان في الرؤية الغربية الحديثة والمحطات التي انحدر فيها رويدًا رويدًا عن وصف “إنسان” حتى قال فرانز فانون([1]): “إني حين أبحث عن الإنسان في التكنيك الأوروبي والأسلوب الأوروبي، لا أرى إلا سلسلة من الإنكارات للإنسان، إلا موكبًا من جرائم قتل الإنسان”([2]).
الإنسان لا يكون إنسانًا إلا بوصل الروح بالجسد، وربط عالم الغيب بالشهادة، وكلما حاول الفصل بين هذه العناصر شَوَّه فطرته وأتى على إنسانيته، فهو دون وصلهما أقرب للبهيمية منه للإنسانية، والحضارة الغربية ضلت طريقها في محاولة الإجابة على سؤال: ما الإنسان؟ وعلائقه الكبرى: كسؤال المعنى والغاية والهدف
والمقالة مقسمة إلى ثلاث محطات:
المحطة الأولى: الإنسان المركز (أشواق الإنسان الذي يصارع الإله):
لم يكن الغرب ليصل إلى محطة “إنكار الإنسان” إلا بعد طمس ملامح هويته التي تسمه عن غيره من الموجودات، وإذا كانت جملة تفسيرات الكون الدينية للأسئلة الكبرى كما يرى ريتشارد تارناس تعرضت “للتطهير” المنهجي من سائر المواصفات الروحية([3])، فالإنسان لم يكن مستبعدًا من هذا التطهير المنهجي –كما سنرى- حيث نزعت عنه تلك الفرادة لينزاح في الفكر الغربي تدريجيًا من المركز إلى الهامش.
ويعزز هذا القول ما أحدثته النظرية الداروينية في البيئة المعرفية الغربية من انقلاب في فهم الإنسان، حيث انتقلت من مجرد فرض علمي إلى أيديولوجيا أثرت على جزء كبير من المعارف الإنسانية، يقول عبد الوهاب المسيري: “لا توجد فلسفة أثرت في عصرنا الحديث أكثر من الفلسفة الداروينية، كما لا توجد فلسفة بلورت الرؤية العلمانية أكثر من الفلسفة الداروينية”([4]).
فالرؤية الداروينية نقلت الإنسان من ذلك المخلوق الفريد، إلى جزء لا يتجزأ من هذه الطبيعة يتساوى مع غيره من الموجودات، ورؤية كهذه لا يمكن أن نرى فيها بريق جواب لسؤال: لماذا؟ أو إشكال المعنى، لذلك يرى سينجر أحد المتخصِّصين في أخلاقيات البحث الحيوي من جامعة برينستون، وأحد المناصرين لقتل الأجنة المعوقين أن الداروينية تنزع عن الإنسان “استثنائيته”، “وكل ما علينا هو التمسك بداروين، فقد أظهر في القرن التاسع عشر أننا مجرد حيوانات، لقد اعتقد البشر أنهم جزء خاص من الخلق أو أن شيئًا سحريًا يفصل بيننا وبين الحيوانات، تغوص نظرية داروين إلى أعماق العقلية الغربية لتقرر مكانة نوعنا في العالم”([5]).
فالرؤية الداروينية عززت التصورات المادية عن الإنسان وسندت موقف الكثير من الفلاسفة تجاه قضاياه، لكن سبقت هذه المحطة المزلزلة لمكانة الإنسان في الكون محطة “الإنسان المركز”، وهي المحطة التي حاول فيها الفكر الغربي أن يقفز على الدين ويعود للتراث اليوناني واستثماره في بناء تصور جديد عن الإنسان الحديث، بعيدًا عن التفسيرات اللاهوتية.
لذلك كانت جذور بعض الأفكار التي حرّكت إنسان عصر النهضة راجعة إلى فلاسفة اليونان([6])، وتصور إنسانوية (Humanism) عصر النهضة عن الإنسان كان موصولاً بالموروث الفلسفي اليوناني، ففي كتابها “ميثولوجيا الحداثة” ترى الكاتبة الإيرانية مريم بور أنَّ “الرؤية الأسطورية الإغريقية القديمة للإنسان أثرت بشكل ملحوظ على الثقافة الغربية الحديثة، حيث اعتبرت شخصية الإنسان ذات صبغة روحية ومكانة عظيمة لا حدود لها باعتباره الهدف المنشود في هذا الكون، وعلى هذا الأساس فهو مكتف ذاتيًا من الناحية الروحية ويعتبر بنية أساسية في الكون”([7]).
فقد جرى تعزيز مفهوم الإنسان بقوة مع ظهور حركة الإنسانيين في القرن السادس عشر، فالقرن السابع عشر، أو لنقل القرن الديكارتي كان مؤشرًا تاريخيًا على بدء التأسيس الفلسفي للحداثة بميلاد الكوجيتو([8]) “أنا أفكر أنا موجود”، الذي كان توكيدًا على الحرية الفكرية للفرد في المساءلة والشك والبحث عن الحقيقة. وميلاد الفرد في المشروع العقلاني الديكارتي كان ميلادًا لحريته كذات مفكرة تحمل بداخلها البداهات الفطرية الحاملة للحقيقة وتلك ثورة معرفية تحررية كبيرة بالقياس إلى التقليد الثقافي القروسطي([9]) الذي كان يرى الحقيقة مصدرها الكتاب المقدس لا غير، فجاء ديكارت وجعل مصدرها العقل([10])، فذلك التصور الخاص عن ماهية الإنسان، يتحدد ميلاده بالعصر الذي أصبح فيه ذاتًا، اعتبرت هي الأساس والمركز، وتعد اللحظة الديكارتية (القرن السابع عشر) بداية فعلية لحلول عهد الإنسان([11]).

وهكذا نَحَتَ عصر النهضة صورًا جديدة للإنسان قائمة على حقه في التأويل وعلى ما له من ميزات خاصة في التفكير والإرادة والوعي والحرية([12])، فهو معيار الأشياء كلها أو كما يقول بيكو ديلا ميراندولا: “لم أر في الكون أبدع من الإنسان”([13])، ليترسخ مفهوم الإنسان المركز أو الإنسان الإله الذي يُتَحاكَم لعقله في حل لغز الوجود والإجابة على سؤال المعنى الذي ظل يحوم حوله دون جواب شاف له.
فما آل إليه الوضع الفكري في بناء رؤيةٍ عن إنسان ما بعد النهضة، وعلاقة الإنساني بالإلهي، لم يكن إلا عودة للوراء وللماضي الغربي الأسطوري، الذي صُوِّر من خلال الملاحم الأسطورية، التي يظهر فيها الإنسان في صراع دائم مع الإله، يقول علي شريعتي في تصويره لأثر الرؤية الأسطورية على النزعة الإنسانية الغربية الحديثة: “أصالة الإنسان الغربية (الهيومانية) تقوم على أساس النظرة الخاصة نفسها لميثولوجيا اليونان القديمة، التي ترى أن بين السماء والأرض عالم الآلهة والإنسان، توجد منافسة وتضاد وحتى إنه يوجد نوع من الحسد والحقد، وأن الآلهة هي قوى ضد الإنسان، وأن جميع جهودها وأحاسيسها تقوم على سلطتها الجبارة على الإنسان وتقييده بضعفه وجهله، لأنها تخشى وعي الإنسان، وحريته، واستقلاله، وسيادته على الطبيعة”([14]).
لكن الإنسان المركز أو الإنسان الإله الذي كان على عرش الوجود في بدايات النهضة، لم يلبث إلا سنوات معدودات لينزوي في الهامش، وعلة ذلك أن الفكر الغربي حربائي في جوابه على سؤال: ما الإنسان؟ فمن الكوجيتو الديكارتي “أنا أفكر أنا موجود”([15])، انتهاء إلى الكوجيتو الكاموي “أنا أتمرد أنا موجود”([16])، دون أن تحصِّل جوابًا شافيًا يروي رمق معرفتك لذاتك، ويمضي بك لسلوك حياة القيمة والهدف، فذلك السؤال المحير: “كيف يمكن حفظ الإنسان؟” الذي ظهر في بدايات النهضة، سينقلب إلى: “كيف يمكن تجاوز الإنسان؟”([17])، أو “كيف يمكن تغييب الإنسان؟”، وفي هذه المرحلة ينزاح الإنسان رويدًا رويدًا من المركز لينزوي في الهامش أو الظل.
تقوم النظرة الغربية للإنسان على أساس النظرة الخاصة نفسها لميثولوجيا اليونان القديمة، التي ترى أن بين السماء والأرض عالم الآلهة والإنسان، وتوجد منافسة وتضاد بينهما، وأن الآلهة هي قوى ضد الإنسان، وأن جميع جهودها وأحاسيسها تقوم على سلطتها الجبارة على الإنسان وتقييده بضعفه وجهله، لأنها تخشى وعي الإنسان، وحريته، واستقلاله، وسيادته على الطبيعة
المحطة الثانية: الإنسان الظل (الإنسان المغيب):
تأرجح الإنسان في الفكر الغربي الحديث بين رؤيتين، رؤية هيومانية مؤلهة جعلت من العبارة السوفسطائية “الإنسان معيار الأشياء كلها” الأرضية الصلبة التي تقُوِّم تصورها للعالم عمومًا وللإنسان ومصيره خصوصًا، فأنسنت الصفات الإلهية حينما أحلت الإنسان محل الإله، وصار هو مركز الكون ومرجعه، وأضحى العقل هو حاكم الإنسان الأعلى، ورؤية مادية طبيعية لم تر في الإنسان ما يميزه عن الكائنات الأخرى، فهو جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة، وهي رؤية أسقطت الإنسان من عرش الألوهية، لينزاح من المركز إلى الهامش، حيث صار في صورته أقرب إلى البهيمية منه إلى الإنسانية.
وأول مفكر وضع يده على الأطروحات المظلمة للعقلانية المادية (الاستنارة المظلمة) هو المفكر الإنجليزي توماس هوبز([18]) حين أعلن أن حالة الطبيعة، وهي حالة الإنسان بعد انسحاب الإله عن الكون، هي “حالة حرب الجميع ضد الجميع”([19])، فالإنسان ذئب لأخيه الإنسان، وسيتم التعاقد الاجتماعي بين البشر لا بسبب فطرة خيرة فيهم وإنما من فرط خوفهم وبسبب حبهم البقاء، فينصبون الدولة التنين حاكمًا عليهم حتى يمكنهم تحقيق قدر ولو قليل من الطمأنينة، “فحرب كل إنسان ضد إنسان ينتج عنها أن لا شيء يمكن أن يكون ظالمًا، إن أفكار الصواب والخطأ، والعدل والظلم، لا مكان لها هنا”([20])، وقد تبعه عدد كبير من المفكرين الغربيين الذين ذهبوا إلى أن الإنسان يحوي الذئب داخله وخارجه، وذاته المتحضرة هذه إن هي إلا قشرة واهية تخبئ الظلمة الكامنة في الإنسان([21]).
وهكذا بدأ الإنسان يتقدم حثيثًا نحو التقليل من شأنه، وأصبحت إرادته أن يقلل من شأن نفسه، فأين إيمانه بكرامته وفرادته؟ أين اعتقاده بأنه لا يمكن أن يحل محله شيء في سلسلة المخلوقات؟ لقد ولى كل هذا بلا رجعة فقد أصبح حيوانًا بالمعنى الحرفي الكامل([22])، وما الإنسان الذي يتأمل (بعقله) إلا حيوان قد فسد([23])، لأن حالة التفكير حسب روسو([24]) تضاد الطبيعة، فالطبيعة الإنسانية إذا تجاوزت حدود الحياة العضوية كان ذلك انحطاطًا لها لا تقدمًا([25])، وكلما دنا الإنسان من حيوانيته ذاب في عالم الطبيعة/ المادة، ناسيًا فرادته.
ووفق هذا التصور الجديد يختفي الإنسان بكل تشكلاته الحداثية، ليظهر الإنسان الظل في عصر ما بعد الحداثة، حيث لم يبق بعد الثورة العلمية إلا عالم المادة والحركة الأجرد الموحش، وهكذا ظهرت الآلة ذلك المخلوق الجديد الذي يتسق مع قوانين هذا العالم([26])، فالإنسان الذي أراد أن يتأله عليه أن يتخلى عن إنسانيته، وهكذا وعلى المدى الطويل يدمر نفسه بالتضحية بها على مذبح الألوهية الحقيقي، أي التقنية، التي سيتنازل لها في نهاية المطاف عن عرشه([27]).
فلم يكن الإنسان ليقدم على هذه التنازلات لولا تخليه عن ذلك القبس الإلهي الذي يميزه عن الموجودات الأخرى، ودخوله في عالم الطبيعة/المادة، الذي سيأتي لا محالة على طبيعته وتركيبته، ويدمر ما تبقى من إنسانيته، فيكون الإشكال المطروح في عصرنا: ما مآل الإنسان الحديث الذي سلك نفق الإنكارات؟
تأرجح الإنسان في الفكر الغربي الحديث بين رؤيتين: رؤية هيومانية مؤلهة جعلت من العبارة السوفسطائية “الإنسان معيار الأشياء كلها” الأرضية الصلبة التي تقُوِّم تصورها للعالم عمومًا وللإنسان ومصيره خصوصًا، ورؤية مادية طبيعية لم تر في الإنسان ما يميزه عن الكائنات الأخرى، فهو جزء لا يتجزأ من الطبيعة أو المادة
المحطة الأخيرة: تجديد النظر للإنسان (أين البديل؟):
فالصراع إذن هو صراع تصورات ورؤى، وما مفهوم الإنسان وقيمته وغائيته إلا تمثلات لهذه الرؤى، والناظر في مجال التداولي المعرفي الغربي الحديث يرى تقلب هذه الحضارة بين رؤى مختلفة، أفقدت الإنسان بريقه وميسمه، ولأن الرجل الغربي اتخذ من عبادة الهوى مبدأ في فهمه للوجود، فقد ضل وأضل، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 50].
فسؤال من نحن؟ لا يمكن أن نجد جوابه إذن في تصور ألغى الثنائية الإنسانية التي سيأتي بيانها قريبًا، ولم ينظر بتبصر وبصيرة في تركيبة هذا الكائن الفريد، الذي جُبل على أن يحيا حياتين، فإن أتت إحداهما على الأخرى فلن نكون أمام الإنسان الرباني أو بالأحرى الإنسان الإنسان، وإنما سنكون أمام صور مشوهة له، وإذا كانت المادية تؤكد دائمًا ما هو المشترك بين الحيوان والإنسان، فالدين يؤكد على ما يفرق بينهما([28])، ولعل الإسلام في نظرته المُتَّزنة للإنسان استطاع أن يبقي على هذه الثنائية، دون أن يغلب طرفًا على طرف.
ففلسفة الإنسان في الإسلام قائمة على الثنائيات، عالم الشهادة/ عالم الغيب، الخالق/ المخلوق، الجسد/ الروح، وهي إن صح التعبير “ثنائيات تلازمية” لا يمكن فصلها، فبإحداها تكون الأخرى، فإذا ألغي طرف ألغي بموجبه الطرف الآخر، فثنائية الوجود الإنساني (ثنائية المادي والروحي) لا يمكن تفسيرها وضمان بقائها واستمرارها إلا بافتراض ثنائية أخرى هي ثنائية الخالق والمخلوق، وهي ثنائية تأسيسية لا يمكن ردها إلى ما هو خارجها. ومن هنا يرى علي عزت بيجوفيتش أن الإنسان بصفة أساسية لا يوجد إلا “بفعل الخلق الإلهي”([29])، ويؤكد أن قضية أصل الإنسان تعد أساس كل أفكار العالم، حيث يقول: “قضية أصل الإنسان هي حجر الزاوية لكل أفكار العالم. فأي مناقشة تدور حول: كيف ينبغي أن يحيا الإنسان؟ تأخذنا إلى الوراء إلى حيث مسألة “أصل الإنسان” وفي ذلك تتناقض الإجابات التي يقدمها كل من الدين والعلم، كما هو الشأن في كثير من القضايا”([30]).
لذلك ارتأى الكثير من المفكرين أن لا بديل لفلسفة الإنسانية إلا في الإسلام([31])، فذهبوا إلى أن تكون قضية الإنسان هي محور العقيدة في الفكر الإسلامي، فذهب عبد المجيد عمر النجار في كثير من كتاباته إلى ضرورة توجه الفكر الإسلامي اليوم إلى إفراد قضية الإنسان ببيان مستقل وشامل كقضية عقدية أصلية يستجلي أبعادها في أصول القرآن والحديث، ويثريها بما كتب السابقون فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وإنه لحري أن يدرج ذلك كله ضمن مباحث العقيدة الإسلامية، فهي بقضية الإنسان أليق من أي مباحث أخرى، وذلك لأن العناصر الأساسية فيها من مثل قيمة الإنسان، وغاية وجوده، والمصير الذي يؤول إليه، هي عناصر ذات بعد عقدي، وإدراجها في هذه المباحث من شأنه أن يجعلها في موقع المرجعية الموجهة للكثير من العلوم الإنسانية([32]).
وهكذا كان الإسلام هو التصور المتكامل للإنسان خلاف التصورات الأخرى القاصرة، فهو جمع في خطابه بين الإنسان الحي المتكامل كما صوره القرآن وتمثل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الطبيعة أو العالم الخارجي، فكان بذلك تعبيرًا عن الإنسان الكامل وعن الحياة في جميع وجوهها، وفي هذا الإطار توحد الإيمان مع القانون وتوحد التعليم والتربية مع السلطة، وبذلك أصبح الإسلام نظامًا([33]).
فلسفة الإنسان في الإسلام قائمة على الثنائيات، عالم الشهادة/ عالم الغيب، الخالق/ المخلوق، الجسد/ الروح، وهي إن صح التعبير “ثنائيات تلازمية” لا يمكن فصلها، فبإحداها تكون الأخرى، فإذا ألغي طرف ألغي بموجبه الطرف الآخر، فثنائية الوجود الإنساني (ثنائية المادي والروحي) لا يمكن تفسيرها وضمان بقائها واستمرارها إلا بافتراض ثنائية أخرى هي ثنائية الخالق والمخلوق، وهي ثنائية تأسيسية لا يمكن ردها إلى ما هو خارجها
وفي الختام:
يمكن القول إن المدخل الطبيعي للإيمان في هذا العصر الذي تسود فيه المادية: محاولة الوصول إلى الله من خلال الإنسان ومن خلال رؤية تركيبية له، وذلك بالنظر إليه كلاً لا جزءًا مخلوقًا موصلاً بعالم الغيب، ولعل السمة المميزة للإسلام أن كان الإنسان بطبيعته وأبعاده التي تجمع بين عالم الشهادة وعالم الغيب حجة لهذا الدين([34])، والآية الموصلة للإيمان بوجود الخالق سبحانه، قال تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21].
د. كريمة دوز
دكتوراه في العقيدة والفكر ومقارنة الأديان.
([1]) فرانز فانون (Frantz Fanon) (1925-1961): طبيب نفسي فرنسي من أصول أفريقية، وفيلسوف اجتماعي، للاطلاع على سيرته كاملة يراجع كتاب: فرانز فانون، ديفيد كوت، عدنان كيالي، مدارات للأبحاث والنشر.
([2]) معذبو الأرض، فرانز فانون، ترجمة: سامي الدروبي، جمال الأتاسي، ص (252).
([3]) آلام العقل الغربي، ريتشارد تارناس، ترجمة: فاضل جتكر، ص (500).
([4]) من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان (إنسانية الإنسان ومادية الأشياء)، عبد الوهاب المسيري، ضمن أعمال مؤتمر: الفلسفة في الفكر الإسلامي قراءة منهجية ومعرفية، تحرير: رائد جميل عكاشة، محمد علي الجندي، مروة محمود خرمه، ص (87).
([5]) العلم وأصل الإنسان، أن جورج وآخران، ترجمة: مؤمن الحسن وموسى إدريس، دار الكاتب، الإسماعيلية-مصر، الطبعة الأولى، (2014م)، ص (10).
([6]) ينظر: كتاب الإنسانية أو نداء المعرفة (L’humanisme ou l’appel du savoir)، للمؤلف (Delphine Leloup)، ص (7).
([7]) ميثولوجيا الحداثة الأصل الإغريقي للأسطورة الغربية، مريم صانع بور، ترجمة: أسعد الكعبي، ص (64).
([8]) لفظ لاتيني معناه معناه “أفكِّر”، يشار به إلى قول ديكارت: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”.
([9]) القروسطي: ما يُذَكِّر بالقرون الوُسْطى.
([10]) نقد الليبيرالية، الطيب بو عزة، ص (132).
([11]) موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، عبد الرزاق الداوي، ص (43)، (بتصرف).
([12]) تشريح العقل الغربي (مقابسات فلسفية في النظر والعمل)، زهير الخويلدي، ص (38).
([13]) ينظر: كتاب الإنسانية أو نداء المعرفة (L’humanisme ou l’appel du savoir)، للمؤلف (Delphine Leloup)، ص (14).
([14]) الإسلام ومدارس الغرب، علي شريعتي، ترجمة: عباس الترجمان، ص (58).
([15]) مقال عن المنهج، رينيه ديكارت، ترجمة: محمد مصطفى حلمي، ص (219).
([16]) الإنسان المتمرد، ألبير كامو، ترجمة: نهادر رضا، ص (29).
([17]) ينظر: هكذا تكلم زرادشت كتاب للجميع ولغير أحد، فريديك نيتشه، ترجمة: علي مصباح، ص (530)، (بتصرف).
([18]) توماس هوبز (Thomas Hobbes)(1588-1679م): فيلسوف إنجليزي، كان لكتابه اللفيثان تأثير قوي على الفلسفة السياسية والأخلاقية الإنجليزية اللاحقة. ينظر: كتاب قاموس كامبريدج للفلسفة (The Cambridge dictionary of philosophy)، للمؤلف (Robert Audi)، ص (386).
([19]) اللفياثان (الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة)، توماس هوبز، ترجمة: دينا حرب وبشرى صعب، ص (140).
([20]) اللفياثان، لتوماس هوبز، ص (136).
([21]) العلمانية والحداثة والعولمة، عبد الوهاب المسيري، ص (40).
([22]) الفلسفة في الفكر الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ص (55)، (بتصرف).
([23]) خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر، جان جاك روسو، ترجمة: بولس غانم، ص (78).
([24]) جون جاك روسو (Jean-Jacques Rousseau) (1712-1778م): فيلسوف فرنسي عرف بنظريته في الحرية والحقوق الاجتماعية، تقوم فلسفته الطبيعية على الرغبة في أن يعيد إلى الإنسان حقوقه الطبيعية ويعود به إلى حاله الأصلية. ينظر: كتاب قاموس كامبريدج للفلسفة (The Cambridge dictionary of philosophy)، للمؤلف (Robert Audi)، ص (800).
([25]) مدخل إلى فلسفة الحضارة أو مقال في الإنسان، أرنست كاسيترر، ترجمة: محمد يوسف نجم، ص (67).
([26]) الإنسان والحضارة، عبد الوهاب المسيري، ص (173)، (بتصرف).
([27]) كينونة الإنسان، إريك فروم، ترجمة: محمد حبيب، ص (187)، (بتصرف).
([28]) الإسلام بين الشرق والغرب، علي عزت بيجوفيتش، ترجمة: محمد يوسف عدس، ص (95).
([29]) من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان، عبد الوهاب المسيري، ص (137-138)، (بتصرف).
([30]) الإسلام بين الشرق والغرب، علي عزت بيجوفيتش، (مرجع سابق)، ص (66).
([31]) للتوسع في هذه الرؤية ينظر: الإسلام في الألفية الثالثة، مراد هوفمان، وقد كتب رينيه جينو عن أزمة العالم الحديث، هذه الأزمة التي صدرتها الحضارة الغربية إلى العالم باعتبارها قائدة قاطرة التقدم، كاشفًا من خلال كتابه “أزمة العالم الحديث” عن الخلل المنهجي في صياغة رؤية الرجل الغربي بعد عصر النهضة، معتبرًا التقدم الغربي تقدمًا لا يحسد عليه إذ كسا الحضارة الغربية ثوبًا ماديًا صرفًا، أحلها مسخًا حقيقيًا، ولم يكتفِ بهذا الكتاب فقط لرفع دثار التقدم المزعوم للحضارة الغربية، بل ألف كتابًا آخر سماه “الشرق والغرب”، حيث لم يخلُ كذلك من إبراز نقاط الضعف في المادية الغربية، وعلى ركابه مضى كل من روجي جارودي ومراد هوفمان، في بيان خَوَر الفكر المادي الغربي الذي طغى على الحضارة الغربية إن لم نقل يسوس العالم الغربي، وارتأوا أن في الرؤية الإسلامية بديلاً للرؤى الكونية الغربية التي لم توازن بين قوى الإنسان وتطلعاته، فكتب مراد هوفمان عن “خواء الذات”، طارحًا بعد نقده للإيديولوجيات الغربية الإسلامَ كبديل حضاري، ولعل القاسم المشترك الذي يجمع كتابات هؤلاء المفكرين تأكيدهم على ضرورة النظر في الإنسان ككائن مركب ضاعت روحه في حضارة طينية لا مكان للروح فيها.
([32]) مبدأ الإنسان، عبد المجيد عمر النجار، ص (13).
([33]) الإسلام بين الشرق والغرب، علي عزت بيجوفيتش، ترجمة: محمد يوسف عدس، ص (110).
([34]) الإسلام بين الشرق والغرب، ص (302).