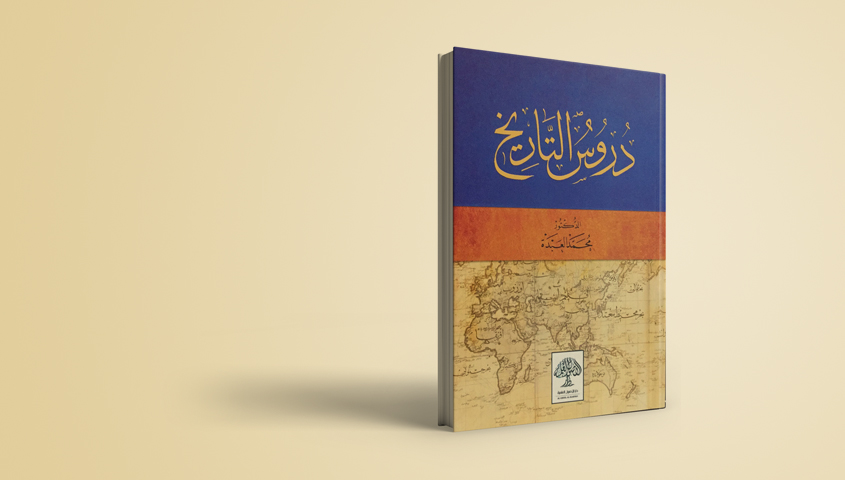وصف الكتاب:
يقع الكتاب في 264 صفحة من القطع المتوسط، والطبعة الثانية لدار الأصول العلمية في إسطنبول، 1440-2019م.
نبذة عن المؤلف[1]:
د. محمد العبدة من مواليد سورية، تخرج في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وحصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة جلاسكو ببريطانيا، عمل في التدريس لفترة طويلة، وكان رئيس تحرير مجلة البيان، وهو عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، ومتفرغ حاليًّا للدعوة والكتابة.
يرى أنّ حل مشكلة المسلمين اليوم يتمثّل في العمل على النهوض بالأمّة (الإقلاع الحضاري) والاستفادة من دروس التاريخ؛ لذا كان اهتمامه منصبًّا على الفكر والدعوة والتاريخ.
محتوى الكتاب:
يقع الكتاب في فصلين.
الفصل الأول: عبارة عن مقدّمات لا بدّ منها لدراسة التاريخ، ويشمل العناصر التالية:
(من يستفيد من التاريخ؟ أهمّية التاريخ، الماضي والحاضر، التاريخ السياسي والتاريخ الحضاري، من يقف خلف تشويه تاريخنا؟).
الفصل الثاني: دروس التاريخ، ويشمل العناصر التالية:
(العزمات البكرية، الزحف البطيء، مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل هو حادثة عادية؟ الفتنة الكبرى أو المواجهة الكبرى، المسلمون والخلافة الراشدة، فتن الباطنية وأثرها على الأمّة الإسلامية، الفرص الضائعة، اتركوا الترك ما تركوكم، عسكرة الدولة هل هو الطريق الصحيح؟ العرب والسياسة).
قراءة في الكتاب
أهمّية دراسة التاريخ:
هناك منظومة من الأحداث تتكرر بين الماضي والمستقبل، وهي إن لم تكن متطابقة إلّا أنّها متشابهة؛ فمن سنن الله جل جلاله أنّ الأسباب نفسها تأتي بالنتائج نفسها في جميع الأوقات ولسائر الشعوب، لذا فإنّ النظر في أحداث الماضي لمعرفة المستقبل منهج صحيح، والتفتيش عن «دروس التاريخ» لا بدّ أن يساعد الإنسان المعاصر على تفهّم بعض مشكلاته؛ لأنّ دراسة تطوّر مشكلةٍ سابقة -يوجد اليوم ما يشبهها- يجعل المرء قادرًا على فهم ملابسات الحاضر والوصول إلى حلولٍ ناجعة.
ما يمر به العالم من مشاكل وفتن ومصائب يدل على أن الناس شعوباً وحكومات لم تتعلم من التاريخ
وفي حين أنّ المسلمين المتقدّمين اعتنوا بالتاريخ عناية كبيرة فاقوا بها جميع الأمم؛ فإنّ اهتمام المسلمين اليوم بالتاريخ قد ضَعُف وأصابه كثير من الإهمال. وما يمرُّ به العالم من مشاكل وفتن ومصائب يدلّ على أنّ الناس شعوبًا وحكومات لم تتعلّم من التاريخ، وإلّا فلو أنّنا درسنا أسباب سقوط الأندلس السياسية والاجتماعية والأخلاقية؛ لما تكررّت هذه المأساة في غيرها من البلاد، ولو أنّنا قرأنا تاريخ الفِرَق لما أصابنا في العصر الحديث من أذى الباطنية ما أصابنا، ولو أنّنا قرأنا تاريخ أوروبا لاستطعنا التعامل معها بسهولة أكثر، ولو قرأنا عن اعتماد أوروبا على إيران لإضعاف الدولة العثمانية لتمكّنا من تفسير ما يحدث الآن.
من الذي يستفيد من التاريخ؟
لا يستفيد من التاريخ مَنْ لا يقدّر أهميته ويضعه في الموضع الذي يستحقه في قائمة العلوم المفيدة، فإنّ دراسة التاريخ تربطنا بمقوّمات الأمّة من الدين واللغة والأخلاق؛ فالنظر في التاريخ من الدين، وهو من إقامة القرآن واستعمال الفرقان والميزان، وليس هو مجرّد قصص تُروى وحوادث تُذكر، بل هي للتفكّر والتدبّر، والذين يتفكّرون ويتدبّرون هم {أُوْلُواْ الأَلْبَاب}، وأُولو الأبصار، وهم أصحاب القلوب الحيّة الواعية {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد} [ق: 37].
هل يستطيع التاريخ أن يعطينا دروسًا ثابتة يمكن أن نستفيد منها في واقعنا ومستقبلنا؟
الجواب نجده في القرآن الكريم، فهو يبيّن لنا أنّ سنن الله سبحانه وتعالى في الأرض باقية، فذنوب الأمّة ليست كذنوب الأفراد فإذا ولغت في الفساد فلا بدّ أنّ يأتيها العقاب، وأنّ أيّ أمّة تغرق في الترف وتجنح إلى السلم الضعيف لا يمضي وقت طويل حتى تفقد استقلالها وحريتها، كما يبيّن لنا أنّ الأساس الأعظم لفوز الجماعات والأمم في مقاصدها وغلبتها على خصومها هو الصلاح والأخذ بأسباب النصر والتقدّم: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون} [الأنبياء: 105].
كيف نقرأ التاريخ؟
إنّ قراءة التاريخ ينبغي أن لا تكون مركّزة على الجانب السياسي فحسب؛ فهذا يُفقد التاريخ الإسلامي جوهره، فهناك الجانب الحضاري المهم جدًا؛ فالمسلمون الأوائل هم مَنْ بَنِوا صروح الفقه الإسلامي، وبنوا المدن، وبرعوا في الطب، واكتشفوا أسرار الداء والدواء، ونظّموا التعاون الاجتماعي من خلال مؤسسة الأوقاف، وأنشؤوا المدارس، وأنشؤوا المكتبات العامّة والخاصة، كما تطوّرت على أيديهم الحِرَف بجميع أشكالها اليدوية والتقنية، ووصل الاحتساب إلى أعلى درجة في المدنيّة والحضارة، وأخذت المرأة مجدها في ميدان العلم والتعليم.
ووجود التمزّق السياسي في بعض الفترات لم يمنع الأمّة أن تحافظ على استقلالها عن السيطرة الأجنبية، وأن تحافظ على وحدتها الاجتماعية والثقافية، وتضمن للناس حرّية التنقّل، في ظل سيادة الشريعة، واستقلال الفقه، وحرّية الاجتهاد. هذا فضلًا عن أنّ الحضارة الإسلامية لم تكن حضارة استعمارية بالمفهوم المعاصر للاستعمار.
من يشوّه تاريخنا؟ ولماذا؟
نظرًا لأهمّية التاريخ ودوره في إعادة الحياة للأمّة الإسلامية والنهوض بها من جديد؛ فقد عمد المستشرقون إلى تشويه التاريخ الإسلامي، وركّزوا على الفِرَق المنحرفة وضخّموا دورها، وحاولوا الطعن في كثير من ثوابت الإسلام وتاريخه في محاولة لتحريفه وتحجيمه.
وهناك بعض المعاصرين الذين يُدندنون حول الطعون الموجّهة إلى التاريخ الإسلامي، فيزعمون أنّ الإسلام لم يُطبق إلّا في عهد الخلفاء الراشدين، بل في عهد أبي بكر وعمر فقط! ويركّزون الطعن في الدولة الأموية على اعتبار أنّها دولة استبدادية. وهؤلاء وإن كانوا يتظاهرون بالحيادية والنقد المجرّد! إلّا أنّ توقيت نشر هذه الطعون بعد انتفاش الباطنية والشعوبية في هذه الأيام يلقي بظلال الشكّ والريبة في مواقف أكثرهم، فربما كانت هناك أصابع خفيّة تثير هذه البلبلة فيتلقّفونها دون علم أو تمحيص.
إنّ وصف الدولة الأموية بأنّها دولة استبدادية من التعميم الجائر الظالم، وهو يلقي ظلالًا قاتمةً كئيبةً على العصور الأولى؛ يُعمي عن معرفة الحقائق، ويدفع إلى الاستخفاف بأهل تلك العصور والشكّ في مواقفهم.
ليس بخافٍ أنّ الشورى لم تُطبّق في الدولة الأمويّة كما ينبغي، وهناك أخطاء وظلم من بعض الولاة، ووضع للأموال في غير محلها، لكنّ الشريعة كانت سائدة، والقضاء مستقل، والعلماء يجهرون بالحق، وأكثر ملوك الأمويين كانوا في العلم وحسن السياسة على جانب عظيم، كما أنّ فتوحات بني أميّة هي أبقى الفتوحات بعد فتوحات الرسول r والخلفاء الراشدين وأبعدها أثرًا في اتساع نطاق الإسلام ونشر العربية، وكانت الحضارة بجميع نواحيها العلمية والاجتماعية في أفضل أحوالها، فضلًا عن أنّ هذه الدولة في أوائل القرون الثلاثة التي زكّاها النبي صلى الله عليه وسلم.
دروس التاريخ:
أجمع المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت لهذا الخليفة العظيم عَزمات فيها كثير من الدروس، كان أوّلها إرسال جيش أسامة والذي كان له دور في تثبيت أركان الدولة، وبثّ الرعب في نفوس الطامعين فيها ويتحيّنون الوقت للانقضاض عليها، ثم كانت له عزمة أخرى بقتال المرتدين دون هوادة، وقد علم الصحابة الذين عارضوه في أول الأمر بصواب رأيه بعد حين.
هذا الثبات على الحقّ والصلابة في إحقاقه والطاعة المطلقة للشرع والاتّباع الكامل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ هو ما ينبغي أن نستفيده في كل حركة إصلاح أو تغيير أو تأسيس دولة أو حكمها، وعند الوقوف في وجه الفتن التي تعصف بالأمّة كل حين.
تسارعت الفتوح في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتساقطت دول الكفر المجاورة للجزيرة العربية، ودخل أهلها في الإسلام. لكّن عمر رضي الله عنه كان يرى في قرارة نفسه أهمّية التروي وعدم التوسّع في الفتوحات؛ حتى يُثبِّت المسلمون أقدامهم في البلاد المفتوحة، ويفقّهوا الداخلين في الإسلام أمور دينهم، وتنتظم الأمور بشكل كامل. وعلى منهجه سار عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث أمر بعض الجيوش بالعودة من جبهات صعبة موغلة في بلاد الأعداء.
إنّ هذا الأمر ليس تقاعسًا عن الدعوة، ولا ابتعادًا عن الجهاد، بل فيه فوائد كثيرة منها: التوجّه بالدعوة للداخلين الجدد إلى الإسلام، والتنبّه إلى المدسوسين بين صفوفهم، والمحافظة على رأس المال (الجيش الإسلامي) وحفظه من الفناء.
ونحن في هذا العصر بأمسّ الحاجة إلى هذا الفقه «السُّنني» للمجتمعات وطرق الدعوة وآثار الفتوحات، فنحن في عالم كثُر فيه التخليط وسهل وصوله إلى عقول الناس وقلوبهم بطرق شتّى، فلا بد من التفتيش والتروِّي؛ لتستقيم الأمور على ركن ركين من الوحدة والتماسك الاجتماعي، وفقه دقيق للكتاب والسنّة.
استشهاد عمر رضي الله عنه لم يكن حادثة عادية، بل كان نتيجة دسيسة من دسائس المجوس، ومؤامرة خطط لها بدقّة. وسببها الحقيقي: الفتوحات التي وجّهها عمر رضي الله عنه إلى بلاد فارس، والتي أدّت إلى ذهاب ملك كسرى ودخول بلاده تحت حكم المسلمين.
إنّ قراءة روايات هذه الحادثة بطريقة أكثر دقّة وعمقًا سيؤدّي إلى كشف الكثير من ملابساتها، وسيشير بأصابع الاتهام إلى أكثر من شخص أبي لؤلؤة المجوسي، الأمر الذي يفتح عيون الوعي والفطنة على المؤامرات التي تُحاك ضد المسلمين، لا سيَّما تلك التي يكون لأحفاد المجوس يدٌ فيها، فكم كادوا للمسلمين عبر العصور، وكم شاركوا في إسقاط دُوَل، وكم سفكوا من دماء المسلمين، ولا يزالون.
كانت حادثة مقتل عثمان رضي الله عنه أعظم الفتن التي مرّت على الأمّة الإسلامية، فهي أصل كلّ بلاء نزل بالمسلمين بعد ذلك، وقد كان لهذه الحادثة أسباب كثيرة، من أهمّها:
التحوّلات الكبرى التي حصلت في الدولة الإسلامية نتيجة توسعها وتغيّر تركيبتها البشرية، فالصحابة تفرّقوا في البلاد، ودخل الناس في الإسلام وبدؤوا يجولون الدولة طولًا وعرضًا.
وكان ممن دخل في الإسلام قومٌ لمّا يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يفقهوا بحقّ تعاليم الإسلام وأخلاقه؛ فكانوا يتأثّرون بأقوال أهل الفتن. وكان منهم شرذمة من الأراذل والأوباش الذين لم يفهموا نصوص الشرع ولم يعرفوا للصحابة قدرهم؛ فظنّوا أنّهم على الحق، وأنّهم بثورتهم على الخليفة يقومون بواجب إنكار المنكر!
وكان لابن سبأ اليهودي ولبعض حديثي العهد بالإسلام ممن لم تزل عقائدهم السابقة في قلوبهم دورٌ في إذكاء الفتنة وتهييج الناس.
وإنّ المتأمل لهذه الفتنة يستقي منها دروسًا كثيرة مهمّة، فيها فائدة لكلّ دولة في كل عصر، منها:
أهميّة إجراء تغييرات كبيرة في نظام الحكم تراعي ما يحدث في الدولة من تغيّرات، وتكون قادرة على الوقوف في وجه التهديدات الجديدة، وتغليب الأفضل والأحوط لسياسة الدولة.
أنّ التعامل مع الناس (مواطني الدولة) ينبغي أن يكون بطريقة تختلف عن التعامل مع جيلٍ ربّاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس فيهم وفيهم، وأوباش الناس وأصحاب الفتنة موجودون في كل عصر، وهؤلاء يتطلّب التعامل معهم كثيرًا من اليقظة والفطنة والمتابعة، والكشف المستمر عن أفكارهم المنحرفة ودحضها بقوة القرآن والسلطان، وقطع دابر أقاويلهم بالتثبّت، وفضح مؤامراتهم ومحاولة ردّهم إلى الحقّ، والقضاء على كل فتنة يبدؤونها قبل أن تستفحل ويستعر أوارها.
التنبّه للاختراق الخارجي، وتتبّع أذرعه التي تمتد داخل المجتمع المسلم من خلال بعض الأفراد أو الجماعات، وتغليب سوء الظن عند اكتشاف أي خيط يصلهم بالأعداء في الخارج، وعدم الغفلة عن جميع نشاطاته، وعدم الإفراط في التسامح معه.
السعي لإحداث الإصلاح الحقيقي في الدولة من خلال تأسيس العمل السياسي والإداري ووضع القواعد والأصول المناسبة للوصول إلى القيادة وتداول السلطة وفق مبدأ الشورى، بعيدًا عن الإفراط بالجنوح نحو التمرّد الهدّام، أو التفريط بالتنصّل السهل من كل مسؤولية!
بقيت ذكرى الخلافة الراشدة في أذهان المسلمين حاضرة ودائمة، وما فتئوا يقيسون كلّ حاكم أتى بعد ذلك على هذه الفترة المضيئة السامقة، بل يقيسون على فترة أبي بكر وعمر خاصّة.
صحيح أنّ الخلافة الراشدة هي القدوة وهي النموذج الفريد في تاريخ البشرية، لكن عصرها قد انقضى، ولن تعود إلّا في آخر الزمان قبل نزول عيسى عليه السلام، وهذا لا يعني اليأس من وجود إمام راشد، ولا التعلّق بخيالات تحمل للمسلمين الخليفةَ الراشد إن مُكّن لهم في الأرض، ولا السعي للتعلّق باسمٍ مجرّدٍ لا رصيد له من الحقيقة والواقع.
إنّ الذي ينبغي على المسلمين عملُه: عبورُ الهوّةِ بين الواقع ونموذج الخلافة الراشدة من خلال السعي إلى الإصلاح السياسي، وتولية الأصلح، والعمل على تطبيق السياسة الشرعية ما أمكن؛ لتحقيق أكبر قدرٍ من تطبيق الشريعة، والحكم بالعدل والرحمة.
من أهم ما على المسلمين فعله عبور الهوة بين الواقع ونموذج الخلافة الراشدة من خلال السعي إلى الإصلاح السياسي، وتولية الأصلح، لتحقيق أكبر قدر من الحكم بالعدل والرحمة.
لا توجد فتنة أخطر ولا أضر على الأمّة الإسلامية من فتنة الفرق الباطنية، التي أسسها ابن سبأ اليهودي ومجوس فارس، فقد نشأت هذه الفرقُ بعد سقوط دولة الأكاسرة؛ فدفعهم حقدهم على الفاتحين المسلمين إلى التظاهر بالإسلام، والعمل تحت مظلّة التشيّع لآل البيت على تحريف الإسلام وإفساد المسلمين والكيد بهم، من خلال:
تحريف عقائد المسلمين عن طريق تشريع الشرك بالأئمة واعتقاد العصمة لهم وإضفاء القدسية عليهم، والتغطية على الخلل الناتج عن هذه العقائد بعقيدة غيبة الإمام الثاني عشر وعقيدة الرجعة، والاستعانة على ذلك بتبنّي الإباحية بطرق متفاوتة.
إذكاء نار الشعوبية وهي النزعة المتعالية والحاقدة من بعض الشعوب الأعجمية، والتي تنتهي بالزندقة والانسلاخ من الإسلام.
تشويه التاريخ الإسلامي وتحريفه وملئه بالأكاذيب، والتركيز على ما فيه من مساوئ.
التحالف مع أعداء الإسلام ومناصرتهم على المسلمين، والأمثلة على هذا كثيرة، أكثرها شناعة مساعدة «ابن العلقمي» و«نصير الدين الطوسي» الرافضيَّين لزعيم المغول «هولاكو» على اقتحام بغداد وإسقاط الخلافة.
إقامة دول على أنقاض إمارات إسلامية، كالدولة العبيدية «الفاطمية» في تونس ومصر، وكان من آثارها قمع أهل السنّة، ونهب خيرات البلاد، وقتل العلماء والأمراء، والاستعانة باليهود والنصارى في إدارة الدولة، والتحالف مع الصليبيين.
إنّ الوعي بتاريخ هذه الفِرَق يُظهر أنّهم لم يكونوا يومًا مصلحين، ولا لما فيه خير الأمّة قاصدين، بل كانوا لكلمة المسلمين مفرّقين، ولأعدائهم مناصرين، وفي هدم دولهم وتشويه حضارتهم ساعين.
كما أنّه يفسّر كثيرًا مما يصيب المسلمين في العصر الحاضر من مآسٍ دينية وسياسية.
الصراع بين الحق والباطل مستمرٌّ أبد الدهر، وهو صراعٌ يسيرُ وُفق أسس وقواعد، وسنن الله فيه لا تتغيّر؛ وعلى أهل الحقِّ -إن أرادوا للحقِّ أن يظفر وللأمّة أن تنهض- أن يراعوها ويأخذوا بها، ومن ذلك اغتنام الفرص.
لقد صُدّ النبي r عن البيت، وكان معه (1400) من الصحابة، وبعد أن عقد صلح الحديبية مع قريش انطلق في دعوته؛ فدخل الناس في دين الله أفواجًا، ثم فتح مكّة بعد ذلك بسنتين لا أكثر ومعه (10000) من الصحابة.
فاغتنام الفرص -إذن- هدي نبوي، فلماذا يغفل عنه المسلمون؟ لقد كانت أمام المسلمين فرص لصدّ حملات الصليبيين على أنطاكيا لكنّهم لم يستغلّوها، ثم كان أمامهم فرصة لتحرير بيت المقدس لكنّهم تقاعسوا فتأخّر التحرير (16) سنة حتى تمّ على يد صلاح الدين الأيوبي، وكانت أمام المسلمين في المغرب العربي فرصة لصدّ عدوان إسبانيا عن شمال المغرب بنصرة القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي، لكنّهم تقاعسوا عن نصرته فانهزم، ولا تزال مدينتا (سبتة) و(مليلية) مستعمرتين حتى اليوم! كذلك كان أمام المسلمين فرصة للدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، لكنّ الجهود بقيت متواضعة جدًا.
الفرص موجودة حاضرة في كل زمان ومكان، والمتيقّظ العارف بسنن الله في الأفراد والمجتمعات فقط هو من يراها ويستغلّها، وعند استغلالها فإنّ هذه الفرصة تُساوي قرونًا من الزمان.
من أعظم الحوادث المؤلمة في التاريخ الإسلامي: اجتياح المغول لبلاد المسلمين، وقتل وتعذيب وتشريد الملايين، وإسقاط الخلافة، وحرق التراث العلمي الذي تشكّل خلال خمسة قرون. لكن هل تأمّلنا في سبب قيام المغول بها الغزو؟
إنّ السبب كما يقول المؤرّخون: أنّ خوارزم شاه أمر بقتل مجموعة من التجّار المغول الذين قدموا إلى سمرقند وبخارى! ثم ندم على قتلهم، لكن لمّا جاء رسولُ جنكيز خان يحمل رسالة التهديد والوعيد قتله أيضًا!! وبدأ يعدّ العدّة للمواجهة الخاسرة.
وفي العصر الحديث: وجد المسلمون أنفسهم في بلاد الغرب يتنفسون الحرية بعد الحرب العالمية الثانية فبدؤوا في نشر الإسلام وإقامة المراكز الإسلامية، ولما سقط الاتحاد السوفيتي كانت الفرصة سانحة للمسلمين لنشر الدعوة في البلاد التي كان يحكمها؛ لكنّ قيام فئة يسيرة من المسلمين بالتحرّش بأكبر قوة عسكرية في العالم بتهوّر ودون حساب موازين القوى؛ أدّى إلى استعدائها وباقي حلفائها؛ فانقضّوا على العالم الإسلامي يقطّعون أوصاله، ويقتلون شعبه، وينهبون خيراته، وأصبح المسلم أينما حلّ مُستضعَفًا مُتّهمًا بما يسمى «الإرهاب».
فمتى نقرأ التاريخ ونأخذ منه الدروس والعبر؟ ومتى نقف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء صريحًا وواضحًا في طريقة التعامل مع القوى العسكرية الهائلة في العالم: (اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم)؟ متى؟
من الدروس المستفادة من التاريخ أنّ النصر على الأعداء يحصل -بإذن الله- بأمرين اثنين لا ينفكّان عن بعضهما:
الأوّل: الإعداد الإيماني والمعنوي.
الثاني: الإعداد العسكري والمادي.
ونجاح الحركات الكبرى التي قاومت الغزو الأوروبي في القرنين السابقين يعود إلى اجتماع هذين الأمرين معًا، فقد نجح الأمير الخطابي المغربي في الوقوف أمام فرنسا وإسبانيا، ونجح محمد بن أحمد السوداني في الوقوف أمام بريطانيا، واستطاع تلامذة السنوسية مقاومة الاحتلال الإيطالي والوقوف في وجه الزحف الفرنسي، وسجّل شامل الداغستاني أروع الانتصارات على روسيا، ونجح علماء الأزهر في قيادة المقاومة في وجه نابليون.
وإنّ الخلل في الأمر الأوّل: بحصول الانهزام النفسي أمام الأعداء، أو بطلب رضا فريق منهم؛ ينجم عنه انهزام حقيقي في أرض المعركة ولو كانت القوة العسكرية في أفضل حالاتها.
محمد علي باشا: أراد تثبيت ملكه في مصر؛ فعمل على فتح أبوابها لتأثيرات الحضارة الغربية، وابتعث البعثات لتتعلّم أنواع العلوم وتعود بأفكار تغريبية. وسخّر هذه البعثات وكلّ إمكانيات الدولة وخزينتها لخدمة مؤسسة واحدة فقط هي: مؤسسة الجيش. ثم ماذا كانت النتيجة؟
كانت أنْ أثبت جيشُ محمد علي باشا كفاءة عالية، لكنّها ليست باتجاه أعداء الإسلام، ولكن باتجاه المسلمين!
فداخليًا: كان هذا الجيش أداة لقهر الشعب وجباية الأموال وسرقة قوت الشعب وفرض الضرائب عليه، والاستيلاء على الأوقاف؛ حتى تحوّلت مصر إلى إقطاع واحد لمحمد علي ولأولاده.
وخارجيًا: توجّه نحو الدولة العثمانية التي عيّنته حاكمًا! فاحتل بلاد الشام حتى وصل إلى قونية، وقهر الناس وفرض عليهم المكوس، واستولى على أكثر المساجد والمدارس.
عندما تولّى الخليفة العباسي المعتصم مقاليد الحكم: استجلب عناصر من الترك والديلم وولّاهم المناصب الوزارية وقيادة الجيش؛ ظنًّا منه أنّهم سيكونون له عصبة داخلية يحمي بها الدولة، لكنَّ هؤلاء كانوا يجهلون أمور الدين وأمور السياسة، وليس لهم ذلك العقل الذي راضه الإسلام ولا القلب الذي هذّبه الدين! فلم يُفلحوا، بشهادة المعتصم نفسه.
الدولة التي لا تؤسّس لأفرادها عُصبة إسلامية تقوم على لُحمة الدين والشرعية الإسلامية والطاعة بالمعروف، ولا تؤسس لطريقة مناسبة لانتقال الحكم بسلام؛ سوف تصبح دولة ضعيفة مهلهلة، وسوف تبحث عن عصبة تحميها، فإمّا أن تلجأ إلى عصبيات خارجية مثل ما فعل المعتصم، أو أن تعتمد على دول أجنبية كما هو الواقع اليوم، أو تعمد إلى تقريب عناصر من داخلها ممن يحقّقون مصالحها ولو كانوا من أوباش الناس وسَقَط المتاع.
كما أنّ هذه التصرّفات تنعكس سلبًا على الشعوب فتفقد ثقتها بنفسها، وتفقدها الحسّ التاريخي والاستراتيجي، وتبعدها عن الممارسة السياسية بمعناها الصحيح، وتجعلها تعتمد على غيرها في الحماية.
بل لقد وصلت نتائج هذا الخلل إلى اعتقاد كثيرين أنّ العرب أبعد الناس عن سياسة الملك! وأنّ الصراع فيما بينهم متجذّر! نعم هذا الوصف ينطبق على الأعراب المتّصفين بالجهل والجفاء، وليس على كل العرب، وينطبق على العرب الذين يبتعدون عن الدين الذي أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن حالات البدائية إلى حالات التحضّر والتمدّن، أمّا السائرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقاموا دولة وأنشؤوا حضارة، وهم قادرون على ذلك الآن إذا عادوا إلى تلك الجذور.
من سنن الله الكونية التي لا تتبدّل ولا تتحوّل، والتي تكرّر ذكرها في القرآن: أنّ العاقبة للمتقين، ولكن مَن هم المتقون الذين تنطبق عليهم هذه السنّة؟ إنّهم الذين يتّقون أسباب الضعف والخذلان والهلاك، كاليأس من رَوح الله، والتنازع والفساد في الأرض، ويقومون بكلّ ما تقوى به الأمم من الأخلاق والأعمال، وأعلاها الاستعانة بالله والصبر على المكاره مهما عظمت.
كما أنّ من سنن الله سبحانه وتعالى أنّ عاقبة المجرمين إلى الهلاك والدمار، ولذلك أبقى الله جل جلاله عقوبات الظالمين المشركين آثارًا يراها الناس كلّما مروا عليهم؛ لعلّها تكون عبرة لهم. والتاريخ البعيد والقريب مليء بأخبار الحكّام الظلمة المستبدّين وكيف أهلكهم الله، وكيف عاشوا مشرّدين بعد أن أُزيحوا عن كراسيهم.
أبقى الله عقوبات الظالمين المشركين آثاراً يراها الناس كلما مروا عليهم، حتى تكون عبرة لهم، ويعرفوا سنة الله في إهلاك وتدمير المجرمين.
وإنّ الإنسان ليتملّكه العجب كيف يسير الظالم على خطا الظالمِ الهالكِ قبلَه ولا يتّعظ به! إنّه الخذلان، وإنّها سنّة الله في الإحاطة بالظالمين بحيث لا يقدرون على فعل الخير أو ما فيه نجاتهم؛ عقوبة لهم على ما اكتسبوا من الإثم، {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور}. [الحج: 46]

[1] مستفادة من الموقع الشخصي للمؤلف https://alabdah.com.