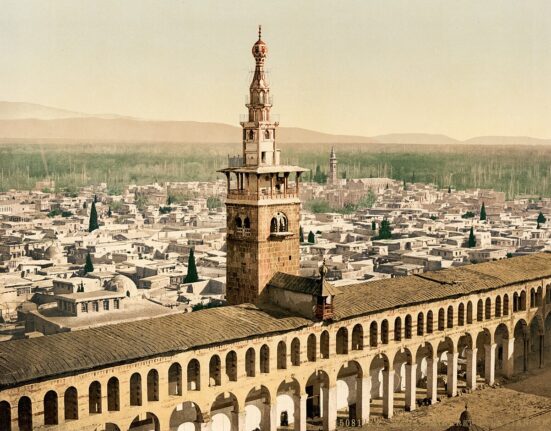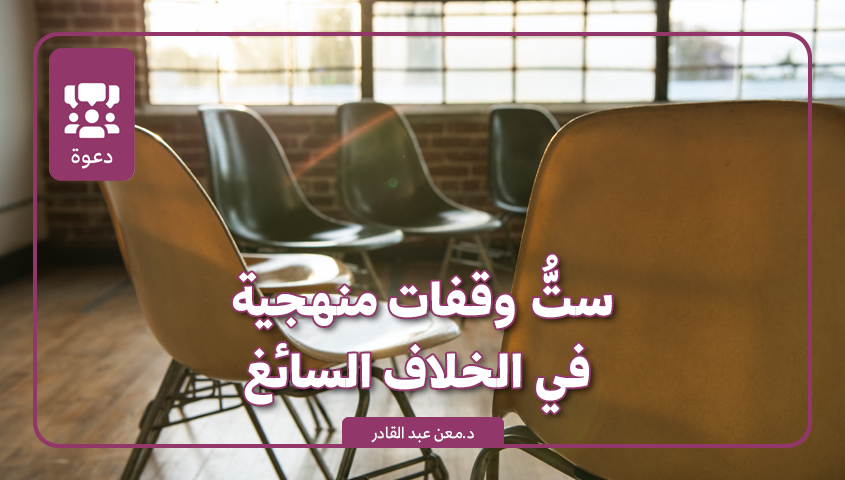يهدف هذا المقال إلى دراسة الحِسبة باعتبارها مؤسسة إسلامية أصيلة أسهمت عبر العصور في ضبط السلوك العام وتحقيق التوازن الاجتماعي، ويتناول جذورها التاريخية وتطورها المؤسسي، مع إبراز وظائفها الرقابية والتنظيمية في الأسواق والمهن والأخلاق العامة. كما يوضح أثرها في تعزيز القيم المجتمعية في السياقات المعاصرة، مع مناقشة التحدّيات التي تعترضها، واقتراح سبل تطويرها بما يتناسب مع المتغيّرات القانونية والتقنية الحديثة.
المقدمة:
تُعَدّ الحسبة من المفاهيم الإسلامية العريقة التي تهدف إلى تحقيق التوازن المجتمعي من خلال تعزيز القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية. وقد كانت الحسبة وما تزال أداةً قويةً للإصلاح المجتمعي؛ حيث تسهم في تنظيم حياة الأفراد، والحد من الفساد، وضمان الالتزام بالمعايير الدينية والأخلاقية والمهنية. يهدف هذا المقال إلى استعراض مفهوم الحسبة، ودورها في التغيير المجتمعي عبر العصور، مع التركيز على أهميتها في العصر الحديث، والتحديات التي تواجهها.
مفهوم الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
تعريف الحسبة:
الحسبة في اللغة تعني الاحتساب، أي القيام بشيء طلبًا للأجر والثواب، جاء في (لسان العرب): “الحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول: فعلته حِسبة، واحتسب فيه احتسابًا، والاحتساب طلب الأجر… وفي الحديث: (مَن ماتَ له ولدٌ فاحتسبه)[1] أي: احتسب الأجر بصبره على مصيبته به… واحتسب بكذا أجرًا عند الله، والجمع الحِسَبُ، وفي الحديث (مَن صامَ رمضان إيمانًا واحتسابًا)[2] أي: طلبًا لوجه الله تعالى وثوابه”[3].
أما في الاصطلاح فهي: وظيفة دينية واجتماعية تهدف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجال العام، لضمان تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حماية الدين والنفس والعقل والمال والعِرض[4].
أو هي: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصلاح بين الناس، قال الله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114][5]، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها، وجزيل ثوابها.
والمعروف هو كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيشمل المعتقدات من أمور الإيمان بالله، والرسل، والقدر، ونحوها، ويشمل العبادات من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وجهاد، ويشمل المعاملات من عقود، وبيع وشراء، ونكاح، وطلاق، وما إلى ذلك. ويشمل التشريعات التنظيمية من حدود، وقصاص، ويشمل أيضًا الأخلاق من صدق، وعدل، وأمانة، ونحوها. وسُمي المعروف معروفًا لأن الفطر المستقيمة والعقول السليمة تعرفه، وتشهد بخيره وصلاحه.
ومعنى الأمر بالمعروف: الدعوة إلى فعله، والإتيان به مع الترغيب فيه، وتمهيد أسبابه وسبله بصورة تثبت أركانه، وتوطد دعائمه، وتجعله السمة العامة للحياة جميعًا.
وأما المنكر: فهو كل ما يبغضه الله تعالى ولا يرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيشمل الشرك بكل ألوانه وصوره، ويشمل الأمراض القلبية من الرياء والحقد والحسد والعداوة والبغضاء ونحوها، ويشمل تضيع العبادات، كما يشمل أيضًا الفواحش كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف، والكذب، والبغي، والظلم، والخيانة ونحوها. وإنما سمي المنكر منكرًا لأنّ الفطر السليمة المستقيمة والعقول السليمة تنكره، وتشهد بشرِّه وضرره وفساده.
ومعنى النهي عن المنكر: التحذير من إتيانه وفعله، مع التنفير منه والصدِّ عنه، وقطع أسبابه وسبله بصورة تقتلعه من جذوره، وتطهر منه الحياة جميعًا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ أجمع على وجوبه المسلمون[6].
الحسبة هي: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصلاح بين الناس، وكان أئمة الصدر الأول يباشرون الحسبة بأنفسهم لعموم صلاحها، وجزيل ثوابها.
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية كبيرة في الإسلام، بل عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، وهو من أهم أعمال الرسل عليهم السلام، ومن أجلّ صفات المؤمنين وخصال الصالحين، وهو سبب خيرية هذه الأمة على غيرها من الأمم، قال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]، وعده الله شرطًا للتمكين في الأرض {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: 41]، وهو من أعظم أسباب النصر، وفي القيام به تكفير للسيئات وحفظ للضرورات الخمس، بل حفظ للمجتمع المسلم، فضلاً عن الأجور العظيمة المترتبة على القيام به.
وتركه إثم عظيم، وسبب لوقوع الهلاك والعذاب وعدم إجابة الدعاء، فعن حُذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (والذي نفسي بيده لَتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر أو ليُوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)[7]، وبتركه يتسلط الفساق والفجار والكفار على الأمة، وتشيع المعاصي وتُستمرأ، ويظهر الجهل ويندثر العلم، وتقلّ شوكة أهله وتقلّ هيبتهم.
الفرق بين الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
يميل كثير من أهل العلم إلى عدِّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا دينيًا على كل مسلم، بطابعه الفردي، في البيت والشارع والحي وحيث دعت الحاجة إليه. أما الحسبة، فغالب أهل العلم يتناولها من جهة كونها نظامًا مؤسسيًا يتضمن تعيين محتسب من قبل الدولة لمراقبة الأسواق، ومنع الغش، وتحقيق العدالة بين الناس، وغير ذلك من الأغراض.
كما أن بينهما عمومًا وخصوصًا؛ ففي الأمر بالمعروف لا يقتصر ذلك على الأمر به حال تركه، وكذا في إنكار المنكر لا يقتصر ذلك على النهي عنه عند فعله، بل إنّ حثّ الناس على الخير وتوعيتهم وتحذيرهم من الشر كل ذلك داخل في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهذا وجه زيادته على الحسبة.
أما وجه زيادة الحسبة فهو أن عمل صاحب الحسبة -بمفهومها الواسع- لا يقتصر على الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، بل إنه أوسع من ذلك بكثير[8].
أهم وظائف نظام الحسبة[9]:
من أهم وظائف المحتسب المعين من طرف الدولة الإسلامية التاريخية: مجموعة من الأمور المحددة، بيانها كما يأتي:
1. الرقابة على الأسواق والتجارة، ويشمل: مراقبة الأسعار، ومنع الاحتكار، وفحص المكاييل والموازين للتأكد من دقتها، ومراقبة جودة السلع، ومنع الغش التجاري.
2. ضبط الأخلاق والسلوك العام، ويشمل: الممارسة الفعلية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع الممارسات غير الأخلاقية في الأماكن العامة، ومراقبة السلوكيات التي تضر بالمجتمع، مثل التسول غير المشروع.
3. ملاحظة الحرف والمهن، وتشمل: التأكد من التزام الحرفيين بالمعايير المهنية، وفحص المنتجات والتأكد من جودتها وسلامتها، وتنظيم عمل الصناع والتجار بما يخدم المصلحة العامة.
4. العناية بالصحة العامة، ويشمل: الإشراف على النظافة العامة في الأسواق والشوارع، والتفتيش على المخابز والمطاعم لضمان النظافة وسلامة الطعام، ومكافحة الأوبئة، والتأكد من دفن الموتى بطريقة شرعية وصحيحة.
5. الإشراف على البناء والعمران: ويتضمن: ضمان عدم التعدي على الطرق العامة والممتلكات، ومراقبة التزام البناء بالقوانين الشرعية والهندسية، وإزالة المخالفات التي قد تؤثر على حركة الناس أو تسبب الضرر.
لكن لا شك أن الحسبة أوسع من هذه المهام، خصوصًا عند استحضارنا للحسبة بمفهومها العام، خارج الإطار الوظيفي، فكل خطأ بحاجة لتقويم هو مجال للحسبة، وكل ما ينفع الناس وجوده ولم يوجد سواء كان هذا النفع دنيويًا أو أخرويًا فهو مجال للاحتساب، ومستوياته تبدأ من البيت والمسجد والحي إلى أن تنتهي إلى أعلى المسؤوليات والمناصب والمقامات، وينبغي أن يكون لكل مقام من يحتسب فيه.
لنظام الحسبة وظائف متعدّدة من أهمّها: ضبط الأخلاق والسلوك العام، والرقابة على الأسواق والتجارة، وملاحظة الحرف والمهن، والعناية بالصحة العامة، والإشراف على البناء والعمران.
أهمية المحتسب في النظام الإسلامي:
عند وجود نظام للحسبة في الدولة المسلمة ومحتسبين تعينهم الدولة: فإنّ المحتسب صاحب ولاية وسلطة تنفيذية يتبع في عمله القواعد الشرعية ويعتمد على الرقابة الصارمة لضمان تنفيذ الأحكام الدينية والمدنية؛ مما يخوّله اتخاذ إجراءات مباشرة لمعالجة المنكرات بما لديه من صلاحيات منحتها إياه الدولة. بخلاف المحتسب المتطوع الذي لا يملك صلاحيات تخوله تنفيذ إجراءات مباشرة، فيقوم بالنصح والتوعية ورفع الأمر إلى الجهات المعنية عند تعذر الإصلاح المباشر[10].
أما عند عدم وجود نظام للحسبة فيعود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأصله واجبًا عامًا في عنق كل مسلم بما يستطيع، وضمن الضوابط العامة.
الحسبة أداةً للتغيير المجتمعي، لمحة وشواهد تاريخية:
كان للحسبة دورٌ مهمٌ في التاريخ الإسلامي؛ حيث كانت أداةً رئيسة للإصلاح المجتمعي، ويتضح ذلك جليًا عند دراسة تطور مفهوم الحِسبة عبر التاريخ الإسلامي، حيث بدأ تطبيق الحِسبة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يراقب الأسواق بنفسه، ويعيِّن من يقوم بها، مثل سعيد بن العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما[11].
واستمر العمل بنظام الحسبة في العصر الأموي، لكن بطريقة غير مركزية، حيث كانت من اختصاص الوالي والقضاة في المدن الكبرى، كما أشار لذلك ابن خلدون في مقدمته[12].
وأصبحت الحِسبة في العصر العباسي مؤسسة رسمية، وعُيّن لها محتسبون متخصصون يتبعون الدولة مباشرة، وكان لهم سلطات أوسع تشمل الرقابة الأخلاقية والاجتماعية، كما أكَّد ابن قدامة في “المغني”[13].
وازدادت صلاحيات المحتسب في العصر المملوكي والعثماني، وأصبحت هناك سجلات رسمية لتنظيم الأسواق والحرف والمهن.
كما استمر نظام الحسبة في العصر الحديث، لكنه تحول إلى أجهزة رقابية مثل الشرطة والهيئات التنظيمية في الدول الإسلامية الحديثة.
وفي العصر العباسي كان المحتسب مسؤولاً عن مراقبة الأسواق ومنع الغش التجاري. وفي الأندلس استخدمت الحسبة للحفاظ على النظام العام وضبط السلوكيات غير الأخلاقية. وأما في الدولة العثمانية فقد تم تطوير مؤسسة الحسبة لتشمل الرقابة الصحية والمهنية؛ مما أسهم في تحسين جودة الحياة العامة.
وهذا لم يُلغ الدور العام التطوعي لكل مسلم في النصح والتوعية والبيان.
للحسبة دورٌ مهمٌ في التاريخ الإسلامي؛ حيث كانت أداةً رئيسة للإصلاح المجتمعي، وقد صارت من مهام الولاة والقضاة في عصر الدولة الأموية، لتصبح في العصور اللاحقة مؤسسة رسمية يعُيّن لها محتسبون متخصصون لهم سلطات واسعة.
دور الحسبة في تعزيز القيم المجتمعية في العصر الحاضر[14]:
المقصود بالقيم المجتمعية: القواعد أو المقاييس التي يقوم على ضوئها السلوك الاجتماعي أو يُحكم عليه، وهي مصدر للمعايير الاجتماعية التي يُقصد بها الأحكام الملموسة والمحددة نسبيًا والمعتمدة في تحديد أنواع السلوك المناسب في أوضاع وظروف معينة[15].
وفي عصرنا الذي نعيشه حصل تراجع كبير في طبيعة القيم السائدة في الكثير من المجتمعات المسلمة فضلاً عن غيرها؛ نتيجة البعد عن روح الشريعة وآدابها، فانتشر الظلم واعتدى القوي على الضعيف، وتراجعت الرقابة الذاتية عن الناس كثيرًا.

ومن أهم القيم المجتمعية التي تعززها ممارسة الحسبة بشكليها (التطوعي والرسمي) في مجتمعاتنا اليوم:
1. محاربة الرذيلة وإحلال الفضيلة:
تسهم الحسبة في منع انتشار الرذائل مثل المخدرات والانحرافات الأخلاقية؛ من خلال التوعية والإرشاد، إضافةً إلى الرقابة على الأماكن التي قد تروِّج لمثل هذه السلوكات.
2. التضييق على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية:
تلعب الحسبة دورًا في مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر آليات الرقابة والإبلاغ عن التجاوزات، مما يعزِّز مناخ العدالة الاجتماعية في المجتمع.
3. وأد المشكلات ومنع تفاقمها والعمل على حلِّها:
من خلال الرقابة الاستباقية، حيث تمنع الحسبة تفاقم المشكلات مثل العنف الأسري والتطرف الفكري، وتسهم في وضع حلول مناسبة قبل تحولها إلى أزمات كبرى.
4. الأمانة والتزام الأخلاق المهنية:
بوجود الحسبة والنصح والرقابة يرتفعُ الالتزام بالضوابط الأخلاقية للمهن المختلفة، مثل منع التلاعب في المنتجات، أو التهاون في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، أو التنفّع الشخصي من موارد الدولة، وهكذا. ومع اعتياد وجود الرقابة يتحول الالتزام تحت الرقابة إلى سلوك طبيعي عند الناس.
5. الرقابة على النظافة والتقيد بالمعايير البيئية:
تلعب الحسبة دورًا في الحفاظ على النظافة العامة، ومراقبة المؤسسات الصناعية والتجارية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية.
6. بث روح المبادرة وتحمل المسؤولية:
الحِسبة من أشرف وأصعب الأعمال؛ لأنها تتعلق بالمسؤولية والمبادرة في أمرٍ يثقل على النفس، وقد تواجه برفض أو مقاومة من الناس. ومع ذلك، فإنّ إقدام المحتسب على هذه المهمة، وشعور الناس بأن فيها نفعًا لهم؛ يشجّعهم على تقليده في إيجابيته وروحه المبادِرة.
7. انتشار مبدأ الثقة والتعاون بين الناس:
المحتسب إنسان إيجابي، فكما أنه يأمر بالخير وينكر الأخطاء فهو كذلك يمد يد العون ويجمع الجهود لمساعدة الملهوف، ومع تكرار هذه الجهود مع من لا يعرفهم واستجابة الناس؛ تتحول هذه المبادرات إلى عادات وقيم مجتمعية مع الوقت.
بوجود الحسبة والنصح والرقابة يرتفع الالتزام بالضوابط الأخلاقية للمهن المختلفة، ومع اعتياد وجود الرقابة يتحول هذا الالتزام إلى سلوك طبيعي عند الناس.
مقترحات لتطوير نظام الحسبة في العصر الحديث[16]:
على الرغم من أن نظام الحسبة الرسمي كان فعَّالاً في العصور الماضية، لكن تطويره لمواكبة العصر الحديث يتطلب تحديث آلياته وأساليبه؛ بحيث يتناسب مع النظم القانونية والإدارية الحديثة. وفيما يأتي بعض المقترحات:
1. تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي: من خلال تحديث القوانين الحسبية لتتوافق مع الأنظمة القانونية الحديثة وحقوق الإنسان، ووضع لوائح واضحة لتنظيم عمل المحتسبين، بحيث يكون دورهم رقابيًا وإرشاديًا أكثر من كونه عقابيًا، ودمج نظام الحسبة ضمن المؤسسات الرقابية الرسمية مثل وزارة التجارة وهيئات حماية المستهلك.
2. التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني: بتعزيز التنسيق بين المحتسبين والجهات الرسمية مثل البلديات والوزارات المختصة؛ لضمان فعالية الرقابة، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الرقابة الشعبية، وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات، وإشراك القطاع الخاص في جهود الرقابة من خلال تحفيز الشركات على الالتزام بمعايير الجودة والنزاهة.
3. التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا: من خلال إطلاق منصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المواطنين حول المخالفات التجارية والأخلاقية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واكتشاف المخالفات في الأسواق والمرافق العامة، والسعي إلى إنشاء تطبيقات ذكية تتيح الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات في التجارة أو الممارسات غير الأخلاقية.
4. التركيز على التوعية والتثقيف: من خلال تنظيم برامج تدريبية للمحتسبين في مجالات القانون والإدارة والتكنولوجيا؛ لضمان أدائهم الفعّال، وتنفيذ حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لتعريف الناس بأهمية الحسبة وأهدافها، ودمج مفهوم الحسبة الحديثة في المناهج التعليمية؛ لتعزيز الرقابة الذاتية في المجتمع.
5. تطوير دور الحسبة في حماية المستهلك: بإنشاء مراكز رقابة ميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين مع توفير آليات سريعة للإنصاف والاعتراض، ودعم مبدأ الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقارير دورية عن أداء الحسبة ونتائج عمليات الرقابة.
6. توسيع نطاق الحسبة ليشمل قضايا جديدة، مثل: مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والتضليل في التجارة الإلكترونية، ودعم الجهود البيئية من خلال مراقبة الالتزام بالمعايير البيئية في الصناعات والمشروعات التنموية، والإشراف على جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان الامتثال للمعايير المهنية.
أهم منتجات نظام الحسبة[17]:
أسهم نظام الحسبة في تطوير العديد من المنتجات والخدمات التي تهدف إلى تنظيم المجتمع وتحقيق العدالة وحماية الحقوق. ويمكن تصنيف منتجات الحسبة إلى عدة مجالات رئيسة:
1. المنتجات الرقابية والتنظيمية: ومن ذلك القوانين واللوائح الحسبية التي تنظِّم الأسواق، وتضبط الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، ومنح التصاريح للحرفيين والتجار، والتأكد من التزامهم بالمعايير، والعناية بالسجلات التجارية والمهنية بتوثيق الأنشطة التجارية والحرفية لضمان الجودة والمصداقية.
2. المنتجات التوعوية والإرشادية: من إصدار الكتب والمراجع الفقهية التي تناولت قواعد الحسبة وأحكامها. وإصدار فتاوى توجيهية بشأن المعاملات التجارية والسلوكات العامة. وتدريب المحتسبين والتجار والمجتمع على مبادئ الحسبة وأخلاقيات العمل.
3. المنتجات التقنية والإدارية الحديثة: مثل منصات الإبلاغ عن المخالفات التجارية والأخلاقية، والتطبيقات الذكية لمراقبة الأسواق وجودة السلع والخدمات، ونشر بيانات وإحصاءات عن أداء الأسواق والمخالفات المضبوطة.
4. المنتجات المجتمعية والخدمية: مثل مكاتب الشكاوى وخطوط الإبلاغ عن الغش والاحتكار، والتفتيش على الأغذية والأدوية، وضمان النظافة العامة، ونشر ثقافة الأخلاق التجارية والسلوكات السليمة.
5. المنتجات الأمنية والقضائية: وتشمل أنظمة ضبط المخالفات، وفرض العقوبات على المخالفين في الأسواق والمجتمع، والتنسيق مع الجهات الأمنية، ودعم الأمن العام من خلال الرقابة على المخالفات السلوكية.
التحديات التي تعترض دور الحسبة في التغيير المجتمعي[18]:
1. ضعف الوعي بمفهوم الحسبة وحدودها، ويتجلى ذلك في خلط البعض بين الحسبة والتدخل في خصوصيات الآخرين.
2. التمييز بين ما هو منكر متفق على إنكاره وما هو محل خلاف مذهبي، فالواجب في الحسبة أن تنصب على المتفق على إنكاره، وكذلك المعروف على المتفق على كونه معروفًا.
3. غياب التأهيل العلمي والدعوي للمحتسبين، وغياب المهارات الاجتماعية والحوارية، والدفع بالمحتسب إلى مباشرة العمل قبل نضوجه علميًا أو تدريبه على خطاب الآخرين.
4. ربط الحسبة بالتشدد أو التطرف في أذهان العامة، فبعض التجارب السلبية أسهمت في تشويه صورة الحسبة، وربطها بالتطرف أو التدخل غير المبرَّر، مما خلق حاجزًا نفسيًا واجتماعيًا تجاهها.
5. تغير أنماط الحياة والانفتاح الإعلامي، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يعقّد مهمة المحتسب، حيث غدت هذه الوسائل تتدخل في توجيه القيم والأخلاق والسلوك.
6. غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وغياب التشريعات المنظمة لدور الحسبة أو ضعف تنفيذها قد يخلق فراغًا تنظيميًا يُستغل بالشكل الخطأ.
7. تحديات قانونية وتشريعية في بعض الدول التي لم تنظم الحسبة في إطار قانوني حديث، مما قد يجعل ممارستها عرضة للتأويل القانوني والجدل.
8. التحولات الفكرية والثقافية داخل المجتمعات، حيث تتنامى التيارات الليبرالية والعلمانية في بعض المجتمعات الإسلامية، وتشكل بيئة غير متقبلة لدور الحسبة.
الخاتمة:
تظل الحسبة أداةً فعالةً في تحقيق التغيير المجتمعي وتعزيز القيم الأخلاقية، ولكنها تحتاج إلى تطوير وتحديث مستمر لمواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية.
فتطوير نظام الحسبة يتطلب الجمع بين المبادئ الشرعية والتقنيات الحديثة لضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع بشكل أكثر كفاءة من خلال: التحديث الرقمي، وتعزيز الأطر القانونية، والتوعية المجتمعية، ويمكن لنظام الحسبة أن يظل أداة فعالة في الحفاظ على النظام العام وتعزيز النزاهة في المجتمعات الحديثة.
ونجاح الحسبة في إحداث التغيير المجتمعي الإيجابي يتطلب معالجة التحديات التي تعرقل مسيرتها، من خلال تأصيل المفهوم الشرعي للحسبة وضبطه قانونيًا، ومن خلال تأهيل المحتسبين علميًا ووجدانيًا، ولا بد من تعزيز التكامل بين الحسبة والمؤسسات الأخرى، والاستفادة من الإعلام والتقنية الحديثة في الدعوة والتوجيه.
والله نسأل أن يجعلنا ممن قال عنهم في كتابه: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33].
تظل الحسبة أداةً فعالةً في تحقيق التغيير المجتمعي وتعزيز القيم الأخلاقية، ولكنها تحتاج إلى تطوير وتحديث مستمر لمواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية
د. محمد ماهر محمد قدسي
عضو هيئة تدريسية برتبة (أستاذ)، دكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة
[1] ينظر: صحيح مسلم (1248).
[2] أخرجه البخاري (38) ومسلم (760).
[3] لسان العرب (1/314-315).
[4] ينظر: أصول الحسبة في الإسلام، للدكتور كمال إمام، ص (9).
[5] ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي، ص (349).
[6] ينظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، ص (741)، والإرشاد، للجويني، ص (368).
[7] أخرجه الترمذي (2169).
[8] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه، لخالد السبت، ص (34).
[9] ينظر: الحسبة في الإسلام، لابن تيمية.
[10] ينظر: دروس الشيخ سفر الحوالي، جزء (26) ص (12) موقع الشبكة الإسلامية.
[11] ينظر: سيرة ابن هشام، ص (12)، والرحيق المختوم، للمباركفوري، ص (٣١٢).
[12] ينظر: مقدمة ابن خلدون، ص (432).
[13] ينظر: المغني، لابن قدامة (2/154).
[14] ينظر: الحسبة في الإسلام، لابن تيمية.
[15] مقالة “القيم الاجتماعية وأثرها في البناء الاجتماعي”، للدكتور شاكر حسين الخشالي، موقع معارج الفكر. ومصطلح “قيم” يعتبر حياديًا؛ بمعنى أن القيم يمكن أن تكون إيجابية نافعة، كما يمكن أن تكون سلبية ضارة، فالتضامن والتكافل قيم إيجابية نافعة، والأنانية والأثرة قيم سلبية ضارة.
[16] ينظر: نظام الحسبة في الإسلام وحاجة العصر الحاضر له، مقال في مجلة جامعة الأزهر – كلية أصول الدين بالمنوفية، العدد 23، الصفحات 681 وما بعدها.
[17] ينظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي.
[18] ينظر: نظام الحسبة في الإسلام، لمحمد سيد الوكيل، ص (٢٢٠)، والفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي (4/398).