جاءت الشريعة جالبة للمصالح دافعة لجنس المشاق والأضرار، والمتأمل في أحكامها يجد أنها لم تقتصر على دفع الضرر الحسي المادي، بل صانت المشاعر وراعت العواطف، وحفظت الشرف والكرامة من أن تُنتهك أو تُهان، ما يؤدي بالمجتمع إلى الرقي السلوكي والأخلاقي، والاحترام المتبادل، والتراحم.
مدخل:
حرص الإسلام على تهذيب سلوك الأفراد من خلال عددٍ من الأحكام والقيم التي شرعها وحثَّ عليها: كالصدق والأمانة والوفاء بالعهود وغيرها، وفي المقابل منع جملةً من الممارسات والسلوكيات التي إن لم تُفضِ إلى إلحاق الضرر بالنفس فإنَّ ضَرَرَها ولا شك سيَلحقُ الغير.
لهذا وغيره فقد حُرِّم كثير من مُسبِّبات الضرر: كالكذب وشهادات الزور وخيانة العهود، وكلُّ ما من شأنه أن يكون سببًا ووسيلةً إلى الأذية وإلحاق الضرر بغير حق، سواءً في الأموال، أو الأجساد، بل حتى في الأعراض والعواطف والمشاعر.
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58] وهو عام في كل زمان ومكان.
ومثله ما جاء في براءة نبي الله موسى عليه السلام بعدما أوذي، فبرَّأه الله مما قيل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ [الأحزاب: 69]، فمجرد مقالة قيلت وتهمة أُلحِقت سماها الله أذية وإنها لكذلك.
ويتجسَّد التحريم من خلال النصوص العامة والخاصة التي وردت في القرآن والسنة. فمنه ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ ضرَّهُ الله)([1]).
فالحديث قاعدةٌ عظيمةٌ عند أهل العلم، ومع قِصَر ألفاظه واختصارِها يدخُلُ في كثيرٍ من الأحكام الشرعية، ويبيّن السياجَ المحكم الذي بنته الشريعة لضمان مصالح الناس، في العاجل والآجل.
المقصود بالضرر:
الضرر في اللغة: “ضد النفع. والمضرة: خلاف المنفعة. وضره يضره ضرًا وضر به وأضر به وضاره مضارة وضرارًا بمعنى، والاسم الضرر”([2]).
واصطلاحًا: “ما يَلحقُ الإنسانَ من أذى لا يحتمله فتَجِبُ إزالته”([3]).
وقيل هو: “الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الآخرين، تعديًا أو إهمالاً”([4]).
ولعل هذا التعريف أوسع؛ إذ يتناول جانب الضرر المادي والمعنوي وكل ما له علاقة بشعور الإنسان وعواطفه، أو شرفه أو عرضه أو كرامته أو سمعته، من غير تخصيصه بنوع معيَّن من أنواع الضرر.
المقصود بالضرر المعنوي:
تعريفات العلماء للضرر المعنوي لم تتجاوز حُدود إلحاق الأذى والمفاسد في الأعراض والكرامات والشرف والسمعة.
ومما ذُكر من تلك التعريفات:
“إلحاق مفسدة في شخص الآخرين لا في أموالهم، وإنما يمس كرامتهم أو يؤذي شعورهم، أو يخدش شرفهم أو يتهمهم في دينهم أو يسيء إلى سمعتهم أو نحو ذلك من الأضرار التي يطلق عليها اليوم اسم الضرر الأدبي”([5]).
وينقسم الضرر إلى أنواعٍ عديدةٍ، ومنها: الضرر المعنوي أو الأدبي، وهو ما سيكون عنه الحديث في هذه المقالة.
فالضرر المعنوي ليس محلُّه أموالَ المضرور وجسده، وإنما يُصيب مصلحةً غيرَ ماليةٍ ولا ماديةٍ محسوسة؛ كالحرية والعِرض والشَّرف.
“الضرر الأدبي والمعنوي كالضرر الذي يلحق الإنسان بسبب الاعتداء على حريته، أو في عرضه، أو في سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو اعتباره المالي”([6]).
ولا ينبغي الاستهانة بالضرر المعنوي بدعوى أنه معنويٌّ فحسب، فليس من السُّهولة تجاهل هذه الأضرار، فقد يكون وقعُها أعظمَ وأشدَّ من الضرر المادي، خاصةً وأنَّ الضرر الماديَّ قابلٌ للتعويض والبدل، أما المعنويُّ فلا يُرَدُّ بحال. وكل محاولات ترميم الانكسار أو الخدش لا تعدو أن تكون كقول ابن الرومي بعد فقده فلذة كبده:
بكاؤكما يشفي وإن كان لا يُجدي *** فجودا فقد أودى نظيركما عندي
لذلك كان للضرر المعنوي اعتبارٌ شرعي، ولا أدلَّ على ذلك مما أعده الله تعالى لمن سعى في إلحاق الأذى بالناس واتهامهم وخدش أعراضهم من الجزاء والعذاب، قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 23].
ولأنَّ الضرر مهما كان نوعُه يتنافى وتكريمَ الإسلام للجنس البشري، ومن التكريم صيانةُ الأعراض وحفظُ المكانة، فجاء التحريمُ عن إيقاع الضرر بالنفس أو الغير حفظًا وتكريمًا، (مَن ضارَّ أضر الله به)([7]).
الضرر المعنوي ليس محلُّه أموالَ المضرور وجسده، وإنما يُصيب مصلحةً غيرَ ماليةٍ ولا ماديةٍ محسوسة؛ كالحرية والعِرض والشَّرف
مفهوم التعويض عن الضرر:
ذكر أهل العلم تعريفات لمفهوم التعويض عن الضرر، ومن ذلك:
– “المالُ الذي يُحكَم به من أوقع ضررًا على غيره في نفسٍ أو مالٍ أو شرف، والتقديرُ في تعويض الشرفِ من باب التعزير الذي وَكَلت الشريعة الإسلامية أمرَهُ إلى الحاكم، يُقدِّرُهُ بالنظر إلى قيمة الضرر ومنزلة المجنيِّ عليه والعُرف الجاري في مِثله. وأساسُ التعويض المالي في الشرف مأخوذٌ من مذهب الإمام الشافعي”([8]).
– “ليس المقصود بالتعويض مجرَّدَ إحلالِ مالٍ محلَّ مال، بل يَدخُل في الغرض منه المواساةُ إن لم تكن المماثلة، ومِن أظهر التطبيقات على ذلك الديةُ والأَرشُ، فليس أحدُهُما بدلاً عن مالٍ ولا عمّا يُقوَّم بمال”([9]).
فالتعريفان يُظهران حقيقةَ التعويض عن الضرر المعنوي، وبعضَ تطبيقاته، وكيفية تقديرِ قيمته، وكذا الحكمةَ من التعويض عنه، والتي تكمن في المواساة وجبر ما حلَّ من الانكسار وحصل من الانفطار.
غير أنه وإن حصل الاتفاق على أنَّ الضرر المعنوي هو ما يُصيب المرء في عِرضِه وسُمعته مما لا يُسبِّب أذىً ظاهرًا، لكن اختُلِف في جواز التعويض الماليِّ عن الضرر النفسي.
مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي:
ثمة خلافٌ في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي، وإن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بمشروعية التعويض، إلا أنَّ ذلك لا يَرفعُ الخلاف بين مُجيزٍ ومانع.
ولعلَّ السببَ في اختلاف الفقهاء هو طبيعةُ النصوص المؤطِّرة للضرر المعنويِّ خاصّةً، وكذا طبيعةُ ومقدار التعويض، وغياب فروع فقهية قريبة الإلحاق؛ حيث إنَّ جُلَّ النصوص الواردة إنما هي في خصوص الضرر المادِّي، وما ورد منها مما يمكن أن ينضوي تحته الضرر المعنوي تبقى نصوصًا عامةً في النهي عن الضرر.
يقول الشيخ الزرقا رحمه الله: “الحكم بالتعويض المالي عن الضرر الأدبي حُكمٌ مستحدَثٌ، ليس له نظائرُ في الفقه الإِسلامي”([10]).
غير أنه قد وُجد في الشريعة بعضُ الأحكام التي قد يُستنبط منها مشروعية دفع الضرر المعنوي بِعِوَضٍ مالي.
فمن ذلك: مشروعية الصداق في الإسلام:
فقد شرع الإسلام المهرَ دلالةً على الرغبة والمودة التي يريد الزوج أن يعبّر عنها لزوجته، وليُستمال به قلبُ المرأة، مُعربًا عن صِدق رغبته وحقيقة طلبه، وليس ثمنًا ولا مقابلاً ماديًّا لأيِّ معنىً من معاني الزواج الذي عبَّر عنه القرآن بأنه ميثاقٌ غليظ.
من أجل تلك المشروعية لم يجعل الإسلام للمهر مقدارًا محددًا، وإن كان بعض الأئمة قد اختلفوا في تحديد أقلِّهِ هل هو دينارٌ من ذهبٍ أو رُبعه؟([11]).
ومن حِكَمِهِ: إكرامُ المرأة وإشعارُها بأنها هي المطلوبة المرغوبة لا الطالبة، وإقدارُها قدرَها حتى ولو اقتضى الحال أن يَفرضَ لها المقدارَ الكبير؛ ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]، فلا يجوز العُدول عما فرض، كل ذلك إكرامًا لها، وهو يرفع من شأن المرأة، ويُعلي من قدرِها وحتى لا تجد في نفسها حرجًا ولا يحلَّ بمشاعرها ضررٌ جرَّاء فقْدِ أهلها والاغتراب عن موطنها، فأثرُهُ النفسيُّ ظاهر جليٌّ غير خَفيّ.
فالرجلُ يبذلُ المال ويهبه إياها نحلةً منه، أي عطيّةً وهديةً وهبةً منه، لا ثمنًا للمرأة، ولا أنه أجرةٌ للاستمتاع.
فلو كان الأمر كذلك لما فرض الإسلام نصف المهر على من تزوَّج ثم طلَّق قبل أن يدخل بزوجته دون مسيس، تقديرًا لهذا الميثاق الغليظ والرباط المقدس، وإشعارًا لها بالمواساة، مما يدلُّ على أن الاستمتاع ليس هو الأساس، ولو كان سبب المهر وعِلَّتُه العِوَض عن الاستمتاع لشرع أن تدفع المرأة الصداق لزوجها كذلك، إذ الاستمتاع حاصلٌ للطرفين، وكلُّ ذلك مما يؤكِّد أن غاية المهر وحكمتَه أعظمُ من الاستمتاع وأجَلُّ من العِوَض والثمنية المادية.
يقول الدكتور الزحيلي رحمه الله: “الحكمة من وجوب المهر: هي إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزازُ المرأة وإكرامُها، وتقديم الدليل على بناء حياةٍ زوجيةٍ كريمةٍ معها، وتوفيرُ حسنِ النيةِ على قصدِ مُعاشرتها بالمعروف، ودوامِ الزواج. وفيه تمكينٌ المرأة من التهيُّؤ للزواج بما يلزم لها من لباسٍ ونَفَقة”([12]).
 تلك المعاني الجليلة التي تضمَّنها المهر، من تطييب نفسِ المرأة به، وإكرامِها وإعزازِها بما قُدم لها، وإعلان حسنِ نية مُعاشرتها بالمعروف، وتمكينِها من تهيئة نفسها بما يلزمُها، كلُّ ذلك ولا شك إن لم يَجبُر ما قد وجدته في نفسها من ضررِ فِراقِ أهلها، والاجتماع برجل غريب والإقامة ببيتٍ غريب وموطن غريب، لكنه كفيلٌ بجبرِ بعضِهِ وتقليلِ وقعِ الضررِ الموجود ببعضِ ما بَذَل، فالنفوسُ ميّالةٌ إلى مَن يُحسن إليها ويُدلِّلُها، فكيف إذا تعلَّق الأمرُ بالمال؟ وتلك الفطرة والنفس البشرية، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ٧ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: 6-8].
تلك المعاني الجليلة التي تضمَّنها المهر، من تطييب نفسِ المرأة به، وإكرامِها وإعزازِها بما قُدم لها، وإعلان حسنِ نية مُعاشرتها بالمعروف، وتمكينِها من تهيئة نفسها بما يلزمُها، كلُّ ذلك ولا شك إن لم يَجبُر ما قد وجدته في نفسها من ضررِ فِراقِ أهلها، والاجتماع برجل غريب والإقامة ببيتٍ غريب وموطن غريب، لكنه كفيلٌ بجبرِ بعضِهِ وتقليلِ وقعِ الضررِ الموجود ببعضِ ما بَذَل، فالنفوسُ ميّالةٌ إلى مَن يُحسن إليها ويُدلِّلُها، فكيف إذا تعلَّق الأمرُ بالمال؟ وتلك الفطرة والنفس البشرية، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ٧ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: 6-8].
متعة الطلاق:
والمقصود بها: “ما يعطيه الزوج لزوجته عند الفراق تسليةً لها لما يحصلُ لها من ألم الفراق”([13])، جبرًا لخاطرها، وليس لها حدٌّ معلوم.
فما يُعطيه الزوج لمطلَّقته عن طيبِ خاطرٍ يجبُرُ به ما قد يحصُلُ من الألم والضرر النفسي الذي حصل لها بسبب الفراق.
وقد توافرت النصوص على مشروعية هذا النوع من المواساة والتسلية. فلقد أمر الله بها في القرآن الكريم: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241].
وقال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236].
فالأمر الوارد في هذين النصين بالمتعة وإن كان مُحتمِلاً للوجوب والندب، ومحلَّ اختلافٍ بين الفقهاء، إلا أنهم مُتَّفقون على أنَّ ذلك يُعتبر دليلاً على تشريع المتعة في الطلاق لغرض جَبر الخواطر والتعويض عن الأضرار النفسية المعنوية، حتى رُوي عن القاضي شريح رحمه الله أنَّه كان يُجبر المطلق على دفعِ المتعة لمطلَّقته، كما أورده ابن عبد البر في الاستذكار([14]).
وقد قال الشيخ الصابوني رحمه الله في تفسير الآية الثانية: “أي وإذا طلقتموهن فادفعوا لهن المتعة تطييبًا لخاطرهن وجبرًا لوحشة الفراق”([15]).
فبالمتعة تنفكُّ تلك الندبة النفسية التي من الممكن أن تجعل الطلاقَ طعنةَ عِداءٍ وخصومة، وبها يَندفعُ ذلك الجوُّ المكفَهِرّ وينسِمُ فيها نسمات الوُدِّ والمعذرة، ويُزيل عن الطلاق جوَّ الأسفِ والأسى.
قال ابن العربي رحمه الله: “… لِما لَحِق الزوجة من رحض العقد ووصم الحِلّ الحاصل للزوج بالعَقد، فإذا طلقها قبل المسيس والفرضِ ألزمه المتعة كفؤًا لهذا المعنى”([16]).
لذلك فكلُّ طلاقٍ تختارُه المرأة من غير سببٍ يكون للزوج في ذلك، كأن تختلع فإنه يسقط حقُّها في المال وفي الأثر النفسي؛ لأنها هي التي ترغب به فينتفي الضرر.
يقول ابن الفَرَس: “… قالوا: المرأة إذا اختارت فراق زوجها لم تشقق لذلك ولا حزنت، فلا يحتاج الزوج إلى تسليتها وتطييب نفسها”([17]).
بل قد يكون الزوج غير راغبٍ بالطلاق فيتضرَّرُ هو جراءَ ذلك، فشُرع له مبلغٌ من المال عند الخُلع تدفعُهُ الزوجة مقابل طلبها للفراق، دفعًا للضرر الواقع من الزوجة على زوجها، كما شُرع لها مُتعة الطلاق دفعًا للضرر وتسليةً للنفس وتطييبًا للخاطر.
ومن هذا أيضًا قولُهم: إن المرأة المراجَعة بعد الطلاق وقبل المتعة لا مُتعة لها كذلك؛ لأنَّ ما يحصل بالمتعة وهو التسلية قد حصل بالارتجاع، فلا محل للمُتعة عندها.
يقول الإمام ابن العربي في المسالك: “المسألة الثالثة: فإن طلَّقها بعد البناء، ثم راجع قبل أن يمتع، فلا مُتعة لها، قاله ابن وهب وأشهب؛ لأن المتعة تسليةٌ عن الفراق، والتسلية بالارتجاع أعظم”([18]).
الأمر الوارد في نصوص المتعة للمطلَّقة -وإن كان مُحتمِلاً للوجوب والندب، ومحلَّ اختلافٍ بين الفقهاء- إلا أنهم مُتَّفقون على أنَّ ذلك يُعتبر دليلاً على تشريعها لغرض جَبر الخواطر والتعويض عن الأضرار النفسية المعنوية
ردُّ الاعتبار:
والمقصود بردِّ الاعتبار هو إرجاعُ الكرامة واستعادةُ المكانة في الحياة الاجتماعية.
فكان تشريع الحدود والأحكام التي تمنع إلحاق الأذى بالغير ضامنًا لهذا الغرض محققًا لتلك المقاصد.
ومما ورد في هذا الباب ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي برجل شَرِب الخمر فقال: (اضربوه). قال أبو هريرة: فمنَّا الضاربُ بيده، ومنا الضاربُ بنعله، ومنا الضارب بثوبه، فلمَا انصرَفَ قال بعض القوم: أخزاك الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطانَ)([19]).
فالنبيُّ عليه السلام عَلَّم الصحابة ونبَّههم على ترك لوم شارب الخمر بعد توقيع العقوبة عليه، وهو عامٌّ في كلِّ من أُدين بجرمٍ ما حتى لا يجد احتقارًا من أفراد المجتمع له ويكون ذلك سببًا للتمادي في ارتكاب جريمته.
وأعظم من ذلك حرصُ الإسلام على صيانة أعراضِ الأموات وردِّ الاعتبار لهم بعد إقامة الحدِّ والتوبة.
فكذلك كان الشأنُ مع الغامدية؛ فلقد ردَّ النبيّ عليه السلام لها اعتبارَها بعد موتها عندما استعظم عمرُ رضي الله عنه صلاةَ النبي عليها وهي التي زَنَتْ، فقال: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال عليه السلام: (لقد تابت توبةً لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدتَ توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟)([20]).
ومن صور الجزاء عن إيقاع الضرر الأدبي في الإسلام التوبيخ والتقريع والإغلاظ بالكلام، ومن ذلك ما روى أبو ذر رضي الله عنه أنه سابّ رجلاً فعيَّره بأمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعيرتَه بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية)([21]).
المقصود بردِّ الاعتبار هو إرجاعُ الكرامة واستعادةُ المكانة في الحياة الاجتماعية، فكان تشريع الحدود والأحكام التي تمنع إلحاق الأذى بالغير ضامنًا لهذا الغرض، محققًا لتلك المقاصد
وقد ورد في القرآن والسنة نماذجُ عدَّةٌ لصور ردِّ الاعتبار، تنوَّعت بين مواساة المتضرِّر مرةً، وإنزال العقاب بصاحب الضرر أخرى.
فمن ذلك:
التعويض عن ضرر القذف:
والمراد بالقذف: الرميُ والاتِّهام بالزنا، وهو عينُ الضرر والأذى النفسي والمعنوي؛ إذ فيه تدنيسٌ للشرف واتِّهامٌ للعِرض، وإلصاقٌ للمذلَّة والمهانة لمن رُمي واتُّهم بذلك.
ومن أوضح صور الجزاء عن إيقاع الضرر الأدبي: “الجزاء بالجلد كما في حدِّ القذف، فإنَّ القاذف يجبُ عليه حدُّ القذف بشروطٍ لما سبَّبه من إيذاءٍ أدبيٍّ ومعنويٍّ للمقذوف وغيره”([22]).
وقد شرعه الإِسلام جزاءً عن إيقاع الضرر الأدبي كغيره من الأحكام والقضايا التي كان الغرض فيها الزجرُ عن ذلك الفعل الشنيع.
ويقول ابن العربي عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 4]: “يريد: يشتُمون. واستعير له اسم الرمي لأنه إذاية بالقول؛ ولذلك قيل له: القذف”([23]).
فخطورة القذف إنما يجدها من لحق به لا من صدر عنه، فجرح اللسان لا يقل ضررًا وخطرًا عن جرح اليد، بل قد يفوقه، وفي هذا المعنى يقول الحمدوني:
جراحات السنان لها التآم *** ولا يلتام ما جرح اللسان
فلا شكَّ أنَّ الجلد عقوبةٌ بدنيةٌ حِسِّية، وردُّ الشهادةِ وعدمُ اعتبارِها واستبعادُه عن المشاركة في مظهرٍ من مظاهر الحياة الاجتماعية والحقوق الدينية عقوبةٌ معنوية.
لأنَّ الإسلام ينظر إلى الأعراض بالتكريم والتنزيه؛ فلا يجوز مسُّها وقربُها بسوء، فمن استطاع أن يدفع عن عِرض غيره سوءًا دفع، ومن لم يستطع سَكَتَ وحاد وامتنع.
مشروعية الدية في القتل الخطأ:
وهي عبارةٌ عن المال الواجب في قتل النفسفع إلى أولياء المجني عليه بسبب تلك الجناية.
وقد أوجب الله على عَصَبة من قَتل قتلاً خطأً ديةَ القتل، تؤدَّى لأهل القتيل تعويضًا عن الضرر الذي أحدثه القاتل، إلا أن يُبرِئ أولياءُ الهالك عَصَبَةَ القاتل من الدية ويتصدَّقوا بها ويُعطوهم إياها. قال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
قال ابن العربي: “المسألة السابعة: “وديةٌ مسلَّمةٌ إلى أهله” أوجب الله تعالى الدية في قتل الخطأ جبراً”([24]).
فقوله: “جبرًا” يقتضي أمرين:
أنَّ الدية تجبُرُ التقصير الحاصل من لدن القاتل الذي أدى إلى إزهاق نفسِ غيره خطأ.
وأنَّ دفعَ الدية من طرفِ عاقلةِ القاتلِ الغرضُ منه جبرُ الضرر الذي لحقَ بأهلِ الهالك جرَّاء هلاكه عن طريق الخطأ، ومواساتُهم في الفقد.
وكِلاهُما يتحقَّق عبر دفع المتسبِّب في الهلاك وأهله الديةَ لأهل الميت خطأً، فالجبرُ حاصلٌ للمحلَّين معًا، فالدية كما وجبت زجرًا عن التقصير، فإنها وجبت جبرًا للضرر والخطأ ومواساة أهل القتيل مواساةً محضةً كما أفهمه كلام العلامة ابن العربي قبل.
وينبغي أن يعلم أن التعويض ليس الغرض منه مجرَّد إحلال مالٍ محلَّ آخر، بل يدخُلُ في الغَرَض منه بالدرجة الأولى المواساةُ، إن لم تكن المماثَلَة، كالدية والأرش، فليس أحدهما عوضًا عن مال ولا عما يُقوَّمُ بمال.
وفي التفسير الوسيط: “والتعبير عن أداء (الدين)([25]) بقوله: ﴿مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ يومئ إلى وجوب حُسن الأداء بأن تسلَّم هذه الدية إلى أُسرة القتيل بكل سماحةٍ ولطفٍ جبرًا لخاطرها عما أصابها”([26]).
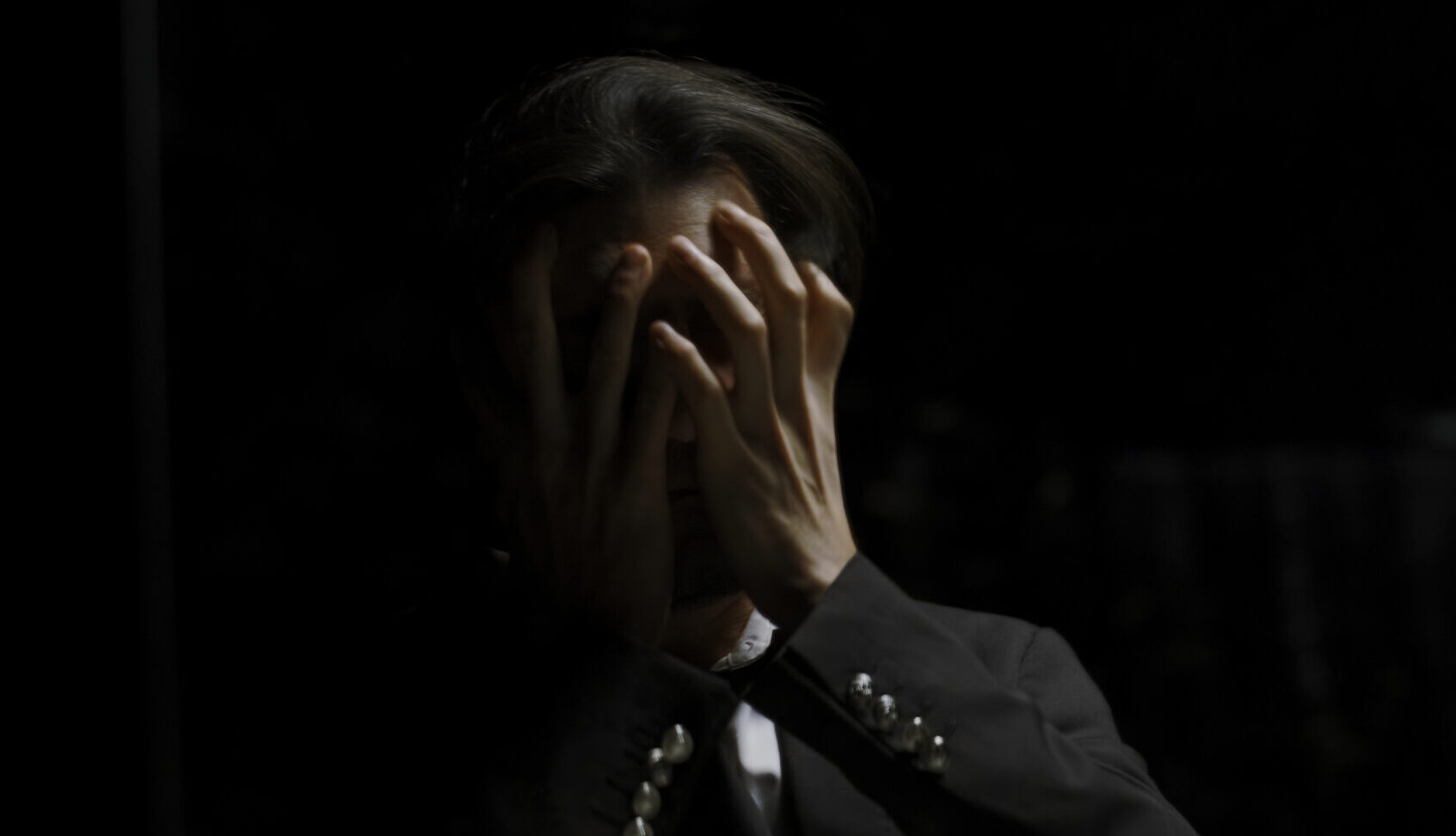
فمتى وجدوا من أنفسهم قوةً على التحمُّل للضرر ومواساةَ أنفُسهم وآثروا التصدُّق بالدية كان لهم ذلك.
يقول مؤلف الفقه المنهجي على مذهب الشافعي: “…لأنَّ الله تعالى شرعَها حقًا للعبد، وتسويةً للعلاقات الإنسانية أن لا يتهدَّدها الضغائن والأحقاد، فإذا عفا صاحب الحق عن حقه؛ فذلك هو الأفضل”([27]).
يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه: “والتصدُّق: الإعطاء. يعني إلا أن يبرئ الأولياءُ ورثةُ المقتولِ القاتلينَ مما أوجب الله لهم من الدية عليهم… -ويضيف- وأما الكفَّارة التي هي لله تعالى فلا تسقُطُ بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصًا في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه، وإنما تسقط الدية التي هي حق لهم”([28]).
ولما كان في علم الله تعالى أن الاتصاف بتلك الصفات الحميدة ليست في مقدور كل البشر، وليس كل عباده مؤهلاً لتحققها فيه لموانع تمنعهم من ذلك ولمرض في قلبهم وضعف في أنفسهم؛ كالأنا وحب الذات وغياب مبدأ الأخوة والرحمة والشعور بالآخر، أوجب الله تعالى بعضَ ما يمكن أن تنجبر به القلوب، وترمم به العواطف، وتتسوى به العلاقات الإنسانية ولا تتقوض.
خاتمة:
إنَّ الشريعة وإنْ صانت الأعراض والأنفس، فإنها قد حفظت على أهلها مشاعرهم وعواطفهم من الانكسار، ومنعت كل ما من شأنه أن يعرضها للانفطار، وحريٌّ بها ذلك!
فهي شريعة الرحمة والعدل، رحمةٌ كلُّها وعدلٌ كلُّها.
يقول ابن قيم الجوزية: “… فإن الشَّريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالحُ كلها…”([29]).
وإنه مما يأباه العقل الصحيح ويرفضه الفكر الرجيح اجتماع الرحمة والعدل مع الضرر، لذلك كان أساس الشريعة الإسلامية نفي الخوف والحزن والأسى، شريعة يستحق فيها الجنةَ مَن سقى كلبًا، فكيف بمن صان قلبًا؟
إنَّ الشريعة وإنْ صانت الأعراض والأنفس، فإنها قد حفظت على أهلها مشاعرهم وعواطفهم من الانكسار، ومنعت كل ما من شأنه أن يعرضها للانفطار، وحريٌّ بها ذلك!
يوسف العزوزي
باحث في الدراسات الفقهية والقضايا الشرعية – المغرب.
([1]) أخرجه الدارقطني في سننه (3079).
([2]) لسان العرب، لابن منظور (9/33).
([3]) تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي، لعبد الله معتصر، ص (86).
([4]) الضرر في الفقه الإسلامي، للدكتور أحمد موافي (1/97).
([5]) نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، لمحمد فوزي فيض الله، ص (92).
([6]) المعاملات المالية المعاصرة، لدبيان بن محمد الدبيان، ص (483).
([7]) أخرجه أبو داود (3635) والترمذي (1940).
([8]) المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية، لمحمود شلتوت، ص (35).
([9] ) المذكرة الايضاحية لإبراهيم أبو رحمه.
([10]) ينظر: الفعل الضار، للدكتور مصطفى الزرقا، ص (121).
([11]) البهجة في شرح التحفة، للتسولي (1/458).
([12]) الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي (7/289).
([13]) الفواكه الدواني، للعلامة النفراوي (2/56).
([14]) الاستذكار، لابن عبد البر (6/120).
([15]) صفوة التفاسير، للصابوني (1/128).
([16]) أحكام القرآن، لابن العربي (1/291).
([17]) أحكام القرآن، لابن الفَرَس (1/358).
([18]) المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي (5/612).
([22]) الفقه الميسر، للدكتور عبد الله الطيار (10/31).
([23]) أحكام القرآن، لابن العربي (3/340).
([25]) لعل المقصود: الدية، بدل الدين.
([26]) التفسير الوسيط للقرآن الكريم، لمحمد طنطاوي (3/258).
([27]) الفقه المنهجي على مذهب الشافعي، مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (8/41).
([29]) إِعلام الموقعين، لابن القيم (1/41).








