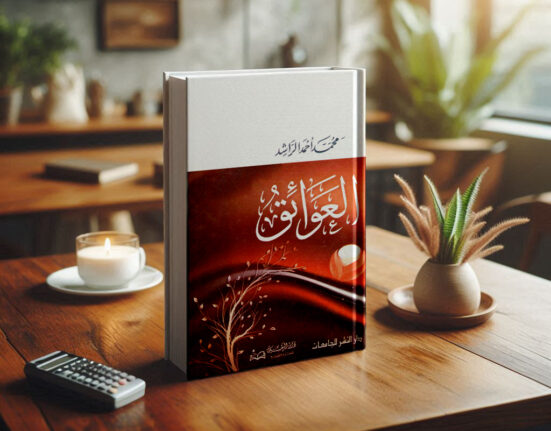تدعو المقالة إلى تحطيم وهم العجز الذي يسيطر على بعض النفوس، مؤكدةً إمكانية تغيير الواقع باتباع القواعد الربانية للعمل والإصلاح، ويؤكد المقال على ضرورة البدء بتغيير النفس، إذ لا يتحقق التغيير الأممي إلا بصلاح الأفراد، كما يشدد على التوازن بين تحمل المسؤولية الفردية، وتفويض ما لا يمكن تغييره لله، فالنجاح يتطلب إيمانًا صادقًا، وعملاً جادًا، وابتعادًا عن التراخي والانهزام.
هل تغيير العالم ممكن؟
من الحيل النفسية التي استقرّت بها الغَلبَة الظاهرة لأهل الباطل: إيهام الأمة المسلمة أنها بمجموعها لا تقدر على نصرة ولا نهضة لأنها لا تملك زمام السلطة الفردية أو الدولية، ولا تقوم لإرادتها قائمة في وجه إرادات الأجندات العالمية التي تدير كواليس الحكم. وهذه الغلبة الظاهرة لأهل الباطل واقعة لا نكران لها، لكن يظل هذا الحال مهما طال -وقد طال- واستتب حالاً طارئًا معوجًّا من حيث مخالفته لما يحب الله تعالى من عباده المسلمين ويرضاه ويريده منهم. ويظل بالإمكان تغييره حقيقة لا مجازًا، وواقعيًّا لا خيالاً.
كيف ذلك؟
إذا نظرنا إلى الآيتين اللتين أرستا قانون التغيير الإلهي:
- {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11].
- {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأنفال: 53].
نجد أن سياقهما جاء من جهة واحدة؛ وهي أن العبد عندما يغير حاله من طاعة لمعصية يعرّض نفسه لزوال نعمة من نعم الدنيا عليه.
لكن حصر زوال النعم في النعم المادية الملموسة فهم قاصر لأمرين:
- فمن جهة: مقصود النعمة في التصور الشرعي هو كل ما يعين في حفظ دين المرء وقيامه به من منافع الدنيا والآخرة، وليس النعم المادية فحسب. ولهذا يمكن -بل ويقع- أن يبتلى مؤمن طائع بنقص في نعمة دنيوية، فيُنعِم الله عليه بتثبيته وحفظ دينه، ويجعل نقصه الدنيوي ذاك رفعة له وزيادة في النعمة الكبرى التي لا تعدلها نعمة في الدارين، وهي نعمة الإيمان التي يَسْلَم بها العبد من العذاب الخالد في الآخرة. فهذا لا يُقال إنه عوقب بنقص في النعم مع أنه طائع، بل امتحانه ذاك رفعة له حقيقة وتزكية وتطهير: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة)[1].
وكذلك ثبت أن المصائب قد تنزل بذنوب المجموع لا الأفراد، فمعلوم ما أصاب جمع المسلمين يوم أُحُد إثر مخالفة جماعة الرُّماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن السيدة زينب بنت جحش عليها الرضوان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يومًا فزعًا يقول: (لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فُتح اليوم مِن ردم يأجوج ومأجوج مثلُ هذه)، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم، إذا كثر الخبث)[2]. ولا تعارض بين كون كل مؤمن محاسبًا وحده في الآخرة، وإمكان عموم البلاء في الدنيا. ففي حديث آخر: (إذا أنزل الله بقوم عذابًا، أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم)[3]. وجاء في شرح الحديث في “فتح الباري”: “والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته…، ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة؛ لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يُعِنْهُم ولم يرضَ بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم، ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع في الخروج من ديار ثمود”[4].
- ومن جهة أخرى: فالتغيير من حال المعصية والتفريط إلى حال الطاعة وحُسن الامتثال ممكن، بل واقع على المستوى الفردي والأممي معًا. ومن ثم فتغيير حال الأمة بصلاحها على المستوى الفردي وتَبَعًا الجماعي، وترقيتها من وضع الاستضعاف والمغلوبية للإعزاز والغلبة ممكن بأمر الله تعالى قطعًا، وعلى ذلك دلّت النصوص، ومنها قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} [النور: 55].
لله الأمر كله:
وأما ما يتمّ تهويله من هيمنة نظام عالمي متجبّر، وخيوط خفية متحكمة، وسلطات غالبة، وأن كل ما يقع إنما هو بتدبيرهم أو بتخطيط منهم… فأمره هيّن على الحقيقة. ذلك أن المُلك كله لله وحده حقيقة وحقًّا، ومقاليد الأمور كلها بيد الله تعالى رأسًا، والأرض لله تعالى وحده يورثها من يشاء متى شاء، والله تعالى هو الذي يؤتي المُلك وهو الذي يَنزِعه، ويَرفع أقوامًا ويضع آخرين؛ فلا حكم ولا سلطان يقوم بذاته، وإنما مشيئة الله تعالى هي التي تجري بقيام الملك أو السلطان لأجل مسمّى عند الله تعالى، كما تقضي باندثاره في أجل مسمّى عند الله تعالى. وهو تعالى قادر أن يقلب موازين الوجود القائمة في أقل من طَرفة عين، وأن يخسف الأرض بمن عليها ويأتي بأقوام آخرين، وأن يهدّ الدنيا برمّتها ويقيم القيامة ذاتها! {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40].
كل ما كان مستقرًّا من حضارات هي اليوم أثر بعد عين، وكذلك ما نراه اليوم من حضارات مستقرة أتى عليها زمان ولم تكن أصلاً. وكل طغيان نظنه راسخًا ضاربًا بجذوره في الأرض قد سبقه ما بدا أعظم منه فزُلزِل وزال. فالأيام دُوَل، والسماوات والأرض مطويات بيد خالقهما الواحد القهار، الذي له الملك والملكوت والعزة والجبروت: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}
ومن ثم، على المؤمن بالله تعالى ألا يخلط بين المُجريات عند مقام الرب تبارك وتعالى، والمجريات في جهته هو بوصفه عبدًا. فمن جهته يأخذ بما عليه من أسباب محتسبًا صابرًا، ويوقن بمعيّة الله تعالى الذي يسمع ويرى ولا يعزُب عنه مثقال ذرة، ويوقن بكمال قدرته تعالى وعظيم مشيئته وحكمته دون ريب أو شك. ثم يَكِل أمر الله تعالى إليه وحده سبحانه، فالله تعالى أعلم متى وأنى وكيف يكون النصر وقلب موازين الغالبية والمغلوبية. وإذا كانت هذه قدرة الله وهذه حكمته وهذا تدبيره.. فما للمؤمن ينظر للموازين الأرضية الحالية باستعظام واستهوال يجعله يستصغر مسؤوليته وطاقاته، ويستبعد نصر الله تعالى وإعلاء مقام أمة الإسلام فوق الأمم؟!
استبطاء النصر:
وقد ضرب الله تعالى لنا مثالاً في القرآن الكريم عن أمة كانت مستضعفة وعالقة في دوامة السخرة والخدمة، وتتعرض للبطش والقتل دون مانع أو رادع، فهيأ لهم من الأسباب والأحداث ما كان كفيلاً بقلب حالهم، قال تعالى في آيتين متتاليتين: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ} [القصص: 4-5]، وتابعت بعدها آيات سورة القصص في وصف الترتيبات الإلهية من ولادة موسى عليه السلام في هذا الظرف العصيب، وكيف أوحى لأمه أن تلقيه في اليم، ثم كيف التقطه آل فرعون ووقع في قلب امرأة فرعون حب هذا الصبي، وكيف نشأ بعدها معززًا مكرمًا، حتى وقع ما وقع من قتله للقبطي، ثم هروبه إلى مدين وعودته منها نبيًا رسولاً.
وبعد مدة من المعاناة تذمّر بنو إسرائيل، واستبطؤوا نصر الله تعالى، خاصة لِمَا ظهر لبصرهم القاصر مِن أنّ الحال لم يعتدل حتى بعد بعث سيدنا موسى عليه السلام، فكان الردّ عليهم في ذلك الزمان هو الردّ في كل زمان على كل متذمّر بنفس العقلية: {قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 128 قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 128-129].
وكان النصر المبين تدبيرًا خالصًا من الله تعالى يوم أن اكتمل اليأس عند بني إسرائيل فقالوا لموسى عليه السلام: {إِنَّا لَمُدْرَكُونَ} [الشعراء: 61]، فأغرق الله فرعون وجنوده في حدث إلهي معجز.
الحاصل أن الله تعالى قادر لا ريب على إبدال موازين النصر والهزيمة في أقل من طرفة عين، لكن محلّ الامتحان في هذه الدنيا ليس قدرة الله تعالى ولا مشيئته ولا تدبيره، وإنما العبد هو محل الامتحان من الله تعالى: صبره ومصابرته ويقينه في وعد ربه تبارك وتعالى وثباته على الحق حتى يلقى الحق تعالى مُقبلاً غير مُدبِر.
ما عليك وما عليك:
بناء على ما سبق، بدل كثرة انشغالنا بسؤال “متى يكون النصر؟”، فليكن تفكّرنا وعملنا موجّهًا لجواب: “ما المطلوب منا؟” وأول المطلوب التمييز بين ما عليك، وما عليك! أي التمييز بين ما الذي تستطيعه فتقوم عليك مسؤولية القيام به (ما يقوم عليك)، وما ليس عليك أن تحمل همه مما ليس بيدك أصلاً التدخل فيه (فما عليك منه بأس)، كما فيمن يشعر بالذنب لكونه لا يعايش الابتلاء بنفسه مع المبتلين أو لكونه في سعة وهُم في ضيق، فهذا الشعور موجّه للوجهة الخاطئة وإن كان في أصله طيبًا. ذلك أنك لستَ مطالبًا أن تعيش كالمُبتلى لتكون مناصرًا له، بل ما دمت عوفيت فأنت مطالب أن تعيش كالمعافى وتتصرف كالمعافى، بأن تكفّ عن التمارض والتعلل والتحجج بأعذار الخذلان والتخاذل، وتتعبد بما آتاك الله تعالى على ما تستطيع.
البطولة التي نحتاجها:
ثم المطلوب أن يصيب كل مسلم من معاني “البطولة” ما يستطيع. ولفظة البطولة هذه مما كثر استعمالها في أدبيات التحفيز والتنمية، بمعانٍ مستوردة من الثقافة الغربية، ألصقت بها هالات خرافية، صوّرت البطل بوصفه نجمًا خارقًا يأتي بمعجزات تغيّر الواقع في لحظة. ومع هذه الصورة، انتشرت ثقافة النجومية والجماهيرية والتنافس على الصدارة والشهرة. وعندما امتزجت هذه التصورات مع المفاهيم الإسلامية في الوعي السطحي، اختلطت الحدود بين السمعة الطيبة والرياء، مما أدى إلى اختلال موازين الأعمال وغياب التوازن بين تقدير الجهود الكبيرة والصغيرة وفق معايير الشهرة والوجاهة. هذا التداخل أثّر في النفوس، فجعلها تتعجل النصر وتستثقل البلاء ويضعف صبرها.
والحق أن الإسلام قائم على البطولة بالمعاني العربية الأصيلة؛ فالبطولة في الإسلام تقوم على إبطال المسلم للباطل وإحقاقه للحق في نفسه أولاً، ثم سعيه في إحقاقه على النطاق الأوسع خارج نفسه بحسب الاستطاعة وما يقيمه الله تعالى فيه من ثغرات وما يجعل له من قبول. وقد شرط الله تعالى وراثة الأرض بالتقوى، التي يمثلها عمليًّا الصلاح والإصلاح معًا: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} [الأنبياء: 105].
وإذن، البطولة التي نحتاجها معشر المسلمين هي أن نؤمن بما أعزّنا الله به من حقٍ صادقَ الإيمان، ونعقله صادق العقل، ونتوقف عن الاشتغال بالنعي على أهل الباطل تداولهم للباطل بأشد الحق، ونلتفت لمعايبة أنفسنا على أخذنا للحق بمنتهى الباطل.
كان من كلام علي رضي الله عنه في خطبته المشهورة: “فيا عَجَبًا من جِدّ هؤلاء القوم في باطلهم، وفشلكم عن حقكم! فقُبحًا لكم وتَرَحًا، حين صرتم هدفًا يُرمى، وفَيئًا يُنتهب، يُغار عليكم ولا تُغيرون، وتُغزَون ولا تَغزُون، ويُعصَى الله وترضون!”
البيان والتبيين للجاحظ
هل أنا من سيعدل المائل؟
ما أكثر ما سمعت تعقيبًا في معرض كلامي عن مسؤولية الفرد المسلم في الصلاح الفردي والإصلاح الأممي على السواء، قول القائل:
- أأنا من سيعدل المائل؟
والرد عليها:
- المطلوب ألا تكون أنت مائلاً! المطلوب منك: عدّل نفسك أنت، ثم من يليك ممن تتحمّل مسؤوليتهم في دائرتك أنت، المهم ألا نفقد الأمل وأن نواصل العمل لما نستطيع، ونترك ما لا نستطيع من التدبير لله تعالى.
هلّا قمنا بما علينا أولاً حق القيام، فُرادى وجماعات، ثم رأينا ما يصنع الله تعالى بنا بعد أن غيّرنا ما بأنفسنا ليوافق مراده منا؟!
ختامًا:
القاعدة الربانية التي لا تتخلف هي أن سعي كل امرئ سوف يُرى ويجازى يوم يُوقف أمام رب العالمين، ولا يَظلِم ربنا مثقال ذرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فليس عليك من حساب الناس من شيء، هذا بينهم وبين الله تعالى، وإنما عليك نفسك أنت، بمعنى عليك أن تجتهد في القيام بكل ما يمكنك القيام به، وليس المقصود بها أن تنشغل بمصالحك وتلبية حاجاتك، وتصمّ آذانك عن أحوال الأمة وتلبية نداء الغوث حيث أمكنك! كيف و(ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع)[5].
علينا معشر المؤمنين أن نتحلى بأدب العبودية في التسليم لحكمة الله ومشيئته في خلقه وتدبيره. وبدلاً من التشاغل بالتلاوم وتبادل الاتهامات وتصيّد أخطاء الآخرين وصرف الطاقة فيما لا يد لنا فيه ولا قدرة على تغييره، فلننظر لما في أيدينا من نعم ونشكر الله عليها، ولما نجهلهه من أمور ديننا فلنتعلمها، ولما ينقصنا من علوم ومهارات فلنستكملها لنقدر على الانتفاع والنفع معًا.
فلنقم بواجب كل وقت في حينه، مستحضرين قوله تعالى: {وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ} [العنكبوت: 6]؛ ثم نَكِل الأمر لذي الأمر كله، والله تعالى حَسْبُ كل مؤمن، وحسيبه.
هدى عبد الرحمن النمر
كاتبة ومؤلّفة ومتحدِّثة في الفكر والأدب وعُمران الذات
[1] أخرجه الترمذي (2399).
[2] أخرجه البخاري (7135).
[3] أخرجه البخاري (7108).
[4] فتح الباري (13/61).
[5] أخرجه البخاري في الأدب المفرد (112).