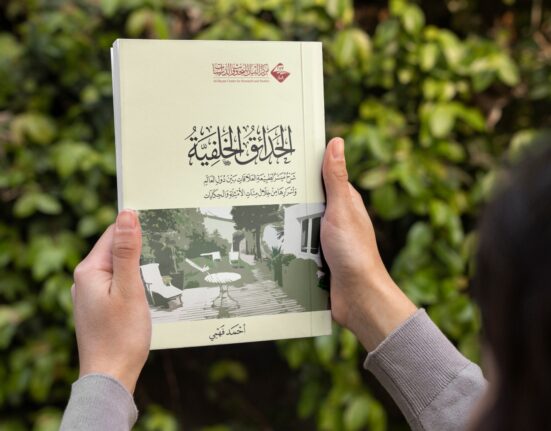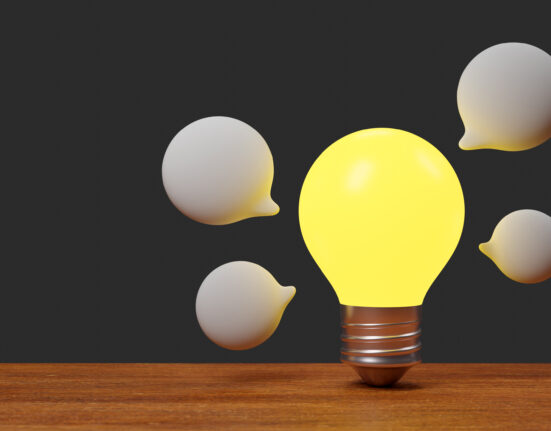يعرض المقال كيف واجه الخطابُ القرآنيُّ البنيةَ الجاهليةَ في جذورها، فهدمَ قداسةَ الموروث، ونقضَ التلقي المقلِّد، وحرّر العقل من سلطان العصبية والمال والنسب؛ ليؤسّسَ ميزانًا جديدًا يقوم على الهداية والتقوى والعمل. ويبيّن كيف أعاد القرآن تشكيل الوعي الإنساني، وبناء منظومة معرفية تُواجه الجاهليات القديمة والمعاصرة، وتردّ الإنسان إلى مصدره العُلوي وغاية وجوده بمنهجٍ يوازن بين العقل والوحي.
أيُّ دعوةٍ جديدة تهدف إلى التغيير في المجتمع تُقابَل بالصَّد؛ لأنها تحملُ في طيَّاتها ثنائية التفكيك والتَّأسيس، وتنقضُ بنية التلقي في ثلاثةِ مستويات متشابكة: خطابٍ سائدٍ تشكَّل من تراكم العادات والتقاليد يسري في الوعي اليومي للناس بلا نقد ولا تمحيص، ومتلقٍّ متماهٍ مع الأفكار التي تسكن وجدانه وضميره، وبيئةٍ حاضنةٍ تُغذِّي هذه المنظومة وتعيد إنتاجها.
وأمامَ هذا المركَّب لا تملكُ الدعوة الجديدة إلا أن تزيح هذه البنية أو تُهذِّبها أو تنتقي منها ما يُعاد بناؤه وَفْقَ أسسٍ نابعة من الفكرةِ البديلة، وهذا ما صنَعَهُ القرآن الكريم في تعامله المبكِّر مع الرؤيةِ القرشية وسادتها، باعتبارهم التجسيد الأوضح لثقافةِ الجاهلية في أوجها. فالعقلُ لا يُصاغُ في فراغ، ولا تتشكَّلُ الأممُ من فرادةِ التجرِبة فقط، وإنما من طرازِ الفكر الذي يسكنها، ومن الوجهةِ التي تنظر منها إلى الوجودِ والمصير.
حينَ أطلَّ الخطابُ القرآني على مشهدِ الجاهلية لم يتوجه إلى السلوك المجرَّد، وإنما اخترقَ التركيبة الذهنية التي تصنعُ هذا السلوك، وأعادَ تأسيس الإنسان من الداخل، لم يأتِ الخطاب القرآني مكرِّرًا لصدى قائم، وإنما تجلى على الوعيِ البشري بمقاييس جديدة من التفكير، لبناءِ نظامٍ معرفيٍّ يُبصر الإنسان من حيث لم يكن يرى، ويهديه إلى ما لا تصله خطاه وحدها، وقد نَهَضَ الكتاب الإلهي ليعالجَ ما استقرَّ في الوجدان من أوهامٍ مقدّسة، ويُقيم مكانها نَسَقًا من التوحيدِ يحرِّرُ الإنسان من كلِّ هيمنةٍ لا تليقُ إلا بالله، وعَزَّز ما يحتاجُ إلى اكتمالٍ وبناء ليخرج من دائرةِ الفعل المجرَّد المعتاد إلى فضاء المعنى القيمي، وبذا سار النص القرآني في هدمِ البنى المستحكمة!
نهج القرآن مع الجاهلية:
لم يكن صِراع الإسلام مع عاداتٍ اجتماعية منعزلة، وإنما مع أنساقٍ فكرية شاملة تحدِّدُ طريقة النظر إلى الكون والإنسان والحق والقيمة، ولذا جاءت آيات القرآن الكريم تُقوِّضُ هذه الأنساق بالحجة والبرهان والنظر، وتبني بدلاً عنها نماذج تفكير جديدة، تُخرج الإنسان من سطوةِ الأرض إلى أُفقِ الوحي.
وليسَ المقصود بهدْمِ البِنية الجاهلية هجاء العرب أو تسفيه إرثهم؛ فهُم -على ما كانَ فيهم من خطأٍ وانحراف- أمةٌ اختزنت من مكارمِ الطباع، والشمائل الحميدة، وصفاء الفطرة، ما جعلها أهلاً لتلقِّي رسالة السماء، واحتضان خطاب النبوة، فكانوا أهل نخوةٍ ووفاء، وشجاعةٍ وسماحة، وبلاغةٍ تصقل الذِّهن، وتفتح القلب للبيان، حتى إذا جاءهم الوحي لم يأتِ ليجتثَّهم من جذورهم، وإنما ليهذِّبَ ما اعتدل، ويقوِّمَ ما اعوج، ويبني على النبيل من خصالهم، ويطهِّرهم من أدران الوثنية والعصبية والظلم، “كانوا خلاصةً في الإنسانية، صهرتهم شمسُ الصحراءِ فلم تبقِ إلا عروق الرُّجولة الحق وخطوطها”[1]. فجاءَ القرآنُ يصفِّي معدنهم من شوائبِ الجاهلية، ويصوغ من معدنهم الأصيل رجالاً تليقُ بهم قيادة العالم، بعد أن نُفِضَت عنهم غشاوة الجاهلية، ونُفخ فيهم من روح الوحي ما جعلهم أعظم أمةٍ خرجت من أصلابِ الأرض.
نقض منهج التلقي غير النقدي:
إنَّ المتتبع لسياقاتِ القرآن في الرد على حُججِ المعاندين، سيجد أنَّ النُّخبة القرشية المعارضة لنهج السماء كانت تتعذَّر بتقديسِ الآباء والماضي بوصفه مرجعًا نهائيًا، ولهذا تصوروا أنَّ الحقَّ هو ما وافقَ سيرة الأجداد، ورأوا أنَّ التقاليد التي نشؤوا في ظلالها حُجة في ذاتها، لا تُراجَع، بل تُسلَّم وتُكَرَّر، وهذا نَمَطٌ سائدٌ يحتمي به كل من أوغلَ النبيُّ في دعوتهم للإقبالِ على دعوةِ التوحيد بقلبٍ لا يشوبه كدر التقديس للآباء، وقيود الماضي، ولذا جاء القرآن مميّزًا بينَ الموروث الحق والموروث الباطل، فنزَعَ صفة القداسة عن التقاليد، وحوَّلها من مسلَّمات إلى مواد للفحص، وعرضها للنقد، وأتاحَ للعقلِ النظرَ فيها بعيدًا عن سياجِ القداسة المضروبة حولها، فكرَّرَ القرآن قولهم: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} [الزخرف: 23]، ليبين منهج التلقي غير النقدي، ثمَّ يأتي السؤال الكاشِف: {أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ} [الزخرف: 24]، لإثبات أنَّ معيار الصحة هو الهداية والبصيرة لا الأسبقية، فالقرآن استبدلَ العقل التكراري بالعقلِ التمييزي الناقد، الذي لا يُسلِّمُ إلا لما قامَ عليه الدليل، ولو خالفَ المعتاد، “ولـمَّا أبوا إلا إلف وهادِ التقليد فدنوا عن السُّمو إلى عدادِ أولي العلم بالنظر السديد؛ أنكر عليهم سبحانه وتعالى ذلك فقالَ مبكتًا لهم: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة: 170]، {أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [المائدة: 104]”[2]، وللزمخشري قولٌ بديعٌ في توجيه الضمير (لهم) فقد صرفه إلى الناس، وعَدَلَ بالخطابِ عنهم على طريقةِ الالتفات للنِّداء على ضلالهم؛ لأنَّه لا ضالَّ أضلُّ من المقلد، كأنه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يقولون[3].
القرآن استبدلَ العقل التكراري بالعقلِ التمييزي الناقد، الذي لا يُسلِّمُ إلا لما قامَ عليه الدليل، ولو خالفَ المعتاد.
تفكيك الأساس العصبوي الجاهلي:
لقد كانت دعوة القرآن الكريم إلى العرب دعوة تريدهم أن ينخلعوا عن معتقدات وعادات باطلة تمكنت من نفوسهم، وسكنت في قلوبهم، والعرب بخاصة أحرص الناس على مألوف التقاليد والعادات، وأشدهم حفاظًا على موروثِ الآباء والأجداد، لا ينخلعونَ عن تقليد من تقاليدهم إلا إذا انخلعت عنهم الحياة، ولا يتخلون عن عادة من عاداتهم إلا إذا تخلت عنهم أرواحهم التي تسكن كيانهم[4].
فقد أتى النص القرآني ليُحرِّر الإنسانَ من سطوةِ “الأثر” إذا لم يكن على “بصيرة”، ويقيم ميزان الهداية على أساسِ الدليل والتمييز والنظر، لا على أساسِ القِدَم أو الكثرة، فالهُدى ليس ما كان عليه السالفُ إن لم يكن الحقُّ معهم، والاتباعُ الحق هو اتباع ما يهدي إلى الله ولو خالف الناس أجمعين، {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3].
وامتدادًا لهذا التحرير القرآني من سطوةِ الأثر، لم يكتفِ الخطاب الإلهيُّ بنقضِ منهج التلقي غير النقدي، وإنما تجاوزَ ذلكَ إلى هدم الأساس العصبوي الذي كانت تُبنى عليه الكرامات، وتُوزن به الأقدار، فأزاح التصور الجاهلي الذي يستمدُّ فيه الفرد قيمته من القبيلة، ويرتهنُ فيه المعنى بالموروث، وتُسبغ فيه القداسة على السُّلالة والنسَب والمقام المجتمعي، كبيت دريد بن الصمَّة:
وهل أنا إلا من غَزِيَّةَ إنْ غوت *** غويت وإن ترشد غزية أرشد
أتى النص القرآني ليُحرِّر الإنسانَ من سطوةِ “الأثر” إذا لم يكن على “بصيرة”، ويقيم ميزان الهداية على أساسِ الدليل والتمييز والنظر، لا على أساسِ القِدَم أو الكثرة.
تأسيس البدائل المعرفية:
لقد كانَ العقلُ العربي يرى أنَّ الكرامةَ موروثة، والحقّ مرهونٌ بمن علا نسبه، وعظم جاهه، وساد قومه، فالقبيلة كانت معبودةً؛ يُضحَّى من أجلها، ويُفنى فيها، وتُطاع طاعة العابدِ لمعبوده، وتُقاتل الأمم لتمجيدِ اسمها، ويُغضُّ الطَّرف عن ظلمها وجور أبنائها باسمِ “العُزوة” و”اللُّحمة” و”الفداء”.
لكن القرآن الكريم جاء بمبدأ جديد في تغيير قيمة الأشياء ومعانيها، فالكرامة أضحت قائمة على التقوى والعمل لا على السُّلالة والنسب والجاه: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، فبطل افتخار المتفاخرين بسلالةٍ أو موطن أو جاهٍ عشائري على أنه مصدر الحق، وإذا بالبشر كلهم سواءٌ على بساطِ الخلقِ الأول، لا يتمايزونَ إلا بما يحملونه من تقوى، وما يقدِّمونه من عمل، وما تنطوي عليه سرائرهم من إخلاص، بل وأعاد توظيف القبيلة ليحول همَّها من حمايةِ الفرد إلى حمايةِ الرسالة، فأعاد لها مكانتها في ضوءِ المنهجِ الإلهيِّ العادل.
وبذا نكتشف أنَّ القرآن نقلَ معيار الكرامة من النسب العالي والجاه والمال الوفير، إلى “التقوى”، لقد غيَّرَ المعيار من اللامستطاع إلى المستطاع؛ لأنَّ التقوى قيمة خلقية وليست وظيفة أو مهنة، ما يعني أنها لا تعيق أحدًا من الاتجاه إلى ما يُحسن أو إلى ما يحب، فكل ينافس في تحصيل التقوى من حيث يحسن أو من حيث يحب، كما أنَّ التقوى لا تتوقف على حسَبٍ أو نسَب أو صفاتٍ جسدية، أو وفرة في المال، بمعنى أنَّ الكل يستطيع تحصيلها والمنافسة فيها، بل وألغيت كل اعتبارات الدَّم عند لحظةِ الميزان الحقيقي في الآخرة: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101]. فكأنَّ القرآن يقول: كل ما عظمتموه في الدنيا من عصبياتٍ فانية، ونَسَبٍ موروث، فهو عند الله هباء لا يزنُ مثقال ذرَّة إن خلا من تقوى تُشرف النفس وتُحيي الضمير.
ولعلَّ مما يعضِّد هذا الفهم أنَّ القرآنَ نَزَلَ معاتبًا للنبي صلى الله عليه وسلم، لاهتمامِه بكبارِ قريش على حساب ضعافها حرصًا منه صلى الله عليه وسلم على دعوتهم ودخولهم في الإسلام لما لهم من شوكةٍ وكرامةٍ موروثة، فجاء النصُّ منتصرًا للبصيرِ المقطوع من الجاهِ الجاهلي ومن كل حفاوةٍ مجتمعية: عبدالله ابن أمِّ مكتوم رضي الله عنه، وأعطاه حقه في الدعوة والاهتمام وإن لم يكن له حَسَبٌ ولا نفوذٌ في قريش، لكنه كان مُقبلاً بقلبه، حاملاً في أعماقهِ بذرة النور، فأراد الله أن يبيِّنَ للأمة إلى يومِ الدين أنَّ ميزانه ليسَ كميزانِ البشر القائم على الموازين المادية والمقاييس الزائفة.
وضع معايير جديدة للمجتمع:
مضى التصوُّر القرآنيُّ يفكِّكُ التصورات الجاهلية الموروثة ركنًا ركنًا، وينقض بنيانها الاعتقادي والاجتماعي من أساسهِ، فلم يكتفِ بزحزحة وثنية النسب والعصبية، وإنما امتدَّ ليقوِّضَ تأليه المال والزعامة، وما يتفرَّع عنه من ازدراءِ الضعفاء واحتقارهم، وتقديم الأغنياء في مواضعِ الكرامة، وتعظيمهم في مواضعِ الرأي والمكانة.
أتى القرآن ليقلب الموازين، ويفضح ضلال هذا المعيار الأرضيِّ البائس، فقال لهم على لسانِ النبوة الهادية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [الأنفال: 28]، فالمال في ميزانِ الوحي ليسَ شرَفًا في ذاته، إنه ابتلاء وفتنةٌ، وقيمة الإنسان لا تُستمدُّ منه؛ لأنه استمدادٌ مرهونٌ ببقائه، وهو أمانة مستودعة، وميراثٌ مردود، واستحقاقه لا يسوِّغ غطرسة، ولا يُجيز ازدراءً، ولا يصنعُ فضلاً ذاتيًّا؛ لأنه امتلاكٌ مؤقَّت، مشروطٌ بالحسابِ، ومربوطٌ بالزوال.
ثمَّ أعادَ القرآن تعريف العلاقة بالمال فقال: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: 46]، وقال: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]، {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد: 7]، ليؤكد أنَّ المالَ ليس ملكًا خالصًا للعبد، وإنما هو مال الله، والعبد فيه مستخْلَفٌ ومُمتحَنٌ، يُسأل عنه: كيفَ جمعه؟ وفيما أنفقه؟
ثمَّ ارتقى التصوُّر القرآنيُّ بضَعَفةِ الناس، وجعلهم في واجهة الإسلام، وصدر الدعوة، وحملة الرسالة صفًا واحدًا مع بقية المؤمنين من ذوي المكان والجاه والنسب، لا لشيءٍ إلا لأنهم صدقوا الإيمان، وسبقوا إلى التصديق، ولم يثنهم فقرهم ولا ضعفهم عن اللحاق بركبِ الدعوةِ الجديدة، فإذا هم في طليعة المسلمين؛ لأنهم وقفوا خلفَ الحق، فوقفَ الحقُّ معهم: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الأنعام: 52]، أُمِرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبقيهم إلى جانبه، ونُهيَ عن الالتفاتِ إلى رغباتِ المتكبرين الذين اقترحوا طردهم؛ لأنَّ الكرامة في هذا الدين لا تُقاس بالهيئةِ ولا بالغنى، بل بما في القلبِ من إخلاص، وبما في السعي من صدق: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى 39 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 40 ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى} [النجم: 39-41]. وبذا، يتكشفُ للناظِر كيف أعاد القرآن تشكيل الوعي البشري من جديد، فانتزعَ منه أوهام العظمة الزائفة، وفتح له باب الكرامة الحقيقية؛ كرامة الإيمان، ورفعة الطاعة وعزها، وشرف القرب من الله.
مضى التصوّر القرآنيّ يفكّك البنية الجاهلية من جذورها؛ فبعد أن زحزح وثنية النسب والعصبية، انتقل إلى تقويض تأليه المال والزعامة، وما نتج عنهما من ازدراء الضعفاء وتعظيم الأغنياء في مواقع الكرامة والرأي.
معالجة القيم المغلوطة والتشكيك فيها منطقيًا:
ولم يقف القرآن عند هدم البنى العقلية الجاهلية في ميدان العقيدة والنسب والمال فحسب، وإنما توغَّل في تقويض منظومة القيم المغلوطة التي كانت تُزكِّي العمل المجرد عن الإيمان، وتُعلي من شأنِ الشعائر ولو قامَ بها مشركٌ بالله. وقد مثَّلت الآية: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [التوبة: 19] نقضًا صريحًا لميزانِ القوم الذي يُسوِّي بين العقيدة الفاسدة مع المظهر الجليلِ، وبين العقيدة الحقَّة والجهاد الصادق. “روى العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنَّ المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السِّقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم، ويستكبرون به، من أجل أنهم أهله وعماره، فخير الله الإيمان والجهاد مع رسوله على عمارةِ المشركين البيتَ وقيامهم على السقاية، وبين أنَّ ذلك لا ينفعهم مع الشرك، وأنهم ظالمون بشركهم، لا تغني عمارتهم شيئًا”[5]. لقد كانت الجاهلية تُقيم الشرف على خدمة الحجيج وعمارة المسجد، ولو اقترنت بالشرك والضلال، فجاء القرآن ليمحو هذا التصور، ويُقيم عوضًا عنه ميزانًا إيمانيًّا لا يعرف قداسة لعمل لا يقوم على التوحيد والإخلاص، ولا وزنًا لشرفٍ لا ينبعُ من صدق العقيدة وصفاء الوجهة، ومن ثمَّ أعاد القرآن ضبطَ المعنى، وحرَّر العقل من أسْرِ التصورات المغلوطة، وبيَّن أنَّ العمل لا يُزكِّيه تاريخه، ولا تُمجِّده الأوهام، وإنما يرفعه الإيمان، وينزله الإخلاص منزلته.
وقد وصف ديتلف نيلسن المفارقة الجذرية التي أحدثها الإسلام في مواجهته للتصورات الجاهلية المضادة لروح الدين، إذ قال: “لـمَّا جاء الإسلام وجد نفسه مضطرًّا إلى أن يخوض غمار حرب طاحنة مع الوثنية، وعلى تلكَ الحرب توقفت حياة الدين وتوفيقه، أو موته وفشله. وقد كان يقضي فيها على كلِّ أثر أو بقيَّة من بقايا الوثنية، أو التي تذكِّر بالوثنية الجاهلية. ولم يعرف علم تاريخ الأديان حربًا بين دينيْن كتلك التي عرفها الإسلام؛ فالكتاب المقدس مثلاً احتفظ بكثير من الديانات القديمة، بخلاف القرآن الكريم الذي لم يحتفظ إلا بالقليل النادر. والمسيحية ضمَّت إليها -سواء أكان ذلك في وطنها أم في الأوطان التي غزتها- كثيرًا من العادات والتقاليد الوثنية، وكانت روح الوئام بينها وبين الوثنية قوية، بخلاف الوثنية مع الإسلام. فلا يوجد دين عالمي بَغَضَ تعدُّد الآلهة، وأُغرم بالتوحيد، وتغنَّى به مثل الإسلام، ولا يوجد دين من الأديان قدَّر الله له النجاح في القضاء على الوثنية كما قدَّر للإسلام”[6]. إذن، فالإسلام دينٌ يقوِّض الهياكل الجاهلية من أصلها، ولا يستبقي منها إلا ما وافَقَ العدل والحق، واتسق مع جوهرِ الرسالة العامر، فيقره لأنَّه من بقايا النور الذي لم تطفئه ظلمات الوثنية، ولم تُفسده مواضعات الأهواء، فهو لا يصالحُ على باطل، ولا يواربُ في عقيدة، لكنه يُبقِي من الموروث ما لم يتعارض مع جوهر التوحيد، ويهدم ما خالفه دونَ تأويل ولا مصانعة، وما وافَقَ منه تصوّراته الكبرى، اعتبره من أنوارِ الفطرة الباقية التي لم تُطْفَأ، فصحَّحَ وجهتها، وكمَّلَ بناءها، وحرَّرها من قيودِ العصبيةِ والانغلاق، (إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ)[7].
الإسلام دينٌ يقوِّض الهياكل الجاهلية من أصلها، ولا يستبقي منها إلا ما وافَقَ العدل والحق، واتسق مع جوهرِ الرسالة العامر، فيقره لأنَّه من بقايا النور الذي لم تطفئه ظلمات الوثنية، ولم تُفسده مواضعات الأهواء.
المقاربة الجاهلية والحالة المعاصرة:
وإذا كنَّا بصدد الحديث عن “الأنماط الذِّهنية” التي حاربها القرآن، فإننا لا نقصرها على اللحظة التاريخية للجاهلية، وإنما ننظر إليها بنيةً فكريةً قابلةً للاستنساخ بأشكال جديدة، لأنَّ ما يعالجه القرآن لا يقتصر على الظواهر، وإنما يتجاوزها إلى “الأنساق المعرفية” التي تصوغ رؤية الإنسان للعالم، وتنظم معاني الخير والشر، والحق والباطل، والوجود والمصير.
ولذا، فإنَّ مقاربة الجاهلية بوصفها بنية أو تركيبة ذهنية لا مجرد طور زمني سابق يُجيز لنا أن نتتبع تكرارها في صور أكثر حداثة؛ إذ تتخذ اليوم لبوسًا جديدًا، لكنه يُعيد إنتاج المنطلقات ذاتها: الانفصال عن الوحي، والاستغناء عن الله، وتأليه الإنسان أو السوق أو الشهوة.
وهذه ليست مقارنة جزافية، وإنما تستند إلى أنَّ الإنسان في كلِّ عصر إذا استغنى عن الوحي عاد إلى جاهليته الخاصة، مهما اختلفت أدواته ومفاهيمه؛ لأنَّ معيار الجاهلية القرآني هو الانحراف عن التوحيد ومضامينه في الحياة.
ومن هنا فإن نقد التيارات المعاصرة لا ينبني على رفض التطور أو تحقير المختلف أو ترك الاعتزاز بالتراث أو العادات والتقاليد لمجرد القِدم، بقدر ما يبنى على محاكمة الرؤية الكامنة فيها إلى “الميزان القرآني” الذي جاء ليفكك هذه البنى، ويقيم للإنسان تصورًا متماسكًا عن ذاته ومصدره وغايته.
لم تندثر الأنماط الذهنية التي حاربها القرآن في الجاهلية، وإنما أعادت إنتاجَ نفسها في منظومات فكرية معاصرة، أكثر تعقيدًا، وأشد إغراءً، وذات نفوذٍ عالمي، وقد وقَفَ النص القرآني بوصفه مرجعية حيَّة في وجه هذه التيارات، مفككًا بِنيتها، كاشفًا زيفها، وراسمًا للإنسان أفقًا من التحررِ الحق.
فالجاهلية القديمة كانت تصوغُ الإنسان على عينِ القبيلة والموروث، والحداثة الجارفة تصوغه على عين السُّوق والهوى والإغراق في اللذَّة والاستغناء، والمآل واحد: قطع الصلة بالله، وطمس الغاية، وتفكيك المعنى، ومن هنا، وقفَ النص القرآني يتصدى لهذه التيارات لا من موقفٍ انفعاليٍّ آنيٍّ، وإنما من مقامٍ معرفي بصير، يفككها من داخلها، ويكشف زيفها، ثم يرد الإنسان إلى موضعه الحق: عبدًا حرًّا لله، مكرَّمًا بالتكليف، مصونًا بسياج الفطرة.
فالإلحاد المادي -وإن لبس ثوب العقل وزيَّن خطابه بادعاء العلمية- يتهاوى عند أول سؤال غائي، ينكر الخالق ويؤمنُ بالمصادفة، ويطلب النظام من رحم الفوضى، وينقض العقل باسم العقل، فيأتي القرآن ليفضح هذا التناقض المستكنّ بقوله: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115]، ويرد العقل إلى مداره الفطري: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس: 101]، حيث يتوقف التكرار وتبدأ العبرة. أما الرأسمالية النيوليبرالية، فقد اختزلت الإنسان، وجعلت مِعيار قيمته ما يملكه ويُراكمه من رغائب الاستهلاك، حتى صار المال هُويَّة، والسوق معبدًا، والأخلاق سلعة تفاوضية، فيأتي القرآن ليعيد التوازن، ويؤكّد -كما أكَّدَ لمن سَبَق- أنَّ المال أمانة: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد: 7]، وأنَّ العلاقات تبنى على العدل والحق: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: 85].
وأما النزعة الفردانية المتطرفة، فقد مزَّقت الإنسان من كلِّ انتماء، فلا هو عبدٌ لربه، ولا عضوٌ في أمة، بل كائنٌ منفلتٌ من كلِّ قيدٍ إلا هواه، ورغباته، وطموحه الجامح، فاستدعاه القرآن من غربته، وربطه بالله وبالعمران معًا: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 105]، فالفرد هنا فاعلٌ مسؤول، حرٌّ محكومٌ بميزان التكليف.
ثم تأتي فاجعة الشُّذوذ الـمُشرعن، بوصفه انحرافًا سلوكيًّا، وهُويّة قانونية تُربى عليها الأجيال، وتُسنُّ لها الشرائع، فجاءَ الخطاب القرآني ونظَرَ إليه كمؤشرٍ على انهيارٍ حضاريٍّ وفطري، فقال: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ 80 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [الأعراف: 80-81]، والإسراف “اعتياد المجاوزةِ للحدود”[8]، وقد وصفهم الله بالإسراف، أي تمكُّن الشهوة منهم حتى ملُّوا المألوف وطلبوا المنكر، وذلك من شأنِ من استرسل في الشهوات حتى يعجزه الاعتياد عن الشفاء منها. وسُمِّي فعلهم فاحشةً وإسرافًا لاشتماله على وجوهٍ من الفساد: إذ استُعملت الغريزة في غير موضعها، فكان اعتداءً على الفطرة، وتغييرًا لخصائص الرجولة، وامتهانًا للإنسان بجعله أداةً لشهوة غيره، مع ما فيه من قطع النسل، وإضرارٍ بالبدن والنفس، فهو انحرافٌ عن سنن الخَلق وفسادٌ في نظام الحياة[9].
ووصفَ حالهم بالجهالة لا بالخطأ العابر: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [النمل: 55]، إذ قلبوا الفطرة، وغابَ عنهم الميزان، وطاشَ العقل المستغني عن الإله كأن لن يقدر عليه أحد. ولو أمعنت النظَر، ما توقَّفَ القرآن عند حدود الإنكار، وإنما تقدَّم خطوة أبعد، ففكَّكَ البنية، وفضح الجذر، ثمَّ أقام على أنقاضه تصورًا متماسكًا يعيد الإنسان إلى مصدره العلوي، ويرشده إلى غايته الكبرى.
ليست الجاهلية طورًا زمنيًا مضى، بل بنية ذهنية تعود كلما استغنى الإنسان عن الوحي؛ فالأفكار الحديثة -مهما تلوّنت- تعيد إنتاج المنطلقات ذاتها: قطع الصلة بالله، وطمس الغاية، وتفكيك المعنى، ولهذا بقي القرآن مرجعية حيّة تفكّك هذه الأنساق وتردّ الإنسان إلى موضعه الحق.
وإذا كان القرآنُ قد وقَفَ في وجه التيارات الجاهلية المعاصرة، فليسَ ذلك انغلاقًا حضاريًّا، ولا توجسًا من الفكرِ البشري في ذاته، وإنما تثبيتٌ لمبدأ قرآنيٍّ جليل: أنَّ الوحي هو الميزان الأعلى الذي تُقاس به الأشياء، لا ما سواه. فالإسلام لا يُخاصم العقول، ولا يقطع الجسور مع النتاج الإنساني، لكنه يأبى أن يكون تابعًا لمناهج وُضعت في غيابِ السماء، أو أن يُطوَّع ليتماهى مع تصورات منبتَّة عن أصل الإنسان وغايته، إنه لا ينغلق عن المعرفة، وإنما ينفتحُ عليها من موقعِ المرجعية الربانية، والنموذج الأمثل، يستوعب ما وافقَ الفِطرة والنُّور، ويكشف ما انحرف منها أو زاغ، فيبقى الوحي أصلاً، وسواه فرع يُوزن لا يَزن، ويُمحَّص لا يُسلَّم له.
ومرام القول: القرآن الكريم كتاب هدايةٍ لا يكتفي بإصلاح السُّلوك، وإنما يعيد تشكيل العقل، ويفككُ بنيات الوهم، ويقيم للإنسان تصورًا جديدًا عن ذاته، وقيمته، ووجهته، لم يهادن الأنساق الموروثة، ولم يصالح الجاهليات المتجددة، لقد جاء بمعيارٍ مطلقٍ للحق، لا يتغير بتغير الزمان ولا يستبدل موضعه، وما تزال هذه الوظيفة الإصلاحية للقرآن ماثلةً، تحرِّرُ العقول من سطوةِ المألوف، وتُعلي الكلمة على السُّلالة، والإيمان على المصلحة، والحق على الصدى، من أراد الهداية فليقبل عليه بقلبٍ صادق يتطلب الفلاح، فإنَّ النور الذي أخرج الأوائل من ظلماتِ الوثنية قادر على أن يبدِّدَ الزَّيفَ المعاصر، ويقيم بها الإنسان من جديد.
د. خالد بريه
كاتب وباحث، مشرف موقع حكمة يمانية
[1] ينظر: الرؤوس، لمارون عبود، ص (18).
[2] ينظر: نظم الدرر (2/ 331).
[3] الكشاف (1/ 213).
[4] إعجاز القرآن، لعبد الكريم الخطيب، ص (14).
[5] محاسن التأويل (5/364).
[6] التاريخ العربي القديم، ديتليف نيلسن وآخرون، ترجمة فؤاد حسنين علي، ص (173).
[7] السنن الكبرى للبيهقي (20782).
[8] نظم الدرر (7/455).
[9] وهذا فحوى كلام العلامة ابن عاشور في تعليقه على الآية. يراجع: التحرير والتنوير (8/232).