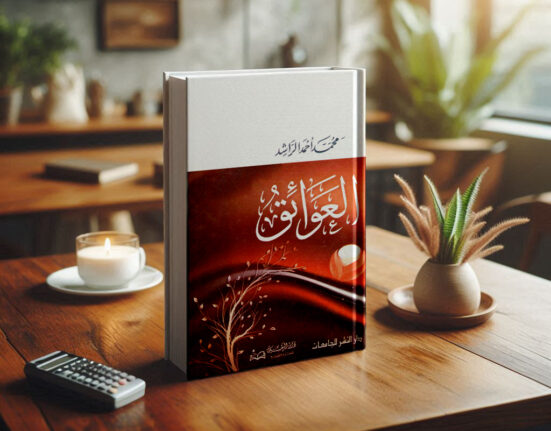رسالة من أديب مؤرخ ومحقق بارع تناول فيها أحداثاً مفصليّة في تاريخ أمتنا الإسلامية كانت سبباً في انحراف البوصلة، اعتمد فيها «منهج التذوق» الذي ابتكره بعد عقود من القراءة والبحث، حيث أطلق من خلال رسالته الدعوة للعودة إلى مكامن الثقافة الإسلامية، وأودعها خلاصة رأيه في العديد من القضايا الثقافية العربية الحديثة.
نبذة عن المؤلف:
هو أبو فهر محمود محمد شاكر، ولد في الإسكندرية في مصر عام ١٣٢٧هـ / ١٩٠٩م، في بيت من بيوت العلم الكبار، فأبوه الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر، وشيخ علماء الاسكندرية، وقاضي القضاة في السودان، وأخوه المحدث العلامة أحمد محمد شاكر رحمهما الله.
التحق بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بالجامعة المصرية، واستمر بها إلى السنة الثانية، حين تركها لخلاف مع أستاذه الدكتور طه حسين حول منهج دراسة الشعر الجاهلي. ثم تفرغ للتأليف والتحقيق والنّشر، فحقَّقَ جملة من أُمَّهات الكتب العربية. وأصبح بيتُه مقصدَ أجيالٍ من دارسي التراث العربي، والمعنيين بالثقافة الإسلامية من مختلف أرجاء العالمين العربي والإسلامي.
اختير عضوًا مراسلاً في مجمع اللغة العربية بدمشق، وعضوًا في مجمع اللغة العربية في القاهرة، ومُنح جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام ١٩٨١م، وجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي عام ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.
توفي رحمه الله تعالى في ٤ ربيع الآخر ١٤١٨هـ الموافق ٧ آب / أغسطس ١٩٩٧م.
وصف الكتاب:
يقع الكتاب في ١٨٢ صفحة من القطع المتوسط، من طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب لعام ١٩٩٧م.
محتوى الكتاب:
- دراسة متعمِّقة من أديبٍ مؤرِّخٍ، ومحقِّقٍ بارعٍ للتراث الإسلامي، سلط فيها الضوءَ على مدة طويلة من تاريخ أمتنا الإسلامية، لا بغرض التأريخ بل لإلقاء الضوء على أحداث كانت سببًا في انحراف البوصلة، قاصدًا تنبيه الأمة للسبيل القويم الكفيل بإعادة مجدها.
- الكتاب لم يفصّل كل شيء، إلا أنه لفت الأنظار إلى منهج جديد غير مألوف هو منهج «التذوق»، وهو مباين للمناهج الحديثة التي وضع «المستشرقون» أسس الكثير منها.
- نداءٌ يوجهه عَلَمٌ من أعلامِ التاريخ والأدب لكل فرد من أفراد أمته؛ أن «اقرأ تاريخك بعين عربية بصيرة لا تغفل، لا بعين أوروبية تخالطها نخوة وطنية».
- وصيةٌ وتنبيهٌ، وصيحة نذير، تدعو المفكرين والأدباء للعودة إلى مكامن الثقافة الإسلامية التي نشأت في ظلال الدين، والتي أريد لها أن تُفَرَّغ من دعائم القوة فيها.
- جهْرٌ بالحق الذي هدى الله إليه مؤلفَ الرسالة، عملاً بحديث النبي ﷺ قال: (ألا لا يمنعَنَّ رَجُلاً هَيبَةُ الناس أن يقول بحقٍّ إذا عَلِمَهُ)[1].
القراءة في الكتاب:
اتبع المؤلف طريقة السَّرد في رسالته؛ فلم يقسمها إلى أبواب وفصول، بل أخذ يتحدث إلى قارئه حديثًا متسلسلاً معتمدًا على تقسيم الرسالة إلى فقرات، فوقع الكتاب في ٢٤ فقرة، ثم ختمها بتذييل ضمَّنه شهادته وشهادة أستاذه طه حسين على فساد أدب عصره وثقافته.
محاور الكتاب:
- رحلة المؤلف إلى منهج التذوق.
- الصراع بين الإسلام والنصرانية الأوروبية انتهاء بمعركة الاستشراق.
- نهضة ديار الإسلام وكيف أبيدت؟ ابتداءً من الحملة الفرنسية، مرورًا بمحمد علي ودوره في تدمير النهضة، وانتهاء بالاحتلال الإنكليزي وتدمير التعليم في مصر.
- قصة التفريغ الثقافي: فساد الحياة الأدبية وشهادتان للتاريخ.
ونتيجة للطريقة السَّردية التي سار عليها المؤلف في كتابه، فقد قسَّمت الفقرات لأربع محاور، ووضعت تشجيرًا بداية كل محور يبيّن أهم نقاطه.
الأصل الأخلاقي هو العامل الحاسم الذي يُمَكِّن لثقافة الأمة بمعناها الشامل، وأسلافنا منحوا هذا الأصل عناية فائقة شاملة، مما حفظ للثقافة الإسلامية ترابطها مدة أربعة عشر قرنًا
المحور الأول: رحلة المؤلف إلى منهج التذوق:
- بداية الرحلة: عشر سنوات من الحيرة والشك والتردد:
أخرج الترمذي وأحمد بإسناد صحيح من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال: (ألا لا يمنعَنَّ رَجُلاً هيبةُ الناس أن يقول بحقٍّ إذا عَلِمَهُ).
افتتح الشيخ محمود شاكر رسالته بهذا الحديث، وبَيَّن في مطلع رسالته أنه لَبِث عشر سنوات من شبابه يراقب الحياة الأدبية الفاسدة التي كانت تملأ عالم الأدب في عصره، من عام ١٩٢٦م حيث كان في السابعة عشرة من عمره، حتى بلغ السابعة والعشرين من عمره عام ١٩٣٦م، قرأ خلالها ما وقع تحت يديه من الشعر العربي بتمهلٍ وتدبرٍ، ونظرٍ في طريقِ البحث عن الحق، فأكسبته هذه المرحلة تذوقًا للغة الشعر.
- الاهتداء إلى «منهج التذوق» ووقفة مع الجرجاني وسيبويه:
ثم قرأ ما وقع تحت يديه من كتب السلف من تفسير للقرآن وعلومه، إلى دواوين السنة وشروحها، وما تفرّع منها من كتب المصطلح، وكتب الرجال، والجرح والتعديل، إلى كتب الفقه وأصوله، وكتب المِلَلِ والنِّحَل ثم كُتُب الأدب، والبلاغة، والنحو، والصرف، حتى منَّ الله عزَّ وجلَّ عليه بعد هذا بابتكارٍ فريدٍ أسماه «منهج التذوق»، وهو تذوق الكلام العربي وما يقصد به وما وراءه من معاني، وأثناء تطوافه بتراث الأمة، وجد أن عبد القاهر الجرجاني في كتابه «الرسالة الشافية» قد سبقه إلى منهج التذوق.
- وقفة مع كتاب المتنبي:
ثم كتب كتابه «المتنبي» مبنيًا على منهجه الجديد، فجاء الثناء عليه من كافة الأطراف، حتى من أدباء المهجر، ومن بعض غير المسلمين، ومن أستاذه طه حسين، ومن الرافعي والعقاد، وكتب عنه الكثيرون.
وكان هذا الثناء سببًا في صرفه عن إتمام الكتاب، لما رآه من انشغال الناس بالمدح البراق، غير متنبهين للسبب الرئيس لتأليفه، فأراد من خلال «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» أن يكشف هذا السّر الذي بقي حبيسًا في صدره لأربعين سنة، فكتبها وجعلها بمثابة مقدمة لكتاب المتنبي، وهي آخر ما أصدره، وأودعها خلاصة رأيه في العديد من القضايا الأساسية المتصلة بمسيرة ثقافتنا العربية الحديثة.
- الدين رأس كل ثقافة:
ثمَّ أشار المؤلف لمكمن الخلاف مع المناهج الأدبية القائمة، مبيِّنًا فسادها من جذورها، ثم ختم حديثه بنفيسة من نفائس تجربته الرائدة ورؤيته لِحَدِّ الثقافة وهي: أن ثقافة كل أمة هي جسدها الذي يقوم به كيانها وتعرف به من بين أقرانها، ورأس كل ثقافة هو الدين بمعناه العام، والذي هو فطرة الإنسان، فالثقافة كلٌّ لا يتجزأ، وبناء لا يتبعّض.
وأن الأصل الأخلاقي هو العامل الحاسم الذي يُمَكِّن لثقافة الأمة بمعناها الشامل، وأسلافنا منحوا هذا الأصل عناية فائقة شاملة، لم يكن لها شبيه عند أمة سبقتهم، ولم يُتَحْ لأمة لحقتهم أن يكون عندها شبيه أو مقارب، وهذه العناية بالأصل الأخلاقي هي التي حفظت على الثقافة الإسلامية ترابطها مدة أربعة عشر قرنًا.
كان مدد اليقظة الأوربية مُستجلَبًا من علوم المسلمين، وكان السبيل إليها معرفة لسان العرب، ولا تتحقق هذه المعرفة إلا ببعث رجال يسيحون في أرض الإسلام يتعلمون اللسان ويجمعون الكتب أو يسرقونها، فكانت فكرة الاستشراق من أكبر الأهداف والوسائل، وعُرف هؤلاء باسم «المستشرقين»
المحور الثاني: الصراع بين الإسلام والنصرانية الأوروبية وانتهاء بمعركة الاستشراق:
- مراحل الصراع بين النصرانية والإسلام:
بدأ بسرد تاريخي لهذا الصراع من سنة ٤٨٩هـ الموافق ١٠٩٦م أي بعد سقوط الحضارة الرومانية، وظهور حضارة الإسلام النبيلة المتماسكة، مما دفع بالنصارى الروم -لما طردوا من الشام واتجهوا إلى أوربا- إلى العمل على تنصير السكسون ليستخدموهم في حربهم على الإسلام، ونتيجة لذلك فقد قاموا بالحروب الصليبية.
عند التأمل في الصراع الإسلامي الأوروبي نجده متجسدًا في أمرين:
أولهما: الحروب الصليبية: التي استمرت لقرنين كاملين ثم انتهت بالإخفاق وباليأس من حرب السلاح نحو قرن ونصف وذلك في عام ٦٩٠هـ الموافق ١٢٩١م، بعد أن تركت في أنفس المقاتلين الهمج [الأوروبيين] بصيصًا من اليقظة والتنبه وبعثت في نفوسهم الشك فيما كانوا قد سمعوه من رهبانهم وملوكهم من تشويه لصورة المسلمين.
ثانيهما: فتح القسطنطينية: في يوم الثلاثاء ٢ من جمادى الأولى سنة ٨٥٧هـ الموافق ٢٩ مايو ١٤٥٣م، والتي كانت لحظة فاصلة، حيث أيقنت النصرانية أن المواجهة المسلحة مع الإسلام لا تفيد، فاندفعت أوروبا لمعركة أطول وأقسى هي معركة الاستشراق ثم الاستعمار ثم التبشير!!
- معركة الاستشراق وتقييم عمل المستشرقين:
نتيجة لما سبق؛ تحددت أهداف المسيحية ووسائلها، فلم يغب عن أحد منهم قطُّ أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة، نحَّوْا فيها السلاح إلى حين، واستبدلوا سلاح العقل والعلم وحسن التدبير به، ثم المكر والدهاء والمداهنة وترك استثارة المارد الإسلامي.
كان مدد اليقظة الأوربية مُستجلَبًا من علوم المسلمين: المسطورة في الكتب أو التي حملها العلماء الأحياء، وكان السبيل إلى ذلك معرفة لسان العرب، ولا تتحقق هذه المعرفة إلا ببعث رجال يسيحون في أرض الإسلام يتعلمون اللسان ويجمعون الكتب أو يسرقونها، فكانت فكرة الاستشراق من أكبر الأهداف والوسائل، وعُرف هؤلاء باسم «المستشرقين»، وهي أهم وأعظم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية، وقد وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر الذي يغذي جهادهم الأدنى وهو الاستعمار، والتبشير، «لا تنس ما حييتَ أن هذه الثلاثة إخوة أعيان لأب واحد وأم واحدة، لا تفرق قط بين أحد منهم».

انساح المستشرقون في أنحاء العالم الإسلامي خاصة، وما هو إلا قليل حتى كان تحت يد الاستشراق آلاف من المخطوطات، فأكبوا عليها يفرزونها، ثم يطبعون بعضها لتكون تحت يد كل دارسٍ مستشرق، وينبه المؤلف لملحظ مهم جدًا فيقول: «فلا تصدق من يقول لك: إن الاستشراق قد خدم اللغة العربية وآدابها وتاريخها وعلومها، لأنه نشر هذه الكتب التي اختارها مطبوعة، فهذا وهمٌ وباطل، كانوا لا يطبعون قط من أي كتاب نشروه أكثر من خمسمائة نسخة – ولم تزل هذه سنتهم إلى يومنا هذا – تُوزَّع على مراكز الاستشراق في أوربة وأمريكا، وما فضل بعد ذلك فقليل جدًا».
كانت للمستشرق صفتان لازمتان: الأولى: أن في قلبه الحمية التي أثارها الصراع بين المسيحية ودار الإسلام، والثانية: أنه يحمل في صميم قلبه ما تحمله قلوب خاصة الأوربيين وعامتهم، وملوكهم وسوقتهم، من الأحلام البهيجة والأشواق الملتهبة إلى حيازة كل ما في دار الإسلام من كنوز العلم والثروة والرفاهية والحضارة.
كتب المستشرقون لجماهيرهم آلافًا من المقالات، تناولت كل ما يخص أمم دار الإسلام، لكن لهدف واحد: هو تصوير الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين، بصورة مقنعة للقارئ الأوربي أنَّ العرب والمسلمين قومٌ جهال جياع، جاءهم رجل ادّعى أنه نبيٌّ مرسَل، ولفّق لهم دينًا من اليهودية والنصرانية فصدّقوه بجهلهم واتبعوه، ولم يلبث هؤلاء الجياع أن عاثوا في الأرض يفتحونها بسيوفهم حتى كان ما كان، وأن من لحق بهم من الموالي هم الذين جعلوا لهذه الحضارة الإسلامية معنى لم يكن لها ولا يكون لولاهم.
أكثر ما كتبه المستشرقون لبني قومهم، سواء كانوا من العامة الذين كتبوا لهم لتبشيع صورة الإسلام وأهله في عيونهم، ووصم نبيِّه ﷺ بالنقائص؛ حتى لا يدخلوا في دين الإسلام دخلت الكثير من الأمم الأخرى، أو كانوا يكتبون لخاصتهم من الساسة؛ ليطلعوهم على ما عند المسلمين من العلوم والكنوز والذخائر من أجل السطو على هذه الكنوز في معركة الاستعمار، أو إلى علمائهم؛ ليبينوا لهم كيف يواجهون المسلمين في معركة شديدة الخطورة، لا تزال ممتدة إلى يومنا هذا، ألا وهي معركة التبشير.
بيَّن المؤلف أن ما يفعله المستشرقون لا يمتُّ للمنهج بصلة؛ وذلك لأن لغتهم مباينة كل المباينة للغتنا، وكذلك ثقافتهم مختلفة عن ثقافتنا، ودينهم مغاير لديننا، وهذه كلها أدوات ما قبل المنهج، ثم إنَّ داء المستشرقين العضال الذي لا يستطيع أكثرهم الشفاء منه؛ وهو داءُ الأهواء، فأكثرهم متبع لهواه.
الثقافة: لفظ جامع يقصد به الدلالة على شيئين أحدهما مبني على الآخر؛ الأول: أصول ثابتة مكتسبة تنغرس في نفس الإنسان منذ مولده ونشأته حتى يشارف حد الإدراك البين، والثاني: فروع مكتسبة منبثقة عن هذه الأصول. تنبثق حين يخرج الناشئ من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير.
الإيمان والعمل والانتماء أركان الثقافة التي لا يكون لها وجود ظاهر محقق إلا بها، وشرط الثقافة بأركانه الثلاثة ممتنع على كل مستشرق، فكيف يكون ما كتبه المستشرقون عملاً علميًا أو بحثًا منهجيًا؟!.
ينتهي المؤلف في هذا المحور بالإشارة لمفهوم (عالمية الثقافة)، ليتوصل إلى أنه باطلٌ كلّ البطلان أن يكون في هذه الدنيا -على ما هي عليه- ثقافة يمكن أن تكون (ثقافةً عالميّة) أي: واحدة يشترك فيها البشر جميعًا ويمتزجون على اختلاف لغتهم ومِللهم ونحلهم وأجناسهم وأوطانهم، فهذا تدليسٌ كبيرٌ، وإنما يراد بشيوع هذه المقولة بين الناس والأمم هدفٌ آخرُ يتعلق بفرض سيطرة أمةٍ غالبةٍ على أممٍ مغلوبة، لتبقى تبعًا لها، فالثقافات متعددة ومتميزة، ولكل ثقافةٍ أسلوبٌ في التفكير والنظر والاستدلال منتزعٌ من الدين الذي تدين به لا محالة، الثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش، لكن لا تتداخل تداخلاً يُفضي إلى الامتزاج البتّة، ولا يأخذُ بعضها عن بعضٍ شيئًا، إلا بعد عرضه على أسلوبها في التفكير والنظر والاستدلال، فإن استجاب للأسلوب أخذته وعدلته وخلصته من الشوائب، وإن استعصى نبذتْهُ وطرحتْه.
المحور الثالث: نهضة ديار الإسلام وكيف أبيدت؟
- نهضة ديار الإسلام، والخمسة الكبار:
سقطت الأندلس بعد أربعين سنة من فتح القسطنطينية ٨٩٧هـ، ثم فُقدت دار الخلافة في القسطنطينية بعد مرور مائتي عام على فتحها، فأيقظت هذه الحادثة بعض علماء المسلمين الذين قاموا لإيقاظ الجماهير المستغرقة، كان على رأسهم خمسة ممن حملوا مشعل التغيير:
- أولهم: عبد القادر بن عمر البغدادي، كان في مصر ما بين (١٠٣٠-١٠٩٣هـ)، الذي وضع «خزانة الأدب» لاستعادة القدرة على تذوق اللغة والشعر والأدب وعلوم العربية.
- ثانيهم: الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ظهر في جزيرة العرب ما بين (١١١٥-١٢٠٦هـ)، الذي هبَّ لمكافحة البدع والعقائد التي تُخالف ما كان عليه سلف الأمة من صفاء عقيدة التوحيد، ولم يقنع بتأليف الكتب بل نزل إلى عامة الناس في بلاد جزيرة العرب وأحدث رجة في قلب دار الإسلام.
- وثالثهم: حسن بن إبراهيم الجبرتي (الكبير) العقيلي، ظهر في مصر ما بين (١١١٠-١١٨٨هـ)، اهتم بالعلوم المستغلقة على أهل زمانه، فجمع كتبها من كل مكان، وحرص على لقاء من يعلم سر ألفاظها ورموزها، وقضى في ذلك عشر سنوات، حتى ملك ناصية الرموز في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية.
- ورابعهم: محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزَّبيدي، في الهند ومصر ما بين (١١٤٥-١٢٠٥هـ) وهو صاحب «تاج العروس»، وهو الذي هبَّ يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الإسلام.
- وخامسهم: محمد بن علي الخولاني الشوكاني الزيدي، ظهر في اليمن ما بين (١١٧٣-١٢٥٠هـ)، وقد هبَّ لإحياء عقيدة السلف، ومنع التقليد في الدين، وحطم الفرقة والتنابذ الذي أدى إليه اختلاف الفرق بالعصبية.
وقد دوَّت أسماء هؤلاء الخمسة في أرجاء ديار الإسلام، فكان ظهورهم بداية تهديد للقوة الجديدة التي ظهرت في أوروبة، وأصبحت هذه اليقظة في ديار الإسلام تُخَوفهم، فعملت على محاصرتها وسعت جاهدة لوأدها.
- الحملة الفرنسية وخطتها في وأد اليقظة المصرية وسرقة التراث:
وقيض الله لفرنسا قائدًا صار اسمه مثيرًا للرعب وبأنه القائد الذي لا يُقهر وهو «نابليون»، وفي ١٧ من المحرم سنة ١٢١٣هـ الموافق لأول يوليو من عام ١٧٩٨م هوى نابليون على مهد اليقظة في الديار المصرية، حيث وضع خطة محكمة تضمنت الخطوات الآتية:
- أولاً: إقناع المشايخ الكبار بأن هدف الحملة الفرنسية هو محاربة المماليك وظلمهم وجورهم الذي تعرض له المصريون والرعايا الفرنسيون.
- ثانيًا: إثارة الأقباط ضد المسلمين، وأن الحملة الفرنسية جاءت لإعلاء راية المسيحية؛ وإن لم ينجح هذا التدبير تمامًا.
- ثالثًا: محاولة تدجين العلماء، وقد نجح مع مجموعة منهم، فخدعهم بحسن استقباله لهم وتوقيرهم.
- رابعًا: إفقار الشعب بالاستيلاء على ثرواته من خلال الضرائب والإتاوات بالإضافة إلى التدمير والتخريب المتعمد.
- خامسًا: سرقة الثروة الفكرية للبلاد بالسطو على ذخائر المخطوطات، وما تزال خزائن كتبهم تشهد على ذلك.
نزل نابليون الإسكندرية ثم زحف إلى القاهرة، مصطحبًا معه عشرات من المستشرقين، وطائفة من العلماء في كل فن وعلم، فبدأ باستمالة رجال الأزهر، فلما رأى امتناعهم أطلق جنوده ليستبيحوا كل شيء ويدنسوا الأزهر، فلما أحس بغليان الشارع رجع إلى فرنسا وعيَّن على الحملة «كليبر» الذي ضرب القاهرة بالمدافع، حتى منّ الله بسليمان الحلبي فقتل «كليبر» سنة ١٢١٥هـ، ثم جاء على الحملة الكذاب المنافق «مينو» الذي أعلن إسلامه لتسكين المسلمين، وتزوج من إحدى بنات مدينة رشيد، وبقى في إمارته يُنْزل بالناس المصائب والبلايا حتى إجلاء الحملة من مصر في يوم الاثنين ٢١ ربيع الآخر سنة ١٢١٦هـ الموافق ٣١ أغسطس ١٨٠١م، لكنها أخذت ما جاءت إليه من كل نفيس من الكتب والعلوم.
ابتدأ المشروع الاستشراقي الأعظم ببعث ثلة من شباب مصر ليتعلموا «ويتفرنسوا» أيضًا في باريس، وليعودوا فيكون منهم حزب كما يشتهي «نابليون» في وصيته لخليفته «كليبر»، والحقيقة أن فكرة البعثات العلمية لم تكن نابعة من عقل هذا الجاهل، بل كانت نابعة من عقولٍ تخطط وتدبر لأهداف بعيدة المدى
- «محمد علي» ودوره في محاربة النهضة:
وبعد الجلاء الفرنسي تولى «محمد علي» وكان رجلاً ذكيًا مكارًا قد خالط المشايخ، وأظهر لهم من النصح وسلامة الصدر ما خدعهم به، فولوه أمر مصر، كان بائع دخان أول أمره، ولم يكن يقرأ ولا يكتب، قدم مصر مع ثلاثمئة جندي بعثت بهم الدولة العثمانية أواخر أيام الحملة الفرنسية.

كانت قوى الاستعمار ترقبه من أول ساعة حطت فيها قدماه أرض مصر، فما إن تولى حتى أحاطت به قناصل الدول المسيحية (الاستعمارية) وبدأت عملية السيطرة عليه حتى أوغروا صدره على المشايخ فغدر بهم وتغلب على أمر مصر، فهيمنت قناصل الصليبيين بهيمنته! فماذا فعل؟
- أثر البعثات التعليمية والدور التغريبي لرفاعة الطهطاوي:
ابتدأ المشروع الاستشراقي الأعظم ببعث ثلة من شباب مصر ليتعلموا «ويتفرنسوا» أيضًا في باريس، وليعودوا فيكون منهم حزب كما يشتهي «نابليون» في وصيته لخليفته «كليبر»، والحقيقة أن فكرة البعثات العلمية لم تكن نابعة من عقل هذا الجاهل، بل كانت نابعة من عقولٍ تخطط وتدبر لأهداف بعيدة المدى.
وُئدت اليقظة في قلب العالم الإسلامي وأقاموا على أنقاضها بناءً جديدًا راسخ الأساس أقامه الاستشراق ليضمن به الغلبة والسيطرة وإخضاع دار الإسلام لأهدافه وغاياته.
هلك «محمد علي» وبقي أولاده من بعده في قبضة القناصل والاستشراق، وعادت البعثات بقلب أوروبي وقالب عربي.
كان على رأس أول بعثة رجلٌ خرج مع البعثة إمامًا يصلى بهم الصلوات الخمس، ويراقب أفراد البعثة وهو «رفاعة الطهطاوي» ابن الثالثة والعشرين من عمره، الصعيدي المنشأ، الأزهري الدراسة، الذي لم ترَ عينه سوى الريف وضواحي الأزهر القديمة المتهالكة.
فرجع بعد ست سنوات من فتنته بباريس ليُخرج مصر من الظلمات إلى النور ومن التخلف إلى التحضر، وأنشأ مدرسة الألسن التي كانت تدرس الآداب الغربية والتاريخ المزور، لكي تنافس من طرف خفي الأزهر الذي أسقط هيبة مشايخه «محمد علي» مؤسس مصر الحديثة.
- الاحتلال الانكليزي وتدمير التعليم على يد «دنلوب»:
ومضت الأيام حتى جاء الاحتلال الإنجليزي في ١٢٩٩هـ الموافق ١٥ سبتمبر ١٨٨٢م ووكل أمر التعليم في مصر إلى قسيس مُبشر خبيث هو «دنلوب» ليؤسس أصول الاحتلال الإنجليزي في مصر ويُمَكن لثقافته، حيث شطر التعليم في البلاد إلى شطر ديني في الأزهر ودنيوي في المدارس، وما تبع ذلك من تفريغ طلبة المدارس من ماضيهم وبعث الانتماء إلى الفرعونية البائدة، لكي يزاحم بقايا ذلك الماضي المتدفق الحي.
المحور الرابع: قصة التفريغ الثقافي – فساد الحياة الأدبية وشهادتان للتاريخ:
في نهاية الرسالة فيما أطلق عليه المؤلف اسم: «ذيل الرسالة» بيَّن قصة فساد الحياة الأدبية، وذكر أنه عازم على أن يورد في هذا الذيل شهادتين هما:
شهادته الشخصية حيث قال: «شهادتي أنا من موقعي بين أفراد جيلي الذي أنتمي إليه، وهو جيل المدارس المفرغ من كل أصول ثقافة أمته، وهو الجيل الذي تَلَقَّى صدمة الدهور الأولى، حيث نشأ في دوامة من التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي».
والشهادة الثانية وهي: «شهادة الدكتور طه حسين من موقع (الأستاذية) لهذا الجيل».
وبيَّن محمود شاكر أن في قراءة هاتين الشهادتين منجاة من الدخول في غمار أحلام (النهضة) و(التجديد) و(الأصالة المعاصرة) و(الثقافة العالمية).
فتحت عنوان «قصة التفريغ الثقافي» أوضح نقطة في غاية الأهمية عن أثر الاحتلال الانجليزي لمصر وجعل التعليم في قبضة المبشر الخبيث «دنلوب»، وما ترتب عليه من تفريغ الأجيال الناشئة من ماضيها المتدفق في دمائها مرتبطًا بالعربية والإسلام والذي سوف يفرغ الأجيال تفريغًا كاملاً من ماضيهم كلِّهِ ثم يملأُ هذا الفراغَ بعلوم وآداب وفنون لا علاقة لها بماضيهم، وإنما هي علوم الغُزَاةِ، وفنون الغُزَاةِ، وآداب الغُزَاةِ، وتاريخ الغُزَاةِ، ولغات الغُزَاةِ.
«لقد كنت أعيش في وقت فُرِّغَ شبابه الدارسون من ماضيهم وتركوا تاريخهم وراء ظهورهم، وذلك لأن الغزاة الذين هجموا علينا فَرَّغوا النشء من كل موروث، ووضعوا في مكانه أشياء تافهة لا قيمة حقة لها، فهجر النشء الجديد كل قديم مما تركه الآباء، واتجهوا باسم التجديد إلى ما جاء لهم به أولئك الذين سيطروا على عقولهم»
الأستاذ محمود شاكر رحمه الله
وفي شهادة الأستاذ محمود شاكر يذكر أنه قد مرت عليه الأيام والليالي والسنون التي كتب خلالها كتابه عن (المتنبي) وهَمُّهُ مصروف إلى قضية الشعر الجاهلي، وطلب اليقين لنفسه إلى أن انكشفت عنه غشاوة من العمى، يقول: ووجدت الصورة الحقيقية التي تفصل العالم الذي أنا فيه –وقتذاك– والعالم الذي عاش فيه مَن قبلي.
لقد كنت أعيش في وقت فُرِّغَ شبابه الدارسون من ماضيهم وتركوا تاريخهم وراء ظهورهم، وذلك لأن الغزاة الذين هجموا علينا فَرَّغوا النشء من كل موروث، ووضعوا في مكانه أشياء تافهة لا قيمة حقة لها، فهجر النشء الجديد كل قديم مما تركه الآباء، واتجهوا باسم التجديد إلى ما جاء لهم به أولئك الذين سيطروا على عقولهم.
ثم ضرب مثلاً بحالة لها شهرة وهو موقف طه حسين من الشعر الجاهلي، وما جاء في كتابه من تشكيك، على أن طه حسين عاد بعد تسع سنوات فكتب عدة مقالات كانت تتضمن رجوعًا عما قاله عن الشعر الجاهلي سنة ١٩٢٦م، ولخص ما كتبه طه حسين باعتباره شهادة لابد من إعلانها، وقد جاء فيها:
«والذين يظنون أن الحضارة الجديدة حملت إلى عقولنا خيرًا خالصًا يخطئون، فقد حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا شرًا غير قليل.. فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود وجهل، كما كان التعصب للقديم مصدر جمود وجهل أيضًا». وإن هذه الأسطر لتدل على باقي فحوى الشهادة التي حرص المؤلف على أن يذكرها لنا في نهاية رسالته.
ختــامًا:
بعد هذا التطواف الطويل نلحظ أن شيخ العربية قد كشف المؤامرة الهادفة لتدمير ثقافتنا وتراثنا، وبــيَّـــن بجلاء الدور المظلم الذي قام به الاستشراق ودعاته، موضِّــحًا أن ثقافة كل أمة هي جسدها الذي يقوم به كيانها وتعرف به من بين أقرانها، ورأس كل ثقافة هو الدين بمعناه العام، والذي هو فطرة الإنسان، فالثقافة كلٌّ لا يتجزأ، وبناء لا يتبعّض.
وذكَّرَ أنَّ الأصل الأخلاقي هو العامل الحاسم الذي يُمَكِّن لثقافة الأمة بمعناها الشامل، وأن أسلافنا منحوا هذا الأصل عناية فائقة شاملة، لم يكن لها شبيه عند أمة سبقتهم، ولم يُتَحْ لأمة لحقتهم أن يكون عندها شبيه أو مقارب، وهذه العناية بالأصل الأخلاقي هي التي حفظت على الثقافة الإسلامية ترابطها مدة أربعة عشر قرنًا.
[1] أخرجه الترمذي (٢١٩١).
أ. عبد القادر بن عبد الكريم العثمان
مدير الشؤون التعليمية في جمعية تاج لتعليم القرآن الكريم.
مدير الشؤون التعليمية في جمعية تاج لتعليم القرآن الكريم.