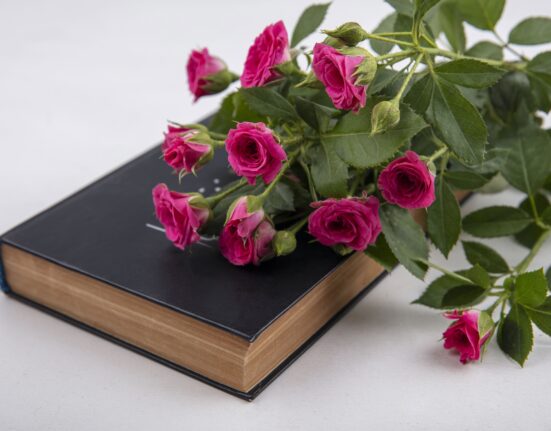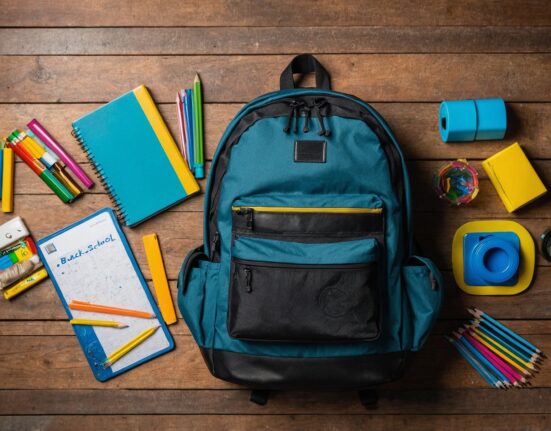إذا كانت التنمية المستدامة في المنظور الغربي قد جعلت جلّ اهتمامها بالجانب المادي، فإنها في الإسلام تتميز بالسعة والتوازن والاستدامة؛ فالرؤية التنموية في الإسلام تنبعث من قضية الاستخلاف وفلسفته في العلاقة بين الإنسان والكون ومالكهما رب العالمين، وهو مفهوم يجمع بين التنمية الروحية والمادية، ويُعلي من شأن النفس الإنسانية ويضعها موضع التكريم اللائق بها.
مقدمة:
التنمية المستدامة في التصور الإسلامي تسعى إلى بناء الإنسان ماديًا ونفسيًا وعقليًا ودينيًا؛ وفقًا لمتطلبات مادية ومعايير وقيم أخلاقية وإنسانية؛ لتحقيق مهمته في الاستخلاف وعمارة الأرض وتنميتها، وهي معايير وقيم يرسخها الدين ويؤصلها وفق ضوابط رشيدة ورؤية هادفة، ووازع يقوم على الوعي ورقابة الضمير، وباعث من طلب الثواب الدنيوي والأخروي.
مفهوم التنمية المستدامة:
تتضمن التنمية المستدامة أربعة عناصر أساسية:
» الأول: أنها عملية متعددة الأبعاد تقوم على التخطيط والتنسيق بين خطط التنمية الشاملة بكافة أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
» الثاني: الاستغلال الأمثل للموارد.
» الثالث: توفير حق الأجيال الحاضرة واللاحقة من الموارد، والارتقاء بالجوانب الكمية والنوعية للمادة والبشر.
» والرابع: إعادة توجيه التقنيات المعاصرة بما يحقق ما يمكن أن نطلق عليه التقنيات الحميدة أو الـمُرَشّدة.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في سبتمبر من عام 2015م للفترة بين (2015 -2030م)، فيما يعرف رسميًا باسم “جدول أعمال 2030م للتنمية المستدامة”، وتتمثل هذه الأهداف في سبعة عشر هدفًا. وفي يناير من عام 2016م أُدرجت هذه الأهداف في خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتغطي هذه الأهداف مجموعة واسعة من قضايا الحياة البيئية والاجتماعية والاقتصادية مثل: (الفقر، الجوع، الصحة، التعليم، تغير المناخ، المساواة بين الجنسين، المياه، الصرف الصحي، الطاقة، البيئة، العدالة الاجتماعية). وتترابط هذه الأهداف العامة (الغايات) فيما بينها، فيؤثر تحقيق كل منها على بقيتها، كما أنّ لكل من الأهداف العامة مجموعة من الأهداف التفصيلية الخاصة بها، تمثل في مجموعها (169) هدفًا تفصيليًا.
والتنمية المستدامة لعموم هذا التوجه تُعد مبدأ إسلاميًا أصيلاً، بل تدخل في مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورياتها الخمس: (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال). وقدمت الشريعة الإسلامية في هذا الصدد إطارًا شاملاً ومنهجًا متكاملاً منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، تخطت فيه حد التنظير إلى الواقعية، سخرت فيه المادة، وأعلت من القيم الروحية.
ركائز وتدابير التنمية المستدامة في القرآن والسنّة:
تقوم الرؤية الإسلامية في معالجة قضايا التنمية المستدامة على خمس مقومات أو ركائز رئيسة، ينضوي تحت كل منها مجموعة من التدابير (آليات التنفيذ)، تتفرّد الشريعة الإسلامية في اثنتين منها (الركائز الإيمانية)، وتشترك في الركائز الثلاث الأخرى (الركائز المادية) مع ما يُطرح وفق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولكن وفق الرؤية الإسلامية، التي تتسم بالعمق والشمول.
أولاً: الركائز الإيمانية وتدابيرها:
تميز المنهج الإسلامي إلى جانب تكامليته وشموليته بأنه لم يؤسس على المؤشرات المادية المجرّدة فحسب، وإنما تجاوزها إلى أبعاد روحية ذات منطلقات إيمانية.
(أ) التقوى والعمل الصالح:
إن الحياة الطيبة في المفهوم القرآني حياة تقوم على الاتصال بالله، والثِّقة به، والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه، وفيها الصحَّة والهدوء، والرِّضا والبركة، والسكَن والمودة، وليس المال إلَّا عنصرًا واحدًا ضمن هذه المنظومة المتكاملة. ولكي يحيا المرء هذه الحياة فإن الإيمان والصلة بالله ضرورة لتحقيقها جنبًا إلى جنب مع العمل المادي النافع، قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل: 97]. ففي غير موضع من القرآن الكريم تُبسط الأرزاق وتتسع المعايش -وهي من المؤشرات المادية للتنمية- ببركة الإيمان والتقوى، قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأعراف: 96]، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)[1].
ومما يزيد العطاء ويباركه: شكر المنعم تبارك وتعالى؛ فبالشكر تدوم النعم، قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7]، وكفران النعم وعدم أداء واجب الشكر فيها يمحقها ويعجل بزوالها، قال تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [النحل: 112].
والإشباع الروحي سبب وأساس ثابت لتحقيق التنمية، والجوانب المادية ليست إلا وسائل تتغير بتغير الأزمان، وقد تم تقديم المتغير على الثابت في هذا الزمن، فالتنمية بالمفهوم الوجداني لا مكان لها في مؤشرات وأدلة التنمية بالمفهوم المعاصر الذي تغلب عليه الصبغة المادية البحتة. وكان من نتائج هذا المسار: تسجيل العديد من البلدان المتقدمة لأعلى معدلات الانتحار، وهي تقع في صدارة ترتيب مؤشرات التنمية في العالم، فقد أشارت إحصاءات عام 2021/2022م إلى تسجيل السويد -على سبيل المثال- أعلى معدلات انتحار بين دول الشمال الأوروبي، وهي الدولة الأولى في العالم في دليل التنمية البشرية بمؤشراته المادية المعاصرة.
الإشباع الروحي سبب وأساس ثابت لتحقيق التنمية، والجوانب المادية ليست إلا وسائل تتغير بتغير الأزمان، وقد تم تقديم المتغير على الثابت في هذا الزمن، فالتنمية بالمفهوم الوجداني لا مكان لها في مؤشرات وأدلة التنمية بالمفهوم المعاصر الذي تغلب عليه الصبغة المادية البحتة
(ب) جريان الأجر (استدامة المثوبة):
مما تتفرد به الشريعة الإسلامية: حثّها على الاستثمار عبر بناء ثروات إنتاجية، تنظر بعين الاعتبار للأجيال القادمة، وتقوم على الخلفية الدينية؛ بدوام نفعها وجريان أجرها وثوابها، ومنها:
(1) الصدقة الجارية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)[2]، فجعلت الشريعة جريان الأجر للميت متعلقًا بمنفعة الأجيال القادمة، والجريان هنا بمعنى الاستدامة.
كما جاء عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يغرس غرسًا، إلا كان ما أُكل منه له صدقة، وما سُرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يَرْزؤه أحد إلا كان له صدقة)[3]، وفي رواية: (إلى يوم القيامة). وفي هذه الأحاديث: فضيلة الغرس والزرع، وأن أجر فاعل ذلك مستمر، ما دام الغرس أو الزرع، وما تولد منه إلى يوم القيامة.
(2) الوقف الخيري:
من خصائص الوقف: البقاء والاستمرارية، أي استمرارية الانتفاع بالوقف في أوجه الخير والبر طيلة أزمنة عديدة، واستمرارية الأجر والثواب.
وشرع الإسلام الأوقاف كإحدى صيغ التكافل الاجتماعي التي ترفد مفهوم التنمية المستدامة، وقد عرف المجتمع الإسلامي نظام الوقف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يُمثل قاعدة اقتصادية ومعنوية لبناء مؤسسات المجتمع المدني ودعمها في كافة المجالات؛ حيث يتضمن ذراعًا استثمارية (تحقق أهدافًا استثمارية) وذراعًا أخرى خيرية (تحقق أهدافًا مجتمعية تكافلية) تعملان سويًا بتنسيق وتكامل، كما تنظر بعين الاعتبار للأجيال القادمة.
شرع الإسلام الأوقاف كإحدى صيغ التكافل الاجتماعي التي ترفد مفهوم التنمية المستدامة
ثانيًا: الركائز المادية وتدابيرها:
(أ) التدابير البيئية (تدابير حفظ وحماية الموارد):
(1) حفظ البقاء:
حث الإسلام على صون الموارد وعدم العبث بها والحفاظ عليها من التلف؛ فاعتبر إهلاك الحرث أحد صور الإفساد في الأرض، قال تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]، وقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره: أن الآية نزلت في الأخنس بن شريق، حيث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أنه يريد الإسلام، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحُمُر فأحرق الزرع وعقر الحُمُر[4].
(2) حفظ الأداء:
حرصت الشريعة على سلامة الموارد والحياة الفطرية، فحثت على حمايتها ورعايتها، فأقرت ما عرفه العرب قديمًا بـ “الحِمى”، وهي الأرض الموات التي تحمى من الرعي فيها؛ ليكثر عشبها فترعاها بهائم خاصة.
ونهت عن إفساد البيئة بالتلوث -على اختلاف مجالاته- واعتبرته ضررًا محرمًا؛ لما له من تأثيرات سيئة على موارد البيئة والصحة العامة، وفي حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعًا: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل)[5]، والموارد هي المَجاري والطرق إلى الماء[6]، وجاء في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن يبال في الماء الراكد)[7].
ويدخل في ذلك حكمًا كل ما من شأنه التأثير على هذه الموارد ووظائفها.
(ب) التدابير الاقتصادية (تدابير الإنماء والإثراء):
قدمت الشريعة منهجًا متكاملاً للاستفادة المثلى من الموارد كيفًا وكمًا، على النحو التالي:
(1) استغلال الموارد وتحريم تعطيلها:
حيث دعت الشريعة إلى إحياء الأرض وعمارتها، وحرَّمت تعطيل استغلال مواردها، قال الله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [المائدة: 103]، قال القرطبي رحمه الله: “ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه تكون حبسًا لا يجتنى ثمرها ولا تزرع أرضها، ولا ينتفع منها بنفع، لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة”[8].
(2) الانتفاع بالموارد وفقًا لغايتها الفطرية:
اهتمت تعاليم الإسلام بكيفية استغلال الموارد المتاحة على النحو الذي يحقق المنفعة منها والغاية التي خلقها الله من أجلها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما رجل راكب على بقرة، التفتت إليه فقالت: لم أُخلق لهذا، خُلقتُ للحراثة)[9]، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها سأله الله عنه يوم القيامة)، قيل: وما حقه؟ قال: (أن تذبحها فتأكلها)[10].
(3) تدوير المخلفات وإعادة استخدامها:
حثت الشريعة على الاستفادة الكاملة من الموارد، وعدم هدر أي جزء منها، عبر تدويرها أو إعادة استخدامها، من ذلك ما جاء عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: (لو أخذتم إهَابها) فقالوا: إنها ميتة، فقال: (يطهرها الماء والقَرَظ)[11].
(4) تحريم الاستغلال الجائر للموارد (الإسراف):
نهت الشريعة عن الإسراف في استغلال الموارد ولو كانت وفيرة، قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} [طه: 81]، أي كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم، ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة[12].
وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال: (ما هذا السرف؟)، فقال: أفي الوضوء إسراف؟!، قال: (نعم، وإن كنت على نهرٍ جارٍ)[13]. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: “جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، (فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثمَّ قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم)”[14].
(5) الحث على السعي في طلب الرزق:
حثت الشريعة على العمل والسعي للتكسب، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأنْ يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيَكُف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)[15]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أكل أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده)[16].
حثت الشريعة على الاستفادة الكاملة من الموارد، وعدم هدر أي جزء منها، عبر تدويرها أو إعادة استخدامها
(ج) التدابير الاجتماعية (تدابير المشاركة والعدالة):
يمكن الوقوف على عدة صور من الحقوق الاجتماعية التي ترتبط بمفهوم التنمية المستدامة، ويشكّل حصولها إقامة لميزان العدل الذي حث عليه الشرع الحنيف:
(1) الشراكة والمشاركة:
من أهداف التنمية المستدامة في إعلان الأمم المتحدة: تنشيط الشراكة من أجل التنمية المستدامة، وهو يتوافق مع ما تضمنته تعاليم الشريعة الإسلامية من إرشادات محفزة لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية، فقد دعت نصوص الشريعة في كثير من المواضع إلى التناصح والتعاون، وهي صور متعددة من المشاركة المجتمعية قولاً أو فعلاً، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. وحثت الشريعة على الشورى، قال الله عز وجل: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]، ووصف الله تعالى المؤمنين بذلك فقال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، والتعبير بالجملة الاسمية يفيد الدوام والاستمرار.
(2) المساواة والعدالة:
تضمن القرآن الكريم آيات عديدة تتعلق بالمساواة، تخاطب الذكر والأنثى في قضايا متعددة؛ بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، فقد خاطب القرآن الرجال والنساء على قدم المساواة بشأن العمل الصالح في قوله عز وجل: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء: 124]. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما النساءُ شقائق الرجال)[17]، وهو تقريرٌ لعموم المساواة بين الرّجل والمرأة؛ فالرّجل والمرأة متساويان في الجوهر والأهليّات الإنسانيّة، وفي القواسم والملكات المشتركة، وفي التّكليف وحمل الأمانة. لكنها من منظور الشريعة ليست المساواة المطلقة التي يهتف بها البعض؛ فالعلاقة بينهما على وفق الاختلاف في التّكوين هي علاقة تكامل وظيفيّ. أما “تمكين المرأة” فقد نجحت تعاليم الإسلام في تحقيقه يوم أن حرّم وأدها، ومكّنها من الحصول على كامل حقوقها الاجتماعية والأسرية والاقتصادية والسياسية[18].
كذلك أرست تعاليم الشريعة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع فئات المجتمع دون تمييز؛ مما أسهم في تطوير فكرة العدالة في الحضارة الإسلامية، وقد انعكس ذلك في الفتوحات الإسلامية؛ فلم يعامل المسلمون سكان البلاد الأصلية على أنهم عبيد، بل سعوا إلى تعليمهم وتثقيفهم وجعل هذه البلاد حواضر إسلامية لا تقل شأنًا عن مركز الخلافة. وهو ما أكد عليه الخلفاء الراشدون وحكام المسلمين مرارًا، ومن ذلك ما يُنسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في كلماته إلى والي مصر بقوله: “واعلم أن الرعية طبقات، لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض؛ فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الإنصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجات والمسكنة، وكل قد سمى الله له سهمه، ووضع على حده وفريضته في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله عهدًا منه عندنا محفوظًا”[19].
كلّ ذلك كفيل بتسهيل وصول جميع أفراد المجتمع للموارد دون حرمان، كما أنّ فيه ضمانة لحماية الدول الفقيرة من المخاطر البيئية والصحية والتلوّث الناتجة عن رمي المخلفات في أراضيهم، وهو ما يعبر عنه في الوقت الحالي بمصطلح “العدالة البيئية”. هذا الأمر يمثل في العصر الحاضر تحديًا كبيرًا، فبعض المجتمعات الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال فكرة التمييز الطبقي متجذرة فيها، وكثير من الدول الصناعية تُصَدّر نفاياتها الخطرة عبر الحدود لدفنها في أراضي الدول الفقيرة، في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية، ودون اعتبار للحقوق الإنسانية[20].
(3) التكافل بين الطبقات والأجيال:
» التكافل بين طبقات المجتمع:
اعتنت الشريعة الإسلامية بقضية التوزيع العادل للثروات، والذي يجب أن يراعي كفاية الحاجات لمجموع الأمة، وبعد ذلك يكون التفاوت في الحيازات -تبعًا للعمل والجهد- حتى لا يزداد غنى الأغنياء، فتصبح الأموال والثروات حكرًا عليهم ودُولة بينهم[21]، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، والمعنى: أن جميع ما في الأرض مخلوق للناس جميعًا، لا تستأثر به فئة دون أخرى[22].
وحثت الشريعة الإسلامية على دعم ومساندة الفئات الفقيرة والمهمشة، ويتفق مع ذلك الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة بحسب إعلان الأمم المتحدة؛ حيث أولت الشريعة عناية بالفئات الفقيرة، وجاءت بأعظم نظم التكافل الإنساني، من زكوات متنوعة تكفي لسد حاجة الفقراء، وأوقاف خيرية لصالح الفقراء والمرضى وطلاب العلم والمنافع الخدمية كالمستشفيات وغيرها، وصدقات تطوعية، وغيرها. وهذا العطاء علامة بارزة تؤكد عظمة شريعتنا الإسلامية.
حثت الشريعة الإسلامية على دعم ومساندة الفئات الفقيرة والمهمشة، ويتفق مع ذلك الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة بحسب إعلان الأمم المتحدة
» التكافل بين الأجيال:
سبق الإسلام جميع التشريعات في الاهتمام بحقوق الأجيال القادمة، بينما عمدت قوى الرأسمالية إلى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الموارد والحد من عدد سكان الأرض خوفًا من نقص الموارد؛ فعمدوا إلى الإغراق في صناعة السلاح وإبادة البشر بالحروب.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: “لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر”[23]، وعن إبراهيم التيمي، قال: “لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: “اقسمه بيننا”، فأبى، فقالوا: “إنا فتحناه عنوة”، قال: “فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟!”[24].
ومن صور التكافل: أنّ الشريعة حثت الآباء على ترك أولادهم أغنياء لا فقراء، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنك أنْ تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)[25].
من النماذج الراشدة التي ساقها القرآن في التنمية المستدامة: خطة ذي القرنين في درء ومجابهة خطر اعتداء المفسدين (قوم يأجوج ومأجوج)، وخطة نبي الله يوسف عليه السلام في إدارة الموارد ومجابهة خطر الجفاف الذي ضرب مصر. وقامت كلتا الخطتين على منطلق إيماني واضح، استلهمتا فيه الرشد والعون والتمكين من الله عز وجل
ثالثًا: خطط وبرامج التنمية المستدامة – نماذج راشدة في ضوء القرآن الكريم:
نقل القرآن الكريم نماذج لخطط ناجحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار شمولي يتضمن الأخذ بالأسباب المادية والروحية معًا، بما يلبي حاجة الفرد والجماعة في تناسق تام وتعاون بين جميع أفراد المجتمع.
ومن النماذج الراشدة التي ساقها القرآن في هذا الشأن: خطة ذي القرنين في درء ومجابهة خطر اعتداء المفسدين (قوم يأجوج ومأجوج)، وخطة نبي الله يوسف عليه السلام في إدارة الموارد ومجابهة خطر الجفاف الذي ضرب مصر. وقامت كلتا الخطتين على منطلق إيماني واضح، استلهما فيه الرشد والعون والتمكين من الله عز وجل.

(أ) خطة ذي القرنين في درء ومجابهة المخاطر:
لقد تتبع العبد الصالح ذو القرنين السُبلَ والوسائل التي تعينه على تحقيق أهدافه وطموحاته في الدعوة والإصلاح ونشر العدالة والرحمة، وتضمنت الخطة العديد من التدابير الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرزها:
1- قيادة ذات كفاءة ورؤية إصلاحية:
قال تعالى: {قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا} [الكهف: 95]، أي: ما أعطانيه ربي من الملك والتمكين خير لي من المال، وطلب منهم العمل بأنفسهم وتوظيف إمكاناتهم البشرية والمادية في إنجاز المطلوب. وفي إطار من حسن المعاملة نجده يطلب إعانة القوم له، وكأنه هو الذي يحتاج إليها.
2- العدل:
كان ذو القرنين عادلاً، فسار في البلاد مدافعًا عن الحق ومقيمًا لميزان العدل بين جماعات البشر، {قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا 87 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا} [الكهف: 87-88].
3- التعليم:
أول أسباب التمكين العلمُ والمعرفة، {إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} [الكهف: 84]؛ وقد طلب منهم ذو القرنين رص قطع الحديد بين الصدفين (الجبلين) حتى ساوى بينهما (التخطيط الهندسي)، ثم علمهم ومن خلال العمل والتطبيق المباشر وبأيديهم تقنيات البناء.
4- التعاون والمشاركة الشعبية:
من أسوأ مثالب التنمية في كثير من الدول النامية: عدم مشاركة الشعوب في اتخاذ القرارات التنموية، حيث تفرض عليهم مشاريع التنمية والتي يغلب عليها في بعض الأحيان طابع الفساد، وربما لا تلبي الأولويات واحتياجات الناس الحقيقية، بينما نجد ذا القرنين يشرك الناس في تنمية بلادهم وحل مشكلاتهم.
5- الإدارة والتحسين المستمر:
من خلال تخطيط محكم يتضمن من الوسائل المثلى تحقيق هدف واضح، شارك المستضعفون في عمل جاد، استخرجوا به الحديد من الأرض، قال تعالى: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ} [الكهف: 96]، ثم صهروه {قَالَ انْفُخُوا} [الكهف: 96]، ثم يأمر مجموعة أخرى أن تُعد نحاسًا مصهورًا، ليفرغ منه على الأول، ليصبح السد قطعة واحدة، كما أصبح الشِّعب سبيكة واحدة وجسدًا واحدًا.
(ب) خطة نبي الله يوسف عليه السلام في إدارة الموارد والأزمات:
تضمنت سورة يوسف عدة إشارات مهمة للأهداف التي ترنو إليها التنمية المستدامة، حيث مرت مصر بأزمة بيئية استمرت زهاء خمسة عشر عامًا إبان حكم الهكسوس، فجاء على لسان نبي الله يوسف عليه السلام مؤولاً رؤيا الملك: {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ 47 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ 48 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} [يوسف: 47-49].
وتمثلت أهم مقومات هذه الخطة فيما يلي:
1- الأمانة والعلم:
يقول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55]؛ فقد طلب عليه السلام تولّي أمر هذه الخطّة لأنّه يتصف بالأمانة والعلم.
2- العدل:
لمواجهة المجاعة والفقر قسّم سيدنا يوسف عليه السلام المكاييل بالعدل، وكان يشرف بنفسه على توزيع الأقوات، ولم ينس أهل البلدان التي امتدت إليها المجاعة، قال الله تعالى على لسان إخوة يوسف: {وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ} [يوسف: 65]، وكانوا في بلاد الشام.
3- التعاون والمشاركة:
كان يشارك في خطة نبي الله يوسف الشعب المصري بأكمله، فخطته اعتمدت على التشغيل الكامل للأمة، في الوقت ذاته كان عليه السلام يشارك الناس فيما هم فيه، فكان يأكل ولا يصل إلى حدّ الشبع، وكان يقول: “أخشى إن شبعت أن أنسى الجياع”، وهي صفة من أهم صفات القائد.
4- العمل الدائب الذي لا ينقطع:
يقول الله تعالى: {تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا} [يوسف: 47]، ودأبًا أي بشكل متواصل، مع الجد والاجتهاد.
5- حفظ الموارد من التلف والفساد:
لا يعني العمل المتواصل استهلاك كل نتاج لهذا العمل، وإنما يتعداه إلى حمايته من العوامل البيئية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدانه وتلفه، قال الله تعالى: {فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ} [يوسف: 47]. فحفظ القمح في سنابله من الوسائل الناجحة في الحفظ من التلف أو الإصابة بالأمراض وغزو الحشرات؛ وهذا من شأنه إطالة أمد بقائها صالحة للاستخدام دون تلف.
6- عدم الإسراف في الاستهلاك:
يشير قول الله تعالى: {إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ} إلى ضرورة الاقتصاد الاستهلاكي، إذ أتى بما يأكله الناس ويقتاتون به في موضع الاستثناء وأكده بقوله: “قَلِيلاً”.
7- تحقيق فائض يسمح بإعادة الإنتاج:
يقول تعالى: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ} [يوسف: 48]، وتحقيق هذا الفائض ليس هدفًا في ذاته، وإنما لا بد من حسن توظيف لهذا الفائض في العملية الإنتاجية، بما يساعد على إعادة الإنتاج وتحقيق الرخاء.
ومع الأخذ بالأسباب المادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تكون نسبة التوفيق لعمل الخير إلى الله عز وجل، كما جاء على لسان نبي الله يوسف: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [يوسف: 101].
خاتمة:
التنمية المستدامة وفق التصور الإسلامي لم تكن غاية في ذاتها كما كانت في الفكر الغربي المعاصر، والذي حصرها في بُعدها الاقتصادي المادي، وجعل مقياسها وغايتها زيادة الإنتاج وتحسينه، وهو ما انعكس سلبًا على الأبعاد البيئية والاجتماعية لعملية التنمية؛ فترتب على ذلك استنزاف موارد البيئة وتدهورها وضعف العلاقات والروابط الاجتماعية وانتشار النزاعات اللاأخلاقية، فقد تميزت الشريعة الإسلامية في جانبها الروحي، وبالرغم من اتفاق الأفكار والنظم الوضعية الحديثة مع إرشادات وتعاليم الشريعة الإسلامية في أغلب ما جاءت به في الجانب المادي للتنمية المستدامة، إلا أن المنهج الإسلامي يظل متفردًا بسبقه وشموله وواقعيته وعمق معالجته للمشكلات المتعلقة بهذا الجانب.
وفي ضوء ذلك، يتضح بجلاء أهمية العودة إلى تعاليم الدين الحنيف كاملة، وجعلها منهاجًا في الحياة، والحرص على التنمية الشاملة للإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها.
وضرورة تطوير النظم التربوية والتعليمية والمناهج الدراسية بتضمينها الرؤية الإسلامية لقضايا التنمية المستدامة؛ وتشجيع وتنمية طرق تربوية وشراكات علمية وبحثية تدعم العمل الجماعي والتطبيقي وفق هذا المنظور.
د. صبحي رمضان فرج سعد
أستاذ جغرافية البيئة – كلية الآداب – جامعة المنوفية بمصر
[1] أخرجه أحمد (22438).
[2] أخرجه مسلم (1631).
[3] أخرجه مسلم (1552)، ويرزؤه: ينقصه ويأخذ منه.
[4] تفسير الطبري (3/572).
[5] أخرجه أبو داود (26).
[6] النهاية في غريب الحديث والأثر (5/173).
[7] أخرجه مسلم (281).
[8] تفسير القرطبي (6/338).
[9] أخرجه البخاري (2324).
[10] أخرجه النسائي (4445).
[11] أخرجه أبو داود (4126)، الإهَاب: جلد حيوان عولج بهدف الاستخدام البشري، القَرَظ: حَبُّ شَجَر السَّلَم، يدبغ به الأديم أو الجلد.
[12] تفسير ابن كثير (5/301).
[13] أخرجه ابن ماجه (425).
[14] أخرجه أحمد (6684).
[15] أخرجه البخاري (1471).
[16] أخرجه البخاري (2072).
[17] أخرجه أبو داود (236).
[18] المرأة في وثيقة خطة التنمية المستدامة 2030م، سامية بن قوية، مجلة آفاق علمية، المجلد: 11، العدد: 2، 2019م، ص (219).
[19] نهج البلاغة، ص (89-90)، وينظر: الأبعاد الروحية والمادية للأمن المجتمعي في الإسلام، في: مقومات الأمن المجتمعي في الإسلام، محمد عمارة، سلسلة قضايا إسلامية، العدد (158) القاهرة، 1429هـ-2008م، ص (93).
[20] العدالة البيئية في الإسلام، صبحي رمضان فرج سعد، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 651، الكويت، ذو القعدة 1440هـ – يوليو 2019م، ص (47).
[21] الإسلام والأمن الاجتماعي، لمحمد عمارة، ص (36-40).
[22] دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية وشروط نجاحها، ليوسف القرضاوي، ص (49).
[23] أخرجه البخاري (2334).
[24] محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لابن المبرد، (2/456)، وتشريع تقسيم الأرض المفتوحة بعد القتال كان من الأمور الاجتهادية التي تركها الشرع للناس ليجتهدوا فيها برأيهم؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قسم الأرض المفتوحة مرة، ولم يقسمها أخرى، والضابط في ذلك مصلحة المسلمين، ورفْضُ عمر رضي الله عنه لتقسيم الأراضي المفتوحة كان اجتهادًا صائبًا منه، بُني على بعد نظر؛ لتكون تلك الأراضي وقفًا للأجيال القادمة، يتوارثونها جيلاً بعد جيل، ولو لم يفعل لما بقي لمن يأتي بعدهم شيء، وحتى لا يتجمع المال في أيدي فئة من المسلمين دون غيرهم.
[25] أخرجه البخاري (1295) ومسلم (1628).