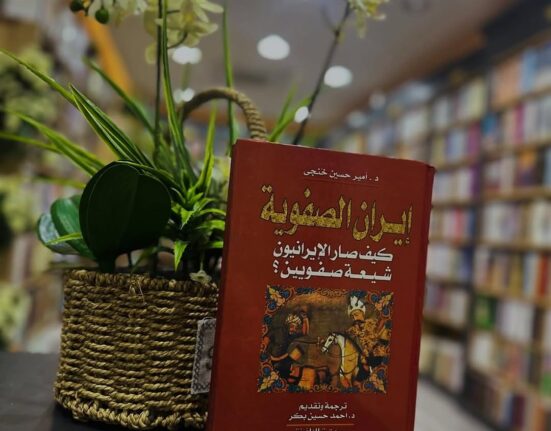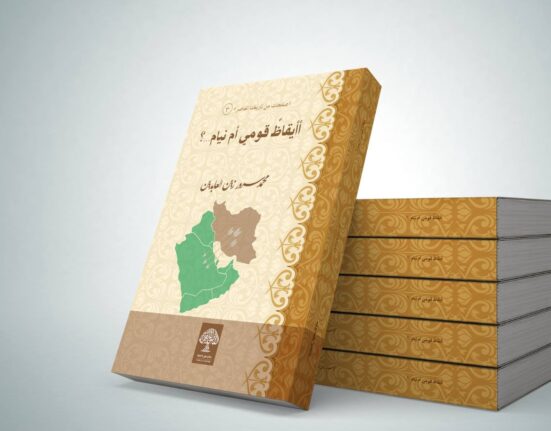تستخدم إيران في خدمة مشروعها في القارّة الأفريقية القوّة الناعمة؛ فتقدّم للدول الأفريقية مختلفَ الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحّية؛ بهدف كسب ولاء السكان المحليين، ونشر الفكر الشيعي، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار وزيادة التوترات الطائفية، مما يهدّد السلم الاجتماعي في البلدان المستهدفة، والمقال الذي بين أيدينا يلقي الضوء على هذه الإستراتيجية.
مدخل:
استخدمت إيران أسلوب القوّة الناعمة[1] في القارّة الأفريقية لخدمة طموحاتها المتعدِّدة، إذ تعدُّ أفريقيا ساحةً خصبةً لتحقيق أهداف إيران غير المتناهية؛ بسبب موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية، وخاصَّة بعد اكتشاف النفط في المنطقة والذي أدَّى إلى ازدياد أهميتها السياسية في المحافل الدولية. لقد سعت إيران من خلال الدعم الاجتماعي والثقافي والديني إلى تحقيق مجموعةٍ من الطموحات الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية في القارَّة، وتُعدُّ هذه الطموحات جزءًا من إستراتيجية أوسع، تهدف إلى تعزيز مكانة إيران بوصفها قوّة إقليمية ودولية، ناهيك عن غايتها ذات الأهمية الكبرى، وهي نشر المذهب الشيعي وتعاليمه في القارّة الأفريقية، مستغلةً لتحقيق هذه الغاية ضعف البنى التحتية؛ التعليمية والصحية والمعيشية التي تعاني منها معظم الدول الأفريقية، وبذلك تظهر إيران بمظهر الحليف للدول المستضعفة والمهمَّشة والباحثة عن العدالة الاجتماعية والإنسانية، وذلك من خلال ادِّعائها خلق نظام عالمي جديد يواجه قوى الغرب المعادية، ونتساءل عمَّا أحدثته تداعيات الثورة الإيرانية في أفريقيا؟ وهل كانت هذه التداعيات مدعاةً لإثارة المخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة؟ وهل كانت سببًا في زيادة التوترات المذهبية لتحقيق أجندات خارجية؟
النفوذ الإيراني في أفريقيا… التمركز والتوسُّع:
منذ بدء الثورة الإيرانية عام 1979م تحوَّل التشيُّع من مجرَّد مذهب ديني محصور ضمن الأبعاد الروحية والمجتمعية إلى مشروع سياسي دولي يخدم أهداف الجمهورية الإيرانية، إذ اعتمدت إيران على إستراتيجية واضحة لتصدير الثورة؛ بهدف توسيع نفوذها الجيوسياسي وتعزيز مكانتها بوصفها قوّة إقليمية ودولية، وقد كانت خطَّتها واضحة للسيطرة على المراكز الإسلامية المؤثِّرة، وإيجاد حلفاء سياسيين في المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية، ولم يكن هذا التحوُّل السياسي محصورًا في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل امتدّ ليشمل مناطق إستراتيجية أخرى في أفريقيا.
ظهرت أطماع إيران في دول أفريقيا منذ زيارة أحمدي نجاد الدبلوماسية عام 2009م لعدد من الدول الأفريقية، “حيث كانت إيران تنظر لأفريقيا بوصفها قارّة المستضعفين، وتمثِّل ثلث مقاعد الأمم المتحدة، وتشكِّل نصف مجموعة عدم الانحياز، وهو ما يعني أنَّها حليف محتمل لها، كما أنَّها في الوقت نفسه تمثِّل ساحة مناسبة لتبنِّي أفكار الثورة الإيرانية”[2]، فتركَّزت أهدافها في دول القرن الأفريقي، والدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر؛ للسيطرة على المنافذ البحرية والبرّية المهمّة، والاستفادة منها في حال حدوث أيِّ صراع في المنطقة، حيث تعدُّ تلك المنطقة محورًا رئيسًا للتجارة العالمية، ومنفذًا مهمًّا يصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقد دعمت مجموعة من الدوافع التنافسية توجّهات السياسة الخارجية لإيران في أفريقيا على اعتبارها منطقة جغرافية تعدُّ من الأغنى في العالم، إذ تتنافس عليها قوى عالمية، وخاصّة الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، فسعت إيران لاستغلال ذلك التنافس لتقديم نفسها كحليف للشعوب الأفريقية في مواجهة ما تصفه بالاستعمار الجديد، وقد سعت إيران إلى استمالة الدول الأفريقية من خلال دعم خطابها التحرُّري الذي يناهض القوى الغربية، حيث قال نجاد في أحد تصريحاته: “هناك دول تدَّعي أنَّها أمم عظمى، وعلى مرِّ السنين تظلم وتستغلّ الدول النامية، وتنهب ثرواتها الطبيعية، وتسلبها حريتها، لقد حان الوقت للدول النامية في آسيا وأفريقيا أن تنهض وترفض الديكتاتورية”[3]، لقد عملت إيران على دعم حلفاء سياسيين وعسكريين في بعض الدول الأفريقية من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي، “ففي العاصمة السنغالية (داكار) يوجد مصنع (خضرو) للسيارات الإيرانية، ومشروع بناء مصفاة للنفط، ومصنع للكيماويات، وآخر للجرارات الزراعية، وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع كلٍّ من موريتانيا وغامبيا ونيجيريا، كما تتمتع إيران بعلاقات قوية مع السودان، فطهران أكبر مصدّري السلاح للخرطوم، كما قامت في عام ۲۰۰۸م بتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وأثناء زيارة الرئيس الإيراني لكينيا وافق على أن تصدّر بلاده نحو ٤ ملايين طن من النفط الخام سنويًا لنيروبي، إضافة إلى تسيير خط طيران مباشر بين عاصمتي البلدين”[4]، كما أبدت إيران اهتمامًا خاصًا ببعض الحركات السياسية ذات الطابع الإسلامي، التي يمكن أن تكون أدوات تخدم أهدافها في تعزيز نفوذها، فقد قامت إيران بتزويد حكومة آبي أحمد بطائرات بدون طيار في إثيوبيا خلال الصراع الدائر في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا صيف 2021م، كما فعلت ذلك مع السودان لتزاحم النفوذ الغربي في المنطقة وتواجه خصومها الإقليميين.
منذ بدء الثورة الإيرانية عام 1979م تحوَّل التشيُّع من مجرَّد مذهب ديني محصور ضمن الأبعاد الروحية والمجتمعية، إلى مشروع سياسي دولي يخدم أهداف الجمهورية الإيرانية، إذ اعتمدت إيران على إستراتيجية واضحة لتصدير الثورة، بهدف توسيع نفوذها الجيوسياسي وتعزيز مكانتها بوصفها قوّة إقليمية ودولية
إستراتيجيات نشر التشيع في أفريقيا:
أ. الاستفادة من الفقر والجهل:
تقدِّم إيران الدعم الاجتماعي والاقتصادي للفئات الفقيرة والمحرومة في دول أفريقيا على الرغم من أنَّها تعاني من ضائقة اقتصادية نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، وتبعًا لذلك فقد “ركَّزت جهودها في أفريقيا والتي بها عدّة دول منتجة لليورانيوم بما في ذلك زيمبابوي والسنغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية”[5]، إذ تعدُّ نيجيريا أكبر مصدِّرة لليورانيوم في العالم. وتشمل إستراتيجية الدعم التي تنتهجها إيران في أفريقيا توزيع المساعدات الغذائية، وتوفير خدمات صحّية مجانية، وتنظيم برامج تعليمية لكافة شرائح المجتمع العمرية، بواسطة منظمات مختلفة مثل “الهلال الأحمر الإيراني”، و”لجنة الخميني للإغاثة”، ويتمُّ توجيه هذه الجهود نحو المناطق التي تعاني ضعفًا في بنيتها التحتية، لتكون تلك المساعدات وسيلة للتقرُّب من السكان وكسب ولائهم، وبالتالي تكون مدخلاً رئيسًا لنشر الفكر الشيعي.
تقدِّم إيران الدعم الاجتماعي والاقتصادي للفئات الفقيرة والمحرومة في دول أفريقيا، على الرغم من أنَّها تعاني من ضائقة اقتصادية، وتبعًا لذلك فقد “ركَّزت جهودها في أفريقيا والتي بها عدة دول منتجة لليورانيوم بما في ذلك زيمبابوي والسنغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية”
ونتيجة لمعاناة الدول الأفريقية من ضعف في أنظمة التعليم وانتشار الأمية؛ تعمل المراكز الشيعية على ملء هذا الفراغ من خلال إنشاء مدارس ومراكز تعليمية تقدِّم التعليم المجاني، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للشباب؛ للدراسة في الحوزات العلمية الإيرانية، ويتمُّ التركيز في هذه البرامج على تدريس الفكر الشيعي وتفسير التاريخ الإسلامي تفسيرًا يتَّفق مع فكرهم ورؤاهم، “على سبيل المثال في عام 2015م كان هناك ٥,٠٠٠ طالب أفريقي مسجلين في فروع «جامعة المصطفى»[6] داخل إيران وخارجها، وقد تخرَّج فيها ٥,٠٠٠ طالب إضافي في عام ٢٠١٦م، كما كان هناك ٤٥,٠٠٠ طالب مسجلين من جميع أنحاء العالم الإسلامي، منهم 10,000 من الإناث. وبين عامي ۲۰۰۷م و ۲۰۱٦م تخرَّج من جامعة المصطفى التي تموّلها إيران لغرض نشر أيديولوجيتها في جميع أنحاء العالم الإسلامي حوالي ٤٠,٠٠٠ رجل دين، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات متاحة عن الميول الدينية لطلاب جامعة المصطفى في الماضي والحاضر فإنَّ إيران تستخدم هذه المؤسسة للترويج للشيعة، وكسب الدعم لنظامها وأيديولوجيتها في البلدان والمجتمعات الإسلامية الأخرى”[7]، فالطلاب الأفارقة الذين يتخرّجون من جامعة المصطفى يتمُّ تدريب بعضهم ليكونوا دعاة ورموزًا لاستقطاب العامة من الشعب الأفريقي، مثل “أحمد عبد الله سامبي الرئيس الأسبق لجزر القمر، وإبراهيم الزكزكي زعيم المنظمة الإسلامية النيجيرية، كلاهما قد تخرَّج في جامعة المصطفى حاملاً المضامين والتوجهات التي رسَّختها سنوات الدراسة والتعاون مع الجامعة”[8]، وتقوم إيران بدعمهم ماديًا ومعنويًا مقابل تجنيدهم بوصفهم دعاة للمذهب الشيعي داخل أفريقيا، وتعدُّ لهم برنامجًا مدروسًا يتمُّ تنفيذه تحت المراقبة والإشراف.
ب. التأثير عبر المراكز الثقافية والدينية:
تشهد أفريقيا تنافسًا كبيرًا بين القوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك إيران التي تسعى إلى نشر الفكر الشيعي في القارّة السمراء من خلال مجموعة من الوسائل الثقافية والتعليمية والاجتماعية. إذ تستخدم إيران المراكز الثقافية لتعزيز الحضور الشيعي وإحداث تأثير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث “نشطت إيران في بناء تيارات شيعية، وبناء الحسينيات ورفدها بالكتب والمصادر، ففتحت مراكز ثقافية وتعليمية شيعية في ساحل العاج، وليبيريا، والكاميرون، ونيجيريا، والسودان”[9] مثل: (المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم وكينيا- منظمة العلاقات والثقافة الإسلامية في كينيا)، ووفرت المصادر التعليمية المتنوعة وعقدت الندوات والمحاضرات ونشرت المطبوعات المجانية أو التي تباع بأسعار زهيدة لضمان انتشارها بين القرَّاء، مستهدفةً بذلك طلاب المدارس والجامعات على وجه الخصوص.
تعتمد إيران في سياستها الخارجية على عقد اتفاقات اقتصادية، سواء مع الحكومات أو مع المؤسسات، وعلى أدوات أيديولوجية معرفية “حيث حاولت إيران المزاوجة بينهما بشكل كبير، من خلال الدور النشط للمراكز الثقافية الإيرانية في الترويج للمذهب الشيعي في أجزاء مختلفة من أفريقيا، حيث أنشأت إيران مؤسسة (والفجر) ومؤسسة (مزدهر) و(جامعة المصطفى العالمية) التي تمارس أدوارًا اجتماعية لا تعليمية فقط”[10] إذ تقوم المراكز الثقافية المنتشرة في الدول الأفريقية بتنظيم فعاليات مختلفة لإحياء مناسبات دينية مرتبطة بالعقيدة الشيعية، حيث يتم دعوة السكان المحليين للمشاركة بهذه المناسبات، لتكون فرصة لتعريفهم بمذهبهم الشيعي وشعائرهم الدينية. كما ساعد على انتشار التشيّع وجود “جاليات شيعية انتشرت وسط المسلمين في بعض الدول الأفريقية… وقد لعبت هذه الجاليات دورًا ملحوظًا في التأثير على العلاقات الإيرانية – الأفريقية على الرغم من اختلاف موقع وقوّة هذه الجاليات”[11]، إذ يمكن أن نقول: إنَّ وجود هذه الجاليات –اللبنانية على وجه الخصوص التي تعتنق في معظمها المذهب الشيعي- شكَّل النواة الأولى للوجود الشيعي في أفريقيا على وجه العموم، “إذ تشير بعض الإحصائيات إلى أنَّ 350 ألف لبناني على الأقل منتشرون عبر القارة، وتمثّل ساحل العاج والسنغال ونيجيريا أهم مراكز الجاليات اللبنانية المقيمة في أفريقيا، بجانب آلاف اللبنانيين الآخرين الذين يقيمون تقريبًا في كلِّ الدول الأفريقية”[12]. كما تستخدم المراكز الثقافية وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والإذاعات المحلية، إلى جانب المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، مثل قناة المنتقم وقناة فدك التي تستقطب جمهورًا واسعًا -ومنه الجمهور الأفريقي- لنشر الفكر الشيعي من خلال الشخصيات المؤثرة دينيًا وثقافيًا واجتماعيًا والتي تستطيع اللعب على وتر العاطفة الدينية لدى عامة الشعب الأفريقي.
تعتمد إيران في سياستها الخارجية على عقد اتفاقات اقتصادية، سواء مع الحكومات أو مع المؤسسات، وعلى أدوات أيديولوجية معرفية
تداعيات المشروع الشيعي على أفريقيا:
أ. زعزعة الاستقرار المذهبي:
أدَّى المشروع الشيعي في أفريقيا إلى انقسامات داخل المجتمعات الإسلامية، التي كانت تتمتع بتجانس مذهبي نسبي، فقد نجحت المراكز الشيعية في استقطاب شرائح من السكان عبر الدعم المالي والاجتماعي، وتقدر “نسبة السكان الشيعة بين مسلمي أفريقيا بما يتراوح بين 5 إلى 10%، وأنّه ثمة أقليات شيعية كبيرة تعيش في عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء أبرزها نيجيريا والكونغو وتنزانيا والسنغال وغانا. وقد شهدت نيجيريا وغانا (وربما تنزانيا) تحديدًا تأثيرًا شيعيًا متجذرًا مقارنة ببقية دول غرب أفريقيا”[13]؛ ما أثار توترات مع الأغلبية السنّيّة، مثل التصادم الدموي الذي حدث في زاريا عام 2015م؛ فقد داهمت سلطات الأمن النيجيرية منزل (الزعيم الشيعي إبراهيم الزكزكي) فجر يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2015م، فاعتقلته بعد أن قتلت عناصرَ من أنصاره -بينهم نائبه محمد محمود تيري- حاولوا الدفاع عنه ومنع الأمن من الوصول إليه، وذلك بعد اقتحامها تجمعًا دينيًا أقامته منظمة الزكزكي في “حسينية بقية الله” بمدينة زاريا”[14]. وقد أوجدت هذه الصدامات حالة من التنافس الطائفي المتصاعد؛ فالتعامل مع النشاطات الدعوية الإسلامية أصبح يروّج له على أنَّه تطرُّف وإرهاب، وهذا ما أتاح الفرصة لينشر الشيعة مذهبهم ومعتقداتهم السلمية مقابل الفكر التكفيري السنّي العنيف (كما يدَّعون)، وقد ساهم ذلك في تغيير الولاءات الدينية والثقافية، وتفكيك الروابط الاجتماعية التقليدية داخل المجتمعات، ما أثَّر سلبًا على السلام الاجتماعي، وأدّى إلى إيجاد بيئة مشحونة تُهدّد استقرار القارّة بشكل عام. “غير أنَّ سياسة نشر التشيّع تجد مواجهة متعدّدة المستويات، تتراوح بين الرفض الرسمي كإغلاق المملكة المغربية السفارة الإيرانية، وغير الرسمي ممثلاً في النشاط الديني والسياسي المناهض للعملية، بوصفها ضربًا لثوابت عقدية وتهديدًا لتماسك المجتمعات، مثلما عبَّر عنه الأزهر الشريف في زيارة نجاد الأخيرة لمصر سنة ۲۰۱۲م، أو العلماء والدعاة كالشيخ يوسف القرضاوي، والأمر نفسه ينطبق على الدول الأفريقية الأخرى، فكثيرون بدؤوا في التنبّه إلى الخطر الإيديولوجي للوجود الإيراني، فالنيجيريون يرفضون تدخُّل إيران ودعمها للإسلاميين والتشيّع في الميدان السياسي النيجيري، وفي السودان بدأت حملات كبيرة للتحذير من التشيع، ودعوات واضحة من الأحزاب السياسية التقليدية وأحزاب جديدة دخلت في حكومة البشير تدعو لفكّ الارتباط بالمحور الإيراني، والسعي لتأمين العمق العربي”[15]، وفي عام 2018م قام المغرب بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران للمرة الثانية، متّهمًا إياها بالتعاون مع حزب الله، بتقديم دعم مالي وعسكري لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية. وكانت المرّة الأولى التي أقدم فيها المغرب على هذه الخطوة في عام 2009م بسبب اتهاماته لإيران بالسعي لنشر المذهب الشيعي داخل المغرب.
أدَّى المشروع الشيعي في أفريقيا إلى انقسامات داخل المجتمعات الإسلامية، التي كانت تتمتع بتجانس مذهبي نسبي، فقد نجحت المراكز الشيعية في استقطاب شرائح من السكان عبر الدعم المالي والاجتماعي
ب. زيادة النفوذ الخارجي:
تصاعد النفوذ الخارجي في القارّة الأفريقية بشكل ملحوظ بعد سعي إيران لنشر مشروعها الشيعي، ما أدَّى إلى إثارة مخاوف قوى إقليمية ودولية أخرى مثل السعودية والولايات المتحدة، حيث ترى هذه القوى في الانتشار الشيعي تهديدًا لنفوذها في أفريقيا، ونتيجة لذلك أصبحت أفريقيا مسرحًا لتجاذبات إقليمية ودولية، فالسعودية ودول الخليج على سبيل المثال سعوا إلى مواجهة النفوذ الإيراني عبر دعم المؤسسات السنّية وإطلاق مبادرات ثقافية ودينية موازية؛ ما أدَّى إلى تصاعد التوترات الطائفية بين السنّة والشيعة في العديد من الدول الأفريقية. بالإضافة إلى أنَّ إيران استخدمت الأراضي الأفريقية لتوسيع وجودها العسكري ودعم حلفائها الحوثيين في اليمن، وهذا ما أدَّى إلى تهديد الأمن في الدول الأفريقية، وإدراك ما يحيط بها من مخاطر تؤثِّر على وحدتها المذهبية، وفي الوقت نفسه تعمل القوى الدولية مثل الولايات المتحدة على الحدّ من النفوذ الإيراني في إطار سياساتها لمواجهة إيران على الساحة العالمية؛ ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في أفريقيا. إنَّ هذه التدخلات أدَّت إلى إضعاف سيادة الدول الأفريقية، حيث أصبحت قراراتها في كثير من الأحيان متأثّرة بتلك التجاذبات، بل تجد الحكومات نفسها مضطرّة للتعامل مع التحدّيات المرتبطة بالاستقطاب الطائفي والتدخّلات الخارجية، ممَّا يعرقل جهودها في تحقيق تنميتها المستدامة.
تصاعَدَ النفوذ الإيراني في القارّة الأفريقية؛ ما أدَّى إلى إثارة مخاوف قوى إقليمية ودولية ترى فيه تهديدًا لنفوذها في أفريقيا، ونتيجة لذلك أصبحت أفريقيا مسرحًا لتجاذبات إقليمية ودولية؛ ما أدَّى إلى تصاعد التوتّرات الطائفية بين السنّة والشيعة في العديد من الدول الأفريقية
خاتمة:
تشكِّل القارّة الأفريقية محورًا مهمًا في الإستراتيجيات الإقليمية والدولية، ما جعلها ساحة تنافس بين القوى المختلفة، بما في ذلك إيران، التي سعت عبر أدوات القوّة الناعمة إلى تحقيق طموحاتها السياسية والدينية والاقتصادية. وقد أظهرت هذه الجهود تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي والوحدة المذهبية داخل المجتمعات الأفريقية، من خلال نشر الفكر الشيعي والتغلغل في البنى المجتمعية مستغلةً ظروف الفقر والجهل التي تعاني منها القارّة. إلى جانب ذلك أثار المشروع الإيراني في أفريقيا توترات طائفية ومذهبية، ما أضعف النسيج الاجتماعي، وزاد من الاستقطاب الداخلي، وفتح المجال لتجاذبات إقليمية ودولية أثرت على سيادة الدول الأفريقية واستقرارها. وفي ظلِّ هذا السياق، يبرز الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الحكومات الأفريقية في تعزيز وحدتها الداخلية، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بعيدًا عن التدخّلات الخارجية. كما أنَّ التعاون الإقليمي والدولي يجب أن يهدف إلى دعم استقرار القارّة لا استغلالها لتحقيق أجندات سياسية أو مذهبية، بما يضمن أمنها وازدهارها في المستقبل، خاصة بعد سقوط النظام في سوريا، إذ يمكننا أن نقول: إنَّ سقوطه يشكِّل تحوّلاً مهمًّا في تغيير موازين القوى الإقليمية والدولية، ما يؤدي إلى تراجع نفوذ إيران في أفريقيا عبر إضعاف دعمها للجماعات الشيعية وتقليص نشاطاتها الثقافية والدعوية، كما سيُفسَّر كضربة رمزية لمشروعها الإقليمي، مما يعزز نفوذ الدول السنّية المنافسة ويدفع الحكومات الأفريقية لتقليل اعتمادها على التحالفات الإيرانية.
د. فاطمة علي عبُّود
دكتوراه في اللُّغة العربيَّة وآدابها، أستاذة اللغة العربية في جامعة سلجوق في تركيا
[1] هو مفهوم صاغه جوزيف ناي من جامعة هارفارد لوصف القدرة على الجذب والضم دون الإكراه أو استخدام القوّة كوسيلة للإقناع.
[2] السياسة الإيرانية والسياسة التركية تجاه أفريقيا، بوزيدي يحيى، دراسة مقارنة، مجلة قراءات أفريقية، العدد (21)، يوليو، 2014م، ص (40).
[3] مقال مترجم: نشاط إيران في شرق أفريقيا، بوابة الشرق الأوسط والقارّة الأفريقية، مجلة قراءات أفريقية، العدد الخامس، يونيو 2010م، ص (108).
[4] السياسة الإيرانية والسياسة التركية تجاه أفريقيا، ص (44).
[5] إيران في أفريقيا… البحث عن موطئ قدم، محمد سليمان الزواوي، قراءات أفريقية، العدد (15)، يناير 2013م، ص (28).
[6] جامعة المصطفى العالمية: تأسست هذه الجامعة عام 1979م، مقرها في مدينة (قم) في إيران، تنتشر فروعها في عدد من دول العالم، أكثرها في أفريقيا، تسعى إلى إعداد الباحثين والأساتذة ذوي الخبرة والكفاءة، ونشر تعاليم الدين الإسلامي من منظور المذهب الشيعي ضمن أنشطتها الثقافية المختلفة.
[7] سياسة إيران الأفريقية في عهد روحاني، انكفاء إقليمي أم إعادة ترتيب أوراق؟ لطفي صور، مجلة قراءات أفريقية، العدد (47)، يناير 2021م، ص (123-124).
[8] جامعة المصطفى في أفريقيا… النشأة ومحددات الدور والتأثير، محمد أحمد عابدي، مجلة قراءات أفريقية، العدد (60)، إبريل 2024م، ص (15).
[9] بعد رحيل رئيسي.. ما مستقبل إيران في قارة الفرص الذهبية؟ غدي قنديل، مركز الدراسات العربية الأوراسية، 31 مايو 2024م.
[10] سياسة إيران الأفريقية في عهد روحاني، انكفاء إقليمي أم إعادة ترتيب أوراق؟، ص (124).
[11] العلاقات الإيرانية الأفريقية، اتجاهات الخطاب الصحفي، هالة أحمد الحسيني، مصر العربي للنشر والتوزيع، 2019م، ص (49).
[12] التشيّع في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء: دراسة مقارنة، بوزيد يحيى، موقع الراصد، 17 ديسمبر 2017م.
[13] المنظّمات والمراكز الشيعيّة في غرب أفريقيا وشرقها… قراءة أولية في خرائط الانتشار والتأثير، منصّة الدراسات الأمنية وأبحاث السلام، 26 يوليو 2024م.
[14] إبراهيم الزكزكي.. “آية الله” الأفريقي، الجزيرة نت، 17/12/2015م.
[15] السياسة الإيرانية والسياسة التركية تجاه أفريقيا، ص (45-46).