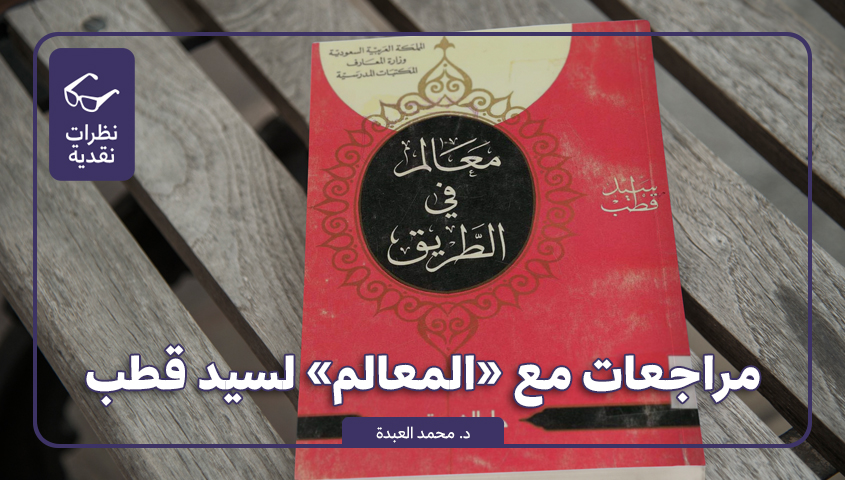يُعدُّ سيد قطب من أكثر أعلام الدعوة الإسلامية المعاصرين تأثيرًا وتجاذبًا بين التيارات المختلفة، فصِدق عباراته وقوة كلماته التي عزَّزتها تضحياته الجسيمة في سبيل الدعوة ومقاومة الطغيان؛ جعلت لكلماته أثرًا بالغًا على سامعها وقارئها. كما أنَّ أطروحاته كانت جريئةً ذات لغةٍ أدبيةٍ راقية، تدعو إلى مواجهة الباطل والتصدّي للطغيان. وحيث كان للعديد من عباراته أثر في تشكيل عدد من التصورات والاجتهادات التي تبنّتها الحركات والتيارات الإسلامية، كان لا بد من عرضها على ميزان الشريعة لنقدها وتمحيصها، وفي هذا المقال يتناول الكاتب شيئًا من ذلك.
مقدمة
لا أحد يجهل مكانة سيد قطب؛ فهو داعية ومفكر إسلامي كبير. وقد أثرى المكتبة الإسلامية مبكرًا بمقالاته وكتاباته الواضحة الجريئة مثل: معركة الإسلام والرأسمالية، السلام العالمي والإسلام، العدالة الاجتماعية في الإسلام. كما أثرى الدراسات القرآنية بكتابيه: (التصوير الفني في القرآن)، و(مشاهد القيامة في القرآن).
وكان كتابه (في ظلال القرآن) قمّة عطائه ودرّة إنتاجه، ثم ظهر كتاب (معالم في الطريق)، وكان لهذا الكتاب دور كبير وتأثير واضح على شباب الحركة الإسلامية، «والكتاب صِيغَ بأسلوبٍ يمتاز بالوضوح والقوة والجِدِّ والجمال واللهجة الصادقة، وأغلى ما فيه هذه الروح الاستعلائية الاعتزازية التي تمثل مرحلةً جديدةً من مراحل الدعوة الإسلامية المعاصرة»[1].
ومن أسباب تأثير الكتاب أنّه ظهر في وقت كان كاتبه فيه معارضًا للسلطة في بلده، بل سجينًا في زنازينها، فقامت السلطة بمصادرة الكتاب، وحاولت منع انتشاره، حتى دفع الكاتبُ حياته ثمنًا للصمود أمام الظلم، وذهب إلى ربه شهيدًا بإذن الله.
استُقبل هذا الكتاب من فئاتٍ كثيرةٍ وَجَدت فيه ضالَّتها المنشودة ورائدَها المأمول واعتبرته الطريق الصحيح، وتعاملت معه بمثالية كبيرة، وحتى لو وجدت بعض الإشكالات والمؤاخذات فيه.
والعدل والإنصاف يقتضي الاعتراف بما في الكتاب من الحق والبيان الواضح، مع بيان الإشكالات التي فيه ومراجعتها، بما لا ينقص من قيمة الكتاب ولا من قدر المؤلف، ولسنا بحاجةٍ للتأكيد على حاجة الدعوة الإسلامية إلى المراجعات بين الفترة والأخرى، وما يجري في هذه الأيام لدى بعض الحركات الإسلامية يُثبت ذلك.
والمراجعات لا تكون في ثوابت الدين والملة، ولكن في فهم النصوص وتطبيقها على الواقع، وفي طريقة عرض الإسلام وأساليب الدعوة، بما يعين على ردِّ المسلمين إلى حقيقة الإسلام، وفيما يأتي اثنان من المواضع التي تحتاج للمراجعة والنظر.
المراجعات لا تكون في ثوابت الدين والملة، ولكن في فهم النصوص وتطبيقها على الواقع، وفي طريقة عرض الإسلام وأساليب الدعوة، بما يعين على ردِّ المسلمين إلى حقيقة الإسلام
الموضع الأول:
يقول سيد قطب رحمه الله في فصل (جيل قرآني فريد):
«لقد كان الرجل حين يدخُلُ في الإسلام يخلع على عتبته كلَّ ماضيه في الجاهلية، كان يشعُرُ أنه بدأ عهدًا جديدًا، منفصلاً كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية، كان يقفُ موقف المستريب الحذِر الذي يُحسُّ أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام، كانت هناك عزلة شعوريةٌ كاملةٌ بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه، تنشأ عنها عزلةٌ كاملة في صِلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله، فهو قد انفصل نهائيًا من بيئته الجاهلية، كان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية عُرفها وتصورها وعاداتها وروابطها …»[2].
هكذا صوّر سيد قطب رحمه الله الشخصية العربية يومها: تنسلخ من كل ماضيها بما فيه من العادات والأعراف والقيم ليصوغه القرآن صياغة مستأنفة (من الصفر) وكأنه صفحة بيضاء، وقد مُحيت كل ثقافته السابقة.
هل هذا صحيح؟ وهل كل الروابط والقيم وكل ما كان قبل البعثة المحمدية هو رجس يجب أن تحصل معه المفاصلة التامة؟
الأدلة الشرعية تقول غير ذلك:
أولاً: القرآن الكريم لا يقطع ما قبله، وقد أنزله الله سبحانه ليتمِّم الرسالات السماوية، ويكون الرسول ﷺ خاتم الأنبياء والرسل، وهكذا تتصل حلقات التوحيد «وكلُّ قيمة تمتُّ إلى الحق والخير هي قيمة معترفٌ بها في نسق الإسلام القيمي، لا يمنعه في ذلك مانع تاريخي، لأنه فرع من شجرة التوحيد الأول، وكل بقية من خير كان عليه الجاهلون ستجد تمامها في الإسلام، والقرآن الكريم يدعو الرسول ﷺ والمؤمنين معه للاعتبار بشهادة التاريخ الذي يقدم القصص القرآني نماذج له، والغرض العام من القصص القرآني أن يصل الرسولَ ﷺ ومَن معه ومَن بعده مِن المؤمنين بالعمق التاريخي، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: ٥١]»[3].
والقرآن الكريم يستشهد بعالِمٍ مِن علماء بني إسرائيل على نبوة محمد ﷺ: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٤٣]. ويحتكم إلى العُرف الأخلاقي المعروف بين الناس، فقوله تعالى: ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: الذي يعرفونه أنه من الفطرة والأخلاق الحسنة.

وفي صحيح مسلم عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله ﷺ: أرأيتَ أمورًا كنت أتحنَّث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله ﷺ: (أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير) وفي رواية له: «قلتُ: فوالله لا أدع شيئًا صنعته في الجاهلية إلا فعلتُ في الإسلام مِثلَه»[4].
قال الإمام النووي: «الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثابُ على ما فعله من الخير»[5].
الإسلام لا يقطع قيم الخير ولكن يضعها في القصد التوحيدي .. وقد كان عند العرب في الجاهلية شيم وأخلاق حميدة، وبقية من سنن الفطرة، فأقرَّها الإسلام ولم يبطلها
فالإسلام لا يقطع قيم الخير ولكن يضعها في القصد التوحيدي، أما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: «فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي ﷺ فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضتُ يدي، قال: (مالك يا عمرو؟) قلت: أردت أن أشترط، قال: (تشترط بماذا؟) قلت: أن يُغفر لي»، قال: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها)[6]. ففيه أنَّ عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يسأل أن تُغفر له الآثام التي ارتكبها في الجاهلية، وأما حكيم بن حزام فكان يسأل عن أعمال الخير التي فعلها في الجاهلية، وقد أوضح لهما الرسول ﷺ أن الدخول في الإسلام لا يجُبُّ الشرَّ والخيرَ معًا، وإنما يستصحب الخير والحق في القيم والأعمال والعلاقات، ويثيب عليها ويبطل الباطل.
وكان عند العرب في الجاهلية شيم وأخلاق حميدة فأقرَّها الإسلام، مثل (القَسامة)[7]، وكانت الدية زمن عبد المطلب مئةً من الإبل وأبقاها النبي ﷺ[8]، وكان عندهم بقية من سنن الفطرة.
وعندما تقول السيدة خديجة رضي الله عنها للرسول ﷺ: (كلا والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَلَّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق)[9] فهذا يدلُّ على أنَّ هذه الصفات كانت موجودةً عندهم.
وعندما أُسرت سفّانة بنت حاتم الطائي قال الرسول ﷺ: (خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق)[10]، وأبوها مات قبل أن يُدرك الإسلام.
ثانيًا: هل يستطيع الإنسان أن ينسلخ تمامًا من ماضيه ويكون صفحة بيضاء، وليس لثقافته السابقة أي تأثير؟ فهذا الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري يقول لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء! فيقول الرسول ﷺ لأبي ذر رضي الله عنه: (إنك امرؤ فيك جاهلية)[11] أي: فيك خصلة من خصال الجاهلية، ومن الأمثلة على ذلك: هذه المُلاحاة التي وقعت في مسجد رسول الله ﷺ بين الأوس والخزرج وظهرت فيها الحمية القبلية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وهي تروي قصة الإفك: «قال رسول الله ﷺ وهو على المنبر: (يا معشر المسلمين مَن يعذرني مِن رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا، وما كان يدخُلُ على أهلي إلا معي)، فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قالت: فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعَمر الله لنقتلنه، فإنَّك مُنافق تُجادل عن المنافقين، فتثاور الحيّان حتى همُّوا أن يقتتلوا، فلم يزل رسول الله ﷺ يُخفضهم حتى سكتوا»[12].
ثالثًا: لقد شاءت الإرادة الربانية اختيار هذا الجيل من العرب ليكونوا أصحاب نبيه ﷺ، كما قال الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود t: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه …»[13].
إنه جيل أقرب للفطرة، وبالرغم من وقوعهم في الوثنية إلا أنهم يحملون تراثًا أخلاقيًا نادر المثال، وهذه الفضائل البارزة عندهم أحياها الإسلام وحَوّر الأهداف ليربطها بمقاصد التوحيد، فالشجاعة الموجودة عندهم -وهي خلق عظيم- زوَّدها القرآن بوجهةٍ محدّدة، ولم تفقد بالإسلام ذرةً من طاقتها الأصلية، وصارت شجاعة سامية مهذَّبة، والحمية والأنفة كانت إلى درجة الغُلُو فعدَّلها الإسلام وجعلها غضبًا لدين الله، وكذلك الكرم وغيره من الفضائل، فكلُّ بقيةٍ من خير كان عليه أهل الجاهلية ستجد تمامها في الإسلام.
لقد وجد الرسول ﷺ حوله أُناسًا يحملون صفات الرجولة والمروءة والصدق.
ولنا أن نسأل: كيف نعلِّل إسراع أبي بكر رضي الله عنه إلى الإيمان من أول يوم؟ لم يتردد ولم يتلعثم، هل هو إيمان العاطفة فقط أم هو إيمان الذكاء والفطنة والعقل الكبير أيضًا؟ لا شكَّ أنه كان يفكر في أحوال مكة ووثنية مكة، والمعروف عنه أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية لا هو ولا عثمان رضي الله عنهما، ثم كيف نعلل إسلام كبار الصحابة على يد أبي بكر: عثمان والزبير وعبدالرحمن بن عوف وطلحة وسعد، أليس لأنَّ أصداء القرآن تجاوبت مع شيءٍ مدفونٍ في أعماقهم، أليس لأنهم وَجَدوا أنفسَهم في هذا الدين؟
أسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة، وفي السنة الثامنة قاد معركة مؤتة بعد استشهاد القادة الثلاثة وأنقذ المسلمين من مأزق كبير، إنه عسكري قائد بفطرته، فهل يترك خبرته العسكرية التي كانت في الجاهلية؟، وقبيلته: بنو مخزوم كان اختصاصهم في قريش (اللواء) أي الاهتمام بالجانب العسكري، وشخصية مثل عمر بن الخطاب من بني عدي كان اختصاصهم في قريش القضاء والفصل في الخصومات، ومنذ أسلم أعز الله به الإسلام كما في رواية البخاري عن عبد الله بن مسعود[14].
قال ﷺ: (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)[15].

وجد العرب في هذا الدين البساطة والوضوح الذي هو من طبيعة حياتهم وما يعرفونه من نفوسهم. شخصيات كبيرة أسلمت وهي قيادية في الجاهلية وصارت قيادية في الإسلام أيضًا.
لماذا يؤكد سيد رحمه الله على مقولته: إنَّ الصحابي عندما يدخل في الإسلام بعد أن كان في جاهلية يتخلص من كل ماضيه، يبدأ عهدًا جديدًا منفصلاً كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية؟ يؤكد ذلك لأنه ينسجم مع أطروحته التي قارن فيها بين الحركة الإسلامية اليوم وما وقع في السيرة النبوية في بداية الدعوة، ووجه الشبه: أنه في بداية الدعوة يوجد مجتمع جاهلي يخرج منه أفراد يتربون بالقرآن والسنة ثم يتكون مجتمع إسلامي يمهد لبناء دولة.
وكذلك اليوم: المجتمع مجتمع جاهلي (كما يراه وكأنه لا فرق بينه وبين المجتمع الجاهلي قبل البعثة) نستخرج منه أفرادًا ينفصلون كليًّا عن هذا المجتمع ويؤسِّسون المجتمع الإسلامي «المهمة هي نفسها: بناء العقيدة على مهل ولفترة طويلة حتى تتشربها العقول والقلوب ثم المجتمع المسلم الذي يتولى في مرحلة لاحقة بناء الدولة»[16].
الخيرية موجودة عند المسلم، ولكنها تتأثر بعوامل ومتغيرات كثيرة نابعة من البيئات التي يعيش فيها، فالواجب أن نتدرَّج بهذه الشخصية إلى الغايات العليا، لا أن نضع صورة مثالية مطلقة ثم لا تتحقق، أو تتحقق عند أفراد قلائل ثم يعقب ذلك الانكماش والتجمع الهامشي
الموضع الثاني:
يرى سيد قطب حسب أطروحته هذه إمكانية إخراج جيل كجيل الصحابة، جيل يتحمل المسؤولية عن إقامة هذا الدين، بل يتحمل مسؤولية قيادة البشرية الضالة الشاردة الغارقة في الآثام، بشرط أن يقتصر تلقي هذا الجيل من النبع الصافي وحده: القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن يكون هذا التلقي للتنفيذ العملي وليس للبحث والدراسة والمتاع العقلي، وأن يعتزل هذا الجيل الجاهلية المحيطة به وسماها (العزلة الشعورية).
يقول مستدلاً على ذلك: «إنَّ قرآن هذه الدعوة بين أيدينا، وحديث رسول الله ﷺ وهديه العملي بين أيدينا كما كانت بين أيدي ذلك الجيل الأول الذي لم يتكرر في التاريخ، ولم يغب إلا شخص رسول الله ﷺ، فهل هذا هو السر؟ (أي لماذا لم يتكرر في التاريخ) لو كان وجود شخص رسول الله ﷺ حتميًا لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للناس كافة، وما جعلها آخر رسالة، ولكن الله سبحانه تكفّل بحفظ الذكر وعلم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول الله ﷺ، وإذن فإن غيبة شخص رسول الله ﷺ لا تفسر تلك الظاهرة»[17].
يؤكد الدكتور جعفر شيخ إدريس أنَّ مقدِّمات هذه الحجَّة لا تؤدِّي إلى نتيجتها، ويقول: «وإذن وجود شخص الرسول ﷺ ليس حتميًا لقيام هذه الدعوة، وإذن فغيبة شخصيته ﷺ لا تمنع من استمرار هذه الدعوة، وهذه حجة صحيحة، … لكن النتيجة التي انتهى إليها الكاتب الفاضل هي: (وإذن فإن غيبة شخص الرسول ﷺ لا تفسِّر تلك الظاهرة) يعني ظاهرة عدم تكرار جيل الصحابة.
إنَّ عدم ضرورة وجود شخص الرسول ﷺ لاستمرار الدعوة لا يعني عدم ضرورته لوجود جيل كجيل الصحابة، فالأمران مختلفان، اللهم إلا إذا قلنا إنَّ الدعوة لا تقوم ولا تؤتي ثمارها إلا بوجود جيل كجيل الصحابة. ولكن هذا سيفضي بنا إلى القول بأنَّ الدعوة نفسها توقفت منذ أن انتهى جيل الصحابة لأنَّه لم يأت بعده جيلٌ مثله، وهو أمر لا يقول به الداعية الفاضل ولا أحد من المسلمين.
وهناك نصوص تدلُّ على أنَّ وجود شخص الرسول ﷺ كان ضروريًا لتخريج ذلك الجيل، ففي حديث حنظلة الأسدي قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: (وما ذاك؟) قلت: يا رسول الله نكون عندك، تذكِّرنا بالنار والجنة حتى كأنَّا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا، فقال رسول الله ﷺ: (والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ثلاث مرات[18].
«وهذا الذي شعر به حنظلة وأيَّده أبو بكر رضي الله عنهما شعورٌ طبيعي، فإنَّ الواحد منّا يعرف من تجربته أنه يقرأ كلامًا فلا يتأثَّر به، فإذا سمعه من إنسان تأثَّر به، فكيف بمؤمن صادق يسمع القرآن والحكمة من في رسول الله ﷺ ويعرف الحوادث والمناسبات التي نزلت فيها كثير من آيات الله وأحاديث رسول الله ﷺ، ويرى هذا الرسول ويخالطه ويصحبه ويفهم عنه من غير ترجمان ولا حاجة إلى شروح وتفاسير، أفيكون حاله كحال إنسان يقرأ القرآن والسنة من الكتب، الفرق كبير بين جيل شاهد رسول الله ﷺ وتربى على يديه، وجيل لم يره ولا رأى من رآه»[19].
وهناك فرق بين رجل الفطرة (العربي قبل البعثة النبوية) الذي لم يخضع للطغيان ولم يفسد بأسه ولا انتُقص من استقلال شخصيته، ولم تفسده المدنيات بمظاهرها الشكلية وفلسفاتها الجدلية، فإذا جاء الإسلام بالتوحيد الخالص والشرائع والآداب صاغ هذه الشخصية التي دخلت دورة الحضارة الإسلامية فكانت نورًا على نور. وبين الإنسان الذي يعيش في فترة ضعف هذه الحضارة، هنا قد يكون الفرد ذكيًا وصادقًا، ولكن الأخلاق أصابها نوع من العطب، وقد يكون المسلم نقيًا لا ينقصه الإخلاص، ولكنه لا يستطيع مجابهة مشاكله وكيفية حلِّها، ويكون متعلمًا حاصلاً على الشهادات، لكنه تنقصه الفاعلية والإنتاجية[20].
الخيرية موجودة عند المسلم لم تنقطع، ولكن هناك عوامل كثيرة نابعة من البيئات التي يعيش فيها لها تأثير عليه، وهناك متغيرات كبيرة لها تأثير أيضًا، فالواجب أن نتدرَّج بهذه الشخصية إلى الغايات العليا التي نسعى إليها، لا أن نضع صورة مثالية مطلقة ثم لا تتحقق، أو تتحقق عند أفراد قلائل ثم يعقب ذلك الانكماش والتجمع الهامشي.
قد يريد بعض الكتاب مدح الإسلام وأنه أنقذ العرب من الجهالة والضلالة، لكنه مع هذه النية الحسنة يجرِّد الشخصية العربية يومها من كلِّ الفضائل ليُثبت عَظَمة الإسلام في بناء الإنسان
سؤال لا بدّ منه:
قد يستغرب البعض ويتساءل: لماذا نطرح هذا الموضوع الآن؟ وما الفائدة منه، والناس قد قرؤوا لسيد واستفادوا منه؟
وأقول: نعم سيد قطب مفكِّرٌ كبير وصاحبُ مدرسةٍ أدبية، ولكنَّ الدعوة الإسلامية بحاجةٍ إلى المراجعات بين كلِّ فترةٍ وأخرى، وهذا من النصيحة والعدل والإنصاف، وهذه بعض الأسباب للكتابة حول بعض فصول (معالم في الطريق):
من سنن الله سبحانه أنَّ الأمر العظيم يسبقه تمهيدات ومقدمات، وقد اختار الله سبحانه لنبيه ﷺ هذا الجيل من البشر الذي يملك الاستعداد لحمل هذه الرسالة، وقد يريد بعض الكتاب مدح الإسلام وأنه أنقذ العرب من الجهالة والضلالة، لكنه -مع هذه النية الحسنة- يجرد الشخصية العربية يومها من كل الفضائل ليثبت عظمة الإسلام في بناء الإنسان، ولكن الذي لا يملك الاستعداد للأمر العظيم لا أظن أنه سينقلب بين ليلة وضحاها من شخصية ضحلة إلى شخصية رائدة، ولنتصور أنه لو كان حول محمد ﷺ أناس كبني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] هل كان لدولة الإسلام أن تقوم؟ وهل كان الإسلام سينتشر في الآفاق؟
إنَّ دراسة الفترة السابقة للبعثة النبوية ضرورية لمعرفة واقع هذه المجتمعات وهذه القبائل التي ستكون هي أول من سيكلَّف بهذه الرسالة وحملها إلى العالم، ومن الملفت للنظر أنَّ ابن إسحاق عندما كتب السيرة قسمها إلى: المبتدأ والمبعث والمغازي، ويقصد بالمبتدأ: ما قبل البعثة.
أعطى سيد رحمه الله للشباب صورةً مثالية، وأنهم -حسب منهجه- هم المجتمع الإسلامي ولو كان عددهم قليلاً، وهم الطليعة الذين سيقودون البشرية، كانت تطبيقات بعضهم لهذا التصور وربما حسب ثقافتهم وقدرتهم -كما شاهدناها- انعزالية استعلائية، وربما يقال: لقد فهموا كلامه بطريقة خاطئة، وقد يكون هذا، ولكن سيدًا عندما أتى بمفاهيم وعبارات قوية جاء بها مجملة حمّالة أوجه، ولم يفسرها ولم يوضح معانيها بالتفصيل.
أراد سيد أن تكون التربية من النبع الصافي قبل أن تختلط الينابيع وتدخل حضارات القدماء وفلسفاتهم وأساطيرهم ولاهوتهم وهذا صحيح، ولكن الصحابة كانوا يتلقون القرآن والسنة مباشرة من الرسول ﷺ، وإذا حصل أي إشكال كانوا يسألونه، أمّا بعد الرسول ﷺ فقد صار مع القرآن والسنة ما بني عليهما مثل الإجماع والقياس ثم الاجتهاد لأهل العلم في واقع الدعوة ومقاصد الشريعة.
مقولة: «خذوا الإسلام جملة أو دعوه» صحيحة من حيث الاعتقاد الجازم بأنَّ هذه الشريعة هي الحق والاستسلام لها، أما في التطبيق العملي فالأمر متعلق بالاستطاعة وعدم وجود الموانع القاهرة
عندما أصرَّ سيد على هذه الحضانة الفكرية كما كانت في الفترة المكية، ثم انتقد أيَّ عمل مرحلي يكون خطوة على الطريق، مما يكثر فيه الخير ويقل فيه الشر، واعتبر ذلك من العوائق لمسيرة الدعوة؛ فالكتابة حول الاقتصاد في الإسلام مثلاً أو مزايا الشريعة في القضية الفلانية، كل هذا لا داعي له، فهذه المشاكل الموجودة لسنا نحن المسلمين سبب وجودها فلماذا نشغل أنفسنا بإيجاد الحلول لها؟! وعندما يقوم المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية فسوف يقبل المسلم كل النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأنها كلها من عند الله، ولذلك فقول سيد رحمه الله: «خذوا الإسلام جملة أو دعوه» صحيح من حيث الاعتقاد الجازم بأنَّ هذه الشريعة هي الحق والاستسلام لهذا الدين، أما في التطبيق العملي فالأمر متعلق بالاستطاعة وعدم وجود الموانع القاهرة فلا يقال: «خذوا الإسلام جملة أو دعوه» بل يستفاد من الزمن لقطع المراحل الضرورية.
وختامًا:
فإنَّ حركة المراجعة والنقد والتقويم ينبغي أن تستمرَّ، فهي حقٌّ لله تعالى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيضاح الحق، وحقٌّ للعباد بالنصح لعامة المسلمين ولصاحب الرأي نفسه، مع حفظ مكانة أصحاب الآراء والمواقف العلمية أو الدعوية، دون غمطٍ لحقِّهم، أو مغالاةٍ في نقدهم أو الحكم عليهم، والله من وراء القصد.
[1] نظرات في منهج العمل الإسلامي، لجعفر شيخ إدريس، ص (٤٦).
[2] ينظر: معالم في الطريق، ص (١٩-٢٠).
[3] أصول الفكر السياسي في القرآن المكي، لعبد القادر التيجاني، ص (٤٨-٥٠).
[4] أخرجهما مسلم (١٢٣).
[5] شرح النووي على صحيح مسلم (٢/١٤١).
[6] أخرجه مسلم (١٢١).
[7] القَسامة هي الأَيمان المكررة في دعوى القتل التي ليس فيها بيِّنة.
[8] الأوائل، للعسكري، ص (٢٨).
[9] أخرجه البخاري (٣).
[10] السيرة النبوية، لابن كثير (١/١٠٩).
[11] أخرج البخاري (٣٠) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «ساببتُ رجلاً فعيَّرتُه بأمه، فقال لي النبي ﷺ: (يا أبا ذر أعيرتَه بأمه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية). قال الحافظ ابن حجر: «قيل: إنَّ الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر» (فتح الباري: ١/٨٦).
[12] أخرجه البخاري (٤٧٥٠).
[13] أخرجه أحمد (٣٦٠٠).
[14] أخرج البخاري (٣٦٨٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ما زلنا أعزةً منذ أسلم عمر».
[15] أخرجه البخاري (٣٣٨٣) ومسلم (٢٦٣٨) واللفظ لمسلم.
[16] مراجعات الإسلاميين، لبلال التليدي، ص (٣٢٦).
[17] معالم في الطريق، ص (١٤-١٥).
[18] أخرجه مسلم (٢٧٥٠).
[19] نظرات في منهج العمل الإسلامي، لجعفر شيخ إدريس، بتصرف يسير (٥٣).
[20] مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، لمحمد العبدة، ص (٥٧).
د. محمد العبدة
مفكر وداعية، دكتوراه في التاريخ الإسلامي، عضو المجلس الإسلامي السوري، نائب رئيس رابطة علماء المسلمين.