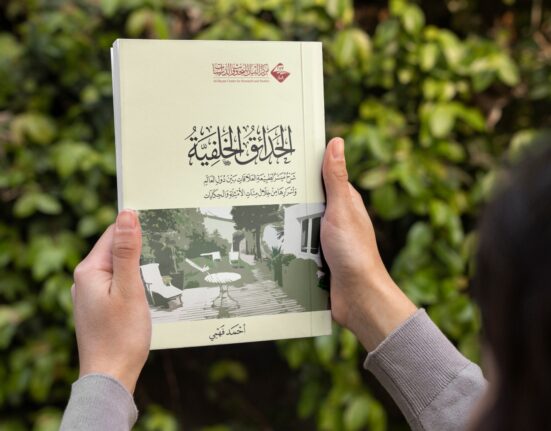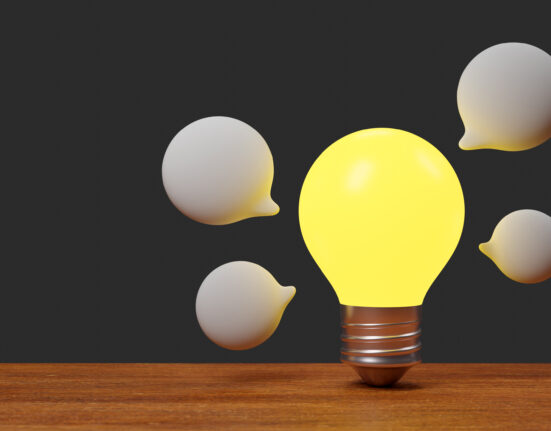يدقُّ الصالحون اليوم ناقوس الخطر مُحذِّرين من انتشار ميلٍ نحو الإلحاد بين شباب المسلمين، وهذه الظاهرة تزداد في الدول المنكوبة بويلات الحروب والتخلف والانهيار الاقتصادي، فما هي أسباب هذا الإلحاد وكيف تسلل إلى نفوس الشباب؟ وكيف نقي شباب المسلمين من الوقوع في براثنه؟ يحاول هذا المقال تناوله وإلقاء الضوء عليه
كثيرًا ما نسمع عن أناس آمنوا بعدما كانوا في ريبةٍ من أمرهم، وأيقنوا بعدما كان الشكُّ يستحوِذ على تفكيرهم، وهذا طريق سليم للوصول للإيمان الحق، وهذا المنهج مستوحى من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في إثارة الشكوك والتساؤلات حول المعبودات من دون الله تعالى وصولاً إلى الإيمان بالله، لكن غير الطبيعي أن يكون الحال معكوسًا، فالنكوص من الإيمان إلى الريبة يستدعي منا وقفة لنرى أسبابها ونتائجها وأين مكمن الخلل فيها، كما يقول تعالى في محكم تنزيله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥].
الإلحاد بين الماضي والحاضر:
ليس من الحكمة أن نتجاهل المشاكل التي تُواجه مجتمعنا بهدف الإبقاء على صورته الناصعة، فنحن نعيش اليوم أزمة يواجهها الشباب في معتقداتهم وقيمهم نتيجة تفرق العالم الإسلامي وضعفه وتراجعه، وهذا الحال أوجد قدرًا من التشويش العقائدي عند بعض الشباب وفقدان الثقة بما يؤمنون به، وكبتُ هذا التشويش خوفًا من مجتمع يرفض الإقرار بما يجول في نفسه يؤدي إلى تحوّل هذا التشويش إلى مصدر لشكٍّ ينهش عقل وقلب الشاب، والغلاف الذي يغطيه لا يبرح أن يزول عندما تغيب عنه الرقابة الاجتماعية، وعند أول اختبار حقيقيّ يواجهه، كما نشاهد عند بعض المهاجرين لبلاد غير المسلمين وتعرضهم لأفكار ومعتقدات تزعزع معتقداتهم وأفكارهم.
وفي هذا المقال عرض لمشكلة الإلحاد بعد أن بدأ يظهر عند بعض شباب مجتمعاتنا.
وهذا الشك السلبي مختلف كثيرًا عن الشكّ المنهجي المعروف عند الفلاسفة الذي يهدف للوصول لليقين؛ فهذا شكّ عقليّ بحت، بينما الذي نتحدّث عنه هنا هو ما يمكننا أن نسمّيه (شكًّا نفسيًّا) ليس له أصول عقلية منطقية، والإلحاد المعاصر بشكل عام يختلف عن الإلحاد الفلسفي القديم الذي ينتُج عن تفسيرات عقلية للوجود فهذا اﻷخير دائمًا ما كان يواجَه بحجج منطقيّة فلسفيّة لإثبات وجود الإله، بينما العديد من صور الإلحاد المعاصر ناتجة عن شرخ يفرز تناقضًا بين ما هو عقائدي وبين ما هو واقعي، فهو حالة نفسية أكثر منه حالة عقلية، إنه رفض للمعتقد الذي ظاهره يخالف واقع الحال المتبدّي للعيان.
نعيش اليوم أزمة يواجهها الشباب في معتقداتهم وقيمهم نتيجة تفرُّق العالم الإسلامي وضعفه وتراجعه، وهذا الحال خلق قدرًا من التشويش العقائدي عند بعض الشباب وفقدان الثقة بما يؤمنون به
على مر الزمان اجتهد العلماء في تقديم الأدلة العقلية والمنطقية على وجود خالقٍ موجدٍ لهذا الكون، بهدف الوصول لإيمان يعتمد على العقل الذي لا يفتأ يبحث عن حلول توافق قوانينه وتكوينه.
وفي المقابل ظهرت موجات الإلحاد مع ظهور الفلسفات الوضعية المادية والتي ركّزت اهتمامها على الطبيعة ورفضت فكرة ما وراء الطبيعة، لذلك فهي ترى الإيمان عمومًا حالة لا عقلية، وتصفه أنه عجز عن فهم هذا العالم بما فيه من ظواهر، فرواد هذه التيارات يرون أن العلم المعاصر قد توصّل لكثير من التفسيرات التي كان يعجز عنها من سبق، ابتداءً بالداروينية التي حاولت إلغاء فكرة الخلق، وصولاً إلى النظريات الفيزيائية التي تفسر نشأة الكون بالانفجار اﻷعظم، وبما أفرزته الفلسفة الوجودية بقلب المفاهيم عن أولوية وجود الإنسان كجسد على ماهيته التي يمكن معادلتها بكلمة روحه، لذلك يرى الإلحاد المعاصر أن على الإنسان المعاصر التخلُّص من فكرة الإله التي كانت مُبرَّرةً في عصور ما قبل النهضة العلمية، أما الآن فقد قدّم العلمُ إجابات عن كل التساؤلات التي كانت خافية عن الإنسان القديم، وما لم يفسره العلم حتى الآن فهو غير موجود!.
وفي سياق هذا الحديث لابد من معرفة أن الإلحاد أنواع وأقسام، فليس كل ملحدٍ يحمل الأفكار والتوجهات نفسها، بل هناك أنواع مختلفة من الإلحاد من حيث المنشأ أو الفكر الذي صدرت عنه، وما يهمنا الحديث عنه هنا هو الإلحاد الناتج عن التفاعلات النفسية مع الواقع المعاش أي الإلحاد النفسي، والذي يمكننا القول عنه: إنه أخطرها؛ لأنه لا يستند على أفكار بل على مزاجيات سيكولوجية، وهنا لا بد من الإشارة لتوجهات الإلحاد العامة، والمرجع الذي نشأت عنه للتمييز بينها وتوصيف حالة الملحد النفسي، فالإلحاد –عمومًا- يمكننا أن نصنّفه ضمن ثلاث توجهات وهي:
١- الإلحاد في شكله العلمي:
وهو كما سبق الإلحاد الناشئ عن التوهم بقدرة العلم على تقديم حلول لكل مشاكل الإنسان المادية والنفسية وحتى الأخلاقية منها، وهذا النوع يعتمد على نظريات علمية في مختلف العلوم الطبيعية لإحلالها محل العقائد الإيمانية، ويمكن تقويض أسس هذا الإلحاد ببيان بطلان صحة هذه النظريات أو الرد عليها بطريقة علمية، وببيان أن العلم لا يمكنه إدراك كل شيء.
٢- الإلحاد في شكله الفلسفي:
وقد ظهر هذا الإلحاد من خلال فلسفات كانت تحاول تفسير الوجود بعيدًا عن نور الوحي منذ زمن اليونانيين القدماء وصولاً لعصر النهضة الأوروبية الحديث، تجلت بصورة سجالات حول إثبات وجود الإله وما يقابله من محاولات إبطال هذه البراهين من قبل المُنْكِرين لوجوده، والمتتبع لتاريخ هذا الفكر يرى أنَّ الفلاسفة المنكرين لوجود الله قلّة قليلة، ولم تلقَ نظرياتهم القبول العام، وذلك لسببٍ يسيرٍ وهو أنهم لم يقدِّموا نظرياتٍ بالمعنى الدقيق، بل كان كلّ عملهم هو (الإنكار)؛ إنكار ما هو مُثْبَت بالأدلة والبراهين دون تقديم نظريات مدعمة بالأدلة والبراهين، مع أن الفريق الآخر كان إيمانه بوجود الإله مليئًا بالتصورات الوثنية والخرافية.
يحصل الإلحاد النفسي بسبب أزمات وضغوط يعاني منها الشخص، فيظنُّ أنه يهرب منها من خلال إنكار الخالق، وأبرز ما تتجلى فيه هذه الأزمات الظروف الضاغطة والأحوال الصعبة التي يمرُّ بها الشخص أو مجتمعه
٣- الإلحاد النفسي:
وهو إلحاد يحصل بسبب أزمات وضغوط نفسية يعاني منها الشخص، فيظنُّ أنه يهرب منها من خلال الإلحاد وإنكار الخالق، وأبرز ما تتجلى فيه هذه الأزمات الظروف الضاغطة، والأحوال الصعبة التي يمرُّ بها الشخص أو مجتمعه، كما وقع في أعقاب الحربين العالميتين وما تلاهما من تحولات فكرية وسياسية واجتماعية هزت المجتمعات من أساسها، وما يحصل في زماننا هذا في عَقْدِ الثورات وبلاد العرب التي أنهكها الظلم والاستبداد وانتهاك الآدمية، وسرقة الخيرات، ثم ما عانته العديد منها في ظل محاولة وأد هذه الثورات من قمع واضطهاد وحروب، فيتساءل شابٌّ داخل نفسه: (لماذا أؤمن) في بلاد المؤمنين المدمرة؟، (لماذا أؤمن) في بلاد المؤمنين الظالمة لأبنائها؟، (لماذا أؤمن) في بلاد تقتل أحلام شبابها ويسيطر عليها المجرمون ويعلو فيها السفهاء وينهش الفقر أبدان الصادقين والشرفاء المؤمنين؟، بينما هناك في بلاد اللاإيمان تنتعش الكرامة والحرية والأمان والمستقبل المشرق؟!
هذه الهواجس تلحّ على عقل هذا الشاب أو ذاك، وتحاول أن تُنهي حالة الصراع الداخلي بين واقعٍ قاسٍ يفرض على الإنسان معتقدًا يوافق حالة التشوش الناتجة عنه، وبين حالة وجدانية ترفض التخلي عن دفء الشعور الناتج عن اتصال الإنسان بخالق رحيم، وفي حال لم يُعالج هذا التشوش فإن البحث عن حل يدفع البعض إلى إنكار وجود الإله هربًا من هذه الضغوط النفسية.
هذا التوجه من الإلحاد أخطر من التوجهين السابقين، لأنه يقوم على إنكارٍ ناتجٍ عن محاولة استنتاج المعتقد من الواقع، أي إنكار الاعتقاد والقول ببطلانه من خلال معطيات مجتزأة من الواقع لا من العقيدة ذاتها بكونها منظومة جاءتنا من خلال الوحي والرسالات، بل يستند صاحب هذا النوع في اعتقاده على الإفرازات التي أنتجها الواقع الذي يدّعي تبني تلك المنظومة العقائدية، فهو يتبنى نتاج الممارسة الخاطئة ويحكم من خلالها على المعتقد النظري الذي هو غير مسؤول عن التطبيقات الخاطئة أو حتى عدم التطبيق نهائيًا، ولكن إلصاق التهمة بالفشل للمعتقد غير المتَّبَع أساسًا.
الإيمان من المنظور النفسي السيكولوجي:
لابد أن نُدرك أولاً أن الإنسان بحاجة إلى الإيمان بالله تعالى، وأن حياته لا تستقيم إلا بذلك، فالنفس البشرية مفطورة على الإيمان بالله، والإيمان بالغيب، وهذه النفس حتى تسعد ولا تشقى تحتاج لاستقرار وهدوء، وهذا لا يكون إلا بالإيمان بالله تعالى؛ وذلك لأمور من أهمها:
- الإيمان بالله تعالى يعني تفويض الأمور إليه، والتوكل عليه، والاستناد إلى قوته العظيمة فيضع فيها الشخص آماله ويحط عندها آلامه، فيتجنب بذلك التوكل على المخلوقات الضعيفة التي لا تملك من أمرها شيئًا، فتهدأ نفسه وتطمئن، وتبتعد عن الخوف والقلق الدائم من الاعتماد على ما لا يمكن الاعتماد عليه.
- عقل الإنسان وعلمه محدود لا يستوعب كل شيء ولا يستطيع إدراك كل شيء، لذا فإنه لن يحل له كل شيء، وستبقى الكثير من الأمور ألغازًا وطلاسم لا يمكن معرفتها، وهي حوله متعددة وديناميكية ومتشعبة، فإن أصر على اكتشافها ومعرفتها فلن يزيده ذلك إلا حيرة واضطرابًا وتوترًا وقلقًا، بينما الإيمان بالغيب يريح الإنسان من ذلك، فيجعله يؤمن بالأشياء والأحداث دون أن يجهد عقله المحدود في الوصول إلى إجابات غير ممكنة، مما ينعكس على استقرار نفسه وصحة عقله.
لأجل ذلك فإن الله تعالى اختص المؤمنين بالثناء على إيمانهم بالغيب، وقد ذُكر الغيب في القرآن الكريم في حوالي (٦٠) آية. ويكفي أن أول صفة للمؤمنين كانت الإيمان بالغيب كما جاء في الآية رقم (٣) من سورة البقرة في أول القرآن ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٣]، ثم في الآية (١٧٩) من سورة آل عمران ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾، مما يدل على الأهمية القصوى للإيمان المطلق بالغيب. فالإيمان بالغيب هو دلالة قطعية على الإيمان بالله والإخلاص في عبادته؛ كما أنه يجعل النفس مستقرة ويدربها على الإخلاص وعلى القبول والتسليم بآيات الله حتى وإن لم نستطع أن نراها رأي العين[1].
وقد تحدث العلماء والمفكرون المسلمون عن أثر الإيمان على الفرد والمجتمع، كما تحدث بذلك بعض فلاسفة الغرب، ومنهم الفيلسوف الألماني (كانط) حيث ربط بين وجود القِيَم الأخلاقية والالتزام بها بوجود الله عز وجل، فأقر بضرورة الإيمان بوجود الله «كضرورة» لحفظ القيم الأخلاقية التي يجب علينا أن نلتزم بها، فهو يضع كل الأدلة الأخرى جانبًا ويقرّ بضرورة «التسليم» بهذه الحقيقة، فهو لا يستطيع تخيّل حياة أخلاقية بدون وجود الله الذي يضمن للإنسان جدوى التزامه بالقيم وذلك من خلال وجود عالَم آخر تسود فيه العدالة.
نعم.. فما الذي يُلزمني بأن أكون صادقًا وعفيفًا وعادلاً إذا لم يكن هناك إله وعالَم آخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء؟![2].
أرواحنا بحاجة للإيمان:
وبالعودة لما قلنا سابقًا عن حالة الشباب المتأزّم نفسيًا في هذا العصر المتخبط والمتسارع في تقلباته فنحن بحاجة إلى الإيمان بالله من الجهة النفسية السيكولوجية قبل كل شيء، ومن يتأمل هذا الواقع الذي نعيش فيه بشيء من التعقل الممزوج بالوجدانية، ويرى كيف نعيش حالة الخيبة والألم والفوضى والانكسارات على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي الحياتي اليومي، لا بدّ أن يتساءل: كيف لنا أن نستمرَّ في الحياة دون وجود أمل بحياة أفضل؟ وكيف لنا أن نعيش في هذا العالم دون أزمات نفسية واكتئاب ويأس بعدَ انسداد الأفق، وفقدان الحلول والخلاص بدون وجود إيمان بما هو أفضل، بما هو أرحم، بما هو جزاء لنا على ما تحمَّلنا من صِعاب؟!
كيف لنا أن نحيا مع اللاجدوى واللامعنى والعدمية التي ينادي بها المشككون؟! وكيف لي أن أتخيل نفسي أني غير موجود في لحظة من اللحظات كما يحاولون إقناعي بأني عبارة عن قشة في مهبِّ الريح وأني سأنتهي إلى اللاوجود أو العدم؟!
وكيف لي أن أؤمن بالمصادفة فقط، وأقتنع أنها هي التي منها ابتدأنا وسننتهي من خلالها أيضًا كأيّة حلقة دخان خرجت من سيجارة أحدهم دون قصدٍ وستتلاشى إلى اللاشيء؟!
وعلى سبيل المثال، فنحن في (سوريا) اليوم أحوج ما نكون إلى الإيمان لكي تبقى نفوسنا حيّة بعد أن أنهكها الدمار والتهجير والفقر، وبعد أن أتعبها واقع ملموس لا يبشر بفرَجٍ قريبٍ، فكيف لهذا الشعب أن لا ينتظر النصر من يقين يبعث الطمأنينة وإمكانية الاستمرار؟!.
فعندما ينادي المؤمنون: (متى نصر الله؟) وذلك من شدّة تردّي الواقع والمعطيات الموجودة فيلجؤون لما هو فوق الواقع والمعطيات من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فهذا السؤال ليس من باب الشكّ بل هو عكس ذلك تمامًا، إنه الإيمان الكامن في أعماق النفس البشرية بأنَّ الفرَجَ بِيَدٍ أعلى من أيديهم.
فأرواحنا دائمًا بحاجة للإيمان بما هو خير مطلق مع انتشار الشرّ في الأرض، وبما هو حقّ مطلق مع شيوع الظلم، وبما هو جمال مطلق مع طغيان القبح على هذه الحياة.
نعم.. نحن بحاجة نفسية لله عزَّ وجل، ولا تعنينا كلّ نظريات الملحدين التي يتحدّثون بها عن العقلانية الجافة وفيزياء الكمّ والذكاء الصناعي الرقمي إذا لم تقدِّم لنا السعادة في الدارَين.
وهنا لابد من الإنصات لكلمات سيد قطب رحمه الله عن أهمية الإيمان على الروح والنفس: «الإيمان بالله نور يشرق في القلب، فيشرق به هذا الكيان البشري، المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة روح الله، فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة، وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طينة معتمة، طينة من لحم ودم كالبهيمة، فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها لولا تلك الإشراقة التي تنتفض فيه من روح الله، يرقرقها الإيمان ويجلوها، ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم، ويشف بها هذا الكيان المعتم.
والإيمان بالله نور تشرق به النفس، فترى الطريق، ترى الطريق واضحة إلى الله، لا يشوبها غبش ولا يحجبها ضباب، غبش الأوهام وضباب الخرافات، أو غبش الشهوات وضباب الأطماع، ومتى رأت الطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار»[3].
وفي هذا السياق لا ينبغي أن نغفل عن مفكر وقائد عظيم حارب الإلحاد فكرًا وعملاً في العصر الحديث وهو علي عزت بيغوفيتش الذي قاد مسلمي البوسنة للتحرير ضد أكبر تيار إلحادي عرفه العصر الحديث وهو التيار الشيوعي في يوغسلافيا؛ فقد اعتمد بيغوفيتش رحمه الله على فكرة ثنائية (الطبيعة والإنسان) ودافع بها عن الإيمان مقابل الواحدية الإلحادية التي ألغت الإنسان مقابل الطبيعة، فقد حاربهم فكريًا بكتابه الذي يعتبر من أهم ما كتب في العصر الحديث عن هذا الاتجاه (الإسلام بين الشرق والغرب) وقد كان يعتبر الإيمان المصدر الأول للأمان: «إن الإيمان بالله والإيمان بعنايته يمنحنا الشعور بالأمن الذي لا يمكن تعويضه بأي شيء آخر»[4].
وأخيرًا فإن علماء النفس اليوم وبعد التطور الكبير الذي شهده هذا العلم في العقود الأخيرة يؤكدون على أن النفس لا تستطيع أن تكون سليمة بدون تعلقها بقوة مطلقة تبعث فيها الأمل والأمان والطموح الدائم نحو الأفضل فكما أن للجسد جهازًا مناعيًا يشكل سدًا ضد الأجسام الغريبة التي تدخل للجسد فكذلك للنفس جهازٌ مناعي يكون سدًا ضد الأفكار والأوهام واليأس؛ ألا وهو الإيمان.
كيف لنا أن نحيا مع اللاجدوى واللامعنى والعدمية التي ينادي بها المشككون؟! وكيف للمرء أن يتخيل نفسه بأنه عبارة عن قشة في مهبِّ الريح وأنه سينتهي إلى اللاوجود أو العدم؟! وكيف يمكن أن تكون المصادفة هي البداية والنهاية كأيّة حلقة دخان خرجت ثم تلاشت؟
كيف أؤمن؟
بعد ما قيل عن أهمية الإيمان قد نواجَهُ بسؤال يقول: لماذا لم يكن إيمانكم بالإله مغيِّرًا لحالكم السيئة التي تعيشون فيها الآن؟ وفي الحقيقة لدينا مفاهيم وأفكار مغلوطة عن الإيمان، وقد أسهمتْ في نشر التشكيك لدى شريحة من شباب اليوم، وأهم ما يجب التنويه له هنا ربْط بعض الدعاة الإيمان بغاية حياتية مباشرة بغية تشجيع الناس على الإيمان، كمن يقول: إنَّ من يمارس العبادات بطريقة صحيحة سيكون في مأمن من الفقر مثلاً، فماذا سيكون حال الإنسان الذي يؤدي عباداته ولايزال فقيرًا؟!
الإيمان غاية وليس وسيلة، وعندما يتمّ تحويله لوسيلة من أجل غاية أقلّ منه لن نصل إلى تلك الغاية بل سيتحول الإيمان إلى حالة مشكوك فيها؛ لأنه لم يحقق الغاية التي رُبط بها أو وُجد من أجلها، فالهزيمة في معركة بين المؤمنين وغيرهم يجب أن لا يتمّ ربطها بالحقيقة الإيمانية للناس لأنّ ذلك مغالطة كبرى لها ارتدادات سلبية، بل علينا أن نعي أن الإيمان في جزء منه هو أن تعطي لكل غاية أسبابها المادية، فالإيمان لا يعني أن نشترط على الله عز وجل تحقيق أهدافنا الدنيوية، ولا يُسْتَمَدُّ الإيمانُ من نتائج أفعالنا، وكذلك فهو لا يعني أن نربط صدق هذا الإيمان بنجاحاتنا أو إخفاقاتنا، فعندما نؤمن تصبح الأحداث نتائج لإيماننا لا غايات، وهذه النقطة مهمة جدًا لمعالجة إسقاط فشلنا على إيماننا، ففي ثاني معركة للمسلمين (أُحُد) لم يكن النصر حليفهم، ولم يكن لذلك تأثير في إيمانهم لأنهم تربّوا على الإيمان المستمدّ من السماء لا من نتائج أحداث الأرض، بل كانوا يبحثون عن أخطائهم وجوانب تقصيرهم التي أدَّت لهزيمتهم، والأسباب التي يجب أن يوفّروها لتحقيق غاياتهم.
وفي الختام نقول: إنَّ الإيمان حاجة لنا كبشر على جميع الصعد الحياتية والأخرويّة، وليس شرطًا مزاجيًا تتحكم به مجريات الأحداث على المستوى الجماعي والفردي، فإذا اسْتُمِدَّ الإيمانُ من السماء كانت نتائجه مُذهِلة على الأرض، أما إذا اسْتُمِدَّ من الأرض فسرعان ما سنفقده، إنه الفرق بين ما هو مُطْلَق وبين ما هو نسبي.
«الإيمان بالله نورٌ تُشرق به النفس، فترى الطريق، ترى الطريق واضحة إلى الله، لا يشوبها غبش ولا يحجبها ضباب، ومتى رأت الطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار»
سيد قطب
أ. محمّد ياسين نعسان
كاتب سوري.
[1] بتصرف من مقالة الإيمان بالغيب والصحة النفسية بقلم د. محمد لبيب سالم، مدونة ملهم.
[2] نقد العقل العملي، عمانويل كانط، وقد عالج الشيخ عبد الله العجيري هذه النقطة باستفاضة في كتابه (شموع النهار) في المستوى الثاني من مستويات الدلالة الفطرية على وجود الله.
[3] في ظلال القرآن (٤/٢٠٨٥).
[4] الإسلام بين الشرق والغرب، ص (٣٧٣).