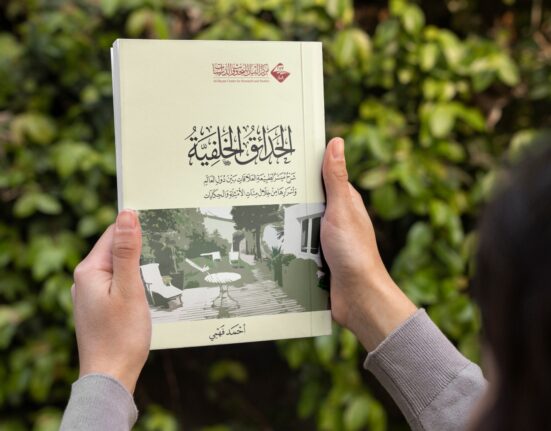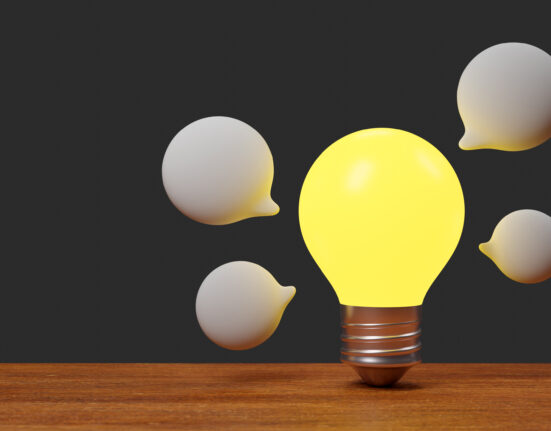لكلِّ جماعةٍ صفاتٌ تُميِّزها عن غيرها، وميزاتٌ تنفرد بها عمَّن سواها.. وقد امتازت الجماعة الَّتي احتضنت دعوة النَّبيَّ ﷺ بصفاتٍ ومناقب نفيسة جعلت لهم مقامًا عاليًا ومكانة رفيعة في الإسلام، إنَّهم الأنصار؛ مَن أحبُّوا النبي ﷺ وفدوه بدمائهم، وبذلوا له البلاد والأموال والدِّيار، وقدَّموا أروع نماذج التَّضحية والإيثار، فرَحِم الله رجال الأنصار ونساء الأنصار.
مدخل:
أبقى الله سبحانه وتعالى ذِكر الأنصار وأعلا مكانتهم وأعطاهم خصوصيةً ليست لغيرهم من عموم المسلمين، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (آية الإيمانِ حبُّ الأنصار، وآية النفاق بغضُ الأنصار)[2]، وفي حديث آخر قريب منه روى البخاري ومسلم عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: (الأنصارُ لا يحبُّهم إلا مؤمن، ولا يُبغضهم إلا منافق، فمن أحبَّهم أحبَّه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله)[3]، وقد أفرد البخاري لهذين الحديثين بابًا أسماه: «حبُّ الأنصار من الإيمان».
وفي هذه المقالة تطواف مع بعض صفاتهم التي مدحها الشرع وبلغوا بها مكانتهم الرفيعة .
خصائص الأنصار :
امتاز الأنصار بعددٍ من الخصائص، ومن أهمها:
١- الإيمان العميق والتسليم لله:
ما لبث الأنصار أن صدَّقوا بنبوّة الرسول ﷺ من أوّل عرضها عليهم، آمنوا قولاً وعملاً وفكرًا وسلوكًا، وانعكس ذلك على تصرفاتهم، فكانوا يُسلِّمون للرسول ﷺ تسليمًا تامًا في جميع أمورهم، ومن ذلك استبدالهم للأخوة الإيمانية الصادقة بالعداوة القديمة التي كانت بين الأوس والخزرج بعد أن كادت تفنيهم حربُ بُعاث، والانطلاق بحماس إلى الدعوة لدين الله بين قومهم، وتهيئة بلدهم لتصبح موطنًا للدعوة ومنطلقًا ومُهاجَرًا للمستضعفين من المسلمين.
وتنقل كتب السيرة قصصًا من التصديق والتسليم تبعث على الدهشة والعجب. من ذلك ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في قصة بيعة العقبة الثانية، حيث قدم وفد منهم إلى رسول الله ﷺ في موسم الحج ليبايعوه فقال لهم عليه الصلاة والسلام: (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة)[4]، فقاموا إليه فبايعوه، وهم يعلمون أن قريشًا -والعرب من خلفها- ستنقلب عليهم وتحاربهم، بايعوه على أن يكون قائدَهم، ويكونوا طوعَ أمره، يسالمون من سالم ويحاربون من حارب، بايعوه على بذل النفس والنفيس في سبيل دعوته، وكل ذلك بمقابل وعد منه ﷺ بأن لهم الجنة.
إن القارئ لا ينتهي عجبه من هذا الموقف، فهو عليه الصلاة والسلام لم يعدهم بمكانة أو زعامة وهم لم يطلبوها -رغم أن غيرهم طلبها[5]– بل وعدهم بأن يدخلهم الله الجنة فحسب، وهو وعد يمكن أن نصنفه بمصطلحات اليوم بأنه هدف غير قابل للقياس في المنظور الدنيوي، لكنها رحمة الله تعالى بهم وفضله عليهم حيث وقر الإيمان في قلوبهم وتمكن من جوارحهم، فاستجابوا دون تردد فحازوا قصب السبق والشرف الرفيع.
وفي هذا اللقاء لم يطلبوا من الرسول ﷺ سوى التثبُّت مما سيفعله إذا انتصرت الدعوة وانتشر الإسلام، حيث قال أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه : «يا رسول الله إنَّ بيننا وبين الرجال حبالاً، وإنا قاطعوها –يعني: اليهود– فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعَنا؟» فتبسم النبي ﷺ ثم قال: (بل الدَّمَ الدَّمَ والهَدْمَ الهَدْمَ، أنا منكم وأنتم مني، أُحارِبُ مَن حَارَبتم وأُسالِم مَن سَالمتم)[6]، فأعظِم بهذا الإيمان والتصديق والتسليم لأمر الله ورسوله، ما أعظمه.
إن القارئ لا ينتهي عجبه من بيعة الأنصار، فالرسول عليه السلام لم يعِدهُم بمكانة أو زعامة، وهم لم يطلبوها، بل وعدهم بأن يُدخلهم الله الجنة فحسب إذا نصروا الدعوة، فاستجابوا دون تردُّد فحازوا قصب السبق والشرف الرفيع
٢- البذل والإيثار:
كان من أول الأعمال التي ابتدأ الرسول ﷺ بها تأسيس المجتمع المسلم ونواة الدولة الإسلامية في المدينة بناء المسجد، وهنا بذل بنو النجار الأرضَ التي شيَّد عليها رسول الله ﷺ مسجده في سبيل الله، ورفضوا أخذ ثمنها.
وكان الأنصار يتنافسون فيما بينهم على إنزال المهاجرين الذين يقدُمون إلى المدينة في بيوتهم، ساعين في خدمتهم وتأمين احتياجاتهم، باذلين لهم أموالهم وأوقاتهم، في أمثلةٍ من البذل والعطاء قلما نجد مثلها في غير تاريخنا الإسلامي، وقد أصَّل رسول الله ﷺ تلك المعاني في نفوس الأنصار بأن جعلها نبراس الأخوة في الله، حين آخى بين الأنصار والمهاجرين، وكان الأنصار على مستوى هذه المسؤولية، فواسوا إخوانهم المهاجرين، وآثروهم على أنفسهم بخير الدنيا، روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: «قالت الأنصار للنبي ﷺ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل»، قال: (لا)، فقالوا: «تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، فقالوا: سمعنا وأطعنا»[7]، فأصبح الأنصاريُّ ونزيله المهاجر أخوين أخوَّةً إيمانية وقلبية وفعلية وصلت إلى حد التوارُث بينهما، وبقي الأمر كذلك حتى نُسخ أمر التوارُث وبقيت الأخوة. لم يكن فعل الأنصار نابعًا من كرمٍ مطبوعٍ في نفوسهم فحسب، أو نخوةٍ عربيةٍ جُبلوا عليها، أو سلامةٍ في فطرتهم، لقد كان الأمر أعظم وأعمق من ذلك بكثير، إنه أثر الإسلام فيهم.
كان الإسلام قد ضرب بجذوره في قلوبهم وظهر أثره في تعاملاتهم وسلوكهم، مما جعلهم واعين لدورهم المحوري في دولة الإسلام الوليدة، ففي هذه المرحلة وقع عليهم عبء توطين الدعوة وتثبيت أركان الدولة، فاحتضنوا المهاجرين وأسهموا في بناء المسجد وبدَّلوا التحالفات التي كانت بينهم وبين اليهود إلى ما شرع لهم رسول الله في صحيفة المدينة، وبهذا كانوا نِعم السند والمؤازر للإسلام والمسلمين.
بعد هجرة الرسول ﷺ أصبح لحياة الأنصار هدف أسمى من مجرد تكثير الأموال والأولاد والانتصار على الخصوم. فصار هدفهم الأعظم أن يلقوا ربهم عز وجل وهو راضٍ عنهم، فكانوا يسعون لنشر الدين والتمكين له في الأرض، مضحِّين بأموالهم وبأرواحهم
٣- التضحية والفداء:
تابعَ الأنصارُ حياتهم التي اعتادوها بعد هجرة الرسول ﷺ، لكن أصبح لها هدف أسمى من مجرد تكثير الأموال والأولاد، والانتصار على الخصوم. صار هدفهم الأعظم أن يلقوا ربهم عز وجل وهو راضٍ عنهم، فكانوا يسعون لنشر الدين والتمكين له في الأرض، مضحِّين بأموالهم تارةً وبأرواحهم تارةً أخرى. ظهرت هذه التضحيات في الغزوات والسرايا، ومن ذلك ما فعلوه في غزوة بدر حيث قال سعد بن معاذ –وهو سيد من سادات الأنصار- جوابًا للرسول عليه الصلاة والسلام حين طلب المشورة قبل المعركة: «… فوالذي بعثك بالحق، لو استعرَضت بِنا هذا البحرَ فخضَّته لَخُضناهُ معك ما تخلّف منا رجل واحد، وما نكره أن تَلقى بنا عدونا غدًا، إنَّا لصُبُرٌ في الحرب صُدُقٌ في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقرَّ به عينك، فسِر بنا على بركة الله» فسُرَّ رسول الله ﷺ بقول سعد ونشَّطه ذلك[8]، وانتقل من المشورة إلى الإعداد والتجهيز وتحفيز الصحابة وتنظيمهم.
فَطِنَ سعد بن معاذ إلى أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب رأي الأنصار خاصة[9]، فالبيعة نصت على حماية الرسول والدفاع عنه في المدينة ولم تنص على خارجها، ولكن تلك النفوس الصافية التي تشرَّب قلبها الإيمان، انقلب حالها إلى الحرص على فعلِ ما يرضي الله ورسوله ﷺ بنفوس راضية مطمئنة ولو كلَّفهم ذلك تقديم أغلى ما يملكون.
أثبت الأنصار إخلاصهم، وصدّقت أفعالهم أقوالهم، ليس في غزوة بدرٍ فحسب، بل في جميع الغزوات والسرايا. ومن ذلك أن عمير بن الحمام الأنصاري لما سمع بشارة الرسول ﷺ له بأنه من أهل الجنة إن قُتِل قال: «لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة»، ورمى تمرات كان يأكلها وانطلق لقتال المشركين[10]، فكان أول شهيد من الأنصار في بدر، فرغم أن الرسول ﷺ بشره بأنه من أهل الجنة إن نال الشهادة في أي جزء من هذه الغزوة، إلّا أن نفسه أكبرت عليه أن يتكاسل، واستطالت البقاء في الدنيا حتى يأكل تمراته التي معه، ولم تمهله حتى لا تتأخر روحه عن دخول الجنة.
بلغت محبة الرسول ﷺ في نفوس الأنصار مكانة تفوق مكانة الأب والأم والولد، وقصص محبتهم وفدائهم له عليه الصلاة والسلام معروفة مبسوطة في كتب السيرة، وتشهد عليها مختلف الوقائع والغزوات
٤- قمم سامقة في حب النبي ﷺ:
لا شك أن إيثار الأنصار وتضحياتهم في سبيل نشر دين الله لا يمكن اختزالها بمشهد أو مشهدين بل كانت من تفاصيل حياتهم اليومية المعتادة، وليس ذلك بمستغرب منهم، فهم الذين بلغت محبة الرسول ﷺ في نفوسهم مكانة تفوق مكانة الأب والأم والولد، وقصص محبتهم وفدائهم له ﷺ معروفة مبسوطة في كتب السيرة، من أعجبها قصة في غزوة بدر، تجمع بين المحبة في أبهى صورها وبين الشجاعة والإقدام، وهي قصة الغلامين الأنصاريين اللذين قتلا أبا جهلٍ فرعونَ هذه الأمة، ووجه العَجَب فيها هو سبب رغبتهما في قتل أبي جهل، وقد اختصراه بقولهما: «أُخبرت أنه يسبُّ رسول الله ﷺ، والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا»[11]، سبحان الله! إن الأنفس لتصغر أمام هذا المشهد الرائع من المحبة والإقدام والفداء، فهذان الشابان اللذان لم يتجاوزا السادسة عشرة من العمر اختارا أبا جهل ليقتلاه انتقامًا للرسول ﷺ وللإسلام والمسلمين رغم أنه لم ينلهما وقومَهما من سبِّ أبي جهلٍ ولا من إيذائه شيء، وهي صورة من الإقدام والفداء لا يقوم بها إلا من امتلأ قلبُه بحُبِّ الإسلام وأهله وشَغل نفسَه وعقلَه بهذا الدين والتضحية لأجله.
ومن ذلك ما فعله أبو طلحة الأنصاري يوم أحد، حيث وقف بين يدي رسول الله ﷺ يدافع عنه ويرمي المشركين بالنبال وكان رجلاً راميًا، فكان رسول الله ﷺ ينظر موضع رمي أبي طلحة، فيقول أبو طلحة: «يا نبي الله، بأبي أنت، لا تُشرف، لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك»[12].
ولا ننسى في هذا السياق ما قالته الأنصارية حين نَعوا إليها زوجها وأباها وأخاها، فما التفتت لذلك لانشغالها بالسؤال عن رسول الله ﷺ، وما اطمأنّت نفسُها إلا حينما رأته وقالت له: «كل مصيبة بعدك جَلل»[13] أي صغيرة. شَغَلَها القلق والخوف على رسول الله ﷺ عن الحزن على أقرب الناس لها.
وهذه القصص على تعجُّبنا مما ورد فيها مما لم تعتد عليه النفوس أو تتحمَّله الأبدان فهي ليست الأعجب، فمما يفوقها عجبًا ما قاله زيد بن الدّثنة الأنصاري، وذلك حين أُسِر وبيع لقريش، وسأله أبو سفيان –وكان على الكفر حينها-: أنشُدك الله يا زيد… أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تُضرَب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال له زيد: «والله ما أُحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنّي جالس في أهلي». فقال أبو سفيان قولته المشهورة: «ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمدٍ محمدًا»[14]. نعم والله إن هذا الخبر لمن أعجب الأخبار، فرغم المكان البعيد والحال الشديد أبت عليه نفسه أن ينقص شيئًا من قدر الرسول ﷺ ولو على سبيل الخيال، بل أنطق الله لسانه بما وقر في قلبه من صادق الحب وعظيم الإجلال للمصطفى ﷺ.
٥- العزة أمام العدو:
رغم كل الإيمان الذي وقر في قلوب الأنصار ومحبتهم للرسول ﷺ والتسليم الكامل له، إلا أنهم كانوا لا يتحرَّجون من سؤاله عن كل ما يَظنُّون أنه يُبعدهم عن مُرادهم من حُسن الصحبة وصدق المعاملة وإخلاص العمل. من ذلك إباؤهم اقتراحَ النبي ﷺ بأن يُفاوضوا بعض قبائل المشركين على شطر ثمار المدينة حتى يفكُّوا الحصار عنها يوم الخندق، رفضوا الاقتراح حين أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه يفعله رأفة بهم، فكان جواب سعد بن معاذ حاسمًا واضحًا مليئًا بعزّة المسلم: «يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا قرىً أو بيعًا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا! واللهِ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم»، قال رسول الله ﷺ: (فأنت وذاك). فتناول سعد بن معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال: «ليجهدوا علينا»[15]. وبذلك رفض الأنصار التفاوض مع المشركين اعتزازًا بالإسلام وافتخارًا بالمكانة السامقة التي وضعهم الإسلام بها.
كان الأنصار حريصين على سلامة صدورهم، يصدقون الله ورسوله ﷺ في أفعالهم وأقوالهم، فإن وجدوا في أنفسهم شيئًا بادروا فأخبروا به رسول الله r حتى يظهر لهم الحق فترتاح له نفوسهم وتسكن أفئدتهم ويزدادوا إيمانًا وتسليمًا
٦- الحرص على سلامة الصدر:
كان الأنصار يصدقون الله ورسوله ﷺ في أفعالهم وأقوالهم، فإن وجدوا في أنفسهم شيئًا بادروا فأخبروا به رسول الله ﷺ حتى يظهر لهم الحق فترتاح له نفوسهم وتسكن أفئدتهم ويزدادوا إيمانًا وتسليمًا. وكل ذلك يعلي من مكانتهم في المجتمع المسلم عامة وعند رسول الله ﷺ خاصة، حتى بلغوا مكانة ليست لسواهم. حكت لنا كتب السيرة قصصًا تدلل على ذلك، لعل من أجملها ذلك الحوار الذي دار بينهم وبين رسول الله ﷺ بعد غزوة حنين، أنقل طرفًا منه لجمال عباراته وعمق نتائجه ورقة معانيه.
فقد وجد الأنصار في أنفسهم شيئًا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطهم شيئًا من الغنائم الكثيرة التي وزعها، وراجعه سعد بن عبادة الأنصاري في ذلك، فاجتمع الرسول ﷺ بالأنصار ومما قاله لهم: (يا معشرَ الأنصار: ما قَالَةٌ بلغتني عنكم، وجِدَةٌ وجدتموها عليَّ في أنفسكم؟ ألم آتكم ضُلالاً فهداكم الله، وعالةً فأغناكم الله، وأعداءً فألف الله بين قلوبكم؟) قالوا: بلى، الله ورسوله أمنّ وأفضل. ثم قال: (ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟) قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المنُّ والفضل. قال ﷺ: (أما والله لو شئتم لقلتم، فلَصَدَقتُم ولصُدِّقتُم: أتيتَنا مكذَّبًا فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريدًا فآويناك، وعائلاً فآسيناك. أَوَجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امْرَأً من الأنصار، ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار).
فبكى القوم حتى أخضَلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسمًا وحظًا. ثم انصرف رسول الله ﷺ، وتفرقوا[16].
سبحان الله، كيف انقلب هذا الذي وجدوه في أنفسهم إلى منحة أبدية فاقت كل ما منحه رسول الله ﷺ لغيرهم، لابد وأن الأنصار قد عادوا إلى المدينة المنورة وهم أكثر سعادة واطمئنانًا، كيف لا وقد رزقهم الله تعالى دعوةً خالصةً لهم ولأبنائهم، وقد أزال تخوفهم من أن يتركهم ليستقر في مكة بأن قال: (لَسَلكتُ شِعبَ الأنصار)، كيف لا وقد قالها صراحة: (لولا الهجرة لكنتُ امرَأً من الأنصار).
من اللحظات الفارقة في تاريخ الإسلام تنازلُ الأنصار أبناء المدينة وأصحاب الأرض عن منصب القيادة ليقدموها لمن هو أحق بها، وهم بهذا تنازلوا عن منصب الخلافة العامة لعموم بلاد المسلمين، ولعل عملهم هذا حفظ الأمة الإسلامية من فتنة عظيمة وشرٍّ كبير
٧- النزول عند داعي العقل والحكمة:
لم يتردد الأنصار في خدمة الدعوة، وبذلوا في ذلك موطنَهم وأموالَهم وأنفسهم دون توان أو تأخير، وكل ذلك كان والرسول ﷺ حاضرٌ معهم ويعيش بينهم، ولمَّا توفي عليه الصلاة والسلام أثبت الأنصار نقاء معدنهم وصفاء سريرتهم وصدق إيمانهم. يكفي القارئ المنصف أن يمر على قصة سقيفة بني ساعدة وكيف اجتمع الأنصار ليختاروا من أنفسهم خليفة للمسلمين، فانتهى اجتماعهم باختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومبايعته بالخلافة، اعترافًا بفضله، وإعمالاً للعقل والحكمة، ونزولاً عند أمر الله بالحض على اجتماع الكلمة والتنفير من التفرق، واستمرارًا لسيرتهم السابقة مع الرسول ﷺ في النصح والبذل والتضحية.
إنها من اللحظات الفارقة في تاريخ الإسلام عندما تنازل الأنصار أبناء المدينة وأصحاب الأرض عن منصب القيادة ليقدموها لمن هو أحق بها، هم بهذا العمل لم يقدموا منصب قيادة المدينة المنورة لأبي بكر الصديق ، بل الأمر أعظم من ذلك، فهم تنازلوا عن منصب الخلافة العامة لعموم بلاد المسلمين لأبي بكر الصديق t خاصة وللقرشيين من المهاجرين من بعده عامة، ولعل عملهم هذا حفظ الأمة الإسلامية من فتنة عظيمة وتنازعٍ مفرقٍ لها، وما حصل هذا إلا لرحمة الله بهذه الأمة وتوفيق الله للأنصار وتمسكهم بإيمانهم وما رباهم عليه الرسول ﷺ.
استوصوا بالأنصار خيرًا:
وبعد هذا التطواف ببعض خصال الأنصار، لن نجد أفضل من حديث الرسول ﷺ لتأكيد مكانتهم في الإسلام .. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس قال: مرَّ أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي ﷺ منَّا، فدخل على النبي ﷺ فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي ﷺ وقد عصب على رأسه حاشية بُرْدٍ، قال: فصعد المنبر، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أُوصيكم بالأنصارِ، فإنهم كَرِشِي وعَيْبَتِي، وقد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم، فاقبلوا من مُحسنهم، وتجاوزوا عن مُسيئهم)[17].
وقد تقدم معنا أن الأنصار بما سبقوا من الإيمان، وبما قدموا من التضحيات، وبما حباهم الله من مكانة سامقة صاروا جزءًا من عقيدة المسلم؛ محبتهم والإقرار بفضلهم من الإيمان، وبغضهم والإزراء بهم من النفاق، فسبحان من هدى أقوامًا لحبهم، وحجب عنه آخرين.
الأنصار صاروا جزءًا من عقيدة المسلم بما سبقوا من الإيمان، وبما قدموا من التضحيات، وبما حباهم الله من مكانة سامقة؛ محبتهم من الإيمان، وبغضهم من النفاق، فسبحان من هدى أقوامًا لحبهم، وحجب عنه آخرين
دروس وعبر من مدرسة الأنصار:
وختامًا وبعد أن استعرضنا بضعة شواهد لفضل ومكانة الأنصار فلا أقل من ذكر بعض الفوائد المستنتجة مما استعرضناه علنا نحقق بذلك قول الشاعر:
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام فلاح
ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:
- المبادرة إلى ما تدعو إليه الفطرة السليمة والعقل الصحيح. فالأنصار سمعوا من اليهود بقرب بعثة النبي ﷺ فلما رأوه وسمعوا منه عرفوه فأسلموا وسبقوا.
- الدنيا عرَض زائل ولَعاعة رخيصة، وكلما كان المرء أزهد فيها وأكثر بذلاً لها في سبيل الله كان أرفع درجة عند الله، والأنصار هم مضرب المثل في الإيثار والعطاء.
- عند وضوح الهدف وتحديده تتذلل الصعوبات ويسهل الوصول إليه ما وجدت الهمة العالية. كما في مواقفهم الكثيرة، ومنها قصة مقتل أبي جهل.
- الإيمان العميق والتسليم للقائد لا يمنع من مراجعته وسؤاله. فقد راجع الأنصار النبي ﷺ في بعض ما اقترحه لهم وقدموا اقتراحات أخرى استحسنها النبي ﷺ وعمل بها.
- المصارحة وحسن الظن المتبادل بين القائد والأتباع في السر أو العلن تمنع استمرار الفتن وقد تمنع حصولها من الأساس. كما حصل بين الرسول ﷺ والأنصار بعد غزوة حنين.
- إذا اختير القائد واجتمعت الكلمة عليه فالأمانة تقتضي مساندته ومناصحته. وقد سلّم الأنصار لأبي بكر ﷺوقريش في الخلافة، وأدَّوا دورهم بأمانة وصدق في بناء الدولة ونشر الدين ومناصحة الخليفة.
رضي الله عن الأنصار وأبناء الأنصار ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياهم مع النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام.
إيمان الأنصار العميق وتسليمهم للنبي ﷺ لم يمنعهم من مراجعته وسؤاله. وقد راجعوه في بعض ما اقترحه لهم من خطط وقدموا له اقتراحات أخرى استحسنها النبي ﷺ وعمل بها
[1] أخرجه البخاري (١٧) و(٣٧٨٤) ومسلم (٧٤).
[2] أخرجه البخاري (٣٧٨٣) ومسلم (٧٥).
[3] أخرجه أحمد (١٤٤٥٦).
[4] من ذلك اشتراط قبيلة كِندة على النبي أن يجعل لهم الملك من بعده ليؤمنوا به. ينظر: السيرة النبوية، لابن كثير (٢/١٥٩).
[5] أخرجه أحمد (١٥٧٩٨)، ومعنى (الدم الدم والهدم الهدم): كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار: دمي دمك وهدمي هدمك، أي: ما هدمتَ من الدماء هدمتُه أنا.
[6] أخرجه البخاري (٢٣٢٥).
[7] سيرة ابن هشام (٢/١٨٨).
[8] لما بلغ رسولَ الله r خروجُ قريش لحماية تجارتهم استشار الناسَ فيما يفعل، فقام أبو بكر فقال وأحسن، وكذا فعل عمر والمقداد y، والنبي يكرر الاستشارة، فقام سعد بن معاذ وقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ (يعني الأنصار) فقال: أجل، فقال سعد t: «فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك…» سيرة ابن هشام (٢/١٨٨).
[9] أخرجه مسلم (١٩٠١).
[10] أخرجه البخاري (٣١٤١) ومسلم (١٧٥٢).
[11] أخرجه البخاري (٣٨١١) ومسلم (١٨١١).
[12] سيرة ابن هشام (٢/٩٩).
[13] سيرة ابن هشام (٢/١٧٧).
[14] سيرة ابن هشام (٢/٢٢٣).
[15] أخرجه أحمد (١١٧٣٠).
[16] أخرجه البخاري (٣٧٩٩)، ومعنى: (كرشي وعيبتي): أي إنهم بطانتي وخاصتي، وموضع سري وأمانتي.