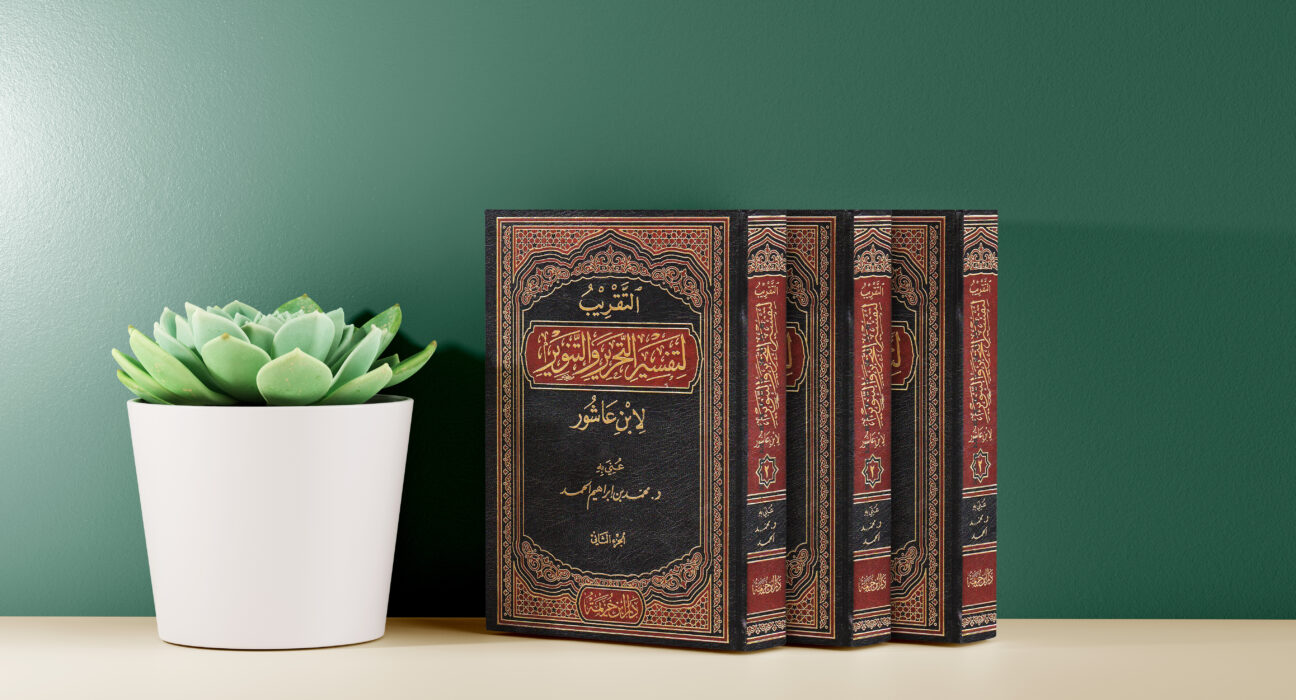لعلم المعاني صلةٌ كبيرةٌ بإعجاز القرآن الكريم من وجوهٍ عديدة؛ فمن أوجُه إعجاز القرآن الإعجازُ بالنظم، ومن جهةٍ أخرى فعلم المعاني لا يستقيم إلا بمراعاة الأحكام النحوية، وتسعى هذه المقالة إلى تقديم صورةٍ عن علم المعاني وأهميته في فهم وتدبر وتفسير القرآن الكريم.
لو سألنا أي مسلم لسلَّم بإعجاز القرآن الكريم، ولكن عن تقليد، أما المطَّلع على علم المعاني فيقف على حقيقة الإعجاز عن علم وتذوق وإحساس ونظر. فليس المهم أن تعرف ما هو أفضل الكلام العربي، ولكنَّ السر أن تعلل لماذا هذا التفضيل؟
ذكر لي أحد الأساتيذ الكبار في البلاغة العربية، فقال: نحن ندرس علم المعاني تقعيدًا وتقريرًا، أما التطبيقات والأمثلة الحية والممارسة والمعايشة فهي في كتب المفسِّرين مستنبطة ومستخرجة من كتاب الله المعجِز، فهناك ميدان التذوُّق والتطبيق الحق لهذا العلم، فكتب تفسير القرآن هي الميدان العملي لعلم المعاني.
فما هو علم المعاني؟ وما أهميته؟ وكيف أطبق هذا العلم على كتاب الله لأقف على شيء من إعجاز ذلك المَعين الذي لا ينضب، والذي مازال غضًا طريًا لا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، معجزًا للفصحاء، مفحمًا للبلغاء؟
تعريف علم المعاني وموضوعه:
هو علم يُعرَف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وموضوع علم المعاني هو اللفظ العربي من حيث إفادته المعنى، الذي هو الغرض المقصود للمتكلم، فيجعل الكلام مشتملاً تلك اللطائف والخصوصيات التي يطابق بها مقتضى الحال، ويدور هذا العلم حول تحليل الجملة المفيدة إلى عناصرها، والبحث في أحوال كل عنصر منها في اللسان العربي، ومواقع ذكره وحذفه، وتقديمه وتأخيره، ومواقع التعريف والتنكير، والإطلاق والتقييد، والتأكيد وعدمه، ومواقع القصر وعدمه، وحول اقتران الجمل المفيدة ببعضها بعطف أو بغير عطف، ومواقع كل منها ومقتضياته، وحول كون الجملة مساوية في ألفاظها لمعناها أو أقل منه، أو زائدًا عليه، ونحو ذلك([1]). ولأن الله تعالى الأعلم بالحال ومقتضاها فجاء كلامه يطابق هذه الحال تمامًا، ومن هنا كان القرآن الكريم أعظم البلاغة.
نشأة علم المعاني:
لقد نشأ هذا العلم غضًّا يانعًا، موصول الأسباب بإعجاز القرآن الكريم، إذ تقرَّر عند فريق من العلماء أنَّ القرآن مُعجزٌ بنظمه، فمضوا يبحثون عن سرِّ هذا النظم المعجز، إلى أن قيض الله لهذا الأمر عالمًا نحويًا كبيرًا، استطاع بذوقه الأدبي الرفيع وثقافته النحوية العريضة أن يَدمج بين النحو والبيان، ويخرج بنظرية النظم لمباحث علم المعاني، وهو عبدالقاهر الجرجاني رحمه الله، وذلك في سِفره العظيم: دلائل الإعجاز، بيد أنَّه لم يكن يُسميها بعلم المعاني، إنَّما يُطلق عليها أحيانًا علم البيان أو النظم، وأحيانًا البلاغة أو الفصاحة([2]). وإذا كان الجرجاني أوَّل من درس علم المعاني تذوُّقًا وتعمُّقًا ونُضجًا ولم يسمِّه باسمه، فقد جاء جارُالله الزمخشريّ فطبق نظرية الجرجاني في علم المعاني على القرآن الكريم في تفسيره الكشاف، وسمَّى هذا العمل باسمه علم المعاني، في معرض ذكره لشروط المفسر لكتاب الله، حيث قال: “لا يتصدَّى لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجلٌ قديرٌ في عِلمين مختصَّين بالقرآن وهما علم المعاني، وعلم البيان”([3]).
وهذه هي المرة الأولى في التاريخ البلاغي التي تُدرج مسائل علم المعاني التي اصطلح البلاغيون عليها تحت هذا الاسم. وكان هذا العلم مجنونًا –مشتتًا– حتى عقَّله –رتَّبه- السكّاكي، حيث تم تثبيت هذا المصطلح نظريًا في كتاب مفتاح العلوم للسكّاكي، وذلك في القسم الثالث منه، فجعله للمعاني والبيان، وأوضح لعلم المعاني قواعد وحدودًا، وميَّز له أصولاً وفروعًا، وفَصَل بين علم المعاني وعلم النحو([4]). وكان هذا الكتاب محورًا للدراسات البلاغية فيما بعد، حيث توالت شروحه، وشروح الشروح، والهوامش والتعليقات والإضافات عليه. وأصبحت كتب البلاغة تدور حوله، حتى قال القائل: “لولا الأعرجان لضاعت بلاغة القرآن”([5]) يقصدون الزمخشري والسكّاكي لأنَّ كلاهما أعرج، فمصطلح علم المعاني ومفهومه أوَّل من تذوقه وشق طريقه وأنضجه وبيَّنه وأسسه مفهومًا واصطلاحًا: الجرجاني، وأول من سمَّاه وطبقه في تفسيره: الزمخشريّ، وأول من فنّنه –جعله فنًّا متكاملاً- وعرَّفه وحد حدوده نظريًا: السكّاكي.
قيَّض الله لعلم المعاني عالمًا استطاع بذوقه الأدبي الرفيع وثقافته اللغوية العريضة أن يَمزج بين النحو والبيان، ويخرج بنظرية النظم لمباحث علم المعاني، وهو عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وذلك في سِفره العظيم: دلائل الإعجاز
فمن رام الإلمام ببلاغة المتقدِّمين فعليه بكتابَي الجُرجاني (دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة)، ومن أراد أن يُلِمَّ ببلاغة المتأخرين فعليه بكتابَي (المطوَّل، والمختصر للتفتازاني والشروح التي وُضعت عليهما) ويحسن البدء بكتب المتأخِّرين، ثم العكوف على كتب المتقدِّمين.
ومنهج العلماء في عرض مسائل علم المعاني ينقسم لمدرستين:
- المدرسة الأدبية الذوقية، وهي مدرسة عبدالقاهر الجرجاني ومن نهج نهجه، فعقدوا للتقديم والتأخير بابًا، وبابًا للذكر والحذف، وبابًا للتعريف والتنكير، وكانوا يُكثرون من ذكر الأمثلة والنصوص ويتذوَّقونها.
- والمدرسة التقريرية التقعيدية، ورُوَّادها البلاغيون المتأخِّرون من أصحاب التعاريف والقوالب، وأصحاب هذه المدرسة يعرضون مسائل علم البيان في ثمانية أبواب: الإسناد الخبري والمسند إليه، ويحتوي مسائل التعريف والتنكير، والذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والمسند، والإنشاء، ومتعلقات الفعل؛ ويقصدون به تقديم المفعول والظرف، والقصر، والوصل والفصل، والمساواة والإطناب والإيجاز.
علاقة علم المعاني بعلم النحو:
هذا العلم قائمٌ على علم النحو، ويمثل مرحلةً متقدمةً عنه، فعلم المعاني لا يستقيم إلا بمراعاة الأحكام النحوية، فهما يمثِّلان مستويين من مستويات النظام اللغوي، وهناك قدرٌ مشترك بين العِلمين، ومعالم التلاقي بين العلمين كثيرة، فبعلم النحو يتحقَّق فهم البنية التركيبية، وبعلم المعاني تتحدَّد أهداف التعبير والتواصل، فلا يمكن فهم وتطبيق علم المعاني بدون النحو، فهو الجذر والساق، وعلم المعاني الثمار والأوراق، لذا من خسر علم النحو خسر علوم العربية وخسر علوم الشريعة.
أهمية علم المعاني في الوقوف على إعجاز القرآن الكريم:
ذكر عبدالقاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز أهمية هذا العلم، فقال:
“ثم إنَّك لا ترى علمًا هو أرسخ أصلاً، وأبسق فرعًا، وأحلى جنىً، وأعذب وِردًا، وأكرم نتاجًا، وأنور سراجًا من علم البيان -يقصد علم المعاني- الذي لولاه لم تر لسانًا يحوك الوشي، ويصوغ الحلي، ويلفظ الدر، وينفث السحر، ويقري الشهد، ويريك بدائع من الزهر، ويجنيك الحلو اليانع من الثمر… إلى فوائد لا يدركها الإحصاء، ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء”([6]).
فأهميته تنبع من الوقوف على أسرار البلاغة في منثور الكلام ومنظومه، فنحتذي حذوهما وننسج على منوالهما، ونعرف السر في افتخار النبي r بقوله: (أوتيت جوامع الكلام)([7]).
وكذلك معرفة وجه إعجاز القرآن من وجهة ما خصه الله به من حُسن التأليف، وبراعة التركيب، وما اشتمل عليه من عذوبة وجزالة وسهولة وسلاسة، فننتفع ببلاغته، وندرك السر في فصاحته، وكيف كان معجزةً خالدةً على وجه الدهر.
وتظهر أهمية علم المعاني ضمن فنون علم البلاغة، بأنّه شرط من شروط من يتصدَّى لكتاب الله مفسرًا، لذا قال الزركشي: “وهذا العلم (المعاني) أعظم أركان المفسِّر، فإنَّه لا بدَّ من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم، وأن يُوَاخي بين الموارد، ويعتمد على ما سيق له الكلام حتى لا يتنافر، وغير ذلك”([8]). ونصَّ على ذلك السيوطي في الإتقان([9]).
فمعرفة هذا العلم بدقائقه وفروعه هو عُمدة التفسير، وهو واسطة عقد البلاغة، وقاعدة الفصاحة.
ونستطيع أن نُجمل أهمية علم المعاني في نواحٍ ثلاثٍ:
- الأولى: الوقوف على إعجاز القرآن الكريم، من حيث ما خصهُ الله به من جودة النظم، وبراعة التراكيب، وحسن الوصف، وجزالة الكلمات.
- الثانية: القدرة على التفريق بين جيد الكلام ورديئه، وبين البيان العالي والكلام الذي هو أشبه بصوت الحيوانات.
- الثالثة: القدرة على تأدية المعنى بوجه سليم دقيق بعيدًا عن الخطأ والزلل، فبهذا العلم يُعرف السبب الذي يدعو إلى التنكير والتعريف، والتقديم والتأخير، والذكر والحذف، والإطناب والإيجاز والمساواة، والقصر، والفصل والوصل، فيأتي الكلام مطابقًا لمقتضى الحال.
***
وبعد أن تعرَّفنا على علم المعاني ومنهج العلماء في تناوُله وأهميته، لابدَّ من أن نعرض بعض تطبيقاته على كتاب الله حتى نتذوَّق بأنفسنا شيئًا من سر إعجاز القرآن الكريم الذي أوحاه الله روحًا من أمره، ومعجزة لنبيه.
“لا ترى علمًا هو أرسخ أصلاً، وأبسق فرعًا، وأحلى جنى، وأعذب وردًا، وأكرم نتاجًا، وأنور سراجًا، من علم البيان (علم المعاني)، الذي لولاه لم تر لسانًا يحوك الوشي، ويصوغ الحلي، ويلفظ الدُّر وينفث السحر، ويقري الشهد، ويريك بدائع من الزهر، ويجنيك الحلو اليانع من الثمر”
عبدالقاهر الجرجاني
أمثلة على تطبيقات علم المعاني في كتاب الله سبحانه:
- أنواع الخبر:
بحث البلاغيون أضرب الخبر من حيث التوكيد وخلافه، فإذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر استغنى عن مؤكدات الحكم، يقول الخطيب القزويني: “وينبغي أن يُقتصر من التركيب على قدر الحاجة، فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغنى عن المؤكدات، وإن كان مترددًا فيه طالبًا حَسُنَ تقويته بمؤكد، وإن كان منكرًا وجب تأكيده بحسب الإنكار… ويسمى الضرب الأول ابتدائيًا، والثاني طلبيًا، والثالث إنكاريًا”([10]).
جاء عن المبَرِّد: قولك: عبدُالله قائم إخبار عن قيامه، وإن عبدَالله قائم جواب سائل عن قيامه، وإن عبدَالله لقائم جواب منكر لقيامه. فهنا المتكلم المخبر كالطبيب الذي يعطي المريض الدواء المناسب بالكمية المناسبة([11]).
فبعد أن تعرفت على أضرُب الخبر فما سرُّ تبايُن الآيتين في قوله تعالى:
﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ١٤ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٥ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ [يس: 14-16] لماذا جاءت الآية الأولى بدون لام التوكيد في قوله (مُرْسَلُونَ) ولماذا جاءت الآية الثانية مع لام التوكيد في قوله (لَمُرْسَلُونَ).
يقول أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: وجاء أولاً (مُرْسَلُونَ) بغير لام لأنه ابتداء إخبار، فلا يحتاج إلى توكيد بعد المحاورة. (لَمُرْسَلُونَ) بلام التوكيد لأنه جواب عن إنكار، وهؤلاء أمة أنكرت النبوات بقولها: ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [يس: 15]([12]).
ففي الآية الأولى ابتداء إخبار فلا يحتاج لمؤكد، وفي الآية الثانية جواب عن إنكار وذلك لأنهم كذبوهم لذا أكدت بثلاثة مؤكدات على حسب حالة تكذيبهم، وهي تقديم (إِلَيكُم) على (لَمُرْسَلُونَ)، وباسمية الجملة، وبدخول لام التوكيد على الخبر (مُرْسَلُونَ).
- الوصل والفصل:
وفي الوصل والفصل في كتاب الله، يُنبه الزمخشريّ إلى ظاهرة أسلوبية دقيقة في نظم القرآن، فيُنبِّه إلى الجملة التي تأتي في نسقٍ مفصولةً عما قبلها من جمل، وتأتي في نَسَقٍ آخر وقد وُصلت بما قبلها، وذلك لأن المعنى قد لا يتَّسق إلا بالوصل، أو لا يتَّسق إلا بالفصل، فما الفصل والوصل إلا وسيلة فنية لتحقيق أهداف المعنى المقصود.
ففي سورة الحج ترد جملة: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ [الحج: 34] موصولة بالواو في بدايتها، ثم تمضي ثلاث وثلاثون آية وتأتي نفس الجملة وهي مفصولة بدون واو في بدايتها، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ [الحج: 67]، يتساءل الزمخشريّ: لِمَ جاءت نظيرة هذه الآية معطوفة بالواو وقد نزعت عن هذه؟ فيجيب: “لأن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك فعطفت على أخواتها، وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفًا”([13]).
- التعريف والتنكير:
وفي التعريف والتنكير وارتباطهما بالأسرار البلاغية في المقام والسياق الذي تردان فيهما، حيث يرتبط ذكر المعرفة والنكرة في السياق بحسب ما يقتضيه المقام من إفادة المخاطب.
ففي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: 131]، ذكر (إِذا) مع (الحَسَنَة) وتعريفها، وذكر (إِنْ) مع (سَيِّئَة) وتنكيرها: إشارة إلى أنَّ الحسنة مقصودةٌ بالذات وكثيرة الوقوع، والسيئة مقصودة بالتبع وقليلة الوقوع. فهنا أتى بالحسنة معرفة للدلالة على القصد والكثرة، ونكَّر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندورها وعدم القصد لها. فسياق الآيات يتحدَّث عن آل فرعون، فعندما أراد المولى تعداد نِعَمه عليهم، وصفها بالحسنة معرَّفة لتدل على كثرة نعم الله عليهم، وعندما بيَّن الله ما ابتلاهم به عبَّر بالسيئة منكَّرة للدلالة على القلة في مقابل الكثرة في جنب النعم.
- التقديم والتأخير:
أما التقديم والتأخير في كتاب الله فهو أسلوب فني مقصود، فيتعرض ترتيب الجملة العربية لخرق فني يتجاوز الدلالة السطحية إلى دلالة أعمق منها بالتقديم والتأخير.
كما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]: ففي التقديم والتأخير في الآية أكثر من غرض بلاغي، قدم العبادة على الاستعانة لأنَّ تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة، ولا شبهة في أنَّ العبادة وسيلة إلى طلب المعونة الضرورية، وقُدم المفعول (إِيّاكَ) على فعله للتعظيم والدلالة على الحصر والتنبيه، وكذلك رعاية توافق رؤوس الآي وجه آخر للتقديم، ويمكن أن تجتمع كل هذه الأغراض البلاغية للتقديم في الآية لأن الأغراض البلاغية تتداخل ولا تتعارض.
وكذلك في هذه الآية التفات من الغيبة للخطاب حيث يقول البيضاوي في ذلك: “ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد، ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك، أي: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص، وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود، فكأن المعلوم صار عيانًا والمعقول مشاهدًا والغيبة حضورًا، بنى أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه، ثم قفَّى بما هو مُنتهى أمره، وهو أن يخوض في لجَّة الوصول، ويصير من أهل المشاهدة، فيراه عيانًا ويناجيه شفاهًا… ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطًا للسامع، فيعدل من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس”([14]).
- الذكر والحذف:
ويعدّ الذكر والحذف من الأساليب البلاغية المهمة في كتاب الله، فهو يعبر عن إيصال الفائدة من الكلام بأبلغ وجه، فأحيانًا الذكر يعبر عن المقصود من الكلام بأوضح صورة، وفي أخرى يكون الحذف أبلغ من الذكر، وهو المعني بالتعبير الفصيح وإيصال المقصود.
ففي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾ [الأنعام: 93]: مفعول (ترى) محذوف دل عليه الظرف المضاف، والتقدير: ولو ترى الظالمين إذ هم في غمرات الموت، والمقصود من هذا الشرط تهويل هذا الحال، ولذلك حذف جواب (لو) كما هو الشأن في مقام التهويل والتعجيب، حتى تذهب النفس فيها كل مذهب من التهويل والتعجيب.
- الإيجاز والإطناب:
والإيجاز والإطناب والمساواة من الأساليب المهمة في البلاغة، وهو شرط من شروطها، فهو يدور حول مناسبة الكلام لمقتضى حال المخاطب، وكل معنى يطوف في خاطر الإنسان وعقله يعبر عنه بإحدى هذه الطرق الثلاثة، ولكن على حسب حال المخاطب ننتقل بين الأساليب الثلاثة.
ورحم الله العلوي صاحب الطراز إذ شبه هذه الأساليب بالثوب للجسد، حيث قال: “اعلم أن الكلام بالإضافة إلى معناه كالقميص بالإضافة إلى قَدِّ مَن هو له، فربما كان على قَدرِ قَدِّهِ من غير زيادة ولا نقصان، وهذا هو المساواة، وتارة يكون زائدًا على قَدِّهِ وهذا هو الإطناب، وربما نقص عن قَدِّهِ، وهذا هو الإيجاز، فإذن الكلام لا يخلو عن هذه الأنواع الثلاثة”([15]).
وفي قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]، وهي من الشواهد التي اهتزت لها رؤوس علماء البلاغة والبيان بالاستشهاد بها في باب الإيجاز، كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده، وهذه الآية بلغت وجازة لفظها وكثرة معناها مع دقته واشتماله على الاعتبارات الغريبة إلى أرفع درجات الفصاحة والبلاغة.
وتنافس البلاغيون في إيجاد الفروق البلاغية بين بلاغة وإيجاز هذه الآية القرآنية، وبين قول العرب: القتل أنفى للقتل، فذكر القزويني ثمانية فروق بين العبارتين، فيما أوصلها الزركشي إلى عشرين فرقًا من وجوهٍ عدّة.
فعلى وَجازة التعبير القرآني في الآية، إلا أنها حملت معاني عظيمة في الحفاظ على الأنفس والأرواح وأمن المجتمعات.
- تلوين الخطاب:
أما تلوين الخطاب فهذا الفن لا يخرج عن كونه تنويعًا وتغييرًا في أساليب الكلام، والانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أو الانتقال من صيغة صرفية إلى أخرى، أو تصرف بالعبارة، بحيث لا يستمر الكلام على طريقة واحدة.
فعند استقصاء الأساليب التي تلفت الانتباه بالتفنن في القول والتغير من حال إلى حال، أو الخروج عن مقتضى الظاهر، نستطيع أن نعْرف حدّ هذا الأسلوب البديع من أساليب البلاغة، فهو يجمع بين طياته أساليب متنوعة عند اجتماعها وتلاحمها يتكوَّن مصطلح” تلوين الخطاب”.
ففي التعبير عن المستقبل بالماضي: تنبيهٌ على تحقق وقوعه، وأن ما هو للوقوع كالواقع، وفائدته أن الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد، كان أبلغ وأوكد في تحقيق الفعل وإيجاده؛ لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد وجد وكان، ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهددة المتوعد بها، فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرًا وتحقيقًا لوقوعه([16])، كما في قوله تعالى: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [إبراهيم: 21]، أي: يبرزون لله يوم القيامة جميعًا، وإنما جيء بلفظ الماضي لتحقق وقوعه، نحو: ونادى أصحابُ الجنة.
لا نقول: كلُّ كلمة لها إعجازها؛ فكل حرفٍ له، بل كل حركة فيه، وكل تقديم وتأخير، وكل تعريف وتنكير، وكل ذكر وحذف، وكل وصل وفصل؛ مقصود لغايةٍ وهدف
التعبير عن الماضي بلفظ المضارع أو المستقبل: فائدة هذا الأسلوب أن المستقبل إذا أُخبر به عن الماضي، تبينت من خلال هذا الأسلوب هيئة الفعل، وذلك باستحضار صورته، فيكون السامع كأنه شاهد يشهد الحدث الآن، وليس كذلك الفعل الماضي، وهكذا يفعل بكل فعل فيه نوع تمييز وخصوصية، كحال تُستغرب، أو تهم المخاطب، أو غير ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 127]، قال ابن عاشور: “حكايتها كأنها مشاهدة لأن المضارع دال على زمن الحال، فاستعماله هنا استعارة تبعية، شبه الماضي بالحال لشهرته ولتكرر الحديث عنه بينهم، فإنهم لحبهم إبراهيم وإجلالهم إياه لا يزالون يذكرون مناقبه وأعظمها بناء الكعبة، فشبه الماضي لذلك بالحال… مما يوجب امتلاء أذهان السامعين بإبراهيم وشؤونه حتى كأنه حاضر بينهم، وكأن أحواله حاضرة مشاهدة”([17]).
- ضرورة علم المعاني للتفسير:
من أراد تذوُّق علم المعاني في كتاب الله بإحساس مرهف فعليه من التفاسير بثلاثة:
- الكشاف وهو العمدة، ومعه حاشية الطيبي على الكشاف لأنَّه شرح المغلقات من مسائل الكشاف.
- ثم تفسير المحرر الوجيز لابن عطية حيث كان ابن تيمية يُقدِّمُه على الكشاف؛ ففيه أهم ما في الكشاف مع ترك مواطن الاعتزال.
- ثم التفسير الثالث الذي لا غنى لبلاغيٍّ عنه: التحرير والتنوير لابن عاشور الذي تشعر وأنت تقرأ تفسيره بأنه من القرن الخامس الهجري، وهو من المعاصرين.
لأنَّ هؤلاء المفسرين عندما وقفوا مع القرآن لم يقفوا معه كوقوفهم مع كلام الناس، بل وقفوا معه على أنه كلام ربِّ الناس، فلا أقول: كلُّ كلمة لها إعجازها؛ فكلُّ حرفٍ له، بل كلُّ حركةٍ فيه، وكلُّ تقديمٍ وتأخير، وكلُّ تعريفٍ وتنكير، وكلُّ ذِكرٍ وحذف، وكلُّ وصلٍ وفصل مقصود لغايةٍ وهدف، ولو انتزعنا كلمة من سياقها القرآني ثم أُديرت على ألسنة البلاغيين لم يجدوا لها بديلاً يؤدي معناها المقصود، وما استخرجه المفسرون من بلاغة الكتاب العزيز هو غيض من فيض قطرة من بحر الكتاب المعجز.
فأرجو أن أكون قد قدمت صورة متكاملة عن علم المعاني وأهميته في فهم وتدبر وتفسير القرآن الكريم، وأخذت بيد القارئ ليقف بنفسه على شيء من أسرار إعجاز القرآن الكريم من خلال بلاغته، حيث إنَّ علوم البلاغة –وواسطة العقد فيها علم المعاني- من أجلِّ العلوم قدرًا، وأتمّها منزلة، وأكملها علوًا، وأدقها أثرًا، وأرجو أن يكون قد تبين وجه من وجوه الإعجاز في نظم القرآن العظيم، وعلامات شرف العبارة في كلام الله الكريم، ودلائل الهداية في معاني الآي الحكيم، ثم يا عجبي! ممن يتصدَّون لتفسير كتاب الله وهم خِلوٌ من علوم العربية وخصوصًا علم المعاني وباقي علوم البلاغة.
د. قمر الزمان غزال
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، محاضر في المركز الثقافي الاسلامي- الكويت.
([1]) ينظر: البلاغة العربية أسسها علومها وفنونها، لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني (1/139).
([2]) ينظر: البلاغة تطور وتاريخ، لشوقي ضيف، ص (190). و: قضية الإعمار القرآني ونشأة علم المعاني، لعثمان هلال عطا الله، ص (449).
([3]) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (1/17).
([4]) مفتاح العلوم، للسكّاكي (1/198).
([5]) هذه العبارة وإن جرت مجرى الإشادة بعمل الزمخشري والسكاكي، إلا أنها تخالف مبدأ تكفُّل الله بحفظ القرآن، فالإعجاز القرآني محفوظ لا يضيع، والعلماء ما هم إلا أسباب لإظهار وجوه هذا الإعجاز، ولو لم يأتِ الأعرجان لقيض الله غيرهما من العلماء.
([6]) دلائل الإعجاز، للجرجاني، ص (15).
([7]) أخرجه البخاري (2977)، ومسلم (523) واللفظ له.
([8]) البرهان في علوم القرآن، للزركشي (1/387).
([9]) الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (4/311).
([10]) تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، مطبوع مع شرحه للتفتازاني، ص (44-45).
([11]) نسبه الجرجاني إلى المبرد في دلائل الإعجاز، ص (315). وكذلك السكاكي في مفتاح العلوم، (3/171).
([12]) البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي (3/546).
([13]) الكشاف، للزمخشري (2/449).
([14]) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاويّ (1/28-29).
([15]) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للعلوي (3/176).
([16]) ينظر: الإيضاح، للقزويني (2/96). المثل السائر، لابن الأثير (2/149). البرهان، للزركشي (3/112).
([17]) التحرير والتنوير، لابن عاشور (2/105).