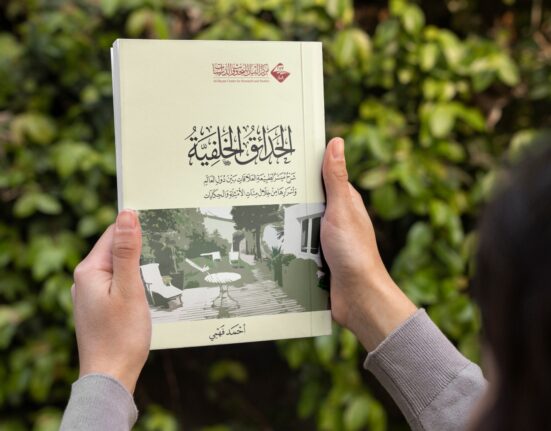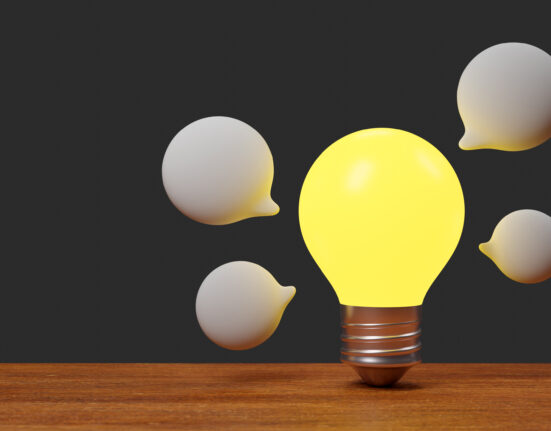انتشرت الأحاديث الضعيفة في السنوات الأخيرة انتشارًا كبيرًا، ومما أسهم في هذا الانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي لا قيود على النشر فيها، مع قلة الاهتمام بالتحرِّي من قبل الناشرين، والمسارعة إلى قبول كل غريب من قبل المتلقِّين، وكأنه علمٌ جديدٌ وفائدةٌ عزيزةٌ. وهذه المقالة تلقي الضوء على عدد من الجوانب المتعلقة بالحديث الضعيف
مدخل:
مضى على الأمة زمان لم يعد الاهتمام بالحديث النبوي رواية واستدلالاً يحظى بتلك المكانة الكبيرة كما كان في العصور السالفة، حتى إذا عادت لها بوادر النهضة الدينية، وشهدت صحوة علمية في مجالات شتى على يد أهل العلم والدعاة، عاد الاهتمام بالحديث النبوي بين عامة الناس. لكن مع ضمور العلم التخصصي، وانتشار وسائل التواصل، ومع العاطفة الدينية وحب الخير ونشره؛ انتشرت الأحاديث الضعيفة إلى جانب الصحيحة حتى اعتادها الناس وظنُّوها صحيحة، خصوصًا أنَّها تنسب لدواوين السنة كالسنن والمسانيد والمعاجم.
وبعد أن يسَّر الله قيام الجهود المعاصرة والمشروعات العلمية التي خدمت السنة النبوية، ونبَّهت إلى ضعيفها، واهتمت بصحيحها، ظهرت تساؤلات واعتراضات ضمن الشبهات التي يواجهها الشباب المسلم ، تشكِّك في الأحاديث النبوية بالعموم، بدعاوى كثيرة منها وجود أحاديث ضعيفة في دواوين السنة، ومنها عدم إمكانية تمييزها من غيرها، … إلى غير ذلك.
وفي هذه المقالة إضاءات للتعريف بالحديث الضعيف، وكيف نشأ، وسبب رواية أهل العلم له، وعوامل انتشاره قديمًا وحديثًا، لتجيب عن جانب مهم من تلك التساؤلات.
ما هو الحديث الضعيف؟
الحديث الضعيف هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث المقبول.
قال ابن الصلاح: «كلُّ حديثٍ لم يجتمع فيه صفاتُ الحديثِ الصحيحِ، ولا صفاتُ الحديثِ الحَسَنِ … فهو حديثٌ ضعيفٌ»[1].
والحديث المقبول نوعان: صحيح وحسن.
والصحيح هو ما اجتمعت فيه شروط القبول الخمسة، وهي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة القادحة.
والحسن هو ما جمع هذه الشروط إلا أنّ في رواته مَن كان خفيف الضبط.
فإذا فُقِدَ أحد هذه الشروط السابقة فالحديث ضعيف.
ومن أمثلته:
• ما فقد شرط الاتصال: الحديث المرسل، والمنقطع، وما في سنده راوٍ مجهول.
• ما فقد شرط العدالة: الحديث الذي في سنده راوٍ متّهم بالكذب، أو الحديث الموضوع (المكذوب).
• ما فقد شرط الضبط: ما في سنده راوٍ سيء الحفظ، أو كثير النسيان، أو أصابه الخَرَف، أو كان لا يُحدّث إلا من كتبه ثم ضاعت أو احترقت.
• ما فقد شرط السلامة من الشذوذ أو العلّة: وهو الحديث الشاذ الذي خالف فيه راويه غيره من الرواة، أو فيه علّة قادحة تمنع من قبوله.
دلالة ضعف الحديث:
بناءً على ما سبق فإن الحكم على الحديث بالضعف لأنَّه فقد شرطًا أو أكثر من شروط القَبول لا يعني أن الحديث كذبٌ في حقيقة الأمر، ولا يعني أنه مطروحٌ بالمرّة، بل يعني أولَ ما يعني أن الحديثَ الضعيفَ مُتوقفٌ فيه لعدم توافر صفات القَبول فيه. قال ابن الصلاح: «وكذلك إذا قالوا في حديث: «إنه غير صحيح» فليس ذلك قطعًا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صِدقًا في نفس الأمر، وإنما المراد به أنَّه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، والله أعلم»[2].
وعليه فبعض أنواع الحديث الضعيف قد تتقوى فتصل إلى درجة الحسن أو الصحيح، وبعضها غير قابل للانجبار كالمضطرب والمنكر والشاذ ورواية الكذّاب.
فإذا كان الشرط المفقود هو الاتصال فقد ينجبر ويتقوّى بمجيئه من طرق أخرى تشهد أنّه متصل، أو تكشف أن الراوي المجهول أو الساقط من الإسناد ثقة أو مقبول، ونحو ذلك.
وإذا كان الشرط المفقود يتعلق بضبط الراوي: فقد ينجبر ويتقوّى بمجيئه من طرق أخرى تشهد أنّ راويه سيء الضبط قد أصاب في هذا الحديث ولم يخطئ فيه.
والضابط في قابلية الحديث الضعيف للانجبار بمجيء الحديث من طرق أخرى يسمّيها علماء الحديث: (المتابعات والشواهد)؛ ما حرره ابن حجر فقال: «والتحرير أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد؛ فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر»[3].
من جهة أخرى: قد يوجد ما يُلحِقُ الحديثَ الضعيفَ بالمقبولِ أو بالمردودِ:
قال ابن حجر: «إنما وَجبَ العملُ بالمقبول منها (أي الأحاديث) لأنها إما أن يوجد فيها أصلُ صفة القَبول وهو ثبوتُ صدق الناقل، أو أصلُ صفة الرد وهو ثبوتُ كذب الناقل، أو لا:
• فالأول: يغلب على الظن ثبوتُ صدقِ الخبر؛ لثبوت صدق ناقله؛ فيؤخذ به.
• والثاني: يغلب على الظن كَذبُ الخبر؛ لثبوت كذب ناقله؛ فيُطرَح.
• والثالث: إن وجدت قرينة تُلحِقه بأحد القسمين الْتَحَقَ، وإلا فيُتَوَقَّفُ فيه، وإذا تُوُقِّفَ عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القَبول، والله أعلم»[4].
والكلام في الأحاديث الضعيفة في هذا المقال هو عن جزء من النوع الثالث، أعني الحديث الذي لم يوجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، ولا وجد فيه ما يلحقه بالمقبول ولا ما يلحقه بالمردود.
فيخرج بهذا:
• الأحاديث الضعيفة في أصلها ووجد فيها ما يُلحقها بالمقبول (فهي مقبولة).
• والأحاديث الضعيفة في أصلها ووُجد فيها ما يلحقها بالمردود (فهي مردودة).
• والأحاديث الموضوعة[5].
وبناءً على ما سبق يقال: ليست كل الأحاديث الضعيفة بمرتبة واحدةٍ، بل لكل نوع منها رتبته التي تخصه، ومن الخطأ الحكم على الأحاديث الضعيفة كلها بحكم واحدٍ. وإن كانت كل الأحاديث الضعيفة بمراتبها المتعددة يجمعها حكم عام هو: عدمُ كونها حجةً شرعيةً بذاتها.
كيف ومتى نشأ الحديث الضعيف؟
في الحقيقة لا يوجد نقطة زمنية تشكل مبتدأ نشأة الحديث الضعيف، إلّا أننا يمكن أن نقول إن البداية كانت في عهد التابعين، حيث نشطت حركة الرواية، وبدأت سلسلة الإسناد تطول؛ ففي حين كان التابعي يروي الحديث عن الصحابي؛ وُجِدَ تابعي يروي عن تابعي عن صحابي، وتابعي يروي عن تابعي عن تابعي (إلى سبعة من التابعين) عن صحابي.
ومع طول سلسلة الإسناد والتي قد يوجد فيها رجل عدل لكنّه سيء الحفظ؛ فيخطئ في نقل الحديث. أو يوجد بين الرواة راوٍ من أهل البدع التي بدأ ظهورها في هذا العصر، وهؤلاء ربما رووا ما يؤّيد بدعتهم أو كذبوا لتأييد بدعتهم؛ كل هذا جعل العلماء لا يقبلون الأحاديث إلا بعد السؤال عن الرواة وأحوالهم للتأكّد من عدالتهم وضبطهم، قال محمد بن سيرين رحمه الله: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»[6].
هذا البحث في الإسناد أوجب فرز الأحاديث المقبولة عن غير المقبولة؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور الحديث الضعيف.
أسباب الحكم على الحديث بالضعف:
أسباب الحكم على الحديث بالضعف كثيرة، بعضها راجع إلى ما ذكر من نقص في ضبط أو عدالة الرواة، وبعضها راجع إلى عدم التزام الرواة بالضوابط التي اتفق عليها العلماء لقبول الحديث، أو تعمّد بعضهم إخفاء عيوب السند حتى يقبل الناس الأحاديث التي يرويها ويشتهر بينهم، وبعضها ناتج عن خطأ غير مقصود، من أمثلة هذه الأسباب ما يلي:
1. مجيء الحديث من رواية سيء الحفظ أو ضعيف الضبط، وتفرده به.
2. مجيء الحديث من رواية مبتدع أو كذّاب.
3. وَهَمُ الراوي وخطؤه (حتى وإن كان ثقةً) في نسبة كلام الصحابة أو غيرهم إلى رسول الله ﷺ، كأن يسمع كلامًا قاله أحد الصحابة أو التابعين فيظنّه من كلام الرسول ﷺ؛ فينسبه إليه. أو يسمع حديثًا عن النبي ﷺ مع شرحه فيظن الشرحَ من الحديث فيرويه كلّه على أنه من كلام النبي ﷺ.
4. وَهَمُ الراوي في اسم شيخه أو من فوقه في الإسناد، أو قلب الإسناد، أو قلب المتن، ونحو ذلك من الأخطاء التي تجعل الثقة بهذه الرواية محل نظر، فيحكم بضعفها.
5. تعمّد الراوي إخفاء أسماء الرواة الذين اشتهروا بالضعف من السند بتسميتهم بغير ما اشتهروا به من الأسماء أو الكنى! وهذا ما يسمّى التدليس، وهو من العيوب التي تقدح في الرواية وتجعلها غير مقبولة.
6. رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع، وهذه الرواية في الحقيقة منقطعة، وتُسمّى الإرسال الخفي.
7. وجود جهالة بالراوي المذكور في السند، بأن يُذكر في الإسناد راوٍ باسمه لكنه لا يعرف مَن هو، ولا تعرف عدالته ولا ضبطه.
لماذا روى المحدثون الحديث الضعيف في كتبهم؟
قد يرد على ذهن القارئ سؤال: لماذا يروي المحدث حديثًا ضعيفًا ويثبته في كتابه؟ ألا يعلم أنه ضعيف؟
والجواب على هذا أن للعلماء أغراضًا متعددة في تصانيفهم، ومن المهم معرفة هذه الأغراض قبل الاعتراض على رواية هذه الأحاديث، ومن هذه الأغراض:
1. جمع السنة النبوية: فقد كان المحدّثون يثبتون في كتبهم ما يجدونه مرويًا في عصرهم من الأحاديث[7]، وروايتهم للأحاديث الضعيفة لا تعني أنهم كانوا يقبلونها ويعتبرونها حجَّة، بل يروونها لاحتمال أن يظهر لها طرقٌ أُخرى تقويها، أو يظهر لها شاهدٌ يقوِّيها، أو أن يظهر تفرُّد الراوي الضعيف بالحديث فلا يَقبَل التقوية. قال الحاكم: «ولعل قائلاً يقول: وما الغرض في تخريج ما لا يصح سنده ولا يُعَدّلُ رواتُه»؟ ثم قال في الجواب: «وللأئمة رضي الله عنه في ذلك غرضٌ ظاهرٌ؛ وهو أن يعرفوا الحديث من أين مَخرجه، والمنفرد به عدل أو مجروح»[8]. ومن أمثلة المصنفات التي تتبع هذه الطريقة: المسانيد عمومًا، كمسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١ه) الذي جمع فيه أحاديث كل صحابي في مكان واحد بقطع النظر عن موضوعات هذه الأحاديث أو صحتها.
2. تمييز الأحاديث الضعيفة: فيقصد المصنف بيان الأحاديث التي فيها علة تمنع من الحكم بصحتها. «ومن أشهر المصنفات التي هي مظنة الضعيف:
1. الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء: ككتاب الضعفاء لابن حبان، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي؛ فإن مؤلفيها يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها.
2. الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة: مثل كتب المراسيل والعلل والمُدرَج وغيرها. ككتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للدارقطني»[9].
3. جمع الأحاديث التي عمل بها الفقهاء: ولو كان بينها حديث ضعيف، وهذا كعمل أصحاب السنن الأربعة: ابن ماجه (٢٧٣ه)، وأبي داوود (٢٧٥ه)، والترمذي (٢٧٩ه)، والنسائي (٣٠٣ه)، وهم لم يشترطوا الصحة ولا الاستيعاب، وانفرد الترمذي من بينهم ببيان حكمه على الأحاديث التي رواها. وكسنن الدارقطني حيث كان يبين ما في الأحاديث التي يرويها من علل أو أوهام.
4. ذكر الأحاديث التي لم يرد في الباب غيرها وإن كانت ضعيفة: قال أبو داود: «وإن من الأحاديث في كتابي «السنن» ما ليس بمتصلٍ، وهو مرسَلٌ ومدلَّسٌ، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل»[10].
وثمة أغراض أخرى للمصنفين في الحديث، وتنوع هذه الأغراض يظهر لنا أنهم قصدوا جمع السنة النبوية أولاً، ثم جاء من أفرد الصحيح بالتصنيف وعلى رأسهم البخاري (٢٥٦ه) ومسلم (٢٦١ه)؛ فقد اشترطا في كتابيهما الصحة، ولم يشترطا استيعاب كل الصحيح.
وقد كان عصرُ الرواية عصرَ علمٍ يسهل على طالب العلم فيه معرفة حال الرواية إسنادًا ومتنًا، لذلك قيل: «من أسند فقد أحالك»، أي أحالك على مصدر الخبر الذي رواه بإسناده لتدرس الإسناد وتعرف درجته.
عوامل انتشار الحديث الضعيف في العصور السابقة:

• الثقة بالرواة الناقلين للأحاديث: فالراوي الضعيف قد يكون عالمًا أو قاضيًا أو مفتيًا، لكن ضعفه جاء من جهة سوءِ حفظه أو ضياع كتبه، أو كبر سنه وشيخوخته، فعبدالله بن لهيعة مثلاً عالم الديار المصرية وقاضيها ومفتيها ومحدثها في زمانه، لكنه كان يُدلِّس عن الضعفاء فلم يقبل حديثه، ثم احترقت كُتبه قبل موته بسنوات فصار يحدث من حفظه فيخلط[11].
• غرابة كثير من الأحاديث الضعيفة: فإنَّ الراوي سيِّء الحفظ قد يروي حديثًا في ثواب عملٍ ولسوء حفظه يُخطئ في قدر الثواب فيُبالغ، فينتشر الحديث بين الناس لما فيه من أجر عظيم على عمل قليل. وكذا الأحاديث التي يرويها الضعيف وفيها مبالغة في العقاب فينتشر الحديث بين الناس حذرًا مما فيه.
• تساهُل العلماء في رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال دون بيان ضعفها، فتدور هذه الأحاديث بين العامة الذين لا يُميِّزون بين الصحيح والضعيف. والعلماء إنما يتساهلون في رواية هذه الأحاديث لأنها لا تنشئ حكمًا شرعيًا ولا تُحلُّ حرامًا ولا تُحرِّم حلالاً، فيروونها للعبرة والاتِّعاظ بما فيها من ترغيب أو ترهيب، فتنتشر بين الناس وينسبونها للنبي ﷺ.
عوامل انتشار الحديث الضعيف في العصور المتأخرة:
يضاف إلى الأسباب التي مرت:
• تيسُّر طباعة الكتب ونشرها أدى إلى انتشار العلم عمومًا، وأدى إلى انتشار الأحاديث عمومًا، ومنها الأحاديث الضعيفة.
• سهولة النشر في وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الرقابة عليها، فيطير ما ينتشر فيها في الآفاق.
• قلة المتخصصين في العلم الشرعي عمومًا وفي علم الحديث خصوصًا، وهذا أدى إلى انتشار الأحاديث الضعيفة بين العامة وبين طلبة العلم أيضًا.
• تساهُل كثير من العلماء وطلبة العلم في الفتوى بالعمل بالحديث الضعيف عمومًا، دون مراعاة الضوابط التي وضعها القائلون بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولا سيما في الأحاديث التي فيها ثواب كبير على عمل قليل كما مر معنا، فصارت هذه الأحاديث مقصِدًا للخطباء والوعاظ يبشرون الناس بها، فيكثر سماع الناس لها وتألفها نفوسهم وتنتشر بينهم انتشارًا واسعًا.
والعلماء الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وضعوا لذلك شروطًا، وهي:
1. أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج بهذا الشرط الأحاديث شديدة الضعف والأحاديث المنكرة والموضوعة، فلا يجوز العمل بها باتفاق.
2. أن يكون الضعيفُ مندرجًا تحت أصلٍ عام، فيخرج بهذا الشرط الحديث الذي يتضمن عملاً مخترعًا ليس له أصل معمول به.
3. ألّا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يثبت عنه، ولكن يعتقد الاحتياط.
4. أن يكون موضوع الحديث الضعيف فضائل الأعمال، فيخرج بهذا الشرط الأحكام والعقائد، فلا يعمل بها بالحديث الضعيف، ولا تثبت أي مسألة من مسائل العقائد بالحديث الضعيف[12].
وما يقوله العلماء المجيزون للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أنّه ينبغي ألّا يتعدّى إلى دعوة الناس إليه وحثهم على العمل به في مختلف المناسبات، والمُشاهَدُ غيرُ ذلك للأسف، فكثيرًا ما تسمع الخطباء في المساجد والوعاظ في وسائل التواصل يحثون ويرشدون إلى عملٍ، ثم يستدلُّون بحديث وهم ويعلمون أنه ضعيف، ويعقبون قولهم هذا بأنه وإن كان ضعيفًا إلا أن الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال! وهذا خطأ؛ لأن الحثَّ والدعوة لا يكونان إلا في أمر مطلوب شرعًا، والقائلون بالعمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا يعتبرونه أمرًا مطلوبًا شرعًا، بل من الجائز المباح.
قد يكون متن الحديث الضعيف صحيح المعنى:
الحديث الذي حكم عليه النقاد بالضعف لعدم توافر صفات القبول فيه قد يكون متنه موافقًا لآية أو حديث آخر صحيح، فنحكم بضعفه سندًا، ولا نجزم عند ذكره بأنه من قول رسول الله ﷺ.
وينبني على هذا أننا إذا رأينا حكمًا شرعيًا ذكره الفقهاء وذكروا عنده حديثًا، ثم بحثنا عن حكم الحديث فوجدناه ضعيفًا: أننا لا نسارع إلى ردّ هذا الحكم لضعف هذا الحديث، فقد يكون للحكم مستندٌ آخر صحيح، إما من القرآن أو السنة أو من قواعد الشريعة، أو يكون حكمًا مجمعًا عليه وخفي علينا دليل الإجماع، فالتسرع في ردّ مثل هذا الحكم جرأة غير محمودة.
ومن أمثلة هذا حديث: (كل قرض جر منفعةً فهو ربًا)[13]، وهو حديث ضعيف جدًا من حيث السند، لكن المعنى الذي يتضمنه وهو أنّ من الربا اشتراط ردّ القرض مع زيادةٍ؛ حكمٌ مُجمعٌ عليه، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المُسْلِفَ إذا شَرَطَ عند السلفِ هديةً أو زيادةً فأسلفه على ذلك أن أَخْذَهُ الزيادةَ ربًا»[14].
خطورة انتشار الأحاديث الضعيفة:
مر معنا أن حكم النقاد بأن هذا الحديث ضعيف لا يعني أنه كذب في نفس الأمر، وأن المراد به: أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور في الحديث المقبول.
ولو أن الأحاديث الضعيفة عوملت بطريقة علمية صحيحة بحيث توضع في مقامها المناسب بحسب نوع الضعف ودرجته، فلا تهمل كلها إهمالاً تامًّا، ولا تقدم على مكانها الصحيح، لهان الأمر، لكن انتشار هذه الأحاديث الضعيفة انتشارًا واسعًا وقبول الناس لها وعملهم بها دون استحضار ما مر، ودون استحضار شروط العمل بالضعيف في فضائل الأعمال عند من يرى جوازه، ودون استحضار أنها ليست حجة شرعية؛ ينتج عنه أخطار لا بد من معرفتها لتجنبها.
فمن هذه الأخطار:
• مزاحمة هذه الأحاديث الضعيفة للأحاديث الصحيحة، وانتشارها على حساب انحسار الأحاديث الصحيحة من الحياة العملية للمسلمين، فالعمل بالحديث الضعيف يعني ترك العمل بحديث صحيح غالبًا، وإن كان الحديث الضعيف يتعلق بموضوع الحديث الصحيح.
• الشك الناشئ عن الغرابة في كثير من الأحاديث الضعيفة سينسحب إلى السنة النبوية عمومًا، فالأحاديث الضعيفة التي فيها ترغيب كبير على عمل قليل أو ترهيب كبير على ذنب صغير سينشئ في نفوس الناس شكًا في السنة عمومًا؛ لأن أكثر ما يطرق سمعهم هو هذه الأحاديث وفيها هذه الغرابة، ولو أنها عوملت بما يناسب وتعرف الناس على ضعفها؛ لانحصر الاستغراب والشك فيها فقط، ولم ينسحب إلى السنة عمومًا.
وختامًا:
ليس من شأن عموم الناس وعوامهم التفريق بين الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال والحديث الضعيف الذي لا يعمل به فيها، ومن هنا لا ينبغي للخطباء والوعاظ أن ينصحوا الناس بالعمل إلا بما صح من الحديث، وعليهم أن يعلموا أنهم مسؤولون أمام الله تعالى عن علمهم الذي علمهم الله.
ولو مات الإنسان ولم يعمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال فلن يسأله الله عن عدم العمل به، ولن ينقص من دين الإنسان شيء بعدم العمل به، والسلامة لا يعدلها شيء.
أ. عبد الملك الصالح
إجازة في الشريعة من جامعة دمشق، ماجستير في الحديث وعلومه.
[1] معرفة أنواع علوم الحديث، لابن الصلاح (٤١).
[2] معرفة أنواع علوم الحديث، ص (١٤).
[3] النكت على مقدمة ابن الصلاح، ص (٧٠).
[4] نزهة النظر (٥١).
[5] الحديث الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مردود ولا اعتبار له، وتسميته حديثًا ليست تسمية مطابِقةً، بل قد يسمى حديثًا «نَظرًا إلى زَعم واضعه، ولتُعرَف طرقُه التي يُتوصل بها لمعرفته ليُنفَى عن القَبول»، ينظر: فتح الباقي، لزكريا الأنصاري، ص (٢٨٥).
[6] أخرجه مسلم في المقدمة، ص (١٥).
[7] قال الإمام مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سنته، أو حديث عمر، أو نحو هذا فاكتبه لي، فإني قد خفت دروس العلم، وذهاب العلماء. أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٣٦)، وعلق البخاري في صحيحه (٩٩): «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء».
[8] المدخل إلى كتاب الإكليل، ص (٣١).
[9] تيسير مصطلح الحديث، للدكتور محمود الطحان، ص (٨١).
[10] رسالة أبي داود إلى أهل مكة، ص (٣٠).
[11] تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام، للذهبي (٤/٦٦٨) وما بعدها.
[12] ينظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، للدكتور عبد الكريم الخضير، ص (٢٧٥).
[13] أخرجه الحارث (٤٣٧) من حديث علي مرفوعًا، وفي إسناده سوار بن مصعب: متروك. وأخرجه البيهقي (١٠٩٣٣) من قول فضالة بن عبيد الصحابي موقوفًا عليه.
[14] الإجماع، لابن المنذر، ص (١٣٦) برقم (٥٧٠).