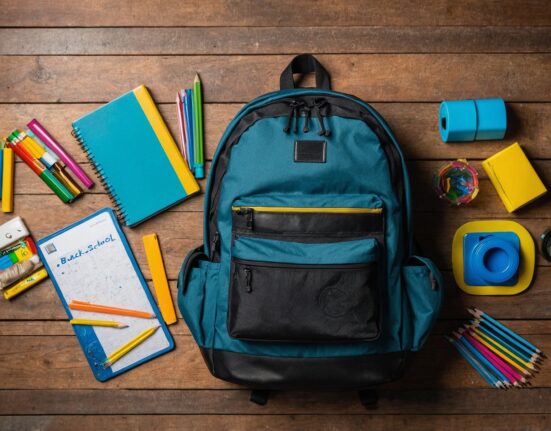تعلّم الأطفال الأول يكون من خلال النظر إلى سلوك والديهم؛ لا من خلال تلقّي توجيهاتهم المباشرة. وإذا اعتمدت التربية على التوجيهات دون التفاعل فستتحوّل إلى صراعٍ بين الوالدين والطفل، وأفضل مناهج التربية الموافقة للفطرة هي ما تكون مزيجًا من المعايشة والتفاعل بين ممارسات الوالدين وملاحظة الطفل، بحيث يكون توجيه الطفل متّسقًا معها؛ لا معاكسًا لها.
أهمية التربية بالقدوة في تشكيل الشخصية:
يتعلم الناشئ بالقدوة فوق ما يتعلم بالتلقين؛ لأنّ التقليد يتوافق مع الفطرة، بخلاف الانصياع للتوجيهات المباشرة التي قد يتمرّد عليها. وعلى ذلك، فكثير من الأعراف المنزلية السائدة: تحوّل التربية من ميدانِ تنشئة وتهذيب وصياغة شخصية سليمة إلى ميدانِ حرب يتدافع فيه السِّباب والصياح، وتهطل فيه إملاءات الأوامر على الناشئ كأنّه عسكري آلي، أو إلى ساحة إقطاعية وملكيّة شخصية يتمّ التحكّم فيها تحكّمًا خانقًا، أو إلى ملعب مفتوح يُترَك للناشئ فيه الحبل على الغارب بدعوى حريته واستقلال شخصيته!
فإذا اتّكأت منهجية الوالدين التربوية على كثرة الصياح والأوامر، كان ذلك مؤشّرًا على مدى بُعدِهِما عمّا ينشدان بُنيانه في أولادهما بالقوة. فلأنْ ينهض طفل في جوف الليل ليشهد أباه يصلّي خاليًا ويدعو الله؛ خيرٌ وأبقى في نفسه من ألف محاضرة في فضل قيام الليل ممن يقضيه ساهرًا أمام التلفاز. وما ظنّك بمن ينشأ على مرأى أمّه تقوم الليل أو تصطبح بترتيل القرآن، وعلى والده حريصًا على صلاة الجماعة على وقتها أو طلب العلم النافع، وعلى والديه يتحاوران بأدب ويتناقشان نقاشات هادفة يُشرِكانِه فيها، ويجتمعون في حلقات سمر ومطالعة مشتركة؟ هكذا تكون التربية الحقّة، التي لا تتأتّى إلا بأن يصدق الوالدان في معايشة ما يزعمان أنّهما يودّان تربية أولادهما عليه؛ لأنّ بيئة التربية ليست منفصمة عنهما وعمّا هما عليه، بل هي في الأساس انعكاس حيّ لحقيقة حالهما ومدى تزكّيهما.
وهذا نموذج تطبيقي في التربية بالقدوة مع التدرج التوجيهي:
حكى سهل بن عبد الله التُّستَريُّ: “كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سِوارٍ، فقال لي خالي يومًا: “ألا تذكر الله الذي خلقك؟” فقلت: “كيف أذكره؟” قال: “قل بقلبك عند تقلُّبك في ثيابك ثلاث مراتٍ من غير أن تحرّك به لسانك: الله معي، الله ناظرٌ إلي، الله شاهدي”. فقلت ذلك لياليَ ثم أعلمتُه، فقال: “قل في كلِّ ليلةٍ سبع مراتٍ”. فقلت ثم أعلمتُه، فقال: “قل ذلك كلَّ ليلةٍ إحدى عشرة مرةً”، فقلته، فوقع في قلبي حلاوتُه! فلما كان بعد سنةٍ قال لي خالي: “احفظ ما علَّمتُك ودُم عليه إلى أن تدخل إلى القبر فإنّه ينفعك في الدنيا والآخرة”. فلم أزل على ذلك سنينَ، فوجدت لذلك حلاوةً في سِرِّي. ثم قال لي خالي يومًا: “يا سهل، مَن كان الله معه وناظرًا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية[1].
وفي موقف آخر يؤكّد على التربية بالقدوة في العبادات خاصّة، يحكي سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيقول: “بِتُّ عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شَنٍّ معلّق وضوءًا خفيفًا، وقام يصلي، فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله”[2].
هكذا يُشرَّبُ الأبناء جوّ التنشئة نفسيًّا ووجدانيًّا كالإسفنجة، قبل عَقلِه وفهمه فكريًّا، ويبدأ هذا التشرّب منذ لحظة ميلاد الطفل وربما أسبق، لكنّ الوالدَين ينشغلان عادة عن سنوات التشرّب والمحاكاة في تكوين الطفل بإعداد خطط التربية لسنوات العقل، فينتظران حتى يبلغ الطفل سن “الفهم” ليبدآ رحلة التلقين والتوجيه والأوامر، التي هي في كثير من الأحيان مخالفة –صراحة وضِمنًا– للأجواء النفسيّة والوجدانيّة التي تَشرَّبها الطفل بالفعل من سلوكهما وسلوك البيئات التي عرَّضوه لها، وبذلك تتحوّل عملية التربية من غرس طبيعي ينسجم فيه فكر الطفل ويتّسق نُموّ مداركه مع ما تَعوَّده في المحيط الغالب إلى غرس قسريّ لما يُمليه الوالدان معاكِسًا لما يشهده الطفل!
وفي المقابل، كثُر الخلط بين التربية بالقدوة التوجيهية التي ترشّد بنية شخصية الناشئ، والتربية على التبعيّة العمياء التي تطمسها. وبسبب ذلك الخلط ظهرت المذاهب الداعية لترك الحبل على الغارب للنشء بدعوى تشجيعهم على الاستقلال وبناء شخصيات قوية! ورأس الخلل حقيقةً هو غياب المعرفة النظرية الصحيحة مع استدامة لما ورثاه سابقًا من صور ممارسة عملية كثير منها مذموم، وبالتالي فقدانهم لركنَي الرشاد والحكمة في كيفية توجيه شخصيّة الطفل توجيهًا بنائيًّا لا آليًّا. فالتربية المتّزنة بالقدوة والتوجيه هي التي تنمّي مدارك الناشئ على أساس تمكينه هو من توجيه زمام نفسه توجيهًا رشيدًا حين يبلغ سنّ الرشد، وأن يكون له من نفسه على نفسه رقيب ووازع.
إذا اتّكأت منهجية الوالدين التربوية على كثرة الصياح والأوامر، كان ذلك مؤشّرًا على مدى بُعدِهِما عمّا ينشدان بُنيانه في أولادهما بالقوة. فلأنْ ينهض طفل في جوف الليل ليشهد أباه يصلّي خاليًا ويدعو الله؛ خيرٌ وأبقى في نفسه من ألف محاضرة في فضل قيام الليل ممن يقضيه ساهرًا أمام التلفاز
مساوئ التربية بالتلقين وتوريث أنماط التديّن على ما فيها من عِلّات:
كون الوالدين قدوة يعني أن يغرسا في الأبناء روح الدين، لا أن يُوَرِّثاهم مجرّد صور تديّنهما، وهذا المزلق الثالث الذي يقع فيه مَن يريد بحسنِ نيّة أن يُنَشِّئ أولاده “متديّنين”، لأنّ مفهومه للتربية الملتزمة أن يستنسخ عنه صورة التزامه هو بالدين على ما قد يكون فيها من عِلَّات، بدل أن يوجّههم لتعلّم دينهم من موارده الأصيلة ومنابعه الصافية وأهله الراسخين في علمه.

هذا النمط التربوي من توريث التديّن ينطوي على ثلاثة مساوئ كبرى:
1- غياب القناعة الراسخة وضعف اليقين:
فتجد أنّ الوالدين يسلكان مسلك الإدارة الآلية نفسه من الأوامر والنواهي، لكن بصبغة دينية هذه المرة: “صلِّ”، “احفظ”، “صُم”… دون جهد حقيقي في زرع قناعة أصيلة بعقيدة متكاملة يصدُر عنها الناشئ من تلقاء نفسه بعدها. ومشكلة التلقين العاري عن غرس اليقين أنّه يسلب من النشء روح الدين وطاقة تجديد الإيمان فيهم، بما يجعلهم صورًا جوفاء من التديّن المستنسَخ ليس إلا، ومهما حَسُن مظهرهم وأداؤهم فداخلهم غالبًا كالطبل الأجوف، لا يعي منطق الدين ولا مقتضيات العقيدة، وإنّما هي ترانيم تُرتَّل بلا وعي لدلالاتها، وواجبات تؤدَّى بلا إدراك لمقاصدها، وبالتالي تعاني هذه الفئة حين تشبّ عن الطوق وتتعرّض لخبرات خارج المألوف، فإذا بدينها يُجرَح عند أوّل حافة حادّة، بدل أن يثبت لو كان قام على ركن شديد. وإن معركة هذا الزمان هي قناعات تُزرع في النفوس لا أجهزة تُنزع من الأيدي!
مثال ذلك: مَن تربّيها والدتها على تقليد “صورة” تحجّبها عند البلوغ في سياق مفاجئ غير مُمهَّد له، بعد سنوات من تعويدها لبسَ المكشوف والإسراف في التأنّق والتغنّج بما يجاوز الشرع وربما حتى العرف المحترم، فتَرِث البنتُ –إذا ورِثَتْ- صورةَ تغطية معينة للرأس، تعتمد صحّتها أو خطؤها على مدى حسن تطبيق الأم، ثم لا يكون تغطّي الفتاة عن قناعة تعبّدية حقّةٍ بقدر ما هو تعوّد أو تبعيّة لأوامر الكبار، وذلك إذا قَبِلَت أن تلتزم، ولم ترجع عنه لاحقًا لهشاشة بُنيان عقيدتها! أين ذلك من الأم التي تُعنى بالتدرج في بيان المبادئ والمفاهيم الكامنة وراء سمت المسلمة عامة، وبيان قدر جزئية الحجاب في منظومة التصور الكلّي لتشريع الخالق وامتثال المخلوق… إلخ. بمثل تلك الخلفية الراسخة، تبادر الصبيّة حين تبلغ لإجابة أمر ربهــــــا على وجهه، ويندر أن تتزعزع مهما رأت من مخالفات قريناتها حولها، بل وتكون أحرص على الاستمساك بما هي عليه من حقّ لـِمَا وعت من أصوله، ومَا صحّ عندها من فهم منطقه واستشعار قدره في منظومة التصوّر الشرعي للوجود ككل. وتفشّي موجات التذبذب في خلع الحجاب ولبسه بين فتيات المسلمين -أو للدقّة ما يصحّ منه أن يُسمّى حجابًا- ليس إلا انعكاسًا لآفات هشاشة البناء العقدي والبنية الفكرية، ولأثر اضطرابات التنشئة على الشخصيّة إجمالاً.
2. التعوّد الآلي على الالتزام بقوالب صمّاء دون فهم منطقها:
يَعتبر الطفلُ والديه بالفطرة مرجعيتَه المطلقة في سنوات التلقّي؛ لذلك يكون من أصول التربية تنبيهه لكونهما نفسيهما متّبعان لمرجعية هي التي تحكمهم جميعًا؛ فالقدوة الحقّة للطفل لا تتمثل في والدين يجيبان عن كلّ تساؤلاته بما يعرفان أو يظنّان أنّهما يعرفان على الدوام، بل فيمن يمكن أن يقولا أحيانًا: “لا أدري، تعال لنسأل أهل العلم”، أو “هذا مبلغ علمي لكن فلنتثبّت”، وشتّان بين مَن يربّي ابنه على أنّه هو بذاته المرجعية، وبالتالي يكون ابنه على الحقيقة تبعًا له هو، ومَن يربّي ابنه على أنّه وابنه وغيرهم متحاكمون لمرجعية مهيمنة عليهم، وكلّهم بلا استثناء تبعٌ لها، ولو كان معنى ذلك أن يُظهِر الوالدان نفسيهما على خطأ، فالحقّ أكبر من ذوات الأشخاص، وهو أحقّ أن يُتبع حيث كان، بذلك يغرسان في الطفـل روح التساؤل الحقّ والاستفهام للتعلّم، والحـرص على التثبّت من المعلوم، والرسوخ فيما يتعلّم… إلى آخر أصول البنية الفكرية السليمة.
وهكذا بدل أن ينشأ الناشئ على “روتين” عدد الركعات أو صفحات الأوراد التي يُلزِمه بها والداه أو أحدهما، وبدل أن يكون في ذهن الوالدين قالبُ تديّن يحاولان تطبيقه قسرًا على كلّ الأبناء دون تمييز، ينشأ الناشئة على معاني التقوى والرجاء والخشية والرهبة التي تدفعهم دفعًا لطلب المعالي والتدرّج في عمق التديّن وقوته، بحسب طاقات كلٍّ واستعداداته الفطرية والكسبية؛ فبواعث العمل لله مُنطلقاتها واحدة، ثم تزهر فروعها في التطبيق بحسب ما يفتح الله على عباده. فلعلّ ابنًا فُتِح له في باب الصيام وإن لم يَقُم الليل، ولعلّ ابنةً فُتِح لها في تلاوة القرآن وإن لم تُكثر صيام النفل كأمّها، ولعلّ أحد الأبناء فُتح له في سرعة حفظ القرآن أكثر من أخيه المحبّ للإنفاق في وجوه الخير، بينما ثالث مُيسَّر له الدعوة وحسن البيان… وهكذا تكون كلّ هذه المدارج والدرجات مقبولة ومحمودة في الأسرة، فتقوّي أواصر التكامل والتواصي بين أفرادها، بدل أن تكون سبب أحقاد تنافسيّة أو مشاحنات مقارنات جائرة بين الإخوة.
يَعتبر الطفلُ والديه بالفطرة مرجعيّته المطلقة في سنوات التلقّي؛ لذلك يكون من أصول التربية تنبيهُه لكونهما نفسيهما متّبعان لمرجعية هي التي تحكمهم جميعًا
3. استبدال المصطلحات الشرعية بأخرى يُضعِف أثر دلالتها:
وهذه ظاهرة تنشئة النشء على مبدأ “الصحّ” و”العيب”، المرادف لـ “أمام الناس” و “من وراء الناس”. فلا تكـاد تطرق أسماع الأطفال ألفاظ “الحرام” و”الحلال” في مقابل ذينك اللفظين، إلا -ربما- متأخّرًا جدًّا، كجزء من منهج ديني للامتحان المدرسي لا التطبيق الحياتي، أو كمصطلحات “تثقيفية” بوصفهم ذوي ثقافة إسلامية! وما لا ينتبه له مَن يبدأ في تربية ناشئ بمراعاة نظر الناس واعتبار آراء الناس أنّه يربّيه ضمنيًّا على أساس “الخوف” لا “التقوى”. فما دام الناس لا يرون العيب فلا عيب في فعله، وما داموا لا يشهدون عمل الصحيح فما عاد للقيام به قيمة، أمّا نفسيّة التقوى فتقوم على مراقبة ربّ الخلق في خاصّة النفس، بغضّ النظر عن حضور الخَلق أو غيابهم.
فلا عجب من ثَمّ أن تنشأ أجيالٌ وآفاتُ الرياء والتسميع والشهرة والعُجْب طبعٌ مركَّب فيها من الصِّغَر، لا آفة طارئة أو عارضة عليها في الكِبَر! وأن تختلّ موازين الأعمال فيُحقَّر أي معروف لا يُدَوّي أثَرُهُ بين الناس، وأن يصير من علامات تحقيق الذات المعاصرة عند غالب الناشئين مدى حظوتهم عند أحد والديهم أو كليهما فوق بقية الإخوة لدرجة التحاسد والتباغض بينهم، أو من علاماتها النجوميّة بين الأقران في مختلف السياقات، وتزايد عدّادات متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا عجب بالتالي أن يَرِقَّ في النفوس معنى الدِّين، ويَضعُف في الوُجدان أثرُ العلم برقابة الله واطلاعه على الفرد في مختلف أحواله، فيكثر وقوع ما حذّرنا منه المصطفى -عليه الصلاة والسلام- من استسهال انتهـاك محارم الله تعالى في الخَلوة، مع التلبّس بلباس الالتزام في العَلَن! وهي ظاهرة قديمة جديدة، وقف عليها كذلك الرافعي في زمانه فقال:
“لقد رقّ الدين في نسائنا ورجالنا، فهل كانت علامة ذلك إلا أنّ كلمة (حرام، وحلال) قد تحوّلت عند أكثرهم وأكثرهنّ إلى (لائق، وغير لائق)، ثم نزلت عند كثير من الشبّان والفتيات إلى (مُعاقب عليه قانونًا، ومُباح قانونًا)، ثم انحطّت آخرًا عند السواد والدهماء إلى (ممكن، وغير ممكن)”[3].
“لقد رقّ الدين في نسائنا ورجالنا، فهل كانت علامة ذلك إلا أنّ كلمة (حرام، وحلال) قد تحوّلت عند أكثرهم وأكثرهنّ إلى (لائق، وغير لائق)، ثم نزلت عند كثير من الشبّان والفتيات إلى (مُعاقب عليه قانونًا، ومُباح قانونًا)، ثم انحطّت آخرًا عند السواد والدهماء إلى (ممكن، وغير ممكن)”.
مصطفى صادق الرافعي
الخلاصة:
عمادُ التربية الحسنة: علمٌ قويم، وقدوةٌ حيّة، ومعاملةٌ رشيدة، وهذه لا تكتسب بالوراثة أو تهبط عفوًا دون بذل جهد من طرف الوالدين في تحقيق والديّتهما، التي ينبغي أن تتجاوز مجرّد إخراج الطفل لحيّز الوجود وحفظ بقائه، إلى رعاية ذلك الوجود وتجويد عمرانه؛ فحِسّ الوالدية وإن كان فطرة يستدعيها السياق تلقائيًّا، إلّا أنّه كغيره من مكوّنات الفطرة يحتاج لبصيرة العلم وتهذيب التزكية وصقل المران، ليثمر ذلك الحِسّ على المدى منهجيةً رشيدةً ووالديةً مؤثّرةً، خاصّة في ظلّ توسّع تحدّيات عصر اليوم وتداخل ثقافاته وانهمار مغرياته، بما لم يعد يصلح معه نهجُ الإدارة الآلية القائمة على الأوامر والنواهي، وسلطوية إملاء الأفعال والمشاعر، وقصر الالتزام الديني الصوري على الخارج بدل بَذرِهِ في الروح من الداخل.
ولا يظنّن الوالدان أنّ شخصيتهما تؤثر على أبنائهما المباشرين فحسب، بل هي تؤثر على جيل كامل بذرته أبناؤهما، وإذا كان التسيّب التربوي قد خرّج أجيالاً من العُقَدِ النفسية والتشوّهات الفكرية المتحرّكة، فقد خرّج التشدّد التربوي أجيالاً غليظة الفهم والقلب. والوسط بينهما هو التربوية العالمة والقدوة الهادية، التي تقوم على التدرّج بصبر ورسوخ، وتجمع بين اللين والحزم كلٌ في موضعه، وتَصدُق الاستعانة بالله تعالى ليبارك في الذرّية ويوفّق والديها لمهمّة تعبيدها له على ما يحبّ ويرضى.
عمادُ التربية الحسنة: علمٌ قويمٌ، وقدوةٌ حيّةٌ، ومعاملةٌ رشيدةٌ، وهذه لا تُكتسب بالوراثة أو تهبط عفوًا دون بذل جهد من طرف الوالدين في تحقيق والديّتهما، التي ينبغي أن تتجاوز مجرّد إخراج الطفل لحيّز الوجود وحفظ بقائه، إلى رعاية ذلك الوجود وتجويد عمرانه
ختامًا:
من أعظم المهام في هذا الوجود بعد النبوة والحكم مهمة “الوالديَّة” نسبة إلى الوالدين؛ فالنبوة دعوة إلى الله تعالى، والحكم إقامة لأمر الله تعالى، والوالديّة تربية على مراد الله تعالى، ثم في الوالديّة نبلٌ من وجهٍ ثانٍ: فالوالد يعطي عطاءه لمن لا يعلم بعدُ أيكون وفيًّا أم غدّارًا، وهل يُثمر فيه غرسُه على ما تمنّى أم يصير غير ذلك. وفي الوالديّة نُبلٌ من وجه ثالث: وهو أنّ الوالد لا يُعطي ولده شيئًا أو أشياء معدودة كما يعطي المعلم العلم والطبيب الدواء مثلاً، بل يعطيه ما بقي من عمره هو بكل تفاصيله، ويبذل له من صميم نفسه وأنفاسه دون حساب.
ولعلّه لذلك -ولغير ذلك- كان برّ الوالدين ثاني ما أمر الله تعالى به بعد الإيمان: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]. ولا ريب أنّ الوالدية الصالحة أعظم نعمة يُنعَم بها على عبد بعد نعمة الإسلام، لكلا طرفيها: الوالد والولد. وأصلحُ الوالدية ما يَهَبها الوالد لله تعالى على سبيل التعبّد، ويقدّمها لولده بدافع المحبّة لقطعة ضُوعِفت له، لا ما يقدّمها بدافع التشرّط على قطعة أُخِذت منه وبغرض انتزاع المردود انتزاعًا من عبء أضيف عليه.
وإذا كانت البُنُوّة الصالحة شكرًا للوالدين على برّهما، فالوالدية الصالحة شكرٌ لله تعالى على هبته، ولذلك جعلها الله تعالى من العمل الذي لا ينقطع أثره لصاحبه: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له)[4].
هدى عبد الرحمن النمر
كاتبة ومؤلّفة ومتحدِّثة في الفكر والأدب وعُمران الذات
[1] إحياء علوم الدين، للغزالي (3/74).
[2] أخرجه البخاري (138).
[3] وحي القلم، للرافعي (1/290).
[4] أخرجه مسلم (1631).