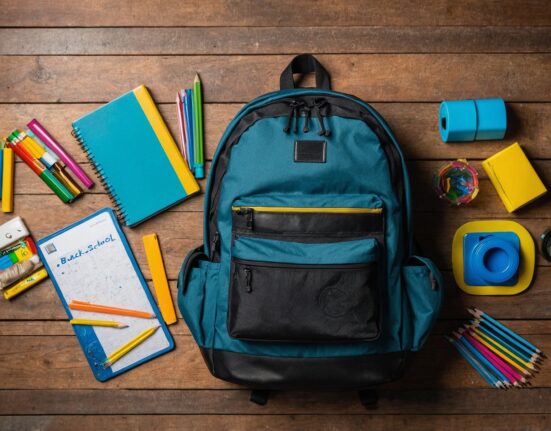محاسن الدين الإسلامي لا تحصى، والإنسانية التي يُنادى بها اليوم أشبعها الإسلام بما لا مزيد فوقه في أي شريعة أو قانون، ولو وزنت الحضارات التي مرت على البشرية في مجال القيم والأخلاق لرجحت أمة الإسلام بما عندها من وحي، وباتباعها لهذا الوحي، وفي هذه المقالة جانب دقيق قلما يُتناول من إعمال القيم والمبادئ الأخلاقية في التعليلات الفقهية في الشريعة الإسلامية.
مقدمة:
إن المتأمل لنصوص التشريع، المتلذذ بمعانيها وحكمها، يلحظ أن أكثر ما فيها نصوص قيمية تربوية تبعث على تقويم علاقة الإنسان بنفسه وعلاقته بغيره، وأن النصوص الشرعية أخلاقية ابتداء وانتهاء؛ لفاعليتها ودورها في بناء الإنسان، وتكوين المجتمعات الإنسانية على اختلافها قيميًا، ومركزيتها في تحقيق معنى الوجود البشري، وذلك سواء في العقيدة والعبادة والثقافة والفكر.
لأجل ذلك كانت عناية الإسلام بالأخلاق عناية عظيمة حتى ارتبط تصور المفكرين والمربين المسلمين للقيم بالتصور الشامل للعلم والإيمان والمعرفة، وتأثيرها على التنشئة التربوية للإنسان، حيث أنتج هذا التصور ما عرف بعد بعلم السلوك الذي برع فيه الغزالي وابن القيم وابن عطاء الله السكندري وغيرهم، وليس ذلك إلا امتدادًا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه مدحًا وثناءً ورفعةً وإعلاءً: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].
وتوضح الأحاديث النبوية الشريفة مكانة القيم والأخلاق في الشريعة الإسلامية وتحث على التحلي بمكارمها والاتصاف بجميلها، فهي من أفضل ما يبلغ به المرء الدرجات الرفيعة، فقال عليه الصلاة والسلام: (وبِبيتٍ في أعلى الجنّة لمن حَسُن خُلقه)[1].
ومن ثم كانت الأخلاق الحسنة هي الخطوة الأولى لولوج أبواب الفلاح والنجاح، فلا يبلغ المرء درجة الفلاح إلا بتزكية نفسه بتحليتها بالمكارم والقيم والفضائل، وتخليتها عن القبائح والرذائل، وذلك بالإتيان بالفرائض على الأوجه المشروعة التي طلبها الرب من العباد، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا تتم بدون تمام الغرض، والصوم صيام النفس والجوارح لتتحقق التقوى، والحج يكمل بالبعد عن اللغو والرفث والفسوق، والزكاة طهارة للمال والنفس وإشاعة للخير، فهي أصول كبرى الغرض منها تحقق هذه المنظومة القيمية التربوية بربط الأصول بحكمها ومقاصدها.
مفهوم القيم وأهميتها:
لا يختلف اثنان على واقع الأمم المتردي عامة، وما تتخبط فيه من المشكلات، وحالات الوهن الأخلاقي، فما نشاهده ونسمع عنه من الفساد وارتفاع معدلات الجريمة وفقدان الرشاد، كله مؤشر واضح ودليل فاضح على تدني منسوب القيم.
فكانت المنظومة القيمية الركيزة التي تبنى عليها المجتمعات ويعتمد عليها رقيها، وبها يقاس سموها ودنوها، وهي عامل متداخل مع جوانب عدة في حياة الإنسان كافة، ففي كل جانب من جوانب نشاطات أفـراد أي مجتمع لا بد من وجـود ضوابط اجتماعية أخلاقية تنتظم بها تلك الجماعات، وبدونها تنفرط أهم روابط المجتمعات، وتكاد تصبح الحياة مستحيلة إن لم تكن كذلك.
وفي هذه المقالة سنتناول مراعاة الجوانب الفقهية في تعليلات الفقهاء عند بحثهم في الأحكام الفقهية.
ما هو المقصود بالقيم؟
تعددت تعريفات المهتمين بموضوع القيم، ومن أحسنها أنها: “مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة والإنسان والإله، كما صورها الإسلام”.
وتتكون هذه المعايير “لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع إمكانياته، وتتجسد من خلال الاهتمامات أو السلوك العملي بطريقة مباشرة وغير مباشرة”[2].
القيم تمثل المعايير المنظمة للسلوك، والمبادئ السامية التي ينشأ عليها الفرد، كالإحسان والكرامة والرحمة، والفضائل التي يسعى الناس إلى إيجادها متى كان فيها الصلاح والفلاح عاجلاً أو آجلاً، ويحسن التعامل مع المجتمع على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه.
التعليل- مفهومه ورأي الفقهاء فيه:
تعليل الأحكام الفقهية والقضايا الشرعية سمة بارزة الظهور في الممارسة الفقهية؛ إذ يعتمده الفقيه في الاستدلال وعرض الأحكام، فإذا عرض لمسألة بين وجه العلة والحجة فيها وما انبنى عليه تسويغ الحكم أو منعه، فهو منهج متوارث متواتر في كتب الفقه وسطور الفقهاء الذين غاصوا في أعماق المعاني وخوافيها لاستخراج دررها، واستجلاء عللها وحكمها؛ إيمانًا منهم بأهمية هذا المنهج واعترافًا بقيمته، فلا يمكن الحكم بصلاحية التشريع لكل زمان ومكان إلا بإدراك العلل وإعمالها.
وما ذلك إلا لأن الفقه يتميز بالطابع العملي ويغلب عليه الاستعمال؛ فكثير من النصوص الشرعية أعملت قضايا التعليل بأمارات وضعها الشارع بقصد الاهتداء إليها، فيمثل التعليل فيها الواسطة بين المجتهدين والأحكام، سواء في ذلك المعاملات والعبادات.
ولأجل ذلك بادر الفقهاء لتعليل ما أمكن تعليله من الأحكام واجتهدوا في الكشف عن أسباب التشريع، ونوعوا العلل إلى علل طبية وقيمية وشرعية، غير أن منهم من وُفِّق للكشف عن إدراك العلل، ومنهم من جانب الصواب، والجواد يكبو والنار تخبو وكفى بالمرء شرفًا أن تعد معايبه.
وهذا ليس معناه قصورهم عن درجة الاجتهاد بقدر ما يعني دقة العلل وخفاءَها، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: “إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم”[3].
وهو عند الإطلاق يقصد به الكشف عن علل الأحكام وبيانها وطرق إثباتها ومسالكها، وبيان ما مِن أجله وُجد حكم من الأحكام الشرعية، دون قصد إنشاء العلل وصناعتها، إذ المعلِّل إنما هو الله تعالى، لذلك فإنَّ التعليل وشغل المعلل لا يتجاوز إدراك العلل وإلحاق ما لم ينص عليه بالمنصوص، دون إنشاء أو صناعة.
ولم يكن التعليل عند من تقدم من الفقهاء المجتهدين مجرد فكرةٍ يرسلونها أو يؤصلونها، ثم ينصرفون عنها، وإنما كان عمليةً وممارسةً دائمةً ومنهجًا معتمدًا، ينتجون فقههم على أساسها، ويوجهون الأحكام الشرعية وفق مقتضياتها، يبذلون الوسع في الكشف عما حملته النصوص من علل تتسم بالملاءمة والظهور والانضباط، بحيث يصلح التعليل بها.
ويقول السرخسي: “التعليل هو تعدية حكم الأصل إلى الفروع”[4]، وقال الدكتور محمد شلبي: “التعليل: تبيين علة الشيء”[5]، فمعناه استخراج العلة وتعدية حكمها، لكن ليس لمجرد الغوص والتعمق في فهم الأسرار الشرعية وفلسفتها التشريعية، ولا لأجل الكسب المعرفي والمتعة العلمية والترف الفكري، بل هو جزء لا يتجزأ من فقه الدين والعمل به، وهو بذلك عمل علمي لا انفكاك عنه للعلماء والفقهاء المجتهدين.
لم يكن التعليل عند مَن تقدم من الفقهاء المجتهدين مجرد فكرةٍ، وإنما كان عمليةً وممارسةً دائمةً ومنهجًا معتمدًا، ينتجون فقههم على أساسها، ويوجهون الأحكام الشرعية وفق مقتضياتها، يبذلون الوسع في الكشف عما حملته النصوص من علل تتسم بالملاءمة والظهور والانضباط، بحيث يصلح التعليل بها.
تطبيقات مراعاة القيم في التعليلات الفقهية:
كان من ضمن ما اختاره الفقهاء بابًا لتبرير الأحكام: التعليلُ بالقيم إيجادًا وعدمًا، واستخدام المبادئ القيمية التربوية لتعليل القضايا الشرعية، وهو منهج فقهي متبع يعكس كيفية إدماج القيم الأخلاقية في عملية الاجتهاد الفقهي واستنباط الأحكام الشرعية بما يتناسب مع مبادئ الأخلاق الإسلامية، وبصورة تضمن تحقيق توازن بين النصوص الشرعية الثابتة والمبادئ الأخلاقية المتغيرة بما تمليه البيئة والظروف، عملاً بالتكامل الواقع بين الصناعتين.
المثال الأول/ تغطية الرأس حال قضاء الحاجة:
إن الفقهاء لما تحملوه من أمانة البيان لم يغفلوا أبسط المسميات بالبيان والشرح والتفصيل، وكان من جملة ما ذكروه من القضايا وناقشوه من الفروع: آداب قضاء الحاجة.
قال الشيخ خليل في المختصر عند الحديث عن آداب قضاء الحاجة: “ندب لقاضي الحاجة جلوس… وتغطية رأسه”[6].
وقال ابن العربي: “ويستر رأسه”[7].
فيندب للمرء تغطية رأسه حال قضاء الحاجة والاختلاء، ويجتهد ألا يتكشف ولا يدخل الخلاء مكشوف الرأس ما أمكنه ذلك، وإن استدعى الأمر أن يضع كمه على رأسه.
قال الخرشي: “فالمراد ألّا يكون مكشوف الرأس كما يفهم من كلام الأُبِّي وغيره، فيكره أن يذهب للخلاء حاسرًا”[8].
كما نصوا على علة تغطية الرأس وحكمتها، فقيل: إن علة ذلك الحياء الذي يعتبر ملاك محاسن الآداب، وما يذكر من العلل الأخرى فهي خلاف المنصوص، إذ الوارد في قصة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قوله: “أيها الناس استحيوا من الله إذا خلوتم، إني لأذهب إلى حاجتي في الخلاء متقنعًا بردائي حياء من ربي”[9].
وفي منح الجليل: “وندب تغطية رأسه: حال قضاء الحاجة والاستنجاء حياء من الله تعالى وملائكته”[10].
وقال المناوي في بيان سبب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة: “وغطى رأسه حياء من ربه تعالى”[11].
ومثله في مراعاة القيم: كراهة التجرد عن الثياب في الخلوة لغير حاجة، لتحقيق قيمة الحياء[12].
فلا معنى لندب الستر للرأس والحث عليه والترغيب فيه في هذا المحل إلا أن يكون المقصود به ما ذكر من التماس الحياء وطلب كماله، وهو أمر ليس بالواجب، فقاضي الحاجة الأصل فيه أنه بمكان يستره عن الناس وتحول أسواره بينه وبينهم، والتغطية للرأس لا تحقق حجبًا للعورات عن الناس، ولكن الأمر متعلق بمبدأ قيمي وتعليل تربوي.
المثال الثاني/ تحديد أمد التعزية بثلاث:
ترغيب المصاب في التصبر وحثُّه على الجلد سنةٌ لمن نزل بهم القضاء، إذ كان من سنته صلى الله عليه وسلم عند حلول المصيبة ترغيب المصاب في الصبر وحثه عليه ومواساته فيما حلَّ به مما يحل بالعباد فيُغيب الأجساد.
فقد روي عن الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم “كان يعزي المسلمين في مصائبهم”[13].
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ تبكي عند قبر، فقال: اتَّقي اللهَ واصبري، قالت: إليكَ عني، فإنَّك لم تُصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوّابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنَّما الصَّبر عندَ الصدمةِ الأولى)[14].
ومن اهتمام الفقهاء بدفع الحزن وإجلاء الأسى تحدثوا عن حكمه وحكمته وصفته ومكانه وزمانه استشعارًا لأهميته في ترميم الصدع وجبر الخواطر.
وكان من جملة القضايا المؤثرة في التعزية المبنية على التوجيه القيمي للأحكام: الحكم بكراهة التعزية بعد ثلاثة أيام، واستحبابها داخل الثلاث.
يقول الإمام النووي رحمه الله: “قال أصحابنا: وتُكره التعزية بعد ثلاثة أيام؛ لأن التعزية لتسكين قلب المصاب، والغالب سكون قلبه بعد الثلاثة، فلا يُجدد له الحزن، هكذا قاله الجماهير من أصحابنا”[15].
فما دامت غايتها التصبُّر وسكون القلب وليس بعثه على الحزن وتجدد الأسى؛ فإن الأليق به الثلاث دون غيرها، وهو نظر تربوي وبُعد قيمي أخلاقي.
وقد أثر عن أبي محلم قوله: “كان الرقاشي وأبو العتاهية متصلين بعلي بن يقطين، فتوفي بعض أهل علي، فوافاه المعزُّون وتأخر الرقاشي أيامًا، ثم أتاه معزيًا فقال علي: التعزية بعد ثلاثة تجدد للمصيبة، والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة”[16].
وهي والحالة تلك كقول القائل:
ومنتصح يكرر ذكر نشوى *** على عمد ليبعث لي اكتئابا
وقال الشيرازي: “وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام”[17]، ومثله ذكره أبو حامد في الوسيط[18].
ولعل الأصل في ذلك -علاوة على ما سبق من اعتبار البعد القيمي الأخلاقي وعدم بعث الحزن وتجدد الأسى- الحمل على أمد الحِداد الوارد في الحديث: (لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا)[19].
فلا يبعد أن تكون التعزية بالميت ثلاثًا دون غيرها تشبيهًا بالإحداد وقياسًا عليه، ومهما يكن فإنَّ البُعد التربوي والنظر القيمي الأخلاقي حاضر وموجود في هذه الممارسة الفقهية والاستنباط الحكمي في الفرع الفقهي المذكور.
المثال الثالث/ صفة التذكية:
بالرغم من أن حياة الحيوان لا تنقطع إلا بإيلامه، شرع الإسلام لنا الحد المقدر دون غيره بحيث لا يجوز تعذيبه بذكاته بغير محدَّدٍ، ولا بالمبالغة في الذبح حتى النخاع، وقد بوب الإمام أبو داوود في السنن: باب في الرفق بالذبيحة.
ولأجله اشترط الفقهاء معرفة الذابح بكيفية الذبح، حتى لا يؤلم البهيمة، واختاروا كراهة الذبح بما يكون سببًا لإبطاء الإماتة، ففيه زيادة الألم للحيوان وهو منهي عنه، وحُرّم الوقذ[20] في الإسلام لمنع التعذيب.
فجاء الأمر بالرفق والإحسان فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا قَتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، وليُحدَّ أحدكم شَفرته، فليُرح ذبيحته)[21].
وهو عام في معنى الإحسان، فكتب علينا الإحسان في كل شيء: في ذكاة الحيوان وذبحه لتحصل راحته وخلاصه من الألم، وفي القصاص، وغيرهما من المحال، كما أنه عام في كل مذكى ومقتول حتى فيما أذن الشرع بقتله لضرره كالحيات والعقارب وباقي الفواسق، فتقتل بأول دفعة ولا تعذب بحال، قال ابن رشد: “فما جاز قتله من الدواب لإذايتها لم يجز قتله إلا بوجه القتل الذي لا مُثلة فيه ولا عذاب”[22].
يقول العلامة أحمد المراغي: “ومن هذا تعلم أنه طلب الإحسان إلى الحيوان والرفق به حين ذبحه حتى لا يتعذب، كما حرم أكل الموقوذة وهي التي تضرب بغير محدد حتى تنحل قواها وتموت”[23].
فالذبح بما يسرع الإماتة والأخذ بالرفق أسهل على الحيوان وأقرب إلى راحته، وهي أمور مرعية قصد إليها الشارع من خلال الأمر بالإحسان.
وقال القرطبي: “وهو من باب الرفق بالبهيمة بالإجهاز عليها، وترك التعذيب، فلو ذبح بسكين كالَّةٍ، أو بشيء له حد وإن لم يكن مجهزًا بل معذبًا فقد أساء، ولكنه إن أصاب سنة الذبح لم تحرم الذبيحة، وبئس ما صنع”[24].
فانظر إلى البعد القيمي التربوي الذي وظفه القرطبي في هذا الفرع، ورَوم الخروج من المسار النقلي إلى التعليل الأخلاقي، حيث تجاوز به اجتهاده حدود النظر إلى صحة الذبح واعتبار ما يجزئ وما لا يجزئ إلى الحقل الأخلاقي والحكم بالإساءة للذبيحة والقضاء بسوء فعل الذابح، فما يحيي الذبيحة أن تحد الشفرة ولا يبقيها عدمه؛ إذ هي مذبوحة في كل الأحوال، لكن إن كان ولا بد فليكن ذلك بقلب رحيم لا فعل أليم.
المثال الرابع/ إنظار المعسر:
الأصل فيه قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].
فالمرء إما موسر أو معسر، وهما صفتان بهما تقاس الخلة وتعرف الصداقة وصدق الأخوة، وكم من خليل أعلن مودته وأظهر خلته وأبدى محبته زمن اليسار، لكنه سرعان ما انكشف بالإعسار، فمدعي الأخوة يكشفه العسر، ويعري صداقته عدم اليسر، وما أصدق قول القائل:
دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة *** ولدى الشدائد تُعرف الإخوان
ومعنى الإعسار: ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة وغزوة العسرة، قيل: سميت بذلك لأنها كانت في حال عسر وضيق من أحوال المسلمين، كما كانت في الصيف وشدة الحر فإنها عسرت عليهم[25].
قال الرازي: “الإعسار هو أن لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه”[26].
والنَّظِرة: بمعنى التأخير والانتظار والإمهال، ونَظَره وانتظره وتنظّره تأنى عليه وأمهله، ومنه قوله سبحانه: {قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [الأعراف: 14].
“والميسرة: مَفْعَلَة من اليسر الذي هو ضد الإعسار، يقال: أيسر الرجل فهو موسر إذا اغتنى وكثر ماله وحسنت حاله”[27].
ومعنى الآية: لو وجد مدين وقد أعسر حاله وعُدم ماله فلم يجد ما يفرغ به الذمة فأخروه حتى يوسر.
و”الطلب يحتمل الوجوب، وقد قال به بعض الفقهاء، ويحتمل الندب، وهو قول مالك والجمهور، فمن لم يشأ لم ينظره ولو ببيع جميع ماله، لأنّ هذا حق يمكن استيفاؤه، والإنظار معروف والمعروف لا يجب، غير أن المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع، ويؤجلونه بالاجتهاد لئلّا يدخل عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص”[28].
وهو اجتهاد قائم على المقوِّم الأخلاقي والإحسان والرفق، لأن الفقه يقتضي استخلاص الدَّين واستيفاءه في جميع الأحوال، أو قيام عوض مقامه كالحبس والاستعمال، لكن واعتبارًا للصناعة الأخلاقية جاء الندب إلى الإنظار -أو التصدق عليه وهو خير- وإبداء المعروف، وهو ملحظ قيمي جاءت الشريعة مرغبة فيه.
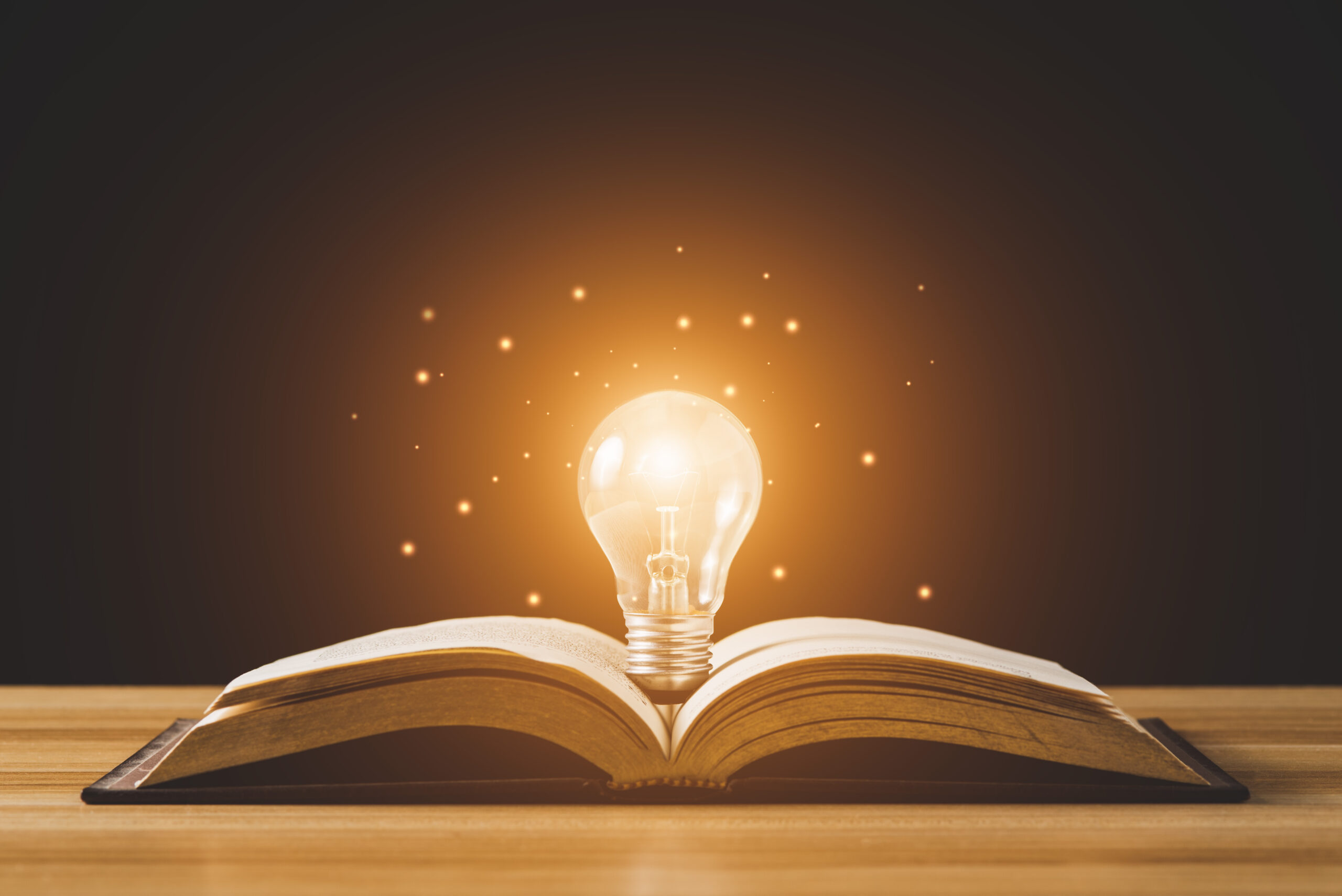
خاتمة:
كانت قضية تعليل الأحكام مما اختلف فيه الفقهاء وتباينت فيه أقوال العلماء، وإنهم وإن اتفقوا على التعليل العام الذي يقصد به أن لكل حكم علة وسببًا، فإنهم لم يتفقوا على التعليل الخاص للأحكام الذي يوظف في الاجتهاد والقياس، فهذا محل الخلاف وتباين الآراء وتضارب الأقوال، هل الأصل فيها التعليل أو التعبد؟
ولأن المقوم التربوي على مر الأزمان يشغل حيزًا مهمًّا ومكانة عظمى من اهتمام الإنسان ويستحوذ على تفكيره، حيث لا تستقيم حياته إلا بها؛ جعلت الشريعة من الأخلاق قاعدة عامة يتحاكم إليها ويقوم بها سلوك المتدين، وجُعلت غاية بعثته وخلاصة رسالته وزبدة ملته عليه الصلاة والسلام.
وهو ما يفسر مدى اهتمام الفقهاء بالمبرر الأخلاقي وتضمينه في كتبهم، وما يفهم من تركيزهم على جانب الحلال والحرام إنما هو مقدمة وبداءة اهتمامهم لا نهايتها.
المقوم التربوي على مر الأزمان يشغل حيزًا مهمًّا ومكانة عظمى من اهتمام الإنسان ويستحوذ على تفكيره، حيث لا تستقيم حياته إلا بها؛ لذا جعلت الشريعة من الأخلاق قاعدة عامة يتحاكم إليها ويقوم بها سلوك المتدين، وجُعلت غاية بعثته وخلاصة رسالته وزبدة ملته عليه الصلاة والسلام.
أ. يوسف العزوزي
باحث في الدراسات الفقهية والقضايا الشرعية – المغرب
[1] أخرج أبو داوود (4800) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا زعيم ببيت في رَبَضِ الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسُن خلقه)، الزعيم: الضامن والكفيل، وربض الجنة: أطرافها لا وسطها.
[2] القيم الإسلامية والتربية: دراسة في طبيعة القيم ومصادرها ودور التربية الإسلامية في تكوينها، لعلي خليل مصطفى، ص (34).
[3] مجموع الفتاوى، لابن تيمية (20/567-568).
[4] أصول السرخسي (2/159).
[5] تعليل الأحكام، للدكتور محمد شلبي، ص (12).
[6] مختصر خليل، ص (20).
[7] عارضة الأحوذي (1/28).
[8] شرح الخرشي على مختصر خليل (1/142).
[9] المرجع السابق نفسه.
[10] شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، للشيخ محمد عليش (1/98-99).
[11] فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي (5/128).
[12] لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، لمحمد بن سالم المجلسي (2/16).
[13] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6071).
[14] أخرجه البخاري (1283) ومسلم (926) واللفظ للبخاري.
[15] الأذكار، للنووي، ص (149).
[16] ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار (19/203).
[17] التنبيه في الفقه الشافعي، للشيرازي، ص (53).
[18] الوسيط في المذهب، للإمام الغزالي (2/392).
[19] أخرجه البخاري (1280) ومسلم (1490).
[20] الوَقْذُ: شدة الضرب… وشاة موقوذة: قتلت بالخشب. ينظر: لسان العرب (3/519).
[21] أخرجه مسلم (1955).
[22] البيان والتحصيل، لابن رشد الجد (18/207).
[23] تفسير المراغي (8/180).
[24] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/362).
[25] ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي، لابن الأثير (5/342).
[26] تفسير الرازي (7/87).
[27] التفسير الوسيط، لسيد طنطاوي (1/640).
[28] التحرير والتنوير، لابن عاشور (3/96).