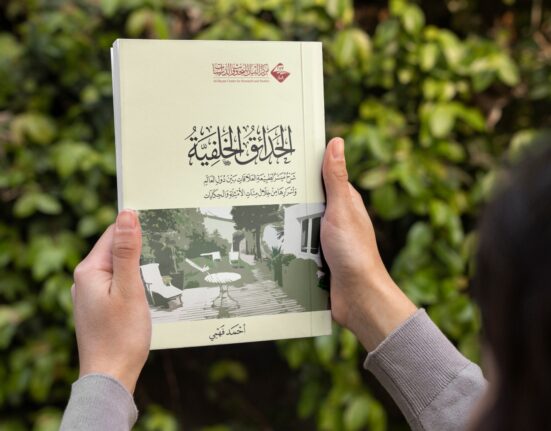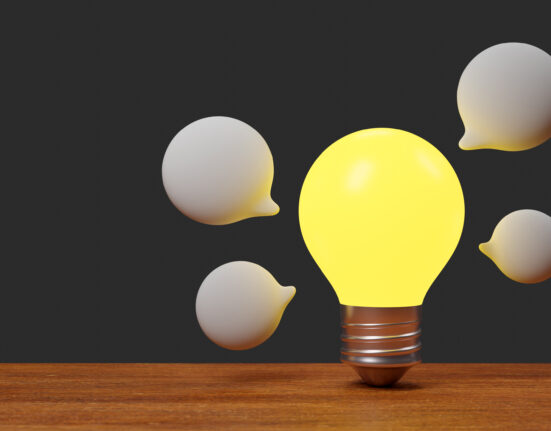قبل سنة من هذه الأيام كان السوريون يسطّرون صفحة من صفحات التاريخ، ويتوّجون فصول ثورتهم المباركة بدكّ حصون النظام البائد، ويعلنون نهاية ملحمة مقاومة شعبية استمرت قرابة خمسين عامًا في مقارعة طغمة فاسدة مجرمة اغتصبت السلطة وأفسدت في البلاد، ويفتحون فصلاً جديدًا للنهوض والبناء والازدهار بإذن الله تعالى.
ومع انصراف السوريين لبناء بلادهم، والتعامل مع مشكلاتها، والتركيز عليها، وفرح عامة المسلمين بهذا النصر المبين، والتوجه لأهلها بالنصح أو الانتقاد لما قد يرونه من أخطاء؛ تظهر (المسألة القُطرية) للواجهة مرة أخرى، بما فيها من حدود، وجنسيات، وثقافات، وغير ذلك. فما هي هذه المسألة؟ وما تأثيرها على النسيج المجتمعي للأمة؟ وكيف نتعامل معها؟
أعراض جانبية، وأوجاع عميقة:
مرّ على سوريا عقد ونصف من الصراع بين الأحرار والطاغية، دارت رحى المعارك في كل شبر من البلاد، وكان النصر كرًا وفرًا ومدًا وجزرًا، حتى تكلل النصر في السابع من جمادى الآخرة عام 1446هـ، الموافق للثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024م بفتح دمشق وتحريرها من حكم الطاغية الذي امتد حكمه مع حكم أبيه قريبًا من نصف قرن.
خلال سنوات الثورة الأربع عشرة حصل نوع من التقسيم الذي شهدته البلاد وأخذ مدى زمنيًا غير قليل، ظهرت خلالها فروقات ملموسة في السمات الاجتماعية والثقافية بين مَن عاشوا تحت حكم النظام ومَن تحرروا من قبضته، فبرز لدى الفئة الأولى حذرٌ شديد في التصريح بالرأي المخالف، واستعداد واسع للتكيف وتحمل التبعات، والبحث عن مساحات آمنة للعيش مهما كانت ضيقة، وفي المقابل نجد لدى سكّان المناطق المحررة حرية أكبر في التعبير عن الرأي، والظهور على الإعلام، والاستعداد لخوض غمار التجارب.
ولم تكن هذه الفروقات تحوّلاً أخلاقيًا في ذوات الناس، بقدر ما كانت نتيجة لإعادة تشكيل غير واعية لعقدٍ اجتماعيٍّ فرضته ظروف القهر أو التحرّر، فأعاد تعريف المقبول والممكن وحدود الفعل العام، خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا[1].
وإذا وسّعنا زاوية النظر إلى واقع الأمة اليوم، فسنجد أن المسلمين يعيشون في دول “قُطرية” يفصل بينها حدود مصطنعة رسمها المستعمر لا تستند إلى جبال أو أنهار أو معالم طبيعية، ولا إلى وحدة تاريخية أو اجتماعية. ومع تعاقب السنين وتنوع أنظمة وأشكال الحكم، وتبعية كل بلد من البلدان لثقافة شرقية أو غربية مفروضة عليها، ومحاولة كل نظام حكم صياغة هوية وطنية خاصة به؛ تعددت أنماط المعيشة والمستويات الاقتصادية والثقافية، ومن ثم مستويات التدين والمحافظة والانفتاح، ومع الوقت صار لسكان كل قطرٍ من الأقطار هويةٌ وسماتٌ اجتماعية وثقافية مختلفة عن الأخرى، بالرغم من صغر أحجام بعض البلدان، وتقاربها الشديد في العادات والانتماءات القبلية والعشائرية.
وهكذا فُصلت السودان عن مصر، وقُسّمت بلاد المغرب العربي إلى عدة دول لم تعرف شعوبها فرقًا بينهم يومًا في التاريخ والجغرافيا، وصارت الجزيرة العربية سبع دول، وبلاد الشام أربع دول على الخريطة، أما التقسيمات التي حصلت بعد الألفية فالعراق وليبيا واليمن وسوريا والسودان تعرضت لتقسيمات إضافية داخل القطر نفسه.
وما يهمنا أنّه في كلٍّ من هذه الأقسام والدول يجري تشكّل سمات وملامح هوية، وتجري صناعة عقد اجتماعي، ينتهي مع الوقت إلى نوع من المواطنة والانتماء.
حبّ الوطن والاهتمام به:
حبّ الأوطان غريزة فطرية متأصلة في النفوس، والإنسان مجبول عليها؛ بسبب النشأة والإقامة، والقرابات والصداقات، وهذه الأمور تنتج عن مجموعها ذكريات طفولة ومشاعر دافئة تبقى في أعماق الإنسان مهما كبر أو ابتعد، وإذا أضفنا إلى ذلك تقارب الطبائع والعادات الاجتماعية؛ فهذه تضيف للإنسان الشعور بالراحة عند البقاء في الوطن وتفضيله على غيره، ومن ثَمّ يحنّ إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هُوجم أو انتُقص منه.
وقد عبّر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبّه لمكة حين أُخرج منها قائلاً: (ما أطيبكِ من بلدٍ وأحبّك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيرك)[2]، ولما سكن المدينة أحبّها وأفصح عن حبه، (اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد)[3].
وجاء في سيرته أنّه: (كان إذا قدِم من سفر، فنظر إلى جُدُرات المدينة أوضَع راحلته، وإن كان على دابة حركها، مِن حبها)[4]، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: “وفي الحديث دلالةٌ على فضل المدينة، وعلى مشروعية حبِّ الوطن والحنين إليه”[5].
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: “وكان يحبّ عائشة، ويحبّ أباها، ويحبّ أسامة، ويحبّ سِبطيه، ويحبّ الحلواء والعسل، ويحبّ جبل أحد، ويحبّ وطنه، ويحبّ الأنصار، إلى أشياء لا تحصى مما لا يغني المؤمن عنها قط”[6].
وقد مرض أبو بكر وبلال بن رباح رضي الله عنهما بعد الهجرة إلى المدينة، فكان بلال إذا أقلع عنه المرض يرفع عقيرته ويقول:
ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلةً ** بواد وحولي إذخرٌ وجليل
وهل أرِدَنْ يومًا مياه مجنةٍ ** وهل يبدوَنْ لي شامةٌ وطَفيل
اللهم العن عتبة، وشيبة، وأميّة بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء[7].
ومع أنّ الوطن يطلق في أصل اللغة على مكان مولد الإنسان ومحل إقامته ومنزله الذي يسكنه[8]؛ إلا أنّه في الاصطلاح المعاصر أصبح يُطلق على منطقة جغرافية أكبر تشكّلت حدودها باتفاقات وظروف سياسية وإن فرّقت بين أبناء المنطقة الواحدة، أو العشيرة والعائلة الواحدة، ومع ذلك فإنّ طولَ العهد بها وانتظامَ أهلها تحت قوانين موحّدة أورثهم نوعًا من الانتماء والميل الفطري إلى بلدهم خصوصًا عند نمو الذكريات والعلاقات والثقافات ضمن هذا الإطار المرسوم، وهذا أمر شعوري معتاد لا يلزم منه الإقرار بهذه الحدود أو الرضا بها.
حبّ الوطن الذي عاش فيه الشخص وترعرع أمر فطري طبيعي، ولا إثم في الانتساب له والاعتزاز به، وخدمة أهله، والحرص على بنائه وتنميته والعمل على الرقيّ به، وتخصيصه بالرعاية والاهتمام، وتقديم أهله في الأعمال والوظائف في إطار ما تقتضيه التنظيمات الحياتية والقانونية، وليس هذا من الرضا بحدود المستعمر، بل من الوعي وفقه الواقع وحسن التعامل معه
تخصيص الوطن ببعض الأمور:
لأجل ما سبق فإنّ حبّ الوطن الذي عاش فيه الشخص وترعرع أمر فطري طبيعي، ولا إثم في الانتساب له والاعتزاز به، وخدمة أهله، والحرص على بنائه وتنميته والعمل على الرقيّ به، وتخصيصه بالرعاية والاهتمام، وتقديم أهله في الأعمال والوظائف في إطار ما تقتضيه التنظيمات الحياتية والقانونية، كاشتراطات الجنسية ونحوها.
وليس هذا من الرضا بحدود المستعمر، بل من الوعي وفقه الواقع وحسن التعامل معه، خصوصًا إذا أُحسن توظيفه لخدمة الإسلام وأهله، ألم ترَ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغشى القبائل في موسم الحج ليعرض عليهم الإسلام، وقد كان في موسمهم من الشرك والتفاخر بالأنساب والقبائل ما فيه، أفكان غشيانه صلى الله عليه وسلم لهم رضًا بما يصنعون؟!
وإذا كان الإنسان يتأثّر بالبيئة التي ولد فيها، ونشأ على ترابها، وعاش من خيراتها؛ فإنّ لهذه البيئة عليه (بمن فيها من الكائنات، وما فيها من المكوّنات) حقوقًا وواجباتٍ كثيرةً تتمثل في حقوق الأُخوّة، وحقوق الجوار، وحقوق القرابة، وغيرها من الحقوق الأُخرى التي على الإنسان في أي زمانٍ ومكان أن يُراعيها وأن يؤدّيها على الوجه المطلوب؛ وفاءً وحبًّا منه لوطنه.
كما يُشرع الدفاع عنه ضد المحتلين والأعداء، وخصّه بالدعاء بالصلاح والأمن والرخاء.
أين المحذور؟
المحذور أن يتحوّل هذا الحبّ الطبيعي إلى «قُطرية» متعصّبة؛ تجعل الدولة أعلى مرجعية وأقدس انتماء، وعقدُ الولاء والبراء على الوطن، بحيث يقدّم ولاء القطر على ولاء العقيدة، فيصير الدفاع عن «حدود الوطن» مقدّمًا على نصرة المسلمين المضطهدين في قُطرٍ آخر، والتعاون مع الكفار ضدّ دولة إسلامية أخرى بحجّة «المصلحة الوطنية».
فالوطنية الحقّة: قيام المسلم بحقوق وطنه دون نسيان أو انقطاع عن حقوق أمّته الكبرى، من الولاء، والانتماء، والنصرة وغيرها.
المحذور في المسألة الوطنية: أن يتحوّل الحبّ الطبيعي للوطن إلى «قُطرية» متعصّبة؛ تجعل الدولة أعلى مرجعية وأقدس انتماء، وعقدُ الولاء والبراء على الوطن، بحيث يقدّم ولاء القطر على ولاء العقيدة، فيصير الدفاع عن «حدود الوطن» مقدّمًا على نصرة المسلمين المضطهدين في قُطرٍ آخر
هل صنع عدوّنا “حدود” أفكارنا؟
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]. فلم يجعل الله الشعوب والقبائل للتعادي والتفاضل القبلي أو القطري، بل للتعارف.
لكنّ الاستعمار الأوروبي (ثم الأمريكي) رسم حدودًا مصطنعة كما أشرنا آنفًا (ضمن اتفاقية سايكس- بيكو وما بعدها) ليحوّل الأمّة الواحدة إلى دويلات متصارعة، فهل نجح فعلاً في أن ينقل هذه الحدود من الخريطة إلى عقولنا وقلوبنا، نعقد الولاءات والرايات عليها، حتى صرنا نراها قَدرًا إلهيًا لا يجوز تجاوزه؟
صور ونتائج خطيرة:
للتعامل الخاطئ مع المسألة القُطرية مظاهر ونتائج وتطبيقات مرفوضة، نذكر بعضًا منها ليتّضح المقصود:
أ. جعل المواطنة مقدّمة على الدين:
وهذا يظهر بشكل جليّ في بلدان المهجر، فتجد المهاجرين من بلد معيّن يقرّبون مَن كان من أهل هذا البلد في البيع والشراء والمجاورة والصحبة ولو كانوا من ملّة أخرى غير الإسلام، في الوقت الذي يتجنّبون فيه مخالطة أمثالهم من بلدان أخرى ولو كانوا مسلمين، والمشكلة هنا ليست مجرّد التعامل؛ فهي في نطاق المباحات، لكنّها في جعل المواطنة أساسًا للتمييز والتفضيل والتعامل.
ب. إهمال التفاعل مع قضايا المسلمين خارج القطر:
وهذا كثير اليوم، خصوصًا في وسائل الإعلام المأجورة، حيث يكثر طرح عبارات ومفاهيم من قبيل: أنا مواطن دولة كذا، أو: البلد الفلاني لأهله؛ ويُقصد بذلك التضييق على الوافدين إليه من مواطني بلد آخر للعمل والاستثمار، أو التملّص من قضايا المسلمين بنحو: فلسطين ليست قضيتي، أو المدافعة عن خذلان قادة الدول المسلمة للقضايا الإسلامية العادلة التي يتعرض فيها المسلمون للبطش والضيم والتهجير بتزيين موقف هؤلاء القادة وتصحيحه، والنيل من منتقديهم، بل ومن الشعب المضطهد بحجج واهية تقوم كلّها على الانتماء القطري.
ج. “القطرية الدينية”:
والتي تتمثّل في منظومة من الفتاوى والأحكام التي تُبنى على أساس الولاء أو الانتماء الوطني، لا على مقتضيات الشرع ومقاصده العامة، وهي ثمرة الإغراق في الانتماء القُطري وما يلحقه من تبعات واعتبارات. وإذا أُلبس هذا المسلك لباسًا شرعيًا كانت مآلاته بالغة الخطورة؛ إذ قد يُتعامل مع الخلافات بين البلدان معاملةَ العداوات الوجودية، فيُحرَّض على القتال، وتُستدعى مفاهيم الولاء والبراء في غير مواضعها، مع الغفلة عن كون هذه الحدود في أصلها مصطنعة، وأنّ غالب هذه الكيانات خاضع لسياسات دولية ومصالح ضيقة.
والقطرية الدينية بهذا الاعتبار من أخطر المشاكل التي أصابت الأمة في واقعها المعاصر؛ إذ حوّلت الإسلام من مشروع حضاري ذي أفق عالمي إلى مجرد غطاءٍ رمزي لتعزيز الكيان الوطني.
وما يزيد الأمر إيلامًا أنّ شريحة واسعة من الشباب الملتزم لا تشعر بوجود خلل في هذا المسلك، بل يتعزز لديها شعور بالاكتفاء الديني، وتتوهم أنّها على الصواب التامّ؛ لأنّها تجمع بين الالتزام الشخصي والحماسة الوطنية.
د. التعصّب لمظاهر وقشور لا وزن لها:
وهذا مما ابتلينا به في هذا الزمان، فتجد التعصّب يبلغ ذروته لمباراة كرة قدم، فتتجاوز المسألة التشجيع العادي إلى هتافات وعبارات مسيئة لشعوب بأكملها، ثمّ قد يتطوّر الأمر إلى التفاخر برموز ومعاني باطلة من قبيل التشفّي بمآسي بلد بسبب خصومة رياضية وما شابه، ومن أسوأ صور هذا التعصب: ما يحصل من معجبي رموز الوسط الفني من ممثلين ومطربين شغلهم الشاغل إفساد الأجيال وإشغالهم عن معالي الأمور.
للتعامل الخاطئ مع المسألة القُطرية مظاهر وتطبيقات مرفوضة، منها جعل المواطنة مقدّمة على الدين، وإهمال التفاعل مع قضايا المسلمين خارج القطر، وتسرب هذه الأفكار إلى الفتاوى التي تُقدم القطر في الولاء على ولاء الإسلام وأخوته، وإذا وصل ذلك إلى التعصب لمظاهر وقشور يختزل فيها الوطن فهذا شر عظيم
كيف نعالج انتقال الحدود إلى عقولنا؟
الإسلام بما فيه من وحي وتشريعات وآداب كفيل برسم منهج صالح لكلّ زمان ومكان، ينعم فيه الناس بالخير والسعادة في كلّ الشؤون، ومما يصلح ذكره لمعالجة المسألة القطرية ما يأتي:
1. التربية على تعظيم الله في النفوس:
فإذا عُظِّم الله هان كلّ شيء في نفس المؤمن، فلا يكون همّه إلا ما يرضي الله، وترتفع حساسيته تجاه ما يسخط الله، ويكون شغله الشاغل التقرّب إلى مولاه بالعبادة وفعل ما ينفع العباد والبلاد.
2. تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته:
وفيها أنّ التفاضل يكون بالتقوى، ومن خلال سيرته يلحظ ذوبان الفوارق بين البلدان والأعراق والألوان، فضلاً عن ارتفاع قيمة الانتماء للدين والاعتزاز به.
3. التوعية بكيد الأعداء وخططهم:
ومن ذلك دراسة تاريخ الاستعمار وتاريخ نشوء الدول القطرية الحديثة في أوروبا، وكيف كانت كلّ منها تعتقد أنّ شعبها متفوق على بقية الشعوب، وكيف نقلت لنا أفكارهم عبر الاستعمار وزرعت في دولنا وإعلامنا ومناهجنا.
4. تحقيق الأخوّة الإيمانية فوق العصبيات:
وتحقيق الأخوّة الإيمانية لا يناقض حبّ الأوطان، بل يحفظها ويصون أمنها واستقرارها. أمّا الدعوة إلى عصبيات تُقدَّم على رابطة الإيمان، وتُعطَّل بها حقوق الأخوّة والنصرة، فهي دعوة مردودة شرعًا؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تقديم لغير ما قدّمه الله ورسوله.
5. ضبط الولاء والبراء على أساس الدين لا الأوطان:
ومن أعظم ما يعالج به الخلل القُطري: تصحيح مفهوم الولاء والبراء، ليكون قائمًا على رابطة الإيمان، لا على الأوطان والانتماءات والشعارات المحدثة. فلا تُعقَد المواقف الشرعية، ولا تُبنى الخصومات والاصطفافات إلا على ما قرّره الوحي من التقوى والإيمان والصبر، لا على قومية أو وطنية أو عصبية جاهلية.
6. العمل على التأليف وجمع الكلمة:
فإذا رأى الناس العلماء والقدوات يتسامون فوق الحدود القطرية، ويضعونها في موضعها الصحيح، ويتنازلون عن حظوظ أنفسهم لصالح جمع الكلمة، فعلوا مثلهم واقتدوا بهم وقدموا ما ينبغي أن يقدم.
وإذا صارت هذه الحدود دينًا نتقاتل من أجله ونكفّر بعضنا من أجله، فقد انتصر عدونا وورثنا نحن الجاهلية بثوب عصري.
وإذا كانت الحكومات والأنظمة قد ألزمت نفسها باتفاقيات ومعاهدات سياسية وقانونية قد تحمِلها على بعض التصرّفات أو المواقف، فإنّنا أفرادًا وجماعات لم نوقّع على شيء من هذا، ولا يلزمنا إلا ميثاق واحد هو قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى)[9].
7. فهم مقصود حماية الأوطان المسلمة:
إنّ حماية الأوطان المسلمة في ميزان الشرع ليست تعظيمًا للأرض لذاتها، وإنما هي حماية للدين، وصيانة للأعراض، وحفظ للأموال، ودفعٌ لأطماع الأعداء. فكلّما قويت بلاد المسلمين وزادت مَنعتُها؛ تيسّرت إقامة الدين، وحُفظت الحقوق، ودُفع البغي، مع بقاء الأخوّة الإيمانية قائمة حتى في حال وقوع الظلم أو البغي من بعض المسلمين.
8. نصرة القضايا الإسلامية بحسب الاستطاعة:
فالأمّة تأثم إذا لم تقم بنصرة المسلم العاجز من غير عذر شرعي؛ لأنّ النصرة حقّ ثابت من حقوق الأخوّة الإيمانية، لا يسقطه ضعف ولا اختلاف مكان. وإذا عجز المسلم عن الهجرة أو عن إظهار دينه لمانع قاهر، بقي حقّه في النصرة قائمًا، وبقيت مسؤوليّة الأمة قائمة بقدر ما تملك من قدرة ووسيلة.
9. التوازن في مسألة الهجرة والمسؤولية الجماعية:
فكما يُطالَب المسلم المقيم في دار الكفر بالهجرة إذا قدر عليها، ويُلام على التقصير فيها، فكذلك تُلام الأمة إذا قصّرت في نصرة المسلم العاجز عن الهجرة، أو منعتْه اعتباراتٌ قومية أو وطنية من الالتحاق بإخوانه. فالتكليف هنا متبادل، والمسؤولية مشتركة، بحسب القدرة والاستطاعة.
لم يجعل الإسلام الوطن بديلاً عن العقيدة، ولا المواطنة نقيضًا للأخوّة، ولا الكيانات السياسية ناسخةً لميثاق الإيمان. والحدود إذا بقيت على الخرائط لم تُفسد الوعي، وإنما الخطر حين تستقر في القلوب. ومعركة الأمة اليوم ليست مع الجغرافيا؛ بل مع تصحيح البوصلة، واستعادة مركزية الدين، ليعود الإسلام إطارًا جامعًا، لا زينةً تخدم كياناتٍ عابرة
وختامًا:
لم يكن أخطرُ ما فعله الاستعمار في جسد الأمة رسمَ حدودٍ على الخرائط، بل نجاحه -إلى حدٍّ غير قليل- في نقل هذه الحدود إلى الوعي والوجدان، حتى غدت معيارًا للولاء والخصومة، ومفتاحًا لفهم الدين وتنزيله. وحين تتحوّل الحدود من واقعٍ سياسيٍّ مُدار إلى هويةٍ ذهنيةٍ مُقدَّسة؛ تختلّ الموازين، ويُقدَّم ما حقّه التأخير، ويُؤخَّر ما حقّه التقديم.
ومن هنا يتبيّن أن جوهر الإشكال ليس في وجود الحدود بوصفها واقعًا سياسيًا، بل في العقد الاجتماعي الذي سمح لها بالتحوّل إلى مرجعية ذهنية وقيمية تُزاحم مرجعية الإيمان.
إنّ الإسلام لم يجعل الأوطان بديلاً عن العقيدة، ولا المواطنة حاجزًا أمام الأخوّة، ولا التنظيمات السياسية ناسخةً لميثاق الإيمان، فبقاء الحدود على الخريطة لا يُفسد الوعي، أمّا انتقالها إلى العقول والقلوب فهو بداية الانقسام الحقيقي. ومن هنا، فإنّ معركة الأمة اليوم ليست مع الجغرافيا، بل مع إعادة ترتيب القيم، واستعادة مركزية الدين، وإعادة وصل ما قُطِع في الوعي، فإذا صلحت البوصلة، سهل التعامل مع الحدود دون أن تتحوّل إلى أصنامٍ جديدة، ويعود الإسلام إطارًا جامعًا لا شعارًا مزيَّنًا لخدمة كياناتٍ عابرة.
أسرة التحرير
[1] ليس على سبيل التعميم، لكنها سمات ملحوظة، ولا يعني عدم وجودها كليًا في المنطقة المقابلة.
[3] أخرجه البخاري (1889) ومسلم (1376).
[6] سير أعلام النبلاء (15/394).
[7] متفق عليه، البخاري (1889)، ومسلم (1376) مختصرًا باختلاف يسير. وهذه الأبيات من بلال رضي الله عنه تعبّر عن حنينه وتمنّيه الرجوع إلى مكة التي كانت فيها صحته، فهو يتمنى أن يبيت ليلة واحدة في وادي مكة، ويطفئ أشواقه الحارة من مياه مجنة -وهي ماء عند عكاظ على أميال يسيرة من مكة بناحية مرّ الظهران، وكان به سوق في الجاهلية- وأن يمتّع ناظريه بمشاهدة الإذخر والجليل، وهما نبتان من الكلأ طيب الرائحة يكونان بمكة، وأن يشاهد شامة وطفيلاً، وهما جبلان متجاوران جنوب غرب مكة على قرابة (90 كم) منها. ثم جعل بلال رضي الله عنه يدعو الله على الذين أخرجوهم من مكة إلى أرض بها وباء وأمراض، فقال: «اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف»، وهؤلاء من رؤوس المشركين وزعمائهم في مكة، مصدر الشرح: الموسوعة الحديثة بموقع الدرر السنية، https://dorar.net/hadith/sharh/5853.
[8] العين (7/454)، تهذيب اللغة (14/21)، الصحاح (6/2214)، المخصص (1/503).