يقدّم الكتاب تحليلاً نقديًا وعميقًا لمفاهيم الأمن في السياق العربي، موضحًا كيف تحوّلت السياسات الأمنية من حماية الإنسان إلى تأمين الأنظمة، ويقترح بديلاً يقوم على أمن إنساني تشاركي. يناقش النظريات العالمية، ويكشف إخفاقات تطبيقها في العالم العربي دون مراعاة السياق، داعيًا لبناء منظومة أمنية عربية تراعي الهوية، والخصوصية، وتعتمد على الشفافية والمجتمع المدني.
المؤلف:
باحث وأكاديمي سوري، حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام 1999م، وعلى شهادة البكالوريوس من الجامعة نفسها عام 1993م. متخصص في التاريخ السياسي للعالم العربي، وله العديد من الكتب والأبحاث المحكّمة والمقالات في الشؤون الإستراتيجية لمنطقة الخليج والمشرق العربي وتاريخ مصر.
مؤسس ومدير “المرصد الإستراتيجي (2015- 2023م)” الذي صدرت عنه العديد من الأوراق البحثية والدراسات والتقارير، من أبرزها: “التقرير الإستراتيجي السوري”. وهو أيضًا مؤسس مركز “شارك” الشبابي الإلكتروني (2017- 2023م) الذي أنجز سلسلة من الإصدارات العلمية، ونظّم عددًا من الفعاليات والدورات.
وصف الكتاب:
الكتاب من إصدار مركز “شارك” الشبابي، يقع في ٢٩٨ صفحة، وصدرت الطبعة الأولى منه عام ٢٠٢٣م.
ويتألف من ثلاثة فصول، وعددٍ من الفهارس والرسوم والجداول التي تخدم مادة الكتاب وتقرّبها للقارئ:
» الفصل الأول: النظريات الأمنية (عرض موسع لأبرز النظريات الأمنية من بداية ظهورها وحتى آخر مراحل تطورها).
» الفصل الثاني: الأمن العربي المعاصر (تقييم للنظريات الأمنية وعرض لإخفاقات استيراد هذه التطبيقات في العالم العربي دون مراعاة خصوصية مجتمعاته).
» الفصل الثالث: تطبيقات الأمن الإقليمي (مقترحات لبناء منظومة أمنية جديدة تأخذ بعين الاعتبار هشاشة النظم القائمة وتعقيد المجتمعات).
موضوع الكتاب:
يقدّم الكتاب الذي بين أيدينا إجابة وافية عن أسئلة غاية في الأهمّية في موضوع الأمن: هل الأمن هو حماية الدولة أم تأمين الإنسان؟ ومن يملك الحق في تعريف الخطر: الدولة أم المجتمع أم الخارج؟
ومن خلال ذلك يساهم في نشر الثقافة الأمنية، ويصوّب الانحرافات المفاهيمية والتطبيقية التي طرأت في الثقافة العربية في هذا الموضوع، ويقدم نماذج تطبيقية يمكن الاستئناس بها لإعادة صياغة المعادلة الأمنية العربية فيما يحقق الاستقرار، ويعزز فرص التنمية، ويحمي الحريات العامة، ويصون الكرامة الإنسانية بدلاً من انتهاكها، كل ذلك بعبارة ميسرة للقارئ المبتدئ، أو غير المتخصص في مجال الأمن[1].
فالكتاب لا يكتفي بمهمة الشرح، بل يسعى إلى إعادة تفكيك المفاهيم الأمنية الموروثة، وتوطينها عربيًا، من خلال عرض النظريات الأمنية وتطبيقها على الواقع العربي، ومِن ثمَّ عرض تطبيقات معاصرة.
عرض الكتاب:
بدأ المؤلف بتعريف لفظ “الأمن”، وأنَّ استخدامه في العلاقات الدولية يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، ويقصد به: “حالة الإحساس بالثقة والطمأنينة بوجود ملاذ من الخطر، ويتمثّل الموقف المترتب على الحاجة إلى الأمان، ويرتبط بخاصية العدوانية لدى الإنسان”، ثمَّ يذكر مشكلة التعريف الاصطلاحي ويذكر عِدَّة تعاريف، ثمَّ يخلص إلى أنّ ظاهرة غياب التعريف الجامع تعود إلى كون حقل الدراسات الأمنية لا يزال جديدًا ويواجه تحديات في طريق التأسيس بصفته حقلاً معرفيًا مستقلاً.
الفصل الأول/ النظريات الأمنية – من فلسفة البقاء إلى أمن الإنسان:
ينطلق هذا الفصل من حقيقة صادمة وبسيطة وهي: أنّ العالم اليوم يعيش تطورًا متسارعًا في فهم الأمن، ليس فقط كممارسة سياسية أو عسكرية، بل كعلم قائم بذاته، له مدارسه ومناهجه ونظرياته، يتطور جيلاً بعد جيل، ويعاد فيه تعريف التهديد والمصالح والفاعلين.
وفي المقابل، يقف العالم العربي شبه غائب عن هذا السباق، فنحن لا نشارك في إنتاج النظريات الأمنية، ولا حتى في استيعابها.
وفي الوقت الذي بات فيه الأمن مجالاً معرفيًا مركّبًا في الجامعات ومراكز الأبحاث؛ لا يزال تعاملنا معه بدائيًا، مرتبطًا بمفاهيم السيطرة والقوة الصلبة، وخاضعًا لإرث من التسييس والاستبداد.
والمفارقة أنّ المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم اضطرابًا أمنيًا: فنحن الأكثر تورطًا في الحروب، والأكثر استيرادًا للسلاح، والأكثر تعرضًا للتدخل، وفي الوقت نفسه الأقل قدرة على فهم “ما هو الأمن؟” وكيف يُبنى؟
هذا الفصل لا يعرض فقط النظريات الأمنية كما ظهرت في الغرب، بل يكشف من خلالها كمّ التخلف النظري الذي نعيشه، ويطرح السؤال المؤلم:
كيف تكون أكثر شعوب الأرض حاجة إلى الأمن، وأقلها فهمًا له؟
يقول المؤلف: “تغيب المنهجية عن الدراسات الأمنية العربية، وتغيب معها القدرة على فهم المفهوم نفسه، أو تبيئته، أو حتى نقده؛ فتتحول المقاربات الأمنية في عالمنا العربي إلى ردود فعل ظرفية، لا تنطلق من فهم مركّب ولا تنتهي إلى حلول مستدامة”.
١- نشأة وتطور الدراسات الأمنية:
يبدأ المؤلف من جذور الموضوع، مشيرًا إلى أن الدراسات الأمنية وُلدت من رحم العلاقات الدولية، لكنها ما لبثت أن تشعبت. في البداية كان “الأمن” يعني شيئًا واحدًا: أمن الدولة من الحرب والعدوان الخارجي، لكن مع الوقت تشظّى المفهوم ليشمل أبعادًا غير عسكرية: الأمن الاقتصادي، والغذائي، والصحي، وحتى الثقافي.
يعرض المؤلف ثلاث مراحل في تطور الحقل الأمني:
• المرحلة التقليدية: (قبل الحرب العالمية الثانية: حيث كان الأمن مرادفًا للسيادة والحروب).
• المرحلة الحديثة: (الحرب الباردة: حيث ظهرت توازنات الرعب والنظريات الواقعية).
• مرحلة ما بعد الحرب الباردة: (حيث توسعت أجندة الأمن لتشمل الإنسان، لا الدولة فقط).
٢- المناهج الكلاسيكية: من الفلسفة إلى المقارنة:
في هذا القسم يستعرض المؤلف المناهج الفكرية التي أسهمت في تشكيل الدراسات الأمنية:
• المنهج المثالي: مستمد من أفلاطون، ويرى أن الأمن يتحقق بوجود حاكم فاضل.
• المنهج التاريخي: ويدعو لفهم الأمن من خلال السياقات الزمنية والدروس السابقة.
• المنهج القانوني: ويربط الأمن بالنظام القانوني والمؤسسات الشرعية.
• المنهج الراديكالي: يقوم على النظرية الاجتماعية لماركس، ويُسلط الضوء على علاقة الأمن بالسلطة والاقتصاد.
• المنهج السوسيولوجي: الذي يركز على البُعد المجتمعي والهويات، فيعمد إلى تحليل الأحداث السياسية من منظور اجتماعي.
• المنهج القياسي: وذلك مِن خلال قياس الحالات السياسية في الدول من خلال صورة الفرد.
• المنهج الاستقرائي: يعتمد على استقراء الواقع السياسي على ضوء الحقائق القائمة للحصول على نتائج علمية يمكن تعميمها.
هذه المناهج -رغم اختلافها- توفر عدسة متعددة الزوايا لفهم “الأمن”، تتجاوز العسكرة والحدود.
الدراسات الأمنية وُلدت من رحم العلاقات الدولية، لكنها ما لبثت أن تشعَّبت. في البداية كان “الأمن” يعني شيئًا واحدًا: أمن الدولة من الحرب والعدوان الخارجي، لكن مع الوقت، تشظّى المفهوم ليشمل أبعادًا غير عسكرية: الأمن الاقتصادي، والغذائي، والصحي، وحتى الثقافي
٣- النظريات الأمنية الكبرى التي تشكلت من خلال الدول الكبرى: الواقعية، الليبرالية، البنائية:
» النظرية الواقعية: الصراع دائم، والدولة مركز الكون:
وفق المدرسة الواقعية فإنَّ الفرد عدواني بالدرجة الأولى، ويسعى للحصول على السلطة، والأفراد ينتظمون في دول تعمل كلٌ منها بشكل مستقل، وتسعى للهيمنة على الدول الأخرى، فلذلك تسعى لحيازة أكبر قدرٍ من القوة بهدف التفوق على خصومها. فالأمن يعني القوة، والعالم محكوم بالفوضى، فالعلاقات الدولية تعجّ بالفوضى، والدولة هي الفاعل الوحيد، ولا أمان إلا بتفوق عسكري، فيجب أن تعتمد على نفسها.
يشير المؤلف إلى عدة تيارات تعمل من خلال النظرية الواقعية، مثل:
• الواقعية الكلاسيكية: الإنسان شرير بالطبيعة.
• الواقعية الجديدة (كينيث والتز): الفوضى الدولية هي سبب الصراع، لا الطبيعة البشرية.
• الواقعية الهجومية (مير شامير): لا سبيل للأمن إلا بالهيمنة.
• الواقعية الدفاعية: ترى أنَّ الدول ليست عدوانية في طبيعتها، وأن توازن القوى كاف للردع.
» النظرية الليبرالية: التعاون ممكن:
وهي تنطلق من افتراض أن الفاعلين غير الدوليين (منظمات، مجتمع مدني، شركات) لهم دور، والأمن يتحقق بالقانون، والمؤسسات، والتعاون الاقتصادي. لكن هذه المدرسة -كما يذكر المؤلف- تلقت انتقادات شديدة، خصوصًا من فوكوياما نفسه؛ الذي دعا إلى تعميم الليبرالية بالقوة، وتفكيك سيادة الدول الضعيفة، لكن التجربة أثبتت فشل النموذج الليبرالي في العراق وأفغانستان.
يشير المؤلف إلى دعوة فوكوياما في كتابه الثقة إلى عولمة الليبرالية بالقسر! وحاول من خلال ذلك تبرير تدخلات قسرية شوهت صورة التحول الديمقراطي.
» النظرية البنائية: الأمن خيال اجتماعي:
وهي تقوم على اعتبار أنَّ الأفراد يعطون المعنى للبنى السياسية والأمنية.
البنائية تؤمن بأن التهديد ليس موضوعيًا، بل ناتج عن تصورات جماعية، وأنّ الأمن مسألة هوية وخطاب. وتعتبر البنائية أنَّ مصدر القوة يكمن في العوامل غير المادية والتي تحقق الأمن (الصورة الوطنية– التأييد الشعبي- القيادة)، ولذلك يجب أن يبحث في التكوينات المجتمعية وربطها بالتفاعلات الدولية وبتحولات الفكر والقيم لتحليل الظواهر الأمنية، يشرح المؤلف أن هذه النظرية فتحت المجال لفهم الصراعات من زاوية (من نحن؟) وليس فقط (ماذا نملك من سلاح؟).
٤- نظرية المباريات: الأمن لعبة استراتيجية:

يولي المؤلف في هذا الفصل عناية خاصة لما يُعرف بنظرية المباريات، باعتبارها أداة لتحليل سلوك الفاعلين في مواقف الصراع أو التعاون.
مع تطور المهددات الأمنية، وتعقدها، وتعدد أطرافها؛ طرأت الحاجة إلى تطبيقات أكثر تطورًا من النظريات الفلسفية، وإلى ضرورة القيام بحسابات دقيقة بدلاً من الاقتصار على الاجتهادات النسبية، ومن أبرز النظريات التي تم استحداثها في هذا المجال؛ “نظرية المباريات” (game theory).
وتُعرّف “نظرية المباريات” بأنها: “طريقة لدراسة صناعة القرار في حالات الصراع، عبر التحليل الرياضي لحالات تضارب المصالح، بغرض الإشارة إلى أفضل الخيارات الممكنة لاتخاذ قرارات في ظل الظروف المعطاة تؤدي إلى الحصول على النتيجة المرغوبة”.
وتُعدّ هذه النظرية من أكثر المناهج تطورًا في تحليل التطورات الأمنية، حيث تقوم على افتراض أزمات معينة، وإسناد أدوار محددة لأطرافها، ومن ثم تحليل كافة أبعادها، وصياغة نطاق واسع من القرارات البديلة التي يصلح كل واحد منها لحل أزمة مفترضة أو واقعة بالفعل.
علمًا بأن تطبيقات نظرية “المباريات” لا تقتصر على المعالجة الأمنية فحسب، بل تُستخدم في علوم الاجتماع والاقتصاد، وفي النظريات السياسية والعلوم العسكرية، وتقوم على أساس وجود احتمالات متعددة ومتشعبة، وتتضمن ثلاث خيارات من المصالح كما في الشكل:
وتقوم المباراة على عشرة عناصر رئيسة هي:
اللاعبون، وأسباب الصراع، والأهداف، والمعلومات المتوفرة، والخيارات المتاحة، والخطة، والإستراتيجية، والعقلانية، والحيلة، والمباراة.
و”في الحالة العربية” غالبًا ما تتحول علاقات التعاون إلى لعبة دجاج قاتلة، حيث يفضّل الطرفان الخسارة الجماعية على “التنازل التكتيكي!”
كما يشير المؤلف إلى أن نظرية المباريات توفّر أدوات لفهم الردع وتوازن القوى، لكنها تتطلب بيئة مؤسسية لا تتوفر غالبًا في الدول العربية.
انتُقد على النظرية كونها أداة غير احترافية للتحليل الأمني، إذ إنها لم توضع في الأصل لمعالجة المهددات الأمنية التي تقوم على واقع يتسم بالفوضى وعدم الانتظام، وينتمي اللاعبون فيه إلى منظومات غير متجانسة من الأفكار والقيم والاتجاهات؛ ما يجعل عملية التنبؤ صعبة للغاية.
وتكمن المشكلة الأكبر في ارتكاز تطبيقات “المباريات” على اعتماد النسبية في القياس، وهو أمر غير دقيق؛ إذ إن الأحداث الدولية والمواقف السياسية لا تتكرر بصورة متطابقة، بل تنشأ مواقف متباينة في كل حالة جديدة وفق متغيرات الظروف المحيطة بها حتى وإن بدت متشابهة.
وبالتالي فإنه لا يمكن الخروج من “اللعبة” بنتائج دقيقة، أو بقوانين ناظمة للعملية السياسية أو الأمنية نظرًا لتعقد المشهد الدولي وتداخله، بل هي في أحسن الأحوال تخمينات يمكن الاستئناس بها من قبل الجهة التي تقوم بتطبيقها، مع مراعاة التعامل مع مخرجاتها على أنها احتمالات ذات طابع ترشيدي يساعد على الاختيار بين مختلف السيناريوهات التي تفرزها عملية الصراع، وهي بالتالي عملية تكتيكية أكثر من كونها نظرية تحليلية شاملة.
تُعدّ نظرية المباريات من أكثر المناهج تطورًا في تحليل التطورات الأمنية، حيث تقوم على افتراض أزمات معينة، وإسناد أدوار محددة لأطرافها، ومن ثم تحليل كافة أبعادها، وصياغة نطاق واسع من القرارات البديلة التي يصلح كل واحد منها لحل أزمة مفترضة أو واقعة بالفعل
٥- المدرسة النقدية: نحو أمن تحرري:
ينتقل المؤلف إلى المدرسة النقدية التي انطلقت في الثمانينات والتسعينيات، وتوسعت في ثلاث تيارات، هي:
• مدرسة كوبنهاغن: وترتكز على مفهوم “التسييس” و”الأمننة”، أي كيف يتحول موضوع ما (الهجرة، الدين، البيئة..) إلى تهديد أمني من خلال الخطاب فقط، دون أن يكون خطرًا واقعيًا. وتقترح هذه المدرسة خمس قطاعات للأمن: (العسكري، السياسي، الاقتصادي، المجتمعي، البيئي).
• مدرسة أبريستويث: تدعو إلى تجاوز الدولة تمامًا، وتبني ما يُعرف بالأمن الإنساني الذي يضع الإنسان في المركز، وتؤمن بضرورة تفكيك بنى الهيمنة والخوف المرتبطة بالأجهزة الأمنية.
• المدرسة الباريسية: وتُعنى بدراسة الأجهزة الأمنية كفاعلين مستقلين، ويقسم المؤلف هذه المدرسة إلى:
1. الأجهزة السياسية: والتي تهدف لحماية النظام.
2. الأجهزة العسكرية: التي تسعى لمواجهة تهديد خارجي.
3. الأجهزة العقائدية: والتي تخدم أيديولوجيا معينة.
4. الأجهزة الاجتماعية: ودورها إعادة إنتاج النظام الثقافي والاجتماعي.
والجدير بالذكر أنّ “أحد إشكاليات الأمن العربي: أن الأجهزة العقائدية طغت على العسكرية، وأدت إلى عسكرة الحياة المدنية نفسها”.
مقارنة مفهوم الأمن لدى تيارات المدرسة النقدية

إنّ أحد إشكاليات الأمن العربي، أنّ الأجهزة العقائدية طغت على العسكرية، وأدّت إلى عسكرة الحياة المدنية نفسها
الفصل الثاني/ الأمن العربي – أزمة المعيار والتكوين:
يأخذ هذا الفصل طابعًا نقديًا أكثر مباشرة، حيث يبدأ من تشخيص “أزمة المفهوم”، وينتقل إلى تفكيك بنى الدولة العربية الحديثة، وتحديات الجغرافيا والهوية، لينتهي بتحليل المعضلة الأمنية والثقافة الأمنية الراهنة.
1. أزمة المعيارية الأوروبية:
ينتقد المؤلف محاولات “تعميم” النموذج الأوروبي في الأمن والديمقراطية، فيذكر حالات مثل:
– فشل التحول الديمقراطي بالقوة في العراق وأفغانستان، وذلك عن طريق فرض الديموقراطية الليبرالية الجديدة والتي قامت على أسس واهية، وتحولت الليبرالية إلى وحشية غير مقبولة تمنح نفسها حق نشر المبادئ بالسلاح والقوة، وهذا ما كان له أثر أمني كبير دوليًا، وفوضى في الأمن الدولي في البلاد التي حاولت هذه الدول أن تفرض هيمنتها عليها.
– تحدث المؤلف عن معاهدة “ويستفاليا”، وأنَّ الدراسات الأمنية الحديثة تعتبر هذه المعاهدة (1648م) نقطة بداية النظام الدولي الحديث، ونتج عنها: إنهاء الحروب الدينية، وتشكل الدول القومية، وفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية. وأنَّ هذا النموذج تعرض لنكسات، وعرض للافتراضات التي جعلت هذه المعاهدة بداية نشوء النظام الدولي، ونقدها، وبيَّن عدم صحة ذلك الادعاء.
– إخفاق تصدير نموذج “الدولة الحديثة” إلى ليبيا وسوريا واليمن، ويبيّن المؤلّف أنَّ مفهوم الأمن في هذه الدول قائم على الحفاظ على فئة فقط، وهذه الفئة هي من تمثل الأمن في البلاد.
– تناقضات الاتحاد الأوروبي تجاه اللجوء والهجرة، حيث تبنى خطابًا أمنيًا ضد اللاجئين: “لم تكن المشكلة في أن العرب يرفضون الديمقراطية، بل في أن النماذج المستوردة لم تُبنَ على فهم حقيقي للسياق المحلي”.
2. تشوهات التأسيس والهوية التائهة:
يفصّل المؤلف كيف أن الدول العربية الحديثة نشأت نتيجة اتفاق سايكس – بيكو، وليس نتيجة تطور طبيعي. فالدولة لم تكن تجسيدًا لمجتمع، بل جهازًا مفروضًا، تم اختزال الهوية في حدود ساكنة وجواز سفر، وتحول الأمن إلى مسألة ولاء للنظام، لا حماية للناس، وغيّبت المرجعية الإسلامية لصالح قوميات مصطنعة.
3. الجغرافيا وأمن الصحراء:
الجغرافيا نفسها تتحول إلى لعنة في بعض السياقات، فالحدود العربية الواسعة رخوة، ومفتوحة. وتُشكّل المناطق الصحراوية الحدودية بيئة خصبة للتهريب والجريمة المنظمة والتدخل الخارجي، يذكر المؤلف أمثلة من ليبيا، ومالي، وسيناء، ومنطقة الحدود العراقية – السورية.
4. المعضلة الأمنية والحروب العربية:
تُعد “المعضلة الأمنية” من أبرز المفاهيم التي يُفككها المؤلف، وهي الحالة التي تؤدي فيها محاولات دولة لتعزيز أمنها إلى تهديد جيرانها، فتدخل المنطقة في سباق تسلح ودوامات صراع.
ويورد الكتاب إحصائيات صادمة للحروب في الوطن العربي، منها:
– ٨٥٪ من النزاعات المسلحة في الوطن العربي خلال العقود الأخيرة كانت داخلية أو مدفوعة بتدخل خارجي.
– ١٣ دولة عربية شهدت حروبًا أو اضطرابات مسلحة منذ عام ٢٠١٠.
– إنفاق بعض الدول العربية على الأمن تجاوز ٣٥٪ من ميزانيتها العامة دون مردود تنموي. وكلما زاد الإنفاق العسكري زادت هشاشة الداخل؛ لأن الإنفاق لم يوجه لتأمين الإنسان، بل لتحصين الأنظمة.
تُعد “المعضلة الأمنية” من أبرز المفاهيم التي يُفككها المؤلف، وهي الحالة التي تؤدي فيها محاولات دولة لتعزيز أمنها إلى تهديد جيرانها؛ فتدخل المنطقة في سباق تسلح ودوامات صراع
5. الوجود العسكري الأجنبي وآثاره:
يناقش المؤلف الأثر العميق للقواعد الأجنبية في دول عربية عدة، ويشير إلى أن هذه القواعد تحولت إلى أدوات لإعادة تشكيل النظام الإقليمي، وأدت إلى تقييد السيادة وتداخل الأمن القومي مع المصالح الغربية، حيث تسهم هذه القواعد في تفتيت المركب الأمني العربي لصالح مركبات بديلة، و”لا يمكن بناء أمن جماعي عربي بوجود أكثر من 25 قاعدة عسكرية أجنبية على أراضينا.”
6. هشاشة المركب الأمني العربي:
المركب الأمني هو النظام الذي يفترض أن يربط دول الإقليم بشبكة مصالح أمنية مشتركة، لكن المؤلف يرى أن هذا المركب هش؛ لأنه قائم على أنظمة لا على مجتمعات، وتُهيمن عليه الخصومات الأيديولوجية بدل الرؤى المشتركة.
7. الثقافة الأمنية المعاصرة:
في هذا المحور ينتقد المؤلف الثقافة الأمنية في الدول العربية، والتي تقوم على: شخصنة الأجهزة الأمنية وربطها بالنظام الحاكم، إضافة لتغييب الشفافية والمساءلة، وتدريب الأفراد على الطاعة لا التفكير؛ مما يؤدي في النهاية إلى قطيعة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني. ويقول: “ما نملكه هو أجهزة ضبط، لا مؤسسات أمن؛ عقيدة أمننا تقوم على الشك لا الوقاية.”
8. تحديات التغيير:
يسرد المؤلف التحديات الكبرى أمام إصلاح القطاع الأمني، ومنها:
– غياب الإرادة السياسية.
– ضعف الكفاءات والنخب.
– الإعاقة البيروقراطية والتشريعية.
– الارتهان للتدخلات الخارجية.
ورغم كل ذلك، يفتح المؤلف الباب للتغيير التدريجي إن تم دمج المجتمعات في التصور الأمني، وتخلي الأنظمة عن احتكار الرواية الأمنية.
في الوطن العربي: ٨٥٪ من النزاعات المسلحة خلال العقود الأخيرة كانت داخلية أو مدفوعة بتدخل خارجي، و١٣ دولة عربية شهدت حروبًا أو اضطرابات مسلحة منذ عام ٢٠١٠، كما أنّ إنفاق بعض الدول العربية على الأمن تجاوز ٣٥٪ من ميزانيتها العامة دون مردود تنموي، وهذا الإنفاق موجّه لتحصين الأنظمة لا لتأمين الإنسان
الفصل الثالث/ من النظرية إلى التطبيق – نحو أمن إقليمي جديد:
ينتقل المؤلف في فصله الثالث إلى تقديم نماذج عملية لبناء أمن عربي متماسك، ينطلق من الخصوصيات، ويستفيد من التجارب العالمية دون أن ينسخها.
1. الخلفية التاريخية للأمن الإقليمي:
يراجع المؤلف محاولات بناء أنظمة أمنية عربية منذ الحرب الباردة، كمعاهدة الدفاع العربي المشترك التي لم تفعّل إلا مرة واحدة، وفشل المحاور السياسية كمحور الصمود أو مجلس التعاون العربي أو تجربة الجامعة العربية التي لم تنتج إطارًا أمنيًا فعالاً؛ وذلك لأنّ “ما يُسمى التعاون الأمني العربي ظل رهينة المزاج السياسي، لا المصالح المشتركة.”
2. مهددات الأمن العربي (المحلي والإقليمي والدولي):
يرسم الكتاب خريطة دقيقة لمهددات الأمن:
– محليًا: الفقر، البطالة، التفكك الأسري، ضعف التعليم.
– إقليميًا: التدخل الإيراني والتركي، النزاعات المزمنة، الصراع العربي – الإسرائيلي.
– دوليًا: الهيمنة الغربية، الحرب على الإرهاب، تغول الشركات الأمنية.
“فلا أمن بلا عدالة اجتماعية؛ ولا استقرار دون مصالحة مع الجغرافيا والتاريخ”.
3. إصلاح قطاع الأمن الوطني:
يُقدم الكتاب مقترحات تفصيلية لإصلاح الأجهزة الأمنية، ومنها:
– إعادة هيكلة المؤسسات وتحديد مهامها.
– ربط الأجهزة الأمنية بالقانون والدستور.
– تدريب الأفراد على مهارات التواصل والحقوق.
– إدخال تقنيات حديثة للمراقبة دون الإخلال بالخصوصية.
4. الإجراءات التأسيسية لبناء مركب أمني إقليمي:
يطرح المؤلف خمس خطوات تأسيسية لبناء مركب أمني إقليمي:
– صياغة عقيدة أمنية عربية غير أيديولوجية.
– بناء مراكز تفكير أمنية مشتركة.
– تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول.
– استثمار التكنولوجيا الأمنية بموارد محلية.
– إشراك المجتمع المدني في رسم السياسات الأمنية.

5. اللعبة الكبرى- موازين القوى والأدوات:
يركّز هذا المحور على أهمية فهم «اللعبة الكبرى» في المنطقة، وكيف نشأ هذا المصطلح، ويشير المؤلف إلى أن ظهور المصطلح كان في النزاع بين بريطانيا وروسيا على أفغانستان حيث كانت تخشى بريطانيا من وصول روسيا إلى الهند، ثمَّ ظهر مصطلح المسألة الشرقية والتي تشير إلى التحالفات بين الدول الغربية في نهاية القرن التاسع عشر لاقتسام أراضي الدولة العثمانية، وما نتج عنه من الصراع على الدولة العثمانية بين الدول.
وبيّن المؤلف أنَّ عملية تفكيك المعضلة العربية يجب أن تبدأ من تحقيق الأمن الإنساني بديلاً عن الصيغ الموجودة، والتي تتمثل في تغول مؤسسات الحكم الاستبدادية المعزولة عن المجتمع، ومن ثمَّ الاعتماد على النظرية الواقعية في بناء الدولة، وبعدها تأتي الاستفادة من النظرية الليبرالية في توسيع دائرة التحالفات الخارجية وتحفيز دور المنظومات الأمنية خارج إطار الإقليم، ومحاولة التوصل إلى مفاهيم مشتركة للأمن ومخاطر غيابه من منظور المدرسة البنائية.
لا أمن بلا عدالة اجتماعية؛ ولا استقرار دون مصالحة مع الجغرافيا والتاريخ
ويعرض المؤلف المكونات التي يمكن الاستفادة منها لرسم خريطة اللعبة الكبرى والتي يمكن تلخصيها بما يلي:
الخريطة: تُظهر تمركز القوى الأجنبية، ومناطق النزاع الساخنة، لمعرفة القوى الفاعلة واللاعبين الأساسيين، والتغير الذي قد يطرأ على الخريطة، مع تحديد القوى والدول المتوسطة والصغيرة.
الوزن الاستراتيجي: من خلالها معرفة الدول الأطراف كالسعودية ومصر وتركيا والتي تمثل ثقلاً حاسمًا، ويمكن أن تكون طرفًا أساسيًا في اللعبة الكبرى في المنطقة.
أدوات التأثير: الإعلام، الاقتصاد، الشركات الأمنية، السيبرانية، وكذلك تحديد الأدوات سواء العسكرية أو المعاهدات أو غير ذلك، لأنّ “مَن لا يملك أدوات اللعبة، لا يملك حق الجلوس إلى طاولتها.”
6. استراتيجية إدارة الصراع:
يناقش الكتاب أربعة نماذج لإدارة الصراع:
– الردع: عبر بناء قوة كافية لثني الخصم.
– الاحتواء: محاصرة الخصوم إقليميًا.
– المناورة: اللعب على التوازنات الدولية.
– التحصين الداخلي: يجعل المجتمعات أكثر مناعة ضد الفوضى.
7. العودة إلى الأصول- الأمن من منظور حضاري:
في الخاتمة، يعود المؤلف إلى ضرورة استلهام النموذج الإسلامي في الأمن، حيث كرامة الإنسان هي أساس الحماية.
العقد السياسي يقوم على الشورى والمشاركة لا القهر، والأمن جزء من مقاصد الشريعة لا مجرَّد جهاز دولة، و”الأمن ليس درعًا، بل بيئة؛ وليس مجرد غياب تهديد، بل حضور طمأنينة.”
خاتمة/ نحو أمن عربي للإنسان لا النظام:
كتاب د. بشير زين العابدين ليس مجرد دليل أكاديمي، بل محاولة تأسيسية لإعادة التفكير بالأمن من منطلق حضاري واقعي وإنساني، عبر تشريح المفاهيم، ونقد التوظيف السلطوي، وطرح نماذج إصلاحية، يفتح المؤلف الباب لنقاش عربي جديد حول: ماذا نريد من الأمن؟ ولمن؟ وكيف؟
إنها دعوة للانتقال من عسكرة البقاء إلى مدنية الحماية، ومن خوف الأنظمة إلى أمان الشعوب.
الأمن ليس درعًا، بل بيئة؛ وليس مجرد غياب تهديد، بل حضور طمأنينة
أ. أحمد أرسلان
مدوِّن، ومتخصص في صناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي
[1] من التعريف بالكتاب على الغلاف الخلفي.
مدوِّن، ومتخصص في صناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي.



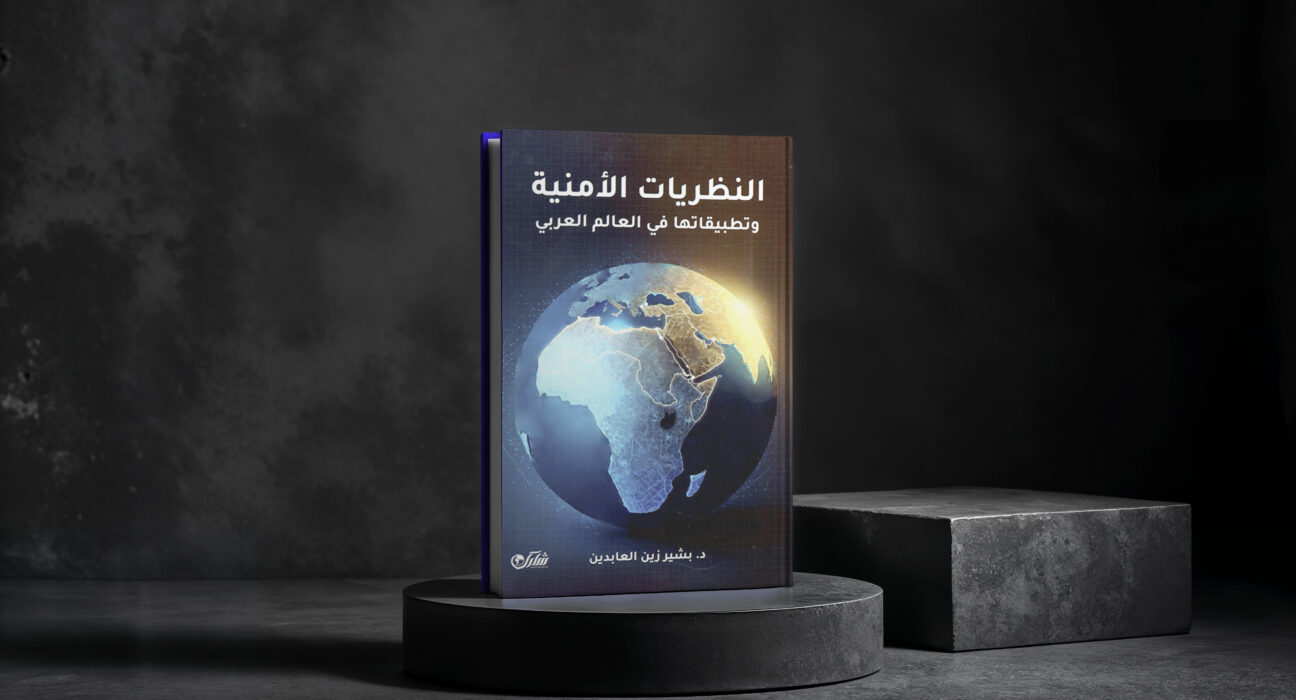
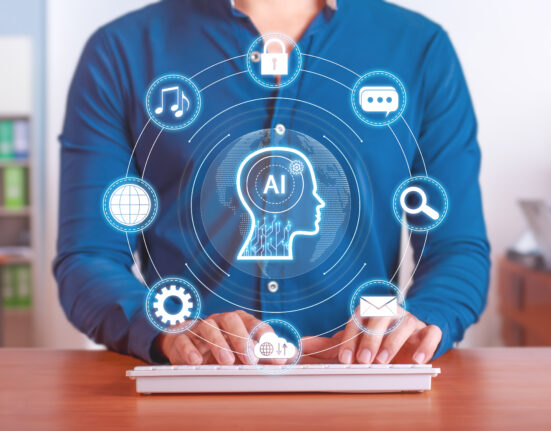

1 تعليق
التعليقات مغلقة