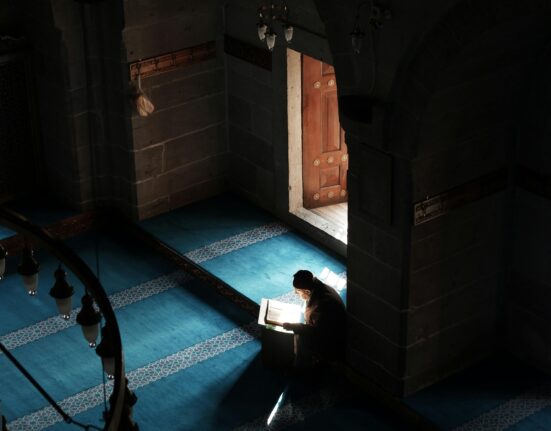فُتحت دمشق، وسقط نظام الأسد، وزال الخوف، وتنفس الناس الحرية بعد الحرمان منها عقودًا من الزمن، {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} [يونس: 58]، {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 4 بِنَصْرِ اللَّهِ} [الروم: 4-5].
وبعد أن كان الناس في بلاد الشام ضعفاء مطاردين في شتى أنحاء الأرض، مضيَّقًا عليهم في شؤون دينهم ودنياهم؛ إذ بهم ينتقلون إلى عزّ النصر، وفسحة الحرّية، والوصول إلى سدّة الحكم والسلطة، {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الأنفال: 26].
الابتلاء بالنصر:
الابتلاء سنّة من سنن الله في الكون، يختبر بها خلقه، قال سبحانه: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2]، وقال عزّ وجلّ: {الم 1 أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ 2 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} [العنكبوت: 1-3].
ومن أعظم أهداف هذا الابتلاء على ما فيه من شدّة ومجاهدة، وصبر ومصابرة وتضحيات: تنقية القلوب، وتزكية النفوس، وتمحيص الصفوف، وتربية الأجيال؛ حتى تكون الأمة مهيئةً للدور العظيم الذي ستقوم به، {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} [البقرة: 214].
وكما أنّ الشدّة ابتلاء، فإنّ النصر ابتلاء أيضًا، بل ربما تكون الفتنة به أعظم؛ لأنّ النفوس أيام الشدّة تكون في ضيقٍ وكرب، وقلّةٍ وخوف، وانقطاع الرجاء بالناس؛ فتقترب من ربّها وتلجأ إليه، وتزهد في الدنيا وتبتعد عنها، أمّا في حال الرخاء فإنّ النفوس لا تعيش هذه الضرورات، ولا تشعر بها، بل ترى أنّ من حلاوة النصر التمتّع بالدنيا وقد فتحت أبوابها، وأنّ ما حصل هو الغاية والنتيجة وقد حان وقت قطف الثمار وتعويض ما فات منها.
لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبّه أصحابه إلى ذلك وهم في زمن شدّة فقال: (فوالله ما الفقرَ أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم)[1].
كما أنّ الشدّة ابتلاء، فإنّ النصر ابتلاء أيضًا، بل ربما تكون الفتنة به أعظم؛ لأنّ النفوس أيام الشدّة تكون في ضيقٍ وكرب، وقلّةٍ وخوف، وانقطاع الرجاء بالناس؛ فتقترب من ربّها وتلجأ إليه، وتزهد في الدنيا وتبتعد عنها، أمّا في حال الرخاء فإنّ النفوس لا تعيش هذه الضرورات، ولا تشعر بها، بل ترى أنّ من حلاوة النصر التمتّع بالدنيا وقد فتحت أبوابها، وأنّ ما حصل هو الغاية والنتيجة وقد حان وقت قطف الثمار وتعويض ما فات منها.
استخلاف مشروط:
إنّ الاستخلاف في الأرض والتمكين للمؤمنين ليس مجرّد مكافأة لهم على صبرهم وجهادهم، وليس هو نهاية المطاف، وإنّما هو تكليف جديد، غايته الابتلاء والاختبار بنوع آخر من العمل والجهاد، قال تعالى: {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 129]، وقال سبحانه: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: 41].
قال سيد قطب: “الاستخلاف ليس مجرّد الملك والقهر والغلبة والحكم، إنّما هو هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء، وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه، وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدّر لها في الأرض، اللائق بخليقة أكرمها الله. إنّ الاستخلاف في الأرض قدرةٌ على العمارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد، وقدرةٌ على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر، وقدرةٌ على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان”[2].

فما بعد النصر والتمكين جهد وعمل قد يفوق الجهد قبله، وإن اختلفت الطبيعة والمسارات، وعلى رأس ذلك:
1. نسبة هذا النصر لله تعالى وقوّته وفضله:
وأنّه سبحانه كما مَنَّ بالنصر فهو قادر على سلبه؛ مما يستدعي التواضع للخالق وعدم التكبّر على الخلق، وحفظ حدود الله، {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 26].
ومَن لم يقم بحقّ هذه النعمة أُخذت منه كما أُخذت ممن كان قبله، مهما كانت قوته وجبروته في الأرض: {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ} [فصلت: 15].
ونسبةُ النصر لله والتعلّق به في طلبه أمر دقيق، مكانه في القلوب، ومتى اختلّ هذا الميزان جاءت النتيجة عكسية، لتثبت للعبيد أنّه ليس لهم من الأمر شيء، قال سيد قطب في قوله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا} [التوبة: 25]: “ويوم حنين الذي هزموا فيه بكثرتهم ثم نصرهم الله بقوته، يوم أن انضمّ إلى جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء، يوم أن غَفَلَت قلوب المسلمين لحظاتٍ عن الله مأخوذةً بالكثرة في العدد والعتاد؛ ليعلم المؤمنون أنّ التجرّد لله وتوثيق الصلة به هي عدّة النصر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة في العدد والعتاد؛ وحين يخذلهم المال والإخوان والأولاد… هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين -للمرة الأولى- جيش عدّته اثنا عشر ألفًا؛ فأعجبتهم كثرتهم، وغفلوا بها عن سبب النصر الأول، فردّهم الله بالهزيمة في أوّل المعركة إليه، ثم نصرهم بالقلّة المؤمنة التي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصقت به”[3]، بل حكى الله تعالى عما فعله بقارون حينما نسب الثروة التي امتلكها إلى نفسه، {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} [القصص: 78]، فكانت النتيجة: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ} [القصص: 81].
كما مَنَّ الله سبحانه بالنصر فهو قادر على سلبه؛ مما يستدعي التواضع للخالق وعدم التكبّر على الخلق، وحفظ حدود الله، ومَن لم يقم بحقّ هذه النعمة أُخذت منه كما أُخذت ممن كان قبله، مهما كانت قوته وجبروته في الأرض.
2. العبودية لله تعالى في جميع الشؤون:
ويشمل ذلك الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 55].
وتتحقق العبودية بتجنّب ما يخالف الشريعة في القوانين والأنظمة والمعاملات وفي سائر شؤون الدولة، ففيما أباحه الله -وهو كثيرٌ متّسعٌ- مندوحة عما حرم ونهى.
أما الخروج عن سبيل الله وكفر نعمته فهو مؤذن بخراب العمران وزوال الدولة، {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء: 16]، {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [النحل: 112].
3. الإصلاح في الأرض ومنع الفساد:
فهو من أهم غايات استخلاف الإنسان على الأرض، ويدخل في ذلك دخولاً أوليًا: إقامة الدين وشعائره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: 41].
ومما يدخل في الإصلاح: إعادة العمران على أساس سليم، وإنجاز ما يتطلّبه من خطط وبنىً تحتية، وتأسيس أنظمة اقتصادية عادلة ينعم فيها الغني ولا يضام فيها الفقير، ويجد كلّ قاصدٍ للكسب مكانًا، واتخاذ الأسباب التي تقوّي الدولة وتمكّنها وترفع من شأنها، وفي ذلك يقول ابن خلدون نقلاً عن بعض الحكماء: “المُلك بالجند، والجند بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالعمارة، والعمارة بالعدل، والعدل بإصلاح العمّال، وإصلاح العمّال باستقامة الوزراء”[4].
ومن ذلك التعاون على البر والتقوى، وترك الأخلاق التي عمل النظام البائد على ترسيخها في الناس طوال فترة حكمه، مثل: الأنانية والأثرة، وحب الدنيا وحب الذات وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة الجماعية، والسعي في تحصيل المنافع مهما كان حكمها، وأيًا كانت السبل الموصلة إليها، وإصلاح هذه الجوانب من استحقاقات المرحلة ومتطلبات التمكين.
4. تحقيق العدل والأخذ على يد الظالم:
فإنّ أعظم فساد الطغاة: ظلمُ الناس، ولذلك من أوّل ما يجب على الحكّام إزاحة هذا الظلم عن كاهل الشعوب، ونشر العدل بينهم كما أمر تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
والظلم هلاك للبلاد والعباد، قال تعالى: {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا} [الكهف: 59]، وقال: {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ} [إبراهيم: 45].
ومما يجدر التنبّه له أنّ مسؤولية الحاكم في إقامة العدل وإماتة الظلم كبيرة؛ فكلاهما يسري في الناس بحسب ما ينتهجه الحاكم من سلوك، روى البخاري رحمه الله أنّ “امرأة سألت أبا بكر رضي الله عنه، قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس”[5].
وروى ابن كثير رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعدما أرسل إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه غنائم الفرس على كثرتها وعظمتها، أن عمر لما نظر إلى ذلك قال: “إن قومًا أدوا هذا لأمناء”، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “إنك عففت فعفَّت رعيتك، ولو رتعت لرتعَت”[6]. وهكذا جرت العادة وقامت السنن في سريان أخلاق وقيم الحكام في الشعوب.
مما يجدر التنبّه له أنّ مسؤولية الحاكم في إقامة العدل وإماتة الظلم كبيرة؛ فكلاهما يسري في الناس بحسب ما ينتهجه الحاكم من سلوك
5. الحذر من التفرّق والاختلاف:
التفرق شرّ وفتنة، قال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 105]، وهو طريق للفشل والضعف، وخسارة النصر وما ترتّب عليه، قال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46]. وممّا يزرع بذور التفرّق والاختلاف: الدعوات الجاهلية القائمة على مخالفة شرع الله، والعنصرية المقيتة، والرويبضات، وغير ذلك.
وتقع مسؤولية التحذير من هذا التفرّق والاختلاف ومنع تضخّم آثاره حال حصوله -بالدرجة الأولى- على العلماء؛ فهم من أولي الأمر الذين تقتدي بهم العامّة، وهم قدوة لمن وراءهم، وهم أعلم بفقه الخلاف وضوابطه وآدابه.
التفرق شرّ وفتنة، وهو طريق للفشل والضعف، وخسارة النصر وما ترتّب عليه، وتقع مسؤولية التحذير منه ومن آثاره حال حصوله على العلماء بالدرجة الأولى؛ فهم من أولي الأمر الذين تقتدي بهم العامّة، وهم قدوة لمن وراءهم، وهم أعلم بفقه الخلاف وضوابطه وآدابه
القيام بشروط التمكين مسؤولية مَن؟
تمكين النصر وتثبيته مسؤولية الجميع، كلٌ بما يُحسنه ومن موقعه، مدنيًا كان أم عسكريًا، في موقعٍ قيادي أو غير قيادي؛ لا سيما مع التوسع الكبير في الحكم، والحاجة الكبرى لإعادة الإعمار والنهوض بالبلد من الخراب والدمار الذي أورثه النظام البائد، وهو تحدٍ كبير لنجاح الثورة وأهلها.
إن التمكين المنشود هو قوة الدولة ومنعتها العسكرية والسياسية، وتخلصها من التخلف الثقافي والمعرفي، وتحقيق الاستقلال المادي وامتلاكها لمواردها، وبروزها في العلوم المادية بأنواعها، وهذا لا يتحقق للمسلمين إلا بالتمكين الشرعي الذي منه العدل وإقامة الدين، وهو إحدى الضمانات المهمة لفاعلية الشام وأهله في المرحلة القادمة، وهو ما حرصت الدول الاستعمارية على سلبه منهم طوال العقود الماضية، مرةً بتقسيم المنطقة، ومرة بزرع الكيان الصهيوني، وأخيراً بتمكين عصابة مجرمة في سوريا وإعطائها الضوء الأخضر لاضطهاد الأكثرية من أهل السنة فيها، ثم تدمير مقدرات البلاد ونهب ثرواتها وتهجير أهلها، وجعل مدنها خراباً يتطلب إعمارها إمكانات كبيرة يتطلب توفيرها جهداً غير قليل.
وهذا يحتم المسؤولية على الجميع.
إن التمكين المنشود هو قوة الدولة ومنعتها العسكرية والسياسية، وتخلصها من التخلف الثقافي والمعرفي، وتحقيق الاستقلال المادي وامتلاكها لمواردها، وبروزها في العلوم المادية بأنواعها، وهذا لا يتحقق للمسلمين إلا بالتمكين الشرعي الذي منه العدل وإقامة الدين.
أسرة التحرير
[1] أخرجه البخاري (4015) ومسلم (2961).
[2] ينظر: في ظلال القرآن (4/2529).
[3] في ظلال القرآن (3/1616-1617).