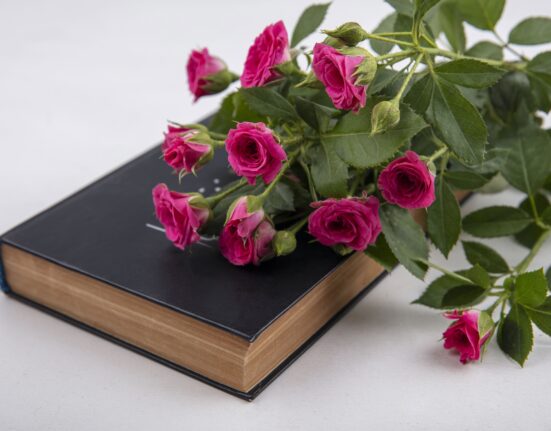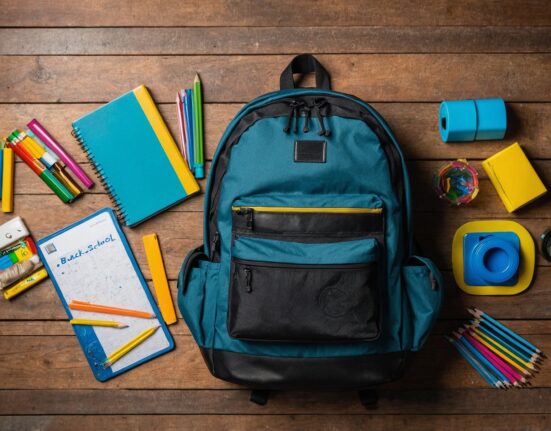يوضح المقال أن التغيرات المناخية تفاقمت بسبب الأنشطة البشرية، مما أثر سلبًا على الصحة والبيئة، ويُبرز المنظور الإسلامي الحلول المستدامة؛ مثل الحفاظ على البيئة، والترشيد، والتدوير، كما يؤكد أهمية التعاون الدولي، والسياسات الخضراء، ودور الدولة والمجتمع في مواجهة هذه الظاهرة، مع الأخذ بمبادئ الشريعة لحماية الأجيال المقبلة.
مقدمة:
رغم أن التغيرات المناخية ظاهرة بدأت منذ عدة قرون، إلا أن وتيرتها وحدتها زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة؛ نظرًا لما شهدته الأنشطة البشرية من اعتماد واسع النطاق على مصادر الوقود الأحفوري، وبخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل؛ وهو ما سبب ارتفاعًا مطردًا في درجة حرارة الغلاف الجوي وآثارًا خطيرة على الأنظمة البيئية والموارد والصحة العامة؛ بما يخل بضمان استدامتها وحفظ نظام التعايش فيها وحقوق الأجيال القادمة.
وانطلاقًا من الوعي العالمي بضرورة تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به الأديان ضمن الجهود العالمية الرامية إلى معالجة قضايا تغير المناخ، نُظمت قمة عالمية لقادة رموز الأديان (نوفمبر -2024م) في جمهورية أذربيجان، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين ورئاسة مؤتمر الأطراف COP29 واللجنة الحكومية للمؤسسات الدينية بأذربيجان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ، وتوجيه نداء عالمي مشترك للحد من الكوارث وحماية الكوكب من التهديدات البيئية.
ويوضح المقال مدى تكامل وشمولية الرؤية الإسلامية في معالجة قضية التغير المناخي، وواقعيتها من خلال تعاملها المباشر مع أصل المشكلة وليس نتائجها، بالإضافة إلى مرتكزاتها القائمة على العقيدة.
أولاً: التلوث البيئي وأضرار التغير المناخي:
يشير مصطلح تغير المناخ إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، الناتجة عن انبعاث غازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، الميثان، الكلورفلوركربون، أكاسيد النيتروز وغيرها). وتؤكد تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنَّ تركيزات غازات الدفيئة بلغت مستويات قياسية. فبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون على الصعيد العالمي 419 جزءًا في المليون، بزيادة تزيد على 50% مقارنة بمستويات تركيزه بفترة ما قبل الثورة الصناعية.
وأسهم تغيّر المناخ بشكل مباشر في حدوث حالات الطوارئ الإنسانية الناجمة عن موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف والأعاصير، التي تتزايد من حيث الحجم والتواتر والشدة.
ويؤثر تغير المناخ بشكل متزايد على الأمن البشري في جميع أنحاء العالم؛ إذ يمكن أن يؤدي هطول الأمطار المفاجئ والظواهر الجوية المتطرفة إلى إشعال فتيل التنافس على الغذاء والماء، كما يمكن أن يؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى فقدان شريحة واسعة من السكان لمورد رزقهم؛ مما يؤدي إلى زيادة التفاوتات الاقتصادية القائمة ووقوع المزيد من الناس في براثن الفقر. ويقدر تقرير للبنك الدولي أن ما بين 68 إلى 135 مليون شخص إضافي قد يقعون في براثن الفقر بحلول عام 2030م بسبب تغير المناخ.
كما تؤدي تأثيرات تغير المناخ بشكل متزايد إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان في جميع أنحاء العالم. فبحسب إحصاءات الأمم المتحدة تدفع موجات الجفاف والفيضانات والعواصف بالفعل إلى نزوح أكثر من 20 مليون شخص من منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى في بلدانهم كل عام.
كذلك يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل مباشر على صحة الإنسان، حيث يزيد الضغوط على الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة خاصة في فصل الصيف، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، إضافة إلى التسبب في حدوث ضربات الشمس وتأثر الصحة العقلية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية (WHO) يُتوقع أن يسبب تغير المناخ نحو 250 ألف حالة وفاة إضافية كل عام بسبب نقص التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري وحدها، خلال الفترة (2030-2050م). وتشير التقديرات إلى أن التكاليف المباشرة للضرر على الصحة (أي دون احتساب التكاليف في القطاعات المحددة للصحة مثل الزراعة والمياه وخدمات الصرف الصحي) تتراوح بين 2 و4 مليار دولار أمريكي في العام بحلول عام 2030م.
يؤثر تغير المناخ على الأمن البشري في جميع أنحاء العالم؛ إذ يمكن أن يؤدي هطول الأمطار المفاجئ والظواهر الجوية المتطرفة إلى إشعال فتيل التنافس على الغذاء والماء، كما يمكن أن يؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى فقدان شريحة واسعة من السكان لمورد رزقهم؛ مما يؤدي إلى زيادة التفاوتات الاقتصادية القائمة ووقوع المزيد من الناس في براثن الفقر
وقد تضمنت كتب التراث الإسلامي إشارات واضحة إلى الآثار الصحية لفساد (تلوث) الهواء، ومن ذلك ما أشار إليه ابن القيم (المتوفى سنة 751ه) في كتابه “الطب النبوي” حيث عقد فصلاً عن الأوبئة التي تنتشر بسبب فساد الهواء جاء فيه: “والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون، فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة؛ لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه، كالعفونة والنتن والسمّية، في أي وقت كان من أوقات السنة”[1].
وألف أبو بكر الرازي (المتوفى سنة 300ه) رسالة في “تأثير فصل الربيع وتغير الهواء تبعًا لذلك”، فيقول: “يظهر هذا الداء في فصل الربيع حين تنفتح الأزهار، فتملأ الجو بغبار الطلع الذي يدخل بتماس مباشر مع مخاطية الأنف، فيتسبب في هذا النوع الخاص من الزكام”[2].
وتحدث محمد بن أحمد التميمي المقدسي (المتوفى سنة 370ه) عن الباعث لتأليف كتابه “مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء”، فقال: “إني نظرت حال علماء الأطباء الساكنين بالأمصار الفاسدةِ الأهويةِ، والبلدان المشهورة بالأوبئةِ الكثيرةِ الأمراض، التي يحدث بها عند انقلابات فصول السنة الأمراض القاتلة والطواعين المهلكة؛ لأجل فساد أهويتها…”[3]، وفي المقالة الرابعة من كتابه يقول عن العلاقة بين تلوث الهواء والماء: “إن الجو إذا فسد بنوع من أنواع الفساد الداخلة عليه، مثل أبخرة المياه الغليظة المتصاعدة إليه، وباختلاف حالاته وتغيير أمزجته في فصول السنة… فلا محالة أنه يفسد لأجل ذلك أيضًا الماء المجاور لتلك الأهوية الفاسدة الذي يشربه أهل تلك البلدان وسكانها؛ لقبوله ما يحدثه فيه الهواء من الحر أو البرد أو العفن أو الغلظ؛ إذ الماء والهواء عنصران متجاوران يستحيل أحدهما إلى الآخر ويدخل أحدهما في أجزاء الآخر فيشابكه ويمازجه”[4].
من أجل ذلك، اعتبر بعض العلماء حفظ البيئة مقصدًا كليًا إلى جانب مقاصد الشريعة وضرورياتها الخمس (حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل)، فإفساد البيئة على هذه الوتيرة الخطيرة في الوقت الحاضر أمر يصعب معه تحقيق الاستخلاف في الأرض وعمارتها؛ وهو ما يصعب معه حفظ الدين. كما أن التلوث البيئي والتغيرات البيئية وما ينتج عنها من كوارث تزهق الأرواح يتنافى مع مقصد الشريعة في حفظ النفس. وأيضًا فإنّ إهدار الموارد واستنزافها – باعتبارها رأس مال طبيعي- والحروب التي تنشب للسيطرة عليها وما يترتب عليها من فقر وتشريد يتعارض مع حفظ المال والنسل والعرض. بالإضافة إلى ذلك فإن الوعي بطبيعة البيئة وقدراتها وسلوكيات التعامل معها برشد ومسؤولية فيه حفظ للعقل من أن يطغى في ذاتيته ونفعيته بما يدمر البيئة ويهلك الحرث والنسل.
اعتبر بعض العلماء حفظ البيئة مقصدًا كليًا إلى جانب مقاصد الشريعة وضرورياتها الخمس (حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل)، فإفساد البيئة على هذه الوتيرة الخطيرة في الوقت الحاضر أمر يصعب معه تحقيق الاستخلاف في الأرض وعمارتها؛ وهو ما يصعب معه حفظ الدين.
ثانيًا: إجراءات مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها في الشريعة الإسلامية:
إن حقيقة المشكلة البيئية لا تكمن في التكنولوجيا التي يمكن أن تنشأ عنها بعض المشاكل العَرَضية، وإنما تكمن في فهم الإنسان لنفسه ولواقعه البيئي (الوعي البيئي)، بالإضافة إلى المستحِثات الداخلية الدافعة أو الرادعة (الضمير البيئي). وقد قدم الإسلام في هذا الصدد تصورًا شاملاً ومنهجًا متكاملاً يحدد للإنسان المسؤوليات والضوابط، ويرسم له سبل التعامل الرشيد مع كل ما يحيط به من عناصر البيئة.
وقد ألمحت الآية (41) من سورة الروم إلى الدور المهـــم لسلوك الإنسان وممارساته في تدهور البيئية وتلوث مواردها، والذي عبرت عنه الآية الكريمة بالفساد، فقال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: 41]. وتبدو الآية الكريمة وكأنها عريضة اتهام للإنسان المعاصر، المستنزف لموارده، الملوث لعناصر بيئته. وقد تضمنت الآية إشارة لأربعة جوانب، وهي: الأول: حدوث تغيير سلبي في البيئة، وهو ما عبرت عنه الآية بقوله تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ}. الثاني: انتساب التغيير إلى التدخلات البشرية غير الرشيدة، وهو ما عبرت عنه الآية بقوله تعالى: {بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ}. الثالث: إلحاق الضرر بالبيئة بفسادها وصيرورتها غير صالحة أو ميسرة لما خلقت له، وهو ما عبرت عنه الآية بقوله تعالى: {لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا}. الرابع: عقاب المخطئ لعله يعود عن بغيه وإفساده، وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة، بقوله تعالى: {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.
(أ) مرتكزات الرؤية الإسلامية:
تزخر تعاليم الدين الإسلامي بالنصوص التي يشكل العمل بمقتضاها حلاً جذريًا لمشكلة التغير المناخي، وماهية ذلك ما يلي:
– خلق الله الأرض على هيئة الصلاح، ونهت تعاليم الشريعة عن إفسادها أو العبث بمواردها، قال الله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56].
– أمر الله الإنسان بعمارة الأرض، والعمارة نقيض الخراب، وتعني تمهيد الأرض وتحويلها إلى حال يجعلها صالحة للانتفاع بها وبخيراتها، قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61].
– من المقرر شرعًا أن سيادة الإنسان على الكون سيادة انتداب، وليست سيادة تملك وتسلط مطلق، فالإنسان قائم بما يقوم به الموكَّل من الحفظ والرعاية، وذلك مفهوم الخلافة الذي جاء به الإسلام، قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ} [الأنعام: 165]، وبناء على ذلك عليه الحفاظ على البيئة ومواردها؛ لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
– دعت تعاليم الإسلام إلى العيش في بيئة آمنة خالية من المخاطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)[5]، وهذا الحق يستوي فيه الناس دون تمييز لفئة على فئة أو لمكان دون آخر؛ ومن ثم فإن أي إجراء يترتب عليه أضرار بالبيئة فهو في حكم الشرع محرم.
(ب) إجراءات مواجهة خطر التغير المناخي من المنظور الإسلامي:
(1) دور الدولة:
* الالتزام بما تقرره مؤتمرات المناخ للحد من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا:
من خلال المشاركة في إغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي، لا سيما إذا كانوا من المسلمين؛ حيث تصير حينئذ واجبًا شرعيًا. ومعلوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يساند كل العقود والاتفاقات العادلة التي يتفق عليها الناس لدرء مفسدة، أو جلب مصلحة عامة، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يشيد بعقد أبرمته قريش في الجاهلية واتفقت فيه على نصرة المظلوم، وسمي هذا العقد بحلف الفضول، وقال عنه: (لو دُعيت به في الإسلام لأجبت)[6]. وهذا بالطبع يوجب انخراط علماء المسلمين ضمن مبادرات مواجهة التغير المناخي، لتحفيز المسلمين أفرادًا ومؤسسات وشعوبًا، نحو تنفيذ مقررات المناخ، انطلاقًا من الالتزام الأممي، وقبله الالتزام الديني والأخلاقي لاستنقاذ الحياة على كوكب الأرض، قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
* التناصح والأخذ على يد المارقين:
يُظهِر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، الصادر عام 2020م، تحت عنوان “تقرير التفاوت في الانبعاثات”، أن هناك تفاوتًا كبيرًا في حجم الانبعاثات الكربونية الصادرة. فدول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعند الأخذ في الاعتبار التأثير التراكمي لما أنتجته الدول من انبعاثات كربونية منذ بدء الثورة الصناعية، فإن مسؤولية الدول الصناعية الغربية عن التغير المناخي تصبح أكثر وضوحًا، بينما الدول الفقيرة هي الأكثر تضررًا. لذلك فإن الضغط على هذه الدول لتبني سياسات بيئية أكثر استدامة أمر مطلوب شرعًا، قال تعالى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ} [هود: 116].
* تبني سياسات وبرامج التحول الأخضر:
التحول الأخضر هو عملية تغيير واسعة تشمل التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة تهدف إلى حماية البيئة وتقليل الأثر السلبي على المناخ، ويشمل مجالات متعددة، مثل التحول إلى مصادر طاقة متجددة (كالطاقة الشمسية والرياح)، تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستدامة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والنقل.
ويُعد التشجير أحد أهم الحلول لمواجهة تغيُّر المناخ، حيث يشكل في ذاته استراتيجية مهمة لمعالجة تغير المناخ. فالأشجار والمساحات الخضراء بشكل عام تزيل الكربون من الغلاف الجوي من خلال عملية التمثيل الضوئي الطبيعية، والتي من خلالها تخزن الأشجار كميات كبيرة من الكربون من الغلاف الجوي في كتلتها الحيوية وفي التربة؛ مما يساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ. وقد حثت عليه تعاليم الإسلام، فقد جاء في عمارة الأرض بالغرس ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)[7]. وروى الأمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قامت على أحدكم القيامة وفي يده فَسيلة فليغرسها)[8].
التحول الأخضر هو عملية تغيير واسعة تشمل التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة تهدف إلى حماية البيئة وتقليل الأثر السلبي على المناخ، ويشمل مجالات متعددة، مثل التحول إلى مصادر طاقة متجددة (كالطاقة الشمسية والرياح)، تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستدامة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والنقل.
(2) دور المجتمع:
* تفعيل دور منظمات المجتمع المدني:
في خضم الاهتمام العالمي بتدابير مكافحة التغير المناخي برزت منظمات المجتمع المدني في تطوير وإصلاح السياسات البيئية والوطنية والعالمية للتصدي لتغير المناخ وتحقيق الأمن البيئي، من خلال تحفيزها على المشاركة المجتمعية، وتعزيز الوعي والتثقيف بقضايا تغير المناخ، والحث على تبني سلوكيات مستدامة، ودعم ومساندة الفئات الفقيرة والمهمشة المعرضة لأخطار بيئية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاعات الحكومية والخاصة للتأكد من التزامها بتطبيق سياسات مكافحة التغير المناخي وإصدار تشريعات تتعلق بهذا الشأن.
وقد دعت نصوص الشريعة في الكثير من المواضع إلى التناصح والتعاضد بين فئات وأفراد المجتمع، وجميعها تدعو في جوهرها إلى صور متعددة من المشاركة المجتمعية قولاً أو فعلاً، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وقال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]، ومن التطبيقات العملية لمفهوم المشاركة المجتمعية في مواجهة الأخطار التي تواجه المجتمع، ما ورد في سورة الكهف على لسان ذي القرنين، قال تعالى: {قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ} [الكهف: 95].
* إحياء دور الوقف البيئي:
يعتبر الوقف البيئي مصدرًا مستلهمًا من التراث والحضارة الإسلامية، كإسهام مؤسسي مالي وقانوني لتمويل ورفد العمل البيئي، وتطبيقاته المعاصرة، كمشروع الصكوك الوقفية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، حيث تعتبر الصكوك الخضراء أداة تمويلية جديدة استحدثت للاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، كبناء محطات توليد الطاقة الشمسية ومحطات الغاز الحيوي ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع النقل التي تقلل من الانبعاثات، والإدارة المستدامة للنفايات، والتكيف مع تغير المناخ.
* تضمين قواعد الفقه الإسلامي في التشريعات البيئية ذات الصلة بقضايا تغير المناخ:
من أمثلة هذه القواعد:
– لا ضرر ولا ضرار: تستند هذه القاعدة إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن “لا ضرر ولا ضرار”. أي لا يجوز الضرر ابتداء، وإذا حصل هذا الضرر فلا يجوز إيقاع الضرر في مقابلة هذا الضرر. ويندرج تحت هذه القاعدة “تدخين التبغ” على سبيل المثال، لما قد ثبت من ضرره، وكراهة رائحته وما يترتب عليه من إيذاء، بالإضافة إلى منافاته للمقصود الشرعي في الحفاظ على النفس والصحة والمال. فقد ثبت أن لتدخين التبغ العديد من التأثيرات البيئية الخطيرة، فلكي يجفف ورق التبغ يحتاج إلى اقتلاع ستمائة مليون شجرة على مستوى العالم يكون مصيرها الاحتراق، واستهلاك أكثر من أربعة أميال من الورق كل ساعة لتغليف وتعبئة السجائر، وهذه الأشجار كان باستطاعتها امتصاص 22 مليون طن من ملوثات ثاني أكسيد الكربون Co2 من الجو. يضاف إلى ذلك أن شركات التبغ تنتج سنويًا 5.5 تريليون سيجارة، لينتج لدينا أكثر من 4.5 تريليون فلتر غير قابلة لإعادة الاستخدام، بما يمثل خمس فضلات الإنسان على كوكب الأرض. ويحتاج كل فلتر إلى عدة شهور وربما سنوات لكي يتكسر إلى مواد بسيطة، كما يغذي التربة بأكثر من 600 مركب كيميائي غير مرغوب فيه[9].
– الضرر يزال: يعني ذلك أن الضرر ظلم يجب منع حصوله، وإذا حصل يجب إزالته. وإذا كان إفساد البيئة هو ضرر، فإنه يتحتم العمل على منع الأسباب المؤدية لحصوله. وإذا وقع هذا الضرر فإنه يجب العمل على مكافحته والوقاية من أضراره. على أن لا يزال الضرر بضرر مثله، فإذا كان هناك مصدر لتلوث الهواء في منطقة معينة (مصنع مثلاً)، فلا يزال المصنع لتنشأ مكانه محرقة قمامة.
– الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: أي يجب أن يزال الضرر الشديد بضرر أقل منه، ما دام ليس بالإمكان إزالته بدون ضرر. وهذا يعني وجوب العمل على إزالة الضرر كليًا متى ما كان ممكنًا. وإلا يجب على الأقل أن يستبدل به ما هو أقل منه ضررًا. فالصناعات الحديثة مثلاً تنفث غازات وعوادم تضر بالبيئة، وبالنظر لحاجة التقدم والحياة إلى آلاتها ومصانعها مما لا يستطاع الاستغناء عنه؛ لذا وجب العمل قدر الإمكان على الإقلال منها واستبدالها بآليات أقل إضرارًا بالبيئة[10].
– درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: استنبطت هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)[11]، لأن المنهيات مفاسد، فتحتم تركها جميعًا، وأما المأمورات فعلى المكلفين أن يأتوا منها ما استطاعوا. لذلك إذا تعارضت مصلحة ومفسدة يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. على أن ذلك مقيد بتساوي المفسدة مع المصلحة أو تكون أكبر منها. أما إذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة بكثير فتقدم المنفعة ولا ينظر إلى المفسدة القليلة. لذلك يجب الامتناع عن أي عمل من شأنه تلويث البيئة أو إفسادها إلا إذا كانت المصلحة المتوخاة من وراء هذا العمل كبيرة جدًا بحيث تطغى على المفسدة الناتجة عن هذا العمل، كإنشاء صناعة ضرورية لحياة الناس أو أمنهم فلا اعتبار هنا للمفسدة الناتجة عنها لأنها، أولاً: ضرورة تبيح محظورًا، ثانيًا: يجب أن يعمل في شأن هذه المفسدة بقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقاعدة أخف الضررين أولى[12].
– المتسبب يضمن بالتعدي والتفريط: هناك فرق بين التعدي والتفريط؛ فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات، أو الاستعمالات[13]. وهناك ما يعرف الآن بـ “ضريبة الطاقة”، وهي أداة سياسة مالية تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق تثبيط استهلاك الطاقة المشتقة من الوقود الأحفوري، ويمكن فرض ضريبة الطاقة على الأفراد والشركات على حد سواء بهدف تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
– ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام: يقع تحت طائلة الحرام هنا كل ما يضر الناس، ومن ثم فإن أي مصدر يضر الناس في صحتهم أو راحتهم، مثل انبعاث غازات تؤذيهم، أو إحداث ضوضاء تقلق راحتهم، يعدّ أمرًا غير مقبول.
– ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: فمثلاً إذا كان من مقتضيات الحد من تلوث البيئة في بلد ما ضرورة استصدار مرسوم أو وضع معايير تحدد مواصفات الملوثات التي تقذف بها عوادم المصانع والسيارات في بيئة هذا البلد، فإن استصدار مثل هذا المرسوم يصبح واجبًا؛ لأن الواجب الأصلي (حماية الناس من أضرار التلوث) لا يتم إلا به.
(3) دور الفرد:
– التربية البيئية من أجل وعي شامل بقضايا البيئة والمناخ: فالهدف الأعلى للتربية الإسلامية هو تنشئة المسلم المتكامل الشخصية وتنمية الدافع الأخلاقي كي يتحكم في نفسه ويوجه سلوكه ويحمي تصرفاته من ممارسة أي عمل يسيء إلى المجتمع والبيئة الطبيعية من حوله، ومن أمثلة هذه السلوكيات: الحرق المكشوف للنفايات والمخلفات الزراعية والتدخين والقطع الجائر للأشجار وغيرها.
– الترشيد وعدم الإسراف: حيث وضعت الشريعة الإسلامية قواعد للحفاظ على موارد البيئة وحمايتها من الاستهلاك الجائر، فكما أنه يتلفها ويفقدها القدرة على التجدد، ينتج عن ذلك كميات هائلة من النفايات تضر بالبيئة وتحدث خللاً في أنظمتها. ومن النصوص التي تدعو إلى الاعتدال والتوسط وعدم الإسراف قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31]، وقوله: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير مخيلة ولا سرف)[14].
– التدوير وإعادة استخدام الموارد: فقد أخرج أبو داوود والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: (لو أخذتم إهابها) فقالوا: إنها ميتة، فقال: (يطهرها الماء والقَرَظ)[15]، والقَرَظ: هو ورق السلم وهو معروف لدبغ الجلود. وللتدوير دور مهم في الحفاظ على موارد البيئة والحد من آثار التغير المناخي، فكل طن من البلاستيك المسترجع يقتصد 700 كجم من البترول الخام، وكل طن من الكرتون المسترجع يقتصد 2.5 طن من خشب الغابات، وكل ورقة مسترجعة تقتصد 1 لتر من الماء، 2.5 وات/ ساعة من الكهرباء و15 جرام من الخشب، وكل ذلك له مردود إيجابي بخفض كمية الانبعاثات الغازية؛ وبالتالي تقليل خطر التغيرات المناخية.
يعتبر الوقف البيئي مصدرًا مستلهمًا من التراث والحضارة الإسلامية، كإسهام مؤسسي مالي وقانوني لتمويل ورفد العمل البيئي، وتطبيقاته المعاصرة، كمشروع الصكوك الوقفية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، حيث تعتبر الصكوك الخضراء أداة تمويلية جديدة استحدثت للاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة
الخاتمة:
في ضوء ما سبق، يتضح شمولية وتوازن التصور الإسلامي لقضية التغير المناخي؛ بما يعيد تشكيل وجه القضية تمامًا، عبر تشجيع الاستجابة الاجتماعية لقضايا تغير المناخ. فلم تكتف تعاليم الدين بإقامة تصور ديني عن حماية المناخ وفق أحكامه الفقهية فقط، وإنما أُرسي هذا التصور على قواعد فكرية ومنطلقات إيمانية.
فالخطاب الديني الإسلامي في الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والمساهمة في علاجها، وجعل التوصيات العلاجية لهذه الظاهرة حالة دينية إيمانية -قبل أن تكون توجيهًا مدنيًا- تقوم على تعزيز المعايير الأخلاقية والقيم الإنسانية كهدف أساسي في تحقيق التنمية المستدامة. وانطلاقًا من ذلك؛ تتحدد بواعث وأولويات وكذلك توجهات وآليات العمل البيئي للحد من آثار التغير المناخي، كخفض الانبعاثات البيئية الناتجة عن استخدام المنتجات البترولية غير النظيفة، وتبني سياسات الإنتاج والاستهلاك المستدام وبرامج التحول الأخضر، وتعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا في الحد من أسباب التغير المناخي والتخفيف من حدة آثاره.
أ. د. صبحي رمضان فرج سعد
أستاذ جغرافية البيئة – كلية الآداب – جامعة المنوفية بمصر
[1] الطب النبوي، ص (33).
[2] قضايا البيئة من منظور إسلامي، لبدوي محمود الشيخ، ص (171).
[3] مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء، لمحمد بن أحمد التميمي المقدسي، ص (35).
[4] المرجع السابق، ص (185).
[5] أخرجه ابن ماجه (2340).
[6] البداية والنهاية (3/83).
[7] أخرجه البخاري (2320) ومسلم (1553).
[8] أخرجه أحمد (12902).
[9] الملحق العلمي لمجلة العربي، العدد 612، نوفمبر 2009م، ص (12-13).
[10] حماية البيئة بالقانون، للجيلاني عبد السلام ارحومة، ص (67).
[11] أخرجه البخاري (7288) ومسلم (1337).
[12] حماية البيئة بالقانون، ص (68).
[13] القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص (50).
[14] أخرجه أحمد (6695).
[15] أخرجه أبو داود (4126) والنسائي (4248).